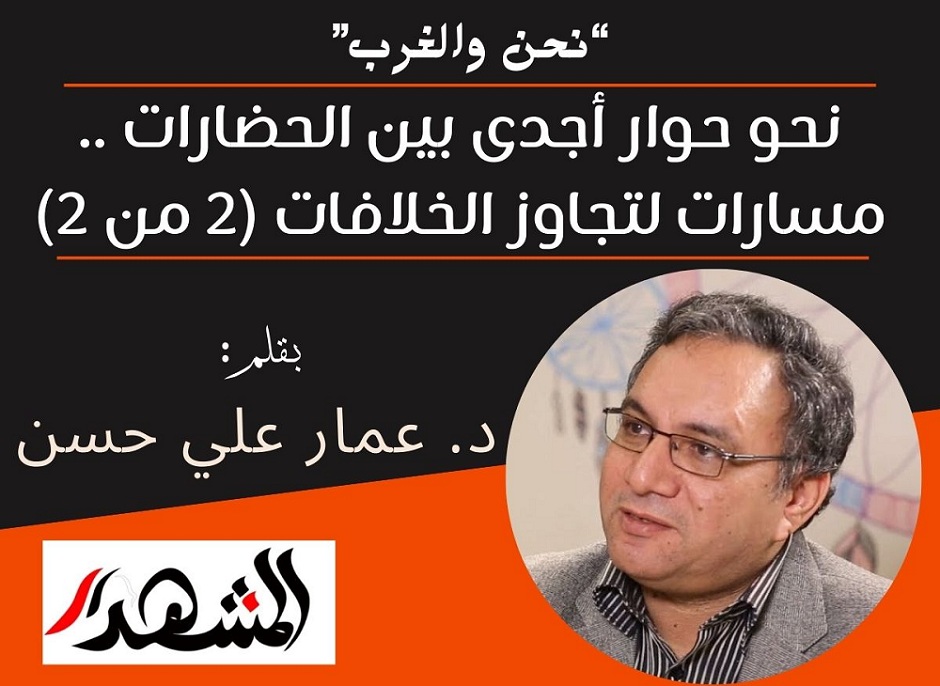ثانيا: ما يتم التحاور حوله ... مسارات لتجاوز الخلافات والاختلافات
من نافلة القول إن الحوار الناجح والنافع لا بد أن ينطلق من أرضيات مشتركة، ولا يهرب من هواجس أي من أطرافه، ويلبي احتياجات المنخرطين فيه والقائمين عليه، ويتصدى لمشكلات حقيقية تواجه الجميع، وهي مشكلات آنية، تعيش بيننا، وليست تلك المطوية في دهاليز التاريخ البعيد. وهذه الأرضية وتلك المشكلات والهواجس يجب أن تشكل إطارا للحوار، وتنبثق منها الركائز التي يهتم بها، ويدور حولها. ويمكن إجمال هذا الإطار في النقاط التالية:
أ ـ الاستشراق المنصف والاستغراب المنظم: فالاستشراق هو "المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق، بإصدار تقارير حوله، وإجازة الآراء فيه وإقرارها، ووصفه، وتدريسه، والاستقرار فيه، وحكمه .. وهو أسلوب غربي للسيطرة على الشرق، واستبنائه، وامتلاك السيادة عليه .. وهو إنشاء استطاعت به الحضارة الغربية أن تتدبر الشرق ـ بل حتى أن تنتجه، سياسيا واجتماعيا وعسكريا وعقائديا وعلميا وتخيليا، حتى أنه أصبح ليس بوسع أي إنسان أن يكتب عن الشرق، أو يفكر فيه، أو يمارس فعلا متعلقا به أن يقوم بذلك دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحدود المعوقة التي فرضها الاستشراق على الفكر والفعل .. ولا يعني هذا أن الاستشراق، بمفرده، يقرر ويحتم ما يمكن أن يقال عن الشرق، بل إنه يشكل شبكة المصالح الكلية التي يستحضر تأثيرها بصورة لا مفر منها في كل مناسبة، يكون فيها الشرق موضعا للنقاش"[1].
ونظرا لأن الاستشراق لم يكن كله عمليا منصفا يروم الحقيقة، إنما رأس حربة لمشروعات استعمارية، فإنه كرس صورا نمطية سلبية مغلوطة عن "الشرق" لاسيما عن العرب والمسلمين، مدفوعا بالنزعتين الاستعمارية والصهيونية. وتقوم الرؤية الاستشراقية على أنه إذا كان العربي ذا تاريخ على الإطلاق، فإن تاريخه جزء من التاريخ الممنوح له أو المستل منه. وبناء عليه ظهر العربي في الكتابات الغربية على أنه يمثل قيمة سلبية، وهو عدو للغرب، وعقبة أمكن تجاوزها لخلق إسرائيل، وارتبط في الأفلام والتلفاز على أنه شخص فاسق وغادر ومخادع ومتعطش للدماء وذي طاقة جنسية مفرطة، قادرا على المكيدة، ومراوغ وسادي وخؤون، ويظهر في أدوار قائد عصابات اللصوص المغيرين، والقراصنة، والعصاة من السكان الأصليين.[2]
وبدوره راح الإعلام الغربي يكرس جهدا وفيرا للحملة على العرب، وتشويه صورتهم، بعد أن انتهى من تشويه صورة الزنوج والهنود الحمر وبعض الأقليات التي تعيش في أوروبا وأمريكا.[3]ووصلت هذه الصورة المشوهة إلى مناهج التعليم نفسها، في مختلف المدارس الغربية،[4] لتصبح جزءا من مضامين التنشئة الاجتماعية.
أما "الاستغراب" فهو دعوة حالمة متفائلة لدراسة الغرب وتفكيك ثقافته وتوجهاته، ولفهمها وهضمها، لامتلاك آليات فاعلة للتعامل معها. لكن هذه الدعوة لم تنتج تيارا عريضا متدفقا مثل الذي أنتجه الاستشراق، وهي ليست سوى جهود فردية متناثرة، تضرب يمينا ويسارا، بلا هدف محدد، ولا خطة ناظمة. لكنها في كل الأحوال لا تقوم على تشويه الغرب، اللهم إلا في بعض كتابات أتباع التيار الإسلامي، مثل ما كتبه سيد قطب ومحمد قطب، بل تنطوي في أغلبها على الإعجاب به، ومحاولة تمثله، والاقتداء بما أنجزه في المعارف التطبيقية والإنسانية والفنون، وفي العمران البشري، لاسيما في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويحتاج حوار الحضارات إلى تصحيح الصور النمطية المغلوطة، وإلا ظل مجرد ترف نخبوي، ورتوش مزيفة، وخطابات علاقات عامة، تظهر وقت الأزمات، ويتم استخدامها مطية لأحوال السياسة وتقلباتها.
ويعني هذا تجاوز الرؤية الاستشراقية التقليدية المناطقية، التي بدأت مع حركة استعمار الغرب للشرق، وتقوم على أن العداء بين الاثنين أصيل ولا فكاك منه، وتفعيل الرؤية الاستشراقية المعدلة التي تدعو إلى الحوار بين الثقافات والحضارات والأديان انطلاقا من أن الصدام الحضاري ليس صداما حول المسيح ومحمد وكونفوشيوس، بقدر ما هو صراع يسببه التوزيع غير العادل للقوة والثروة والنفوذ، وصولا إلى "الرؤية المدنية الشعبية ـ القاعدية" التي تنهض على أكتاف الغربيين المتحررين من التراث الاستعماري، والنازعين إلى بناء روابط إنسانية، لا ترضخ للمصالح الضيقة للدول، ولا تنظر إلى "الآخر" باعتباره كتلة صماء، وترفض أي صراع على أساس الحضارات.[5] وقد عبرت هذه القوى عن وجودها في المظاهرات المناهضة للعولمة، والاحتجاجات الرافضة لغزو العراق، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ب ـ تهذيب علاقات السوق: فكثير من الأطروحات الاقتصادية التي عرفها العالم في العقدين اللذين أعقبا انهيار الاتحاد السوفيتي، ركزت على إطلاق الحرية لفعل الأسواق، قاصدة بهذا في الأساس، وبعيدا عن أي مخاتلة أو خداع مرتبطة بفضائل التحرر الاقتصادي الكامل، فتح الأبواب على مصاريعها أمام الشركات العملاقة المتعدية للجنسيات. وانطلقت هذه الفكرة من أن السوق بستطيع بمفرده، أو من تلقاء نفسه، أن يحقق التوازن الاقتصادي والنمو.
وتم فرض هذا المسار على العالم الثالث، ومنه العالم العربي والإسلامي، فراحت المنظمات المانحة والراعية تضع "أجندات" وتطالب دولنا بأن تلتزم بها، ولا تحيد عنها، باعبتارها "الوصفة العلاجية" الوحيدة القادرة على تحقيق النمو والتنمية. وتم فرض هذا المسار، من دون مراعاة ظروف ومصالح الدول الفقيرة، بل إن بعضها تم استخدامه كفأر تجارب للوقوف على مدى نجاعة رؤية اقتصادية غربية ما من عدمه. ولم تعط الدول المتقدمة صناعيا فرصة للدول النامية والمتخلفة في هذا المضمار، أن تدير معها حوارا حول "الأصلح اقتصاديا" أو المناسب لها.
وظل هذا الوضع قائما حين نكب العالم بأزمة مالية طاحنة، يعاني منها الجميع، وهي في بنيتها أزمة في النظام الرأسمالي الاحتكاري في تطوره وفي التزامه بأيديولوجيته الليبرالية الاقصادية الجديدة، وبالتالي تفتح الباب أمام سؤال محوري وجوهري وعريض حول مصير هذا النظام، وتعيد طرح المقولات والرؤى التي انتقدت الرأسمالية المفتوحة بلا نهاية وبلا ضوابط، ومنها ما ذكره كارل بولانتي أستاذ التاريخ الاقتصادي الإنجليزي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، من أن هناك كارثة تكمن في المسعى اليوتوبي لليبرالية الاقتصادية لإقامة نظام سوقي قادر على تنظيم نفسه بنفسه. وهو ما حذر منه آدم سميث نفسه حين ربط ببين الملكيات الكبيرة وعدم المساواة، وأكد أن الوفرة لدى الغني تفترض فقر الكثيرين، وهو قول شبيه بما هو منسوب إلى علي بن أبي طالب من أنه "ما متع غني إلا بما أفقر به فقير"،[6] لكن الغرب لم يكن معنيا بسماع أي أصوات من خارجه حول الطرق الاقتصادية الأفضل لتحقيق سعادة القطاعات الأعرض من البشر.
إن المطلوب في مواجهة الأزمة هو تأطير عمل الأسواق بواسطة تقنين اجتماعي تتجلى فيه مصالح الطبقات الشعبية، أي تحديد شروط توافق اجتماعي جديد خاص بالمرحلة، وقائم على تطوير ميزان القوى لصالح الشعوب، عبر تحقيق أهداف مرحلية مثل التوظيف الشامل للأيدي العاملة، وتعديل توزيع الدخل القومي، وإنعاش حركة التنمية، وكلها مسائل مرتبطة بإنعاش دور الدولة الوطنية، بوصفها الإطار المناسب، لبلورة وتنفيذ هذه المشروعات.[7] وهذا المطلوب لا بد أن يشمله أي حوار قائم بين الشمال والجنوب في الفترة المقبلة، وإلا ظل العالم يعاني من ويلات الأزمة المالية الراهنة.
وفي كل الأحوال فإن الأسواق هي مجال مفتوح لحوار حضاري، لا يسلط الضوء عليه كثيرا، إذ إنها المكان الذي يتعرف فيه البشر بعضهم على بعض في اختيار صامت، وإرادة لا تشكيك في وجودها. فالسلع التي تتدفق عبر الحدود، وتتناقلها الأيدي، ويقبل الناس على شرائها طائعين، هي واحدة من أدوات الحوار الضروري. وهذه الوسيلة تحمل في مضمونها وشكلها شيئين مهمين، الأول هو التعبير عما وصلت إليه دولة ما من تقدم تقني، والثاني هو تحديد مدى احتياج العالم لما تنتجه هذه الدولة، ومن ثم ترسيخ الاعتقاد في أهمية دورها، وبالتتابع إيمان الكل بأهمية الكل في حياته الاقتصادية.
وفي ظل سوق عادل، يمكن أن تقبل كل دولة على إنتاج السلعة التي تتمتع فيها بميزة نسبية، ويصبح الباب أمام تبادل السلع والخدمات مفتوحا، وهذا من شأنه أن يعزز الحوار بين الجميع. فالخلافات الاقتصادية، وإحساس الجنوب بأن الشمال يريد أن يبتلعه، تارة باستعماره ونهب ثرواته ومنها المواد الخام، وتارة بتحويله إلى تابع اقتصادي، بعد رحيل الاستعمار التقليدي، وتارة ثالثة باحتكار أسواق سلع بعينها، وحرمان الآخرين من فرص المنافسة في إنتاجها.
وهذه الأوضاع الاقتصادية خلقت حواجز عالية بين "الشمال" و"الجنوب" ألقت بظلاها على مجالات التعاون والحوار الأخرى. فالأفريقي الذي يتضور جوعا، لا يمكنه أن يغفر للرجل الأبيض قيامه بسكب الألبان وإلقاء آلاف الأطنان من القمح في المحيط الأطلسى، بغية الحفاظ على أسعاره مرتفعة. وإذا جلس الطرفان إلى طاولة للتحاور حول أي قضية، حتى ولو كانت ثقافية بحتة، فإن مثل هذا التصرف سيزحف، من دون شك، إلى عقول المتحاورين الأفارقة وألسنتهم، وسيقدمون على ذكره، وحتى لو احتفظوا بالضغائن في قلوبهم، فإنهم سيظلون طوال الوقت غير مقتنعين بجدية الرجل الأبيض أو الأصفر في التحاور معهم.
-------------------
بقلم: د. عمار علي حسن
[1] إدوار سعيد، "الاستشراق: المعرفة. السلطة. الإنشاء"، ترجمة: كمال أبو ديب، (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1995) الطبعة الرابعة، ص: 39.
[2] المرجع السابق، ص: 286 ـ 287.
[3] لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، أنظر: عزة عزت، "صورة العرب والمسلمين في العالم"، (القاهرة، مركز الحضارة العربية، 2002) الطبعة الأولى.
[4] أنظر:Group of Researchers, Arab&MuslimsImage in Education Textbooks Around the World, KSA, Riyadh, Ministry of Education, Al-Ma’rifa Magazine, Al- Ma’rifa Book, no 12, 1st Edition, 2003.
[5] سمير مرقس، "الآخر.. الحوار .. المواطنة"، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2006) الطبعة الثانية، ص: 80 ـ 87.
[6] منير الحمش، "الأزمة المالية الراهنة ومصير النظام الرأسمالي"، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي، يونيو 2009) العدد رقم (364)، ص: 13 و27.
[7] سمير أمين، "مقتضيات برنامج تحرر سياسي" في: فخري لبيب (محرر) مرجع سابق، ص: 77 ـ 78.
الجزء الأول من مقال د. عمار علي حسن