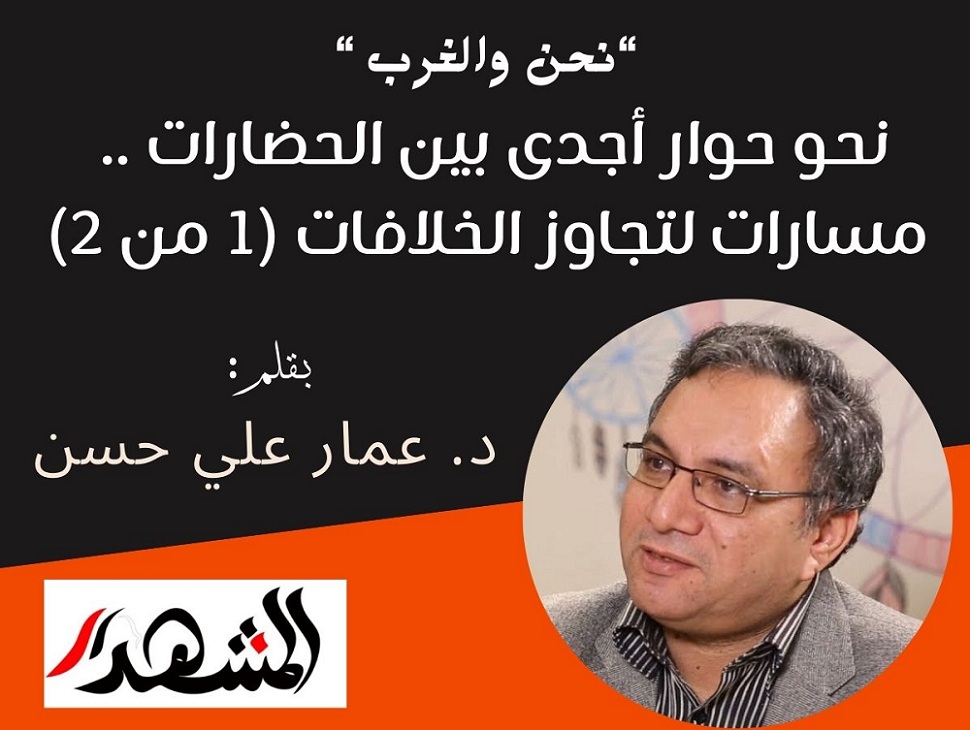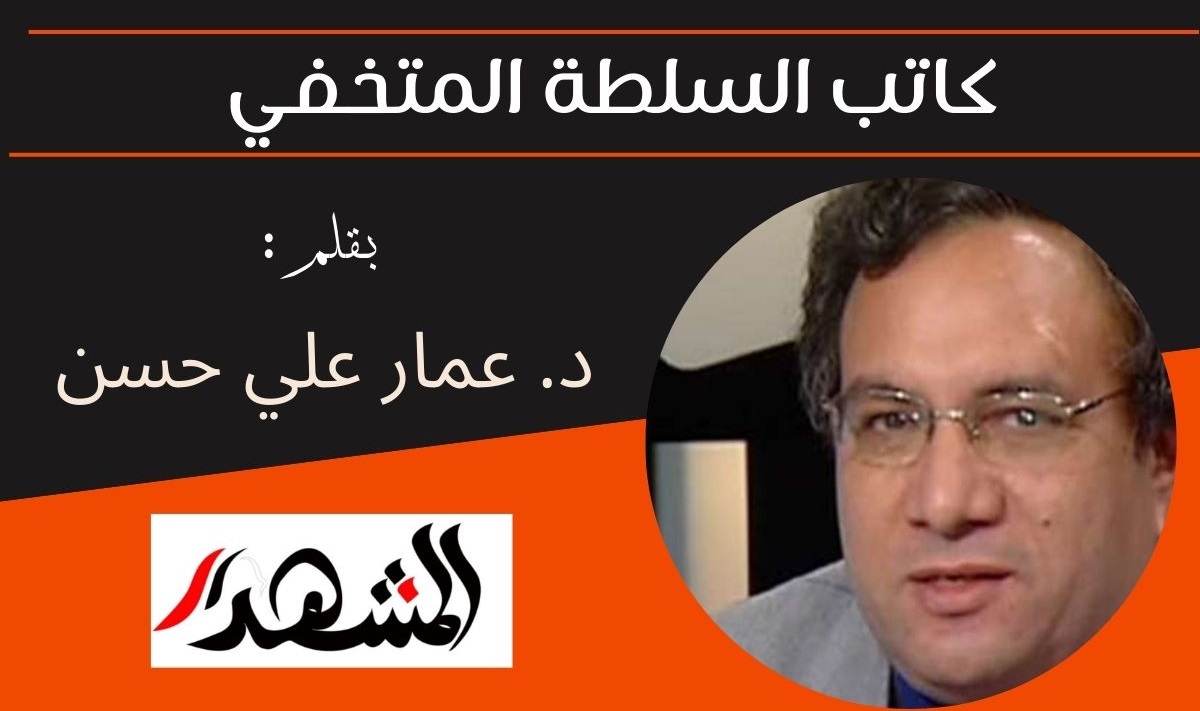في تلاحق الدوائر الحضارية نشبت صراعات وسالت دماء وسُطّر تاريخ من التناحر البشري، غلب على المسارات الإيجابية التي نجمت عن هذا التلاحق، وذلك التلاقح، الذي لا ينتهي بين الحضارات الإنسانية، على مستوى الفكر والحركة، والذي لولاه ما مضت حياة بني آدم على الأرض في خط متصاعد، بحثا عن الحقيقة والتمكن والرفاه.
وغلبة التناحر والتباغض على التعاون والتفاهم فيما تم تسجيله ورصده عن العلاقات المستمرة بين الحضارات يعود إلى أمرين أساسيين، الأول أن الصراعات المسلحة هي الأحداث الأكثر لفتا للانتباه، والتي تترك علامات يمكن معرفتها وتحديد معالمها بيسر وسهولة، وبالتالي أمكن تدوينها لتطغى على التفاعلات الناعمة، وغير المرئية، بين الحضارات والتي لها البقاء الفعلي، والفعل الإيجابي، الذي يغلب مع الزمن كل ما سطره المحاربون بكل عدتهم وعتادهم بدءا من سنابك الخيول والرماح الممشوقة المسنونة وانتهاء بجنازير الدبابات والصواريخ عابرة القارات. والثاني هو أن الإمبراطوريات استخدمت في تمددها العسكري تعبيرات ومفاهيم حضارية كخطاب تحايلي يرمي إلى تبرير مسلكها العدواني التوسعي، حيث تحدث قادة الجيوش عن رسالة حضارية مزعومة، وأرسلوا إلى الشعوب المراد غزوها رسائل تقول إنهم لا يستهدفون احتلال الأرض ولا نهب الثروات إنما تمدين الناس وترقية حياتهم وتخليصهم من حكامهم الطغاة.
لكننا في هذه اللحظة التاريخية الفارقة لا يجب أن نستسلم للمقولة التاريخية التي تتصور أن "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيان أبدا"، لأنها أولا من صك المحاربين وليست من صناعة أهل الفكر والدراية، وهي ثانيا تختلف مع منطق الحياة وطبيعة تطورها التي تقول بجلاء إن تاريخ الإنسانية عبارة عن طبقات يركب بعضها بعضا، وأن الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها صنعوا طيلة عمرهم المديد هذه الطبقات، فصارت رقائق حضارية متواصلة ومتداخلة ومتفاعلة.
وقد حاول بعض المفكرين الغربيين أن يهيلوا التراب على عطاء الحضارات الأخرى، ويهضموا حق شعوبها في الإبداع الخلاق، فروجوا لفكرة "المركزية الأوروبية" ذات الصبغة العنصرية والتي تتوهم أن شعلة الحضارة انتقلت من الإغريق الأقدمين إلى الأوربيين المحدثين، ولم تمر بأي وسائط، ولم تتأثر في نشأتها بأحد، ولم تنقل في وصولها إلى الزمن الحديث عن أحد. لكن هذه المغالطة لم ترض كثيرين بمن في ذلك علماء غربيين، تحدث بعضهم عن أن الإغريق نقلوا عن الحضارة الفرعونية، وأن العرب والمسلمين أضافوا الكثير إلى ما أنتجته القريحة الإغريقية، وأهدوه للإنسانية، فالتقطه الأوروبيون وهضموه واستفادوا منه، وزادوا عليه كثيرا حتى وصلنا إلى التقدم العلمي والتقني الرهيب الذي نعيشه الآن.
ولمّا أراد بعض العقلاء أن يقربوا بين البشر المختلفين في الألسنة والألوان والمشارب والأهواء والظروف الحياتية، ساروا في اتجاهين الأول هو حوار الحضارات والثاني يتعلق بحوار الأديان. لكن الطريق الأخيرة ملغمة إلى أقصى حد، فنقاط الخلاف بين الإسلام والمسيحية واليهودية تتمحور في جانب كبير منها حول العقيدة، وهي مسألة غير قابلة للتفاوض ولا التنازل أو المساومة. ورغم أن الأطراف المتحاورة تحاول تجنبها أو تدعي ذلك فإنها لا تستطيع أن تتجاوزها، ولم تنجح إلى الآن في تفرقة جلية بين "اللاهوت" و"الناسوت" . ولأجل كل هذا اقتنع كثيرون في نهاية المطاف، وبعد جولات عدة من النقاش والمداولة، أن الحوار يكون بين أتباع هذه الديانات، أو بين المتدينين أنفسهم، وليس بين الأديان ذاتها.
والوصول إلى تلك النقطة يجعل الحديث عن حوار الحضارات لا حوار الأديان هو الأجدى والأنفع. فالحضارة تشمل الدين، لكن الأخير لا يشملها، وفي الوقت نفسه فإن تجاذب أطراف الحديث حول الحضارات أخف وطأة على النفس وأيسر على العقل من التعامل مع العقائد. ووجه الشمول في المدخل الحضاري أنه يجمع بين الدين وغيره في نسيج واحد مترابط، فيبتعد الحوار عن المسائل العقدية ليركز على الثقافة النخبوية وطرائق المعيشة بما فيها العادات والتقاليد والموروث الشعبي ومستوى المعارف التي ارتقى إليها تجمع بشري ما، والأفكار المتداولة في لحظة التحاور، والآداب والفنون التي يتم إبداعها، وأنماط الإنتاج السائدة. ويدخل كل هذا محل نقاش حول سبل استفادة كل طرف مما لدى الآخر من هذا المخزون الحضاري، المادي والمعنوي، وهنا يصبح الباب مفتوحا أمام عطاء مجالات علمية وعملية عديدة ومنها السياسة والاقتصاد والاجتماع والفنون.
ويبدو أن الذين رفعوا شعار "حوار الأديان" بدأوا هم أنفسهم يتجهون إلى التحاور الثقافي والحضاري، غير منبت الصلة عن المصالح والسياقات العامة. والمثال الجلي على ذلك هو "المنتدى الكاثوليكي ـ الإسلامي" الذي انعقد مطلع شهر نوفمبر من عام 2008، حيث تم نقل الحوار بين ممثلي أكبر عقيدتين سماويتين على الأرض من مجال العقائد إلى مسارات الحياة، وهي المسألة التي جسدها البيان الختامي للمنتدى بدعوته إلي إرساء نظام مالي أخلاقي يراعي أوضاع الفقراء والدول المدينة، وبتعهد الطرفين العمل معا لمكافحة العنف الذي يرتكب باسم الدين، إلى جانب التأكيد على ضرورة الدفاع عن الحريات الدينية، ورعاية حقوق متساوية للأقليات الدينية، واحترام الشخصيات والرموز الدينية أيضا.
وهذا المنتدى، الذي قرر منظموه أن يُعقد كل سنتين أعطى البعد الحضاري للحوار بين المسلمين والمسيحيين زخما جديدا، وقدم برهانا ناصعا على أن فكرة "حوار الحضارات" هي الأجدى في اللحظة الراهنة للتقريب بين البشر الذين قال فيهم رب العزة في محكم آيات القرآن الكريم: "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا".
وأطروحة "حوار الحضارات" لم تمت أمام المد الكاسح للمقولات والتصورات المضادة، التي بنيت على أساس الصراع والصدام باعتباره "حتمية تاريخية" والتي رمت إلى تسويق المشروع الإمبراطوري للولايات المتحدة الأمريكية، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وانقضاء نظام "القطبية الثنائية". لكن حوار الحضارات واجه بفعل سياسات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة تحديا كبيرا في المسار والمصير، وظهر في لحظة ما وكأنه حيلة من قبل الضعفاء لترويض القوة المفرطة لأمريكا وحلفائها، دون أن يفقد المتحمسين له لأسباب إنسانية وقناعات سياسية في الغرب ذاته.
وربما يعود هذا إلى أن هناك إدراك لمعادلة حياتية تقول من دون مواربة أن "الحضارة كانت دائما وأبدا محور الالتقاء بين الشعوب المتنازعة، والتي كان صراعها السياسي والعسكري عادة ما ينتهي إلى التقاء حضاري تذوب فيه الخصومات، ويبدأ معه التفاعل الذي ينتهي إلى الاتصال والتعاون، والأخذ والعطاء، والتأثير والتأثر، والأهم من هذا وذاك التقاء الشعوب المتخاصمة، وبداية التعايش وتبادل الأفكار"[1].
وقد أثبتت أطروحة "حوار الحضارات" أنها إحدى الوسائل المهمة والحيوية لإنقاذ العالم برمته من جنون الصراع المفتوح، الذي أعاد الاستعمار التقليدي إلى التاريخ بعد أن ظن كثيرون أنه رحل إلى غير رجعة، وأوقع العالم في أزمة مالية طاحنة، مدت أياديها السوداء فأضرت الجميع، وبرهنت على أن العالم ليس منقسما إلى معسكرين متطاحنين، كما يطرح أسامة بن لادن في كلامه عن "الفسطاطين" ولا إلى عدة معسكرات يتحالف بعضها استعدادا لصراع ضروس بين الحضارات الإنسانية، كما زعم صمويل هنتجتون، إنما هناك مخاطر مشتركة، وغايات متطابقة، تضع الجميع، أو حتى الأغلبية، في خندق واحد، أو على الأقل في خنادق متلاصقة.
ومع إقصاء المحافظين الجدد عن البيت الأبيض، وتبني الرئيس باراك أوباما تصورات مغايرة، تنطوي على فتح حوار جاد وبناء مع العالم الإسلامي، بات من الضروري أن تفتح الأبواب على مصاريعها أمام كل من بوسعه أن يقدم أي مقاربة أو إسهام، جوهري أو عارض، عميق أو سطحي، متسع أو ضيق، لتعزيز التوجهات المعززة لحوار الحضارات. وحتى لو لم تأخذ هذه المقاربات طريقها إلى التطبيق الكلي أو الجزئي، فإنها ستسهم، من دون شك، في تشجيع الذهنية المنفتحة على الآخر، ومحاربة الانغلاق والجمود والتطرف، الذي يفضي إلى ممارسة العنف المتبادل بين أتباع الحضارات والثقافات.
يفضي التتبع الدقيق للخطاب الفكري لحوار الحضارات إلى نتيجة مفادها أن هذا الحوار يفتقر، حتى هذه اللحظة، إلى منهج محدد، ورؤية واضحة، وجدول أعمال يحوي الموضوعات التي ينبغي أن يدور حولها الحوار.[2] وقد ينبع هذا الخلل من اختلاف مقاصد إطلاق هذا الحوار لدى القائمين به والمشاركين فيه، وغلبة السياسي على الفكري، وعدم قيامه على أسس يتوافق عليها الجميع.
وحتى يتم هذا الحوار على أكمل وجه ممكن، فيجب أن نبحث عن مقاربات أكثر جدوى لتحاور الحضارات الإنسانية، تفتح الباب أمام إشراك فئات أخرى، وتطرح قضايا جديدة، وتعمق النقاش كيفا، وتزيده كما، بحيث يأخذ صيغة "التفاعل الخلاق" بين وحدات حضارية متجاورة ومتزامنة، مهما كان حجم التباينات القائمة، وتتجاوز مجرد توظيف المسألة الحضارية في إدارة الأزمات أو تلطيف حدتها، لتصبح منهج حياة عالميا، تساهم البشرية جميعها في صناعته، وتروم به ومعه التقليل من الصراعات الدولية، وتخفيضها إلى الحد الأدنى، سواء عن طريق الإطفاء التدريجي لوهج النزعات الإستعمارية، أو تقليم أظافر الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتبديد سوء الفهم المتبادل بين الشعوب.
وحتي يمكن ارتقاء هذه الغاية لابد من مقاربات أو مداخل متماسكة يراعي فيها توفير كل عناصر إيجابية مستطاعة في بيئة الحوار وأطرافه ووسائله ومحتواه وأهدافه. وهذا يتطلب الإجابة على الأسئلة الآتية: ما هي أوجه الخلافات والاختلافات بين الشرق والغرب التي حالت ـ حتى الآن ـ دون بناء حوار حضاري فعال؟ وعلى أي أسس أو ركائز يستند حوار الحضارات؟ وما هي المسارات أو المقاربات الناجعة التي يجب أن نسلكها في سبيل تعزيز هذا الحوار؟ وما هي القضايا التي يجب أن تشتبك الحضارات الإنسانية المعاصرة حولها؟ وما هي الأطرف المنوط بها إنشاء هذا الحوار ورعايته ومنحه قوة دفع دائمة؟ وإلى أي حد يشكل "حوار الحضارات" رافدا مهما من روافد بناء الذات وتحصينها في مواجهة "الآخر"؟ وهل بوسع البشر أن يقطعوا الطريق على أي صدام أو صراع سياسي في المستقبل؟ أم أن الإمكانات والاحتمالات تقف عند حد تقليل هذه الصراعات وتلك الصدامات، أو تخفيض نتائجها السلبية إلى الحد الأدنى؟
أولا: عيوب تصم الطرح الحالي لـ "حوار الحضارات"
هناك عدة عيوب وصمت العديد من المقاربات التي رمت إلى إطلاق الحوار بين الحضارات، وتحسين شروطه، يمكن ذكرها على النحو التالي:
1 ـ اختلاط الأدوار والقضايا، حيث تتداخل المسائل العقدية مع الفكرية، وتحل الرؤى والتصورات الدينية في وقت يكون فيه النقاش بحاجة ماسة إلى تجنيب ما يختلف عليه، ولا توجد فرصة في تغييره، ولا يحبذ أي من المتحاورين التنازل عنه، وإعلاء ما يتم الاتفاق حوله، وما يمثل قواسم مشتركة بين الجميع.
وما يزيد الطين بلة أن العديد من هذه الحوارات تُترك لرجال الدين وعلمائه، وهؤلاء ينصب اهتمامهم الأساسي على الدفاع عن المعتقدات والمسالك المذهبية، وتبرئتها مما يلصق بها من اتهامات، وما يلقي عليها من صور نمطية مغلوطة. ولا يعني هذا إبعاد المعتقد الديني عن الحوار برمته، إنما تخصيص مسارات له، تساعد المجرى الرئيسي للحوار والذي يجب أن ينصرف إلى القضايا الثقافية والمصالح المتبادلة في المجالات كافة.
2 ـ التوظيف السياسي لفكرة "حوار الحضارات" من قبل الدول الكبرى، فالسياسة تشكل جوهر الصراع الحضاري المزعوم، بل إن إمعان النظر في طبيعة الصراع الدولي الراهن، أو السابق، وربما اللاحق، يكتشف للوهلة الأولى. ففي حقية الأمر فإن "الحضارات لا تتصادم، وإنما تتصادم القوى السياسية والاقتصادية النافذة في حضارة من الحضارات مع قريناتها في حضارات وثقافات أخرى"[3]. والصراعات السياسية في حد ذاتها باتت من السمات والصفات والطبائع المستمرة لدى الكيانات البشرية، عائلات أو قبائل أو دول أو إمبراطوريات، لكنها المحاولات الزائفة التي تلبس هذا النوع من الصراعات لبوسا حضاريا، وتحاول أن تمده على اتساعه، وتمنحه عمقا، عبر ربطه بالحضارات، هي التي تشكل خطرا على الحوار الحضاري، وتجعل منه مجرد تكتيك في استراتيجية كبرى، أو تفصيل جزئي في تصور سياسي شامل ينطوي على رغبة عارمة في الهيمنة والاستحواذ من قبل الدول الكبرى على نظيرتها الصغرى.
3 ـ حصر الحوار في نطاق النخب، بشتى أنواعها، وعدم الإلتفات إلى الجمهور العريض، المعني بهذا الحوار، والذي يمكن أن يساهم في إنجاحه، لو وضعت خطة متكاملة الأركان، يشارك الجميع في صياغتها، من أجل إشراك الناس جميعا، في مشارق الأرض ومغاربها، في الحوار عبر مختلف أدوات الاتصال الجماهيري، التي شهدت ثورة كبيرة في السنوات الأخيرة.
4 ـ غلبة اللغة والتوجهات الاستعلائية، التي تنطلق من أن هناك أطرافا أقوى وأكثر تحضرا من الأخرى المتحاورة معها. ومثل هذا التصور يقود إلى إزكاء الصراع وتأجيجه، وليس إلى قيام حوار إيجابي يقود إلى التعاون. فالصراع يحدث عندما تختال إحدى الثقافات على الأخريات، وتعتبر نفسها الثقافة العظمى، ودونها الصغريات، "والعلاقة بينهما هي علاقة ميتافيزيقية، علاقة بين الواحد والكثير، علاقة ذات صلة بالوجود، علاقة بين الإله والمخلوقات، بل إنها علاقة أخلاقية بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن، إنها ثقافة واحدة، في سعيها إلى القوة، تتجاوز كل الثقافات الأخرى، وتتفوق عليها"[4].
(الجزء الثاني من المقال ما يتم التحاور حوله ... مسارات لتجاوز الخلافات والاختلافات - ينشر غدا)
------------------------
بقلم: د. عمار علي حسن
هوامش
[1]كاي حافظ (محرر)، "الإسلام والغرب وإمكانية الحوار"، ترجمة: صلاح محجوب إدريس، (القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2005)، الطبعة الثانية، ص: 7.
[2]السيد يس، "الديمقراطية وحوار الثقافات: تحليل للأزمة وتفكيك للخطاب"، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2007) الطبعة الثانية، ص: 285.
[3]جميل مطر، "حوار الحضارات ... السياسي أولا"، (بيروت، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية)، العدد رقم (325) مارس 2006، ص: 56.
[4] حسن حنفي، "الثقافات: صراع أم حوار ... نموذجان بديلان"، في: فخري لبيب، "صراع الحضارات أم حوار الثقافات؟"، (القاهرة: مطبوعات التضامن، 1997) الطبعة الأولى، ص: 55.
مقالات سابقة في ملف "نحن والغرب"