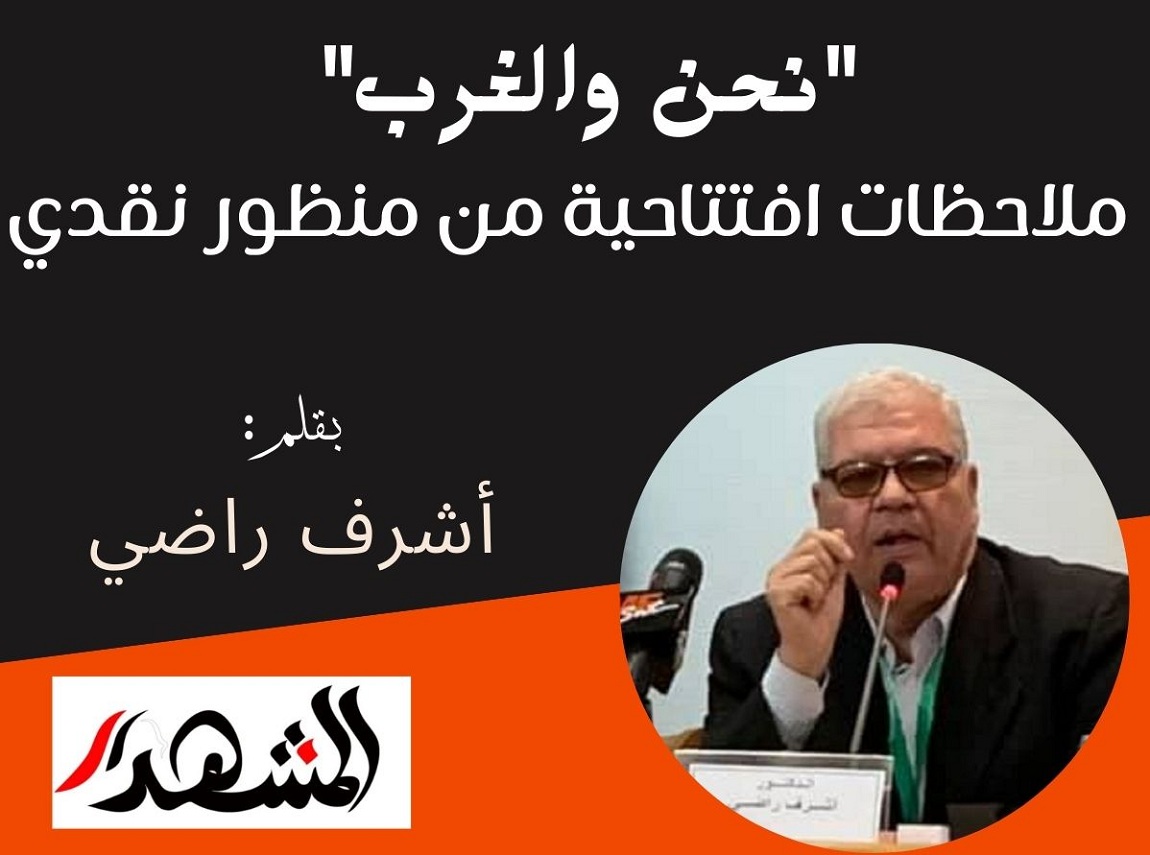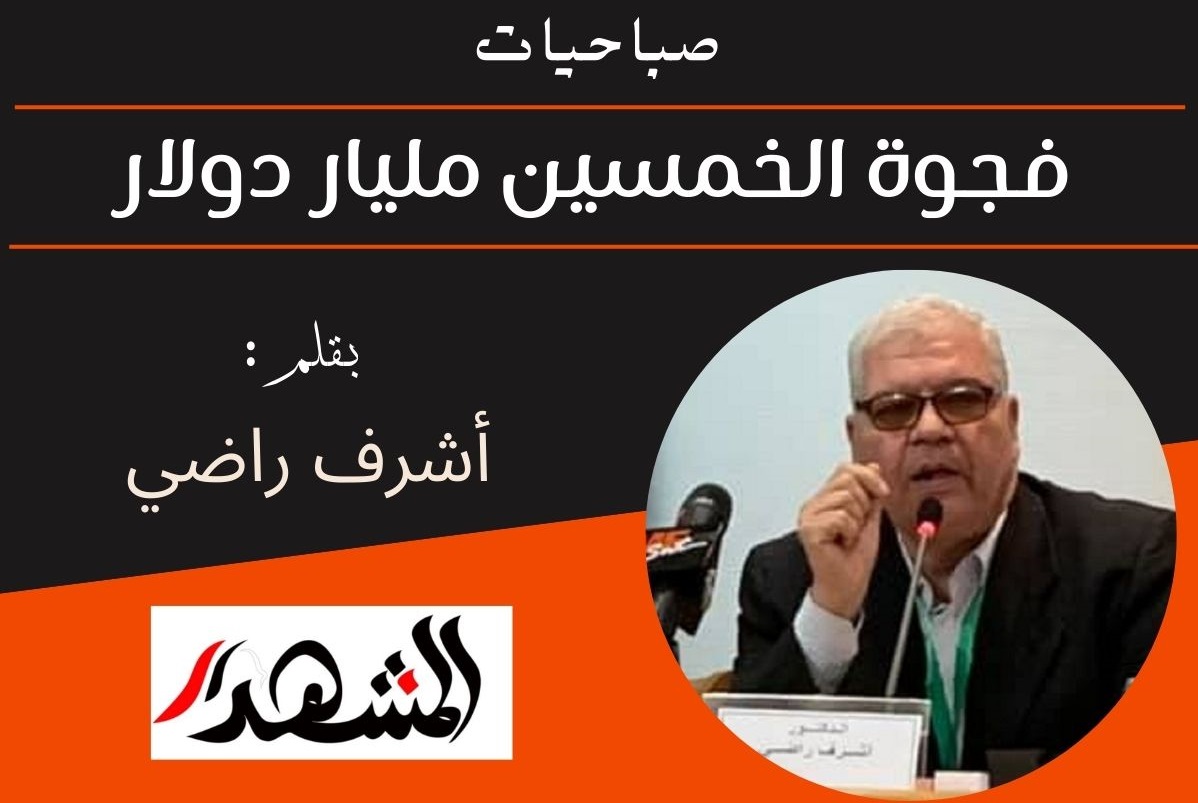حسناً، فعل الأستاذ مجدي شندي رئيس تحرير جريدة "المشهد" حين رتب لندوة، هي أقرب إلى حلقة للنقاش حول ملاحظات تستند إلى مشاهدات وخبرات واقعية، قدمها الدكتور سليم العبدلي، وهو أكاديمي ومثقف عراقي مقيم في الدنمرك منذ أكثر من أربعين عاماً، مستمدة من رحلته في مجتمعات غربية، منذ أن خرج من العراق طواعية، وهو في العشرين من عمره، هرباً من نظام قمعي أدت ممارساته الاستبدادية ضد مواطنيه إلى خروج نحو مليوني عراقي، طواعية أو قسراً. هذه المشاهدات الواقعية التي تعكس طبيعة علاقتنا مع المجتمعات الغربية وتفاعلنا معها، على قدر كبير من الأهمية، خصوصاً إذا ما اتبع أسلوب التفكير العلمي المتحرر من الأحكام المسبقة والمطلقة والمستعد لتعديل ما هو مستقر ومترسخ في الأذهان على ضوء التجربة والواقع، ولا هدف ولا غاية له سوى السعي المستمر والدائم وراء الحقيقة وإعلانها، لتصحيح كثير من تصوراتنا المسبقة والتعامل الإيجابي والبناء مع العالم في جوانبه المختلفة.
ثمة ملاحظة مهمة هنا، أبداها الدكتور العبدلي في حديثه تتعلق بتجربته في الصين، إذ أشار في حديثه رداً على سؤال عن رؤيته للصين كتجربة مغايرة لتجربته في المجتمعات الأوروبية الغربية والولايات المتحدة، إلى أنه أعد بشكل شخصي مفكرة دون فيها كل ما وصله من معرفة عن الصين قبل زيارته، مشيراً إلى أن السرديات الغربية عن الصين هي مصدرها الأساسي، ودون في مقابل هذه المعرفة المسبقة التي تعامل معها كفرضيات يتعين اختبارها في ضوء مشاهداته الواقعية التي عاينها من خلال تجربته في الصين، إذا يزورها ويقيم فيها بعض الوقت كمحاضر في جامعة العاصمة الطبيعية في بكين، وساعدته هذه المقارنة بين معرفته المسبقة عن الصين وبين ما عاينه بنفسه على تصحيح مكونات الصورة التي رسمتها السردية الغربية للصين. هذه الملاحظة استعدت لدى ذاكرتي كتاب "الحضارة: الغرب والبقية" الصادر في عام 2011، للمؤرخ الأسكتلندي، نيل فرجسون (1964-)، الذي يعد من أهم المدافعين عن الإمبراطورية البريطانية، وكتاب "استعمار مصر"، لأستاذ التاريخ الأمريكي تيموثي ميتشيل، الصادر في عام 1988. والكتابان يتناولان كيفية انتاج التصور الغربي لبقية العالم، في الحقبة الاستعمارية وما بعد الاستعمارية. النقطة التي يجب استخلاصها من هذه الملاحظة الثاقبة للدكتور سليم هي التحديد الدقيق للرؤية الغربية للمجتمعات والبلدان غير الغربية، واختبار الأسس التي تقوم عليها هذه الرؤية من خلال الملاحظة الدقيقة والمنهجية لهذه المجتمعات بغرض المراجعة والتصحيح، وهذه الآلية هي التي يجب اتباعها في تناول موضوع رؤيتنا للغرب وعلاقتنا معه.
التحرر من التصورات المسبقة
الطموح أن تكون المحاضرة، والنقاش الذي أثارته، وأن يكون هذا المقال وما سيتبعه من مقالات أكتبها ويكتبها آخرون، مقدمة لحوار موسع وممتد وحر بين المثقفين والكتاب، يتيح من خلال المقالات زاويا مختلفة للنظر إلى الموضوع تعين النخب في مصر وفي مجتمعاتنا العربية على إعادة التفكير في هذه القضية المحورية، على نحو يُفسح المجال لأن يكون مثقفونا وأن تكون نخبنا جزءاً من الحل وليس مصدراً للأزمة وسبباً للمشكلة، وأن يكون ذلك كله استهلالاً لحوارات أوسع تشمل مثقفين ونخب في المجتمعات الغربية وغير الغربية، يعيد للمثقفين المستنيرين دورهم في صياغة مشروع مناهض للمشروع التي يروج له اليمين المتطرف في المجتمعات المختلفة الذي يسعى لاستغلال حالة العداء التاريخي، من خلال تثبيت التصورات والأحكام المسبقة والصور النمطية الراسخة في أذهان العامة. لا أعرف ما إذا كان هذا الطموح سيتحقق ولا أعرف مسبقاً إلى أين يمكن أن يقودنا هذا الحوار بين الرؤى المختلفة، لكن كل ما أعرفه هو أنه يتعين البدء في هذا الجهد باعتباره السبيل الوحيد لاكتشاف الممكن وتطويره والتعرف على الصعوبات وتذليلها. وكانت الندوة والنقاش نقطة البداية والنقاش التي يتعين على المثقفين والكتاب المهمومين الإمساك بها.
قد يكون التأكيد على ضرورة وأهمية التحرر من الأفكار والتصورات المسبقة والابتعاد عن الأحكام المطلقة والقطعية شرطا رئيسيا لنجاح مثل هذا الحوار، الذي يحرص جميع المشاركين فيه على الخروج باستنتاجات جديدة منه تساعد على إحداث التغيير المنشود والمرجو. والهدف من الحوار الذي يقوم بين طرفين أو أكثر هو أن نعمل سوياً من أجل بناء الأفكار والرؤى، وهو بهذا المعنى يختلف عن المونولوج، الذي يعبر عن حديث النفس أو النجوى، الذي يسعى الفرد من خلاله إلى طرح تصوراته ورؤيته بمعزل عن تصورات الآخرين ورؤاهم، وهو أيضاً يختلف عن السجال الذي ينبري فيه كل طرف لمحاولة إثبات صحة تصوره ورأيه في مواجهة تصورات الآخرين وآرائهم، ويتشبث برأيه مهما يكن مناقضاً أو معارضاً للواقع وتغيراته. فالوظيفة الأساسية لأي حوار هي تخليصنا من التحيزات المعرفية والنقاط العمياء في تفكيرنا والتصورات الثابتة والجمود العقائدي والفكري، والأهم أنه الآلية الأساسية لتحقيق التراكم المعرفي عبر تبادل الآراء المختلفة والاختبار المستمر لما لدينا من معرفة مسبقة من خلال التجربة. غير أن القيمة الأهم للحوار تتجاوز المحاورين إلى الجمهور العام وتعمل على تغيير أنماط التفكير السائدة في المجتمع، ويدفع الجميع لعملية متواصلة للبحث والاهتمام بالواقع والمعلومة على حساب التصورات والرؤى الجامدة، والحوار بهذا المعنى يكون آلية مهمة من آليات التغيير والتحرر من الأفكار المسبقة المتسلطة، ومن ثم التقليل من تأثير التطرف الفكري والعقائدي.
ويُساعد الحوار على انتقالنا إلى التفكير العلمي الممنهج في أي قضية من القضايا، ويشجعنا على التفكير النقدي القائم على مبدأ "نسبية" ما نتوصل إليه من استنتاجات وآراء في حدود ما هو متاح لدينا من بيانات ومعلومات وأدوات، ويجعلنا أكثر انشغالاً بالمستقبل والبحث عن حلول مرتبطة باللحظة الراهنة، والتمييز بين ما هو واقعي ومعقول ومرتبط بالخبرة المشتركة مع الآخرين وبين ما هو إيماني مرتبط بالخبرة الخاصة لكل فرد من ناحية، وبين ما هو أسطوري وخرافي لا تدعمه أي وقائع من ناحية ثانية. ويضع كل ما لدينا من أفكار وأحكام موضع الاختبار بشكل مستمر. لقد تطور التفكير البشري بشكل غير مسبوق مع تطور العلم ومنجزاته، وأثر الأمران معاً على معرفتنا بالعالم وبأنفسنا، وجعلنا أكثر قدرة على تمييز الأشياء وعلى التطور الذاتي وعلى تطوير العالم وتغييره. فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر، ليس فقط على التعلم من تجربته، وإنما أيضاً على الخروج باستنتاجات تساعده على استكشاف بدائل جديدة لتحسين شروط حياته والتكيف مع محيطه. وعليه، علينا التعامل مع قضية علاقتنا مع الغرب كإشكالية تفرض علينا تحديات تمكننا من خلال هذا الحوار الموسع المتعدد المستويات والمراحل على اكتشاف مسارات جديدة وبدائل للمستقبل. هذا الأمر لا ينعكس إيجابياً علينا فقط، وإنما ينعكس كذلك على المجتمعات الغربية ويصحح العلاقة بين الغرب والعالم.
الحضارة والثقافة والقيم العالمية
ثمة إشكالية أساسية في علاقتنا مع الغرب في اللحظة الراهنة مصدرها الخلط الشديد بين عدة مفاهيم، وهذا الخلط لا يقتصر على المثقفين والمفكرين والجمهور العام في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وإنما قد يقع فيه كثير من المفكرين والباحثين الغربيين أيضاً، بقصد أو بدون قصد. ولعل مفهوم "الحضارة" من أكثر المفاهيم التي تتعرض للخلط والتداخل بينه وبين غيره من المفاهيم، مثل مفهوم التحضر والتمدين ومفهوم الثقافة، وبينه وبين مفهوم التاريخ. وهناك أيضاً إشكالية أخرى مصدرها ما أحدثه التمركز على الذات الجماعية مع تطور المجتمعات البشرية وبين فكرة التمايز والتفوق والأفضلية من خلط بين القيم والمفاهيم المرتبطة بثقافة مجتمع من المجتمعات وبين القيم المرتبطة بالإنسان في تطوره، التي تعد قيماً عالمية. قد يكون التعريف الذي قدمه الدكتور حسين مؤنس، أستاذ التاريخ المصري، في كتاب "الحضارة: بحث في أصول وعوامل قيامها وتطورها"، من التعريفات التي تقدم فهماً أفضل للحضارة، على غيره من التعريفات، وهو الأقرب إلى المعنى الذي ذهب إليه المؤرخ البريطاني ول ديورانت (1885- 1981) في موسوعته قصة الحضارة.
أشار مؤنس في مقدمة كتابه الصادر في يناير عام 1987، كاستهلال لسلسلة عالم المعرفة، وهي سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بدولة الكويت، إلى أنه يتطرق إلى موضوع جديد وأن عدد الكتب التي تحدثت بشكل مباشر عن ذلك الموضوع، لم يتجاوز الثلاثة كتب. والتعريف الذي يقدمه للحضارة ينهي ذلك الربط بين الحضارة وبين أجناس وشعوب بعينها، ليجعلها مفهوماً إنسانياً بامتياز. فالحضارة عنده هي "ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته"، وبالتالي فإنها تتمثل في صورة أوضح وأصدق في الاكتشافات التي تقوم عليها حياة البشر، مثل رغيف الخبر وإناء الفخار، اللذين استغرقا من البشرية عشرات ألوف السنين ونقلاها من حقبة في التاريخ إلى حقبة أخرى جديدة، وهي مرتبطة بمنجزات تنفع أكبر عدد من الناس وتيسر لهم أسباب الاستقرار والأمن، وتشكل نقطة تحول في حياة الإنسان لها أثار بعيدة المدى، وهي بهذا المعنى جزء من التاريخ ونتاج جانبي له. غير أن الارتباط بين التاريخ والحضارة وحركتهما أسهما في تقديم معنى جديد لكل منها. التاريخ لم يعد مرتبطاً بالماضي، وإنما يشمل أيضا الحاضر والمستقبل، وارتبط المفهوم الجديد للحضارة بمفهوم التقدم وحركة التاريخ، والاثنان مرتبطان بفكرة العمران التي استخلصها عبد الرجمن ابن خلدون من دراسته للتاريخ والاجتماع، واكتسب مفهوم الحضارة معنى جديداً، يشير إلى السيطرة على منجزاتها ومعرفة كيفية استعمالها والاستفادة منها، وهو أمر يتطلب قوة عقلية وخلقية، وإلا تحول المنجز الحضاري إلى أداة ترد الإنسانية إلى بدائيته الوحشية.
لعل النقاش الذي يجريه في الفصل السادس من الكتاب حول العلاقة بين الحضارة والثقافة يساعدنا على التمييز بين الاثنين، على الرغم من ارتباطهما الوثيق. لقد أصبح التفكير في مسألة الحضارة منذ منتصف القرن الماضي يميل إلى رفض الحضارة العالمية، والنظر إلى تعددية الحضارات في العالم. هذا الرأي غير دقيق ويحتاج إلى مراجعة في ضوء إعادة التفكير في مسألة العلاقة بين الحضارة والثقافة. فالحضارة العالمية واحدة، وهي التي تحدد شروط التقدم ومواكبة العصر وتضع لهما المعايير وقواعد السلوك والتعامل، أما الثقافات متعددة ونسبية. والحضارة بوصفها حضارة عالمية ليست حكراً على جنس أو شعب أو أمة بذاتها، بل تساهم فيها جميع الأمم والثقافات بقدر ما تقدمه من منجزات تدفع في سبيل تقدم البشرية، كما يمكن للبشرية من الناحيتين النظرية والعملية الاستفادة من منجزاتها، ولا يجوز لجماعة أو جماعات أن تنسب لنفسها التقدم، حتى لو كانت تتحكم في أدوات صنع هذا التقدم وآليات وتستفيد من تراكم المعرفة. هذه مسألة مهمة لتمييز القيم العالمية المرتبطة بالحضارة عن القيم الثقافية المرتبطة بالجماعات البشرية المتباينة. هذا الخلط بين المجالين سبب رئيسي لطبيعة الأزمة بين الجماعات البشرية. لا شك أن كثيرا من القيم العالمية المرتبطة بالإنسان متحققة بدرجة أعلى في المجتمعات الأوروبية والغربية نظراً لأن هذه المجتمعات أصبحت مركزاً للحضارة العالمية الراهنة التي يراها البعض حضارة مسيحية يهودية، ويراها آخرون حضارة مادية رأسمالية قائمة على فكرة التقدم العلمي.
تاريخ الحضارات وتفكيك الصور النمطية
قد تساعدنا العودة لتاريخ الحضارات في العالم على تحسين فهمنا لعلاقة المسلمين والعرب بالغرب، وهو موضوع أعيد طرحه للنقاش والبحث منذ صدمة الحداثة التي تعرضت لها مصر والمنطقة التي كانت خاضعة للدولة العثمانية، منذ الحملة الفرنسية على مصر التي اختتمت القرن الثامن عشر واستهلت القرن التاسع عشر، ذلك أن شعوب تلك المنطقة استيقظت من سباتها العميق على عالم جديد تشكل في أوروبا وأحدث فارقاً هائلاً في التقدم، واتخذ هذا الموضوع مساراً مختلفاً خلال العقود الأربعة الأولى من الألفية الجديدة والتي استهلت أيضاً بهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وما ترتب عليها من تداعيات باعدت أكثر بيننا وبين المجتمعات الغربية على الرغم من كثافة التفاعلات المرتبطة بالعولمة. لا شك، أن هناك جذور تاريخية أبعد لتلك العلاقة التي غلب عليها الصراع منذ توسع الإسكندر الأكبر شرقاً وجنوباً في مواجهة الفرس، ليؤسس الإمبراطورية الرومانية، التي استمرت لنحو ستة قرون، أنهاها توسع العرب المسلمين المنطلقين من الجزيرة العربية شرقاً وغرباً لتأسيس إمبراطوريات متعاقبة في ظل نظام للخلافة الإسلامية، أُعلن انتهاؤه رسمياً في عام 1924، وتخللت هذا التاريخ سلسلة من الحروب والمواجهات العسكرية بين الإمبراطوريتين، أشهرها الحملات والحروب الصليبية على المشرق العربي، والتي استمرت لنحو ثلاثة قرون (1092 – 1291)، وحروب الاسترداد التي استهدفت إنهاء الحكم العربي الإسلامي في الأندلس حتى منتصف القرن الخامس عشر وتحديداً في عام 1492. غير أن العلاقة بين ضفتي البحر المتوسط لم تكن مواجهات عسكرية طوال الوقت، فقد شهدت صوراً كثيرة للتعاون وللتفاعل الثقافي حتى في ظل الحروب التي ساهمت في تعديل الصور النمطية المستقرة في الأذهان لدى الطرفين.
تجدد الجدل حول العلاقة بيننا وبين الغرب في الأعوام الثلاثة الماضية، وتحديداً بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير عام 2022، والمقارنات التي عُقدت بين تعامل الدول الأوروبية مع اللاجئين الأوكرانيين وتعاملهم مع اللاجئين القادمين من الجنوب، سواء من العالم العربي والإسلامي أو من الدول الأفريقية، واحتدم هذا الجدل بعد حرب غزة في أكتوبر عام 2023، وموقف الدول الأوروبية من العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والذي اتخذ طابع التطهير العرقي عبر عمليات التهجير واستهداف المدنيين على نحو يصفه كثير من المراقبين بحرب "الإبادة". وفي ظل صعود المتطرفين على الجانبين منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر وتقسيم العالم إلى "فسطاطين"، يكون من الضروري إعادة طرح الموضوع من منظور نقدي، بهدف استجلاء المسارات المحتملة للعلاقات المشحونة بين الغرب والعالم العربي تحديداً، واستكشاف سبل لإعادة بنائها على نحو يساعد على احتواء برامج المتطرفين التي تستند إلى دعاوى العنصرية والتفوق، الأمر الذي يستدعي إلى النظر إلى هذه العلاقات نظرة تحليلية نقدية، تركز بشكل مباشر على نقاط الاحتكاك والصدام من أجل تطوير آليات عمل تساعد على فتح المجال لنمط جديد من التفاعلات بين الغرب وبقية دول العالم. هناك عدة ملاحظات تمهيدية للشروع في هذا الجهد الذي نأمل أن يشارك فيه المثقفون المصريون والعرب وعلى الجانب الآخر.
أخطر ما في مسألة "نحن والغرب"، هو الانطلاق من صور نمطية قائمة على تعميمات، لا تسمح لنا برؤية الحقائق والتغيرات والتحولات الحادثة داخل كل نسق، ولا التفاعلات المكثفة بين الجانبين، وتحول دون تقييم الأسباب الحقيقية للصراع أو محفزات التعاون البناء، وتفسح المجال للمتطرفين ومشروعاتهم الحقيقية التي لا تستهدف الصراع مع الجانب الآخر بقدر ما تستهدف إحكام السيطرة على المجتمعات. فالهدف الرئيسي للأحزاب اليمينية والشعبوية في البلدان الغربية هو إحكام سيطرتها على تلك المجتمعات والانقلاب على تجربتها التاريخية التي أفرزت نظماً اجتماعية وسياسية حددت معايير للحداثة والتقدم، مرتكزة على مفهوم "الحرية"، حرية الفرد في مواجهة الجماعة، والتي جرى تنظيم ممارستها من خلال شبكة من التشريعات والترتيبات المؤسسية الحديثة، التي تستهدف حماية هذه الحرية في مواجهة صور من الطغيان والاستبداد، لكن وتيرة التقدم الذي تحقق نتيجة للعلم والبحوث وتطبيقاتهما والذي أتاح للأفراد من أدوات لتحكم الفرد والسيطرة تجاوزت وتيرة التقدم الذي تحقق على المستوى القيمي، وترتب على هذا التفاوت العديد من المشكلات التي ناقشها مفكرون عرب هاجروا إلى أوروبا ومفكرون أوروبيون أعادوا النظر في كثير من المسلمات التي انطلقوا منها في دراستهم للمجتمعات غير الأوروبية في إطار مشروع لنقد الاستشراق ساهم فيه مفكرون عرب. غير أن التفاوت الشديد في الثروة والقدرات بين المجتمعات الغربية والبلدان العربية والإسلامية كان مصدراً لكثير من المشكلات والقضايا التي تستحق نقاشاً منفصلاً في مقال آخر، قد تكون نقطة الانطلاق فيه مراجعة ذلك الزعم الزائف بتفوق الغرب مادياً وتراجعه أخلاقياً وقيمياً وتأخر العالم العربي ماديا وتفوق أخلاقيا وقيمياً. وسيراً على المنهج الذي وضعناه في مقدمة المقال، يظل هذا الزعم فرضية تحتاج إلى اختبار.
----------------------------
بقلم: أشرف راضي