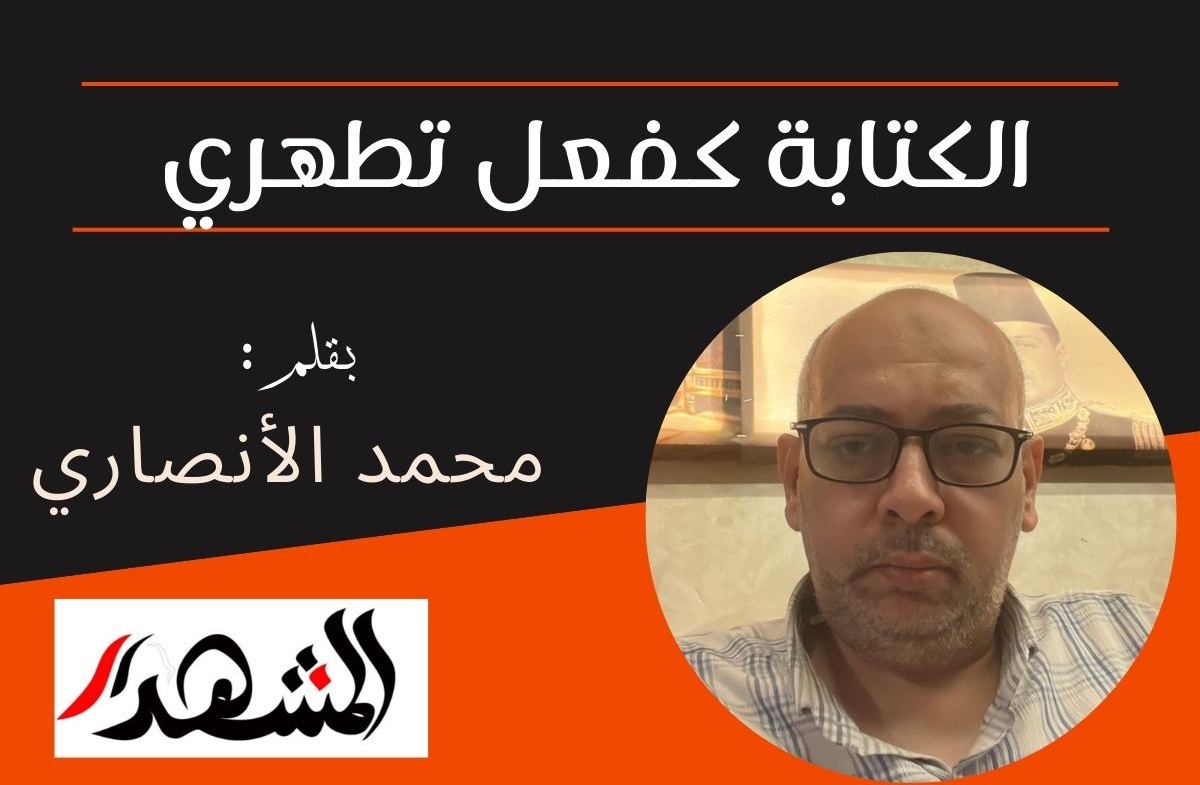لم يحالفني الحظ في حضور الندوة المهمة التي نظمتها جريدة المشهد في يوم 26-2-2025 بعنوان "نحن والغرب". و لكن من خلال مقال الأستاذ أشرف راضي في المشهد بعنوان " نحن و الغرب: ملاحظات افتتاحية من منظور نقدي" ، و مقال رئيس تحرير المشهد الأستاذ مجدي شندي بعنوان " نحن و الغرب : دعوة للتفكير و الكتابة و تفكيك القوالب النمطية على الضفتين."، استدركت بعضا مما فاتني. وفي واقع الامر، طالما شكل هذا العنوان محملا بحمولة عالية من الأفكار والتصورات شغلا شاغلا بالنسبة لي. وليس لي أن أضيف الكثير على ما سطره الصديقان في هذا الموضوع الذي شغل المفكرين المسلمين و العرب على الأقل منذ عودة رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873) من بعثته الباريسية عام 1832. وفي حقيقة الامر أثير الموضوع في ذهن القلة من المصريين منذ وصول الحملة الفرنسية، و من أهم الشخصيات التي عبرت عن ثنائية الحب/ الكره للفرنسيس الغزاة كان المؤرخ المشهور عبد الرحمن الجبرتي صاحب موسوعة عجائب الأثار في التراجم والأخبار الذي لم يمنعه كرهه الشديد للغزاة من التعبير عن الدهشة والاعجاب من بعض منجزاتهم العلمية. عن هذه الازدواجية أتحدث في هذا المقال. فموقفنا من الغرب -مع الإقرار بملاحظة الأستاذ أشرف والأستاذ مجدي شندي ان الغرب ليس كيانا واحدا في المطلق - يحكمه منذ عصر النهضة العربية وحتى الآن بعد نفسي في الأساس وليس عقلانيا وهو علاقة الحب/ الكره. وما يميز العلاقات القائمة على رد فعل نفسي لا عقلاني هو احتواؤها على أفكار متناقضة ومتضاربة .
وفي واقع الامر ليس التناقض في الفكر هو مكمن الأزمة لان المواقف الفكرية تحتمل مبدأ التناقض أحيانا. المشكلة أن هذا التناقض في حالة المسلمين والعرب متضمن في موقف نفسي وليس في موقف عقلاني. فنحن نحب ونكره بناء على انطباعات وليس قراءات دقيقة للأخر. وهنا تكمن المشكلة في موقفنا الازدواجي من الغرب منبع السعادة و الشقاء. ولن نبدأ في التعامل مع الغرب بفروعه وتنويعاته و أبعاده المتعددة إلا إذا استبدلنا معادلة الحب/ الكره النفسية بقراءة عقلانية تتضافر فيها عوامل الحب والكره كي ننتج في النهاية "موقفا نقديا" حقيقيا. وفائدة هذا الموقف على صعوبة الوصول اليه، لن تعود فقط على توازننا الفكري وعلى إمكانية تفعيل استراتيجيات وسياسات عقلانية للتعامل مع الغرب، ولكن حتى على تعامل الغرب ذاته معنا وتقديره لتماسكنا المنطقي والسياسي.
في بداية الأمر علينا أن نتحرر من عقدة الحب/ الكره. وأول خطوة في سبيل ذلك هو تحديد مبررات الحب والكره والتعامل بعقلانية. ثم يأتي دور بناء استراتيجيات التعامل مع الغرب كظاهرة إنسانية وليس كعدو دائم أو صديق ودود ولكن من منطلق تحليل الفرص والمخاطر على ضوء من الدين والتاريخ والسياسة. أعتقد أن هذا يمثل بداية الطريق للتحرر والشفاء مما أسماه المفكر السوري جورج طرابيشي بالـ "المرض بالغرب"
مبررات الحب
من الطبيعي جدا للمواطن المسلم والعربي المعاصر ، سواء كان الرجل العادي أو المثقف أن يحب جوانب عديدة من الثقافة الغربية بالرغم من الإرث الاستعماري لدول الغرب في بلادنا. ولا ينبغي أبدا أن يوصم ذلك بالخيانة أو التغريب أو الغزو الثقافي أو الاستلاب إلى أخر ذلك من الأوصاف الإقصائية والتخوينية التي دأبت على توظيفها العديد من التيارات الإسلامية والتيارات القومية في بلادنا. هناك وسائل التثقيف والترفيه وهي مدينة ولا شك للثقافة الغربية بالكثير شئنا أم أبينا. فالمسرح والقصة والرواية والفيلم والفن التشكيلي في العالمين العربي والإسلامي لم يكن لها أن تتطور لولا تأسيس هذه الأجناس الفنية على أسس ومبادئ نشأت في السياق الثقافي الغربي. ربما يجادل البعض أن المسرح مثلا تطور من أصوله الدينية في مصر القديمة. ولكنه لم يصل إلى الشكل الحديث إلا بإسهامات غربية في الأساس. علينا أن ندرك ذلك. وعلينا أيضا أن ندرك أن أصل هذه الفنون الغربي ليس عائقا من محاولة تطويرها لتتلاءم مع البيئة العربية. ولنا مثال أخر في مؤسسات التعليم. الموسرون من المسلمين و العرب يحرصون على إرسال أولادهم الى مدارس وجامعات الغرب لأن العودة من باريس أو لندن أو الولايات المتحدة بشهادة علمية يضمن للأولاد مستقبلا باهرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بغض النظر عما قد يعتري المناهج الغربية من قيم معرفية قد تتناقض في نظر البعض مع خصوصيات ثقافية دينية أو قومية. بشكل عام يقوم المنهج الغربي ابستمولوجيا على الفهم والربط والتحليل، بينما ما زالت مناهجنا التقليدية قائمة على التلقين . أيضا قد يرى البعض أن الحفظ و التلقين مهم. ومع الإقرار بذلك لا يمكن إنكار القيمة المعرفية للمنهج التعليمي الغربي.
من الواضح أنه في زمن الاستعمار حرص المستعمر البريطاني على "قولبة" التعليم ليخدم حاجاته وسياساته. و أيضا عمل الاستعمار الفرنسي والإيطالي والألماني والهولندي على ترسيخ سياسات " طمس الهوية" . ولكن في التحليل الأخير لا يمكن تصور المستوى الثقافي الذي بلغته دولة مثل مصر لو لم تتوالى البعثات التعليمية إلى الغرب منذ 1826 وحتى الان. و أكاد أسمع صوت الإسلامي يردد عاليا و لكن هذه البعثات نقلت لنا " قيم و أخلاق الغرب الهدامة." المسألة ببساطة ان التعليم هو معطى يكاد يكون محايدا لأنه لن يجبر أحد الطالب المسلم أو غيره على تغيير دينه أو الالحاد او تبني قيم حداثية بعينها. في نهاية الأمر التعليم في الغرب ينمي ولا شك النزعة النقدية وهو في واقع الامر ما تبناه رواد الإصلاح والحداثة في عالمنا العربي من أمثال الطهطاوي ومحمد عبده وخير الدين التونسي........الخ.
مبررات الكره
لا شك أن الارث الاستعماري منذ الحروب الصليبية و حتى الآن، بعد أن انقلب الاستعمار المباشر الى "هيمنة اقتصادية وسياسية" هو من أهم أسباب ودواعي الكره. وفي نظر أصحاب مدرسة "إسلامية المعرفة مثلا" فان التأثير المنهجي الغربي على العقل المسلم لا يقل خطورة عن الاستعمار العسكري.
لقد قام المفكر الفلسطيني إسماعيل راجي الفاروقي بإنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي في ولاية فرجينيا عام 1981. والفاروقي كان أكاديميا من الطراز الأول قضى حياته الأكاديمية كلها في جامعات كندا والولايات المتحدة. وخلفه بعد أن توفى عام 1986 الفقيه الازهري العراقي طه جابر العلواني. ومن أبرز مفكري هذه المدرسة عبدالحميد أبو سليمان والدكتورة منى أبو الفضل. ولكن يجمع كل هؤلاء رغم التحذير من الأبستمولوجيا الغربية الاستخدام المكثف للمناهج الغربية في تزاوج عميق بينها وبين الأبستمولوجيا المستمدة من الرؤية الدينية. لم يدعي أساتذة "إسلامية المعرفة" الطهرانية المعرفية. ولكن أفكارهم تطورت الى نوع من أنواع القطيعة المعرفية التامة مع رموز أخرين في الحركة الإسلامية بمعناها الأوسع. وأنا أدعي ادعاء في هذا المقال فيه شيء من المغامرة أن خطاب منظري الجماعات الجهادية يكتسب شرعية قوية من فكرة "خطورة تأثير المنهج الغربي" على العقل المسلم حتى قبل وجود المعهد العالمي للفكر الإسلامي. وربما أفردت مقالا في المستقبل لتناول هذا التأثير.
"السؤال الأخلاقي" و هو عنوان أحد كتب الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن يتعلق بمكونات الحداثة التي تناهض الأخلاق مثل الفردية المتطرفة والاعتداء على البيئة والنسبية الأخلاقية الجنسانية والاستهلاك والمادية والحلولية المابعد حداثية (او العلمانية الشاملة في لغة دكتور عبد الوهاب المسيري)إذن كراهية العديد من المكونات الأخلاقية للحداثة هو وجه آخر من وجوه كراهية الغرب. وهنا أشير الى كتاب مهم لطه عبد الرحمن بعنوان "روح الحداثة" يفرق فيه بين روح الحداثة وتطبيق الحداثة (يقصد الحداثة كما يطبقها الغرب). ويقترح في هذا الكتاب إنشاء حداثة إسلامية ويعده واجبا شرعيا بعد استبدال أخلاق ومناهج الحداثة الغربية بأخلاق ومناهج " الائتمانية" في إشارة الى الآية الكريمة (إنا عرضنا الأمانة .......). ولكن من المهم الإشارة الى ان مشروع "روح الحداثة " ما زال يكتنفه العديد من الثغرات.
ما أحاول أن أشير إليه في هذا المقال هو ضرورة الفرز العقلاني لعوامل الحب والكره كي نخلص إلى موقف عقلاني حقيقي من الغرب يتجنب تشنجات الموقف النفسي القائم على واحد من ثلاثة أعمدة: إما الرفض المطلق أو الاعتناق الكامل أو التخبط والتناقض بين الاثنين. و هذا ما أسميته بخطيئة الازدواجية في الموقف من الغرب.
---------------------------------
بقلم: محمد الأنصاري