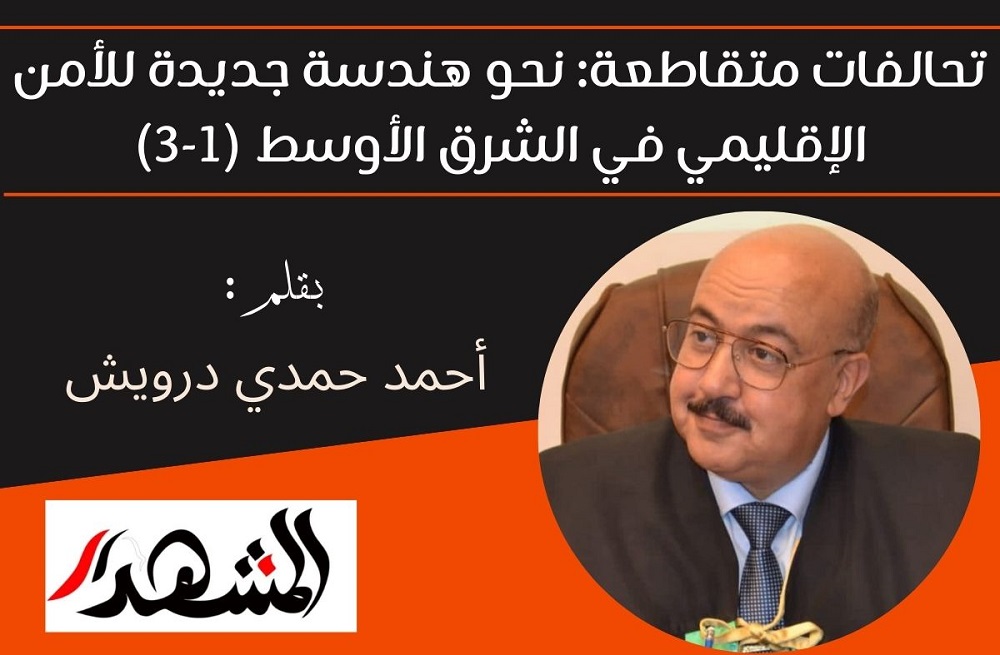تحالفات متقاطعة.. تمهيد للمقالات الثلاث
(بقلم: أشرف راضي)
تطرح المقالات الثلاث للدكتور أحمد حمدي درويش سؤالًا مركزيًا على صناع السياسية والنخبة الاستراتيجية والمثقفين، بخصوص ما تفرض البيئة الدولية التي تزداد تعقيداً من تحديات بالنسبة للأمن على المستويين الوطني والإقليمي، وإذا كان النظر إلى مسألة الأمن من المنظور الإنساني الأوسع فإن ذلك ينقلنا إلى مستوى الأمن العالمي. السؤال المركزي، هو: كيف تصوغ المنطقة نموذجًا أمنيًا وجوديًا في زمن اللا يقين؟ ويطرح الكاتب فكرة "التحالفات المتقاطعة" والتي تشير إلى شبكات التعاون الإقليمي والمرن التي تتبلور حول مصالح محددة ومعرفة بدقة لمواجهة تهديدات قائمة أو محتملة وكامنة في البنية المعقدة للعلاقات الدولية والناجمة عن التنافس الذي يزداد احتداما بين القوى العالمية الكبرى وشبكات المصالح.
ويدعو إلى التحول من الولاء الأيديولوجي الثابت إلى منطقة "إدارة المخاطر" وتعظيم المصلحة" في إعادة صياغة أكثر تركيبًا وعمقًا لفكرة أن الدافع الأساسي لسلوك الدول هو الدفاع عن مصالحها وتسخير تحالفاتها لهذا الغرض وأن هذا يتم في بيئة معقدة تتطلب مرونة استراتيجية وإجراءات لبناء الثقة عبر التعاون الوظيفي. ويقدم في المقالات الثلاث نماذج تطبيقية أولية للفكرة. والهدف الرئيسي لهذه المقالات الثلاث هو تحليل إمكانية قيام تحالف مصري تركي كأقصى اختبار للنموذج المقترح وأبعاد هذا التحالف. ويقترح مجالات محتملة لهذا التحالف تشمل الأمن البحري والأمن الاقتصادي، والتعاون الدفاعي-الاستخباراتي، والتنسيق الدبلوماسي الإقليمي. ولا تكتفي المقالات ببحث الضرورات لمثل هذا التحالف، وإنما يتناول بالبحث والتحليل التحديات والعقبات التي تحول دون قيامه، والتي تتمثل في صراع الهويات والولاءات العميقة، وعدم الاستقرار المزمن وغياب الثقة، والتدخل الخارجي وتعقيد البيئة الجيوسياسية. وينتقل من تحليل فرص قيام هذا التحالف والقيود التي تعرقله لاستشراف التوجهات المستقبلية وتحديد شروط النجاح التي يحددها في ثلاث ركائز: التركيز على المصالح الوطنية الملموسة والمشتركة، البناء التدريجي والتراكمي بالبدء بالمجالات المنخفضة الحساسية، والشفافية وإدارة التوقعات بدبلوماسية واضحة.
وتطرح المقالات الثلاث تفكيرًا استراتيجيًا لخبير في هذا المجال، بحكم المسار الوظيفي والتخصص، الذي أصقله بالدراسة والبحث في مجال العلاقات الدولية والاستراتيجية، وهو طرح جدير بالاهتمام والتأمل والدراسة ويستفز العقول للتفكير في سبل للتعامل مع التحديات من خلال دراسة واعية وفهم دقيق للسياسات العالمية والعلاقات الدولية في بيئة شديدة التعقيد. وهو لا يطرح في المقالات الثلاث حلًا شاملًا، ولا يزعم ذلك، والحقيقة أنه لا وجود لمثل الحلول الشاملة واليقين في ظل هذه البيئة المعقدة لكن الأمر الممكن والمتاح هو "هندسة أمنية تكتيكية ضرورية يعبر عنها نموذج "التحالفات المتقاطعة"، وإدراك حقيقة أن الأمن في القرن الحادي والعشرين "أصبح قدرة ديناميكية على التكيف والتعاون"، فالاستقرار الإقليمي بات مرهونًا بقدرة الدول على نسج شبكات مرنة ومعقدة من "التحالفات المتقاطعة".
-------------------------------
الحلقة الأولى
في قلب النظام العالمي المضطرب، يجد الشرق الأوسط نفسه عند مفترق طاقات جيوبوليتيكية هائلة، لم يعد مجرد مسرح للصراعات التقليدية، بل تحول إلى مختبر حي لتأثيرات التغير الدولي سريع الوتيرة والحدَّة، إن المنطقة التي لطالما كانت حاضنة لأقدم الحضارات، تواجه اليوم رياحاً عاتية من التحولات لا تقتصر على حدودها؛ فتصاعد المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى، من أمريكا اللاتينية إلى أوكرانيا إلى بحر الصين الجنوبي، يهز أركان نظام عالمي كان مستقراً نسبياً، لتنتقل ارتداداته كموجات صدمة إلى كل بؤر التوتر الإقليمي.
وهذه "الزلازل الدولية" المتلاحقة لا تخلق تهديدات جديدة فحسب، بل تعيد تفعيل وتضخيم المخاطر الكامنة، لتظهر في صورة مركبة ومعقدة: فالمخاوف الجيوبوليتيكية من توسع النفوذ الإقليمي تتداخل مع أزمات اقتصادية هيكلية تهدد الاستقرار الاجتماعي، بينما تستغل التنظيمات من غير الدول فجوات السيادة الناجمة عن هذه الفوضى لتزرع بؤراً جديدة للعنف، والأمن القومي للدول لم يعد مقتصراً على حدودها البرية؛ فالممرات المائية الحيوية - من مضيق هرمز إلى قناة السويس والبحر الأحمر - أصبحت ساحات للتنافس والتهديد المباشر لشرايين الطاقة والتجارة العالمية، فيما تُستخدم الأسلحة غير التقليدية، من الطائرات المسيرة (الدرونز) إلى الحرب السيبرانية، في صراعات بالوكالة تذكي نيراناً يصعب إخمادها.
وفي مواجهة هذا المشهد الخطير، يظهر قصور النماذج الأمنية التقليدية بجلاء، فالنُظم التحالفية الثنائية أو الأحادية القطب التي هيمنت على عقود ما بعد الحرب الباردة، لم تعد قادرة على احتواء هذه التهديدات المتشابكة والمتعددة المستويات، لقد أضحت الحاجة ملحة إلى "هندسة استراتيجية جديدة" للتعاون الإقليمي، ليست هندسة تقليدية صلبة، بل هي "هندسة مرنة للتحالفات المتقاطعة"، قادرة على التكيف مع الديناميكيات السريعة، تحالفات لا تسعى إلى توحيد كتل متجانسة، بل إلى بناء شبكات ذكية من الشراكات المرنة والتكتيكية، حيث تتقاطع المصالح بين دول قد تختلف في رؤاها الشاملة ولكنها تلتقي عند تهديدات وجودية مشتركة، وهذه الهندسة الجديدة هي محاولة لتحويل منطق التنافس الصفري السائد إلى منطق إدارة المخاطر الجماعية، حيث يصبح التعاون في ملفات مثل الأمن البحري والطاقة ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات، بوابة لبناء الحد الأدنى من الثقة والاستقرار في منطقة تبحث عن خلاص من دوامة التهديدات المتفاقمة.
فلم تعد الجيوش وحدها تُعلَن الحرب، ولم يعد صراع الشرق الأوسط يدور على جبهات واضحة المعالم، بل تحول إلى ساحة معقدة تتصارع فيها عواصف جيوبوليتيكية كبرى مع براكين أمنية محلية، في توليفة غير مسبوقة من التهديدات، ونحن أمام "حروب الجيل الرابع" التي تذوب فيها الحدود بين العسكري والاقتصادي والاجتماعي والسيبراني، والمنطقة لم تعد فقط مسرحاً للتنافس الدولي، بل أصبحت "حلقة وصل حيوية" في الصراع على إعادة تشكيل النظام العالمي، حيث تتداخل خطوط الصدع القديمة مع شرايين الاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة.
وتقبع تحت سطح الصراع المرئي مجموعة من التهديدات البنيوية الهيكلية، العميقة الجذور بالشرق الأوسط، والتي تشكل تهديداتها الوقود الدائم للاشتعال:
1. أزمة الدولة الوطنية وانزياح السيادة: ففي قلب الشرق الأوسط المضطرب، تواجه العديد من الدول الوطنية اختبارًا وجوديًا لم يعد نظريًا، بل تحول إلى واقع ملموس يتمثل في عملية تآكل مزدوجة ومعقدة للسيادة، فمن جهة تتعرض سيادة الدولة للتحدي من الداخل، حيث تبرز كيانات ما دون الدولة - من ميليشيات طائفية وعسكرية إلى تنظيمات مسلحة - لتنتزع أدوارًا تقليدية كانت حكرًا على الدولة، بدءًا من احتكار وسائل العنف وفرض الأمن، وصولاً إلى تقديم الخدمات وتوزيع الولاءات، ولم يعد هذا مجرد ظاهرة هامشية، بل تحول إلى "نظام بديل" في بعض البقاع، حيث تخلق التنظيمات المسلحة شبكات معقدة للسلطة والنفوذ تعمل في ظل الدولة أو بالتوازي معها، وتتمتع بمواردها المالية وعقيدتها الأيديولوجية وقدرتها على تعبئة المقاتلين، مما يحولها إلى لاعب جيوبوليتيكي مستقل يقلب موازين القوى المحلية.
في المقابل، تمارس قوى إقليمية ودولية نفوذها من فوق الدولة، فتتقاذف الدولة وتجبرها على الانزياح في سياساتها تحت وطأة الضغوط والتحالفات المتشابكة، وتخلق هذه "الثنائية السيادية" فجوات أمنية مميتة تتسع مثل الشقوق في جدار الدولة، لتصبح ملاذًا لكل الأطراف؛ فالميليشيات تتحول إلى وكلاء محليين لصراعات بالوكالة، بينما تستخدم القوى الخارجية هذه الكيانات كأدوات استراتيجية طويلة المدى لفرض نفوذها، مما يؤدي إلى تفريغ الدولة من مضمونها ككيان مستقل، والنتيجة هي واقع مركب حيث تتعايش هياكل سلطة متعددة ومتداخلة في نفس الفضاء الجغرافي، مما يولد حالة دائمة من السيولة والصراع على الشرعية، ويحول المجتمعات إلى ساحات لمعارك لا تنتهي، ويجعل استعادة الدولة لاحتكارها الشرعي للعنف وإعادة بناء عقدها الاجتماعي مع مواطنيها مهمة شاقة تكاد تكون مستحيلة في ظل هذه التشابكات الإقليمية والدولية المعقدة.
2- الشرخ الاقتصادي الهيكلي العميق: المتسبب في تشققات أسس الاستقرار الاجتماعي، والذي يُغذيه نموذج تقليدي يعاني من "لعنة الموارد الأحادية"، فبينما تظل عائدات النفط والغاز أو قنوات الملاحة والممرات البحرية، محركاً رئيسياً لدخل الدولة في العديد من الاقتصادات، يخلق هذا الاعتماد شبه الكلي حالة من الهشاشة المزمنة؛ إذ تجعل الاقتصادات رهينة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وتعيق بناء قطاعات إنتاجية متنوعة وقادرة على خلق فرص العمل بوتيرة تضاهي النمو السكاني السريع، ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين المناطق التي تواجه أعلى معدلات بطالة بين الشباب على مستوى العالم، حيث يتضاعف حجم الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً مقارنة بعدد الوظائف المُتاحة، مما يولد فجوة ساحقة بين الطموحات الاقتصادية للشباب المتعلم والواقع المرير لندرة الفرص.
وهذا الخانق الاقتصادي ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو محرِّك رئيسي لسخط اجتماعي مُزمن، فالشباب المحبط، الذي يشعر بأن النظام الاقتصادي قد حرمه من مستقبله، يصبح وقوداً للاحتجاجات المطالبة بالعدالة والكرامة، كما يجعل مجتمعات بأكملها أكثر قابلية للاستقطاب، وتُظهر الدراسات، مثل تلك الصادرة عن مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط، كيف يتم استغلال هذا الغضب المكبوت إيديولوجياً وسياسياً؛ حيث تقدم التنظيمات المتطرفة والميليشيات المسلحة نفسها كمخرج من اليأس الاقتصادي، بينما تستخدمه القوى السياسية الداخلية والخارجية كورقة ضغط لتحقيق مكاسب (أحداث فنزويلا الأخيرة مثالاً)، وبالتالي، فإن أي صدمة خارجية - سواء كانت انهياراً حاداً في أسعار النفط، أو أزمة غذاء عالمية، أو جائحة - لا تبقى تداعياتها اقتصادية فحسب، بل تتحول فوراً إلى هزة عنيفة تهدد الاستقرار الاجتماعي الهشّ من أساسه، وتكشف عن عمق الأزمة الهيكلية التي تتطلب إصلاحاً جذرياً يتجاوز الإصلاحات السطحية.
3. التحدي الديموغرافي والبيئي المتفاقم: حيث تقف المنطقة، بحسب تعريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة والباحثين في معهد الموارد العالمية، على خط المواجهة الأمامي والأكثر حدة مع تغير المناخ على مستوى العالم، فالمنطقة التي تعد بالفعل الأكثر جفافاً على كوكب الأرض، تشهد تسارعاً مقلقاً في وتيرة التصحر وارتفاع درجات الحرارة بمعدلات تفوق المتوسط العالمي، ويترجم هذا الواقع البيئي القاسي إلى تهديدات وجودية ملموسة، أبرزها الإجهاد المائي الحاد الذي تجاوز في أكثر من 12 دولة فيها عتبة الفقر المائي المطلق، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مما يدفع باتجاه نضوب المصادر التقليدية ويهدد الأمن الغذائي لملايين السكان الذين يعتمدون على زراعات مروية آخذة في التقلص، ويتفاعل هذا الضغط البيئي المتصاعد، والمتمثل أيضاً في تملح الأراضي الزراعية الخصبة وتآكلها، مع تحدي ديموغرافي هائل يتمثل في موجات النزوح الداخلي والإقليمي الهائلة الناتجة عن النزاعات وعدم الاستقرار، ليخلقا معاً عاصفة كاملة، فتدفق النازحين إلى مراكز المدن والمناطق الساحلية الأقل جفافاً يزيد من الضغط على الموارد المحدودة أساساً، ويفاقم من حدة المنافسة الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤدي إلى إذكاء التوترات المجتمعية ويهدد بتمزق النسيج الاجتماعي الهش في دول عديدة، ويضع حكومات المنطقة أمام معادلة صعبة: كيفية تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكانها في عصر تنحسر فيه الموارد الأساسية باضطراد.
فضلاً عن تلك التهديدات الهيكلية المتجذرة في الشرق الأوسط، فإن رياح النظام الدولي المتقلب، من المنافسة إلى المواجهة، حوَّلت المنطقة تحولاً جيوبوليتيكياً، فلم تعد المنطقة مجرد متلقٍ سلبي للقرارات الدولية، بل أصبحت ساحة رئيسية لتصفية حسابات القوى الكبرى:
1- تحول صراع القوى من تنافس إلى مواجهة شاملة؛ حيث تسود حالة من الصراع الجيوبوليتيكي الشامل في العلاقات الدولية، حيث تجاوز التنافس بين القوى الكبرى - الولايات المتحدة، الصين، وروسيا - النماذج التقليدية للدبلوماسية والاقتصاد ليتحول إلى مواجهة متعددة الأبعاد واسعة النطاق، فلم تعد هذه القوى تتنافس ضمن حدود ساحات واضحة، بل أطلقت العنان لحروب بالوكالة متعددة المستويات، توظف فيها كل أدوات القوة الناعمة والصلبة، من العقوبات الاقتصادية والمنافسة التكنولوجية إلى استخدام الجماعات المسلحة كوكلاء إقليميين، ولقد أعلنت واشنطن بوضوح أن العقد الحالي هو العقد الحاسم في مواجهتها مع الصين، التي تنظر إليها على أنها التحدي الوحيد القادر على إعادة تشكيل النظام الدولي، وفي المقابل تتبنى بكين سياسة خارجية أكثر جرأة واستعداداً للمواجهة، مع تركيز واضح لجهازها العسكري بأكمله على الاستعداد للحرب، بينما تؤكد موسكو استراتيجياً على سعيها لتقويض النظام العالمي القائم على الهيمنة الغربية، وخلق عالم متعدد الأقطاب يكون لها فيه موقع مؤثر، معتمدة على مفهوم "العالم الروسي" لتبرير تدخلاتها.
وفي هذا المشهد شديد التقلب، تجد العواصم الإقليمية، وخاصة في الشرق الأوسط الذي يقع في قلب التنافس الدولي، نفسها في موقف بالغ الحساسية، فهي مجبرة على ممارسة رياضة التوازن الخطرة بين هذه القوى المتصارعة، سعياً لتحقيق مكاسب أو لدرء أخطار، فتارة تستجيب لدعوات واشنطن لإعادة تشكيل تحالفات قيمية لمواجهة المشروع القومي الشعبوي الذي تروج له روسيا وتدعمه الصين، وتارة أخرى تتجه شرقاً نحو الشراكة مع بكين التي باتت شريكاً تجارياً لا غنى عنه للعديد من دول المنطقة، وهذا الانقسام في النظام الدولي، حيث تتلاشى الهيمنة الأحادية دون أن يظهر نظام بديل مستقر، يضع الدول المتوسطة والصغيرة على خط النار، فهي تتعرض لضغوط وإغراءات مستمرة من جميع الأطراف، وتواجه مزيجاً من الفرص والضغوط للحصول على مزايا اقتصادية وضمانات أمنية، غير أن هامش المناورة هذا قد يضيق بشكل خطير إذا ما تفاقمت حدة المواجهة بين القطبين المتنافسين، مما يجعل هذه الدول أول من يدفع الثمن الباهظ لأي تحول مفاجئ في موازين القوة العالمية، أو لأي خطأ في التقدير أو حادث عسكري قد يشتعل في إحدى بؤر الصراع العديدة التي تعج بها المنطقة.
2- تآكل النظام الأمني الإقليمي التقليدي: فلم تعد الضمانات الأمنية القديمة قادرة على احتواء التهديدات الجديدة، وتتصدع أركان مفهوم الأمن الإقليمي التقليدي تحت وطأة تحولات جيوبوليتيكية وتكنولوجية عميقة، حيث لم تعد عقيدة الردع المتبادلة القائمة على التهديد التقليدي قادرة على احتواء التهديدات الجديدة في عصر يتسم بالسيولة والاضطراب، فالمنطقة التي تعاني تاريخياً من عجز مزمن في الأمن الجماعي وغياب تصورات مشتركة حول مصادر التهديد، تواجه الآن ديناميكيات أكثر تعقيداً، فلقد أنهت التكنولوجيا الحديثة، من الطائرات المسيرة (الدرونز) المتفوقة تقنياً إلى الهجمات السيبرانية الاستراتيجية، مفاهيم السيادة التقليدية وغيّرت طبيعة الحرب ذاتها، وأدى هذا إلى بروز واقع أمني "سائل"، حيث يمكن للدول والجماعات من غير الدول شن ضربات مؤثرة بتكاليف مالية وبشرية زهيدة نسبياً، مما يجعل حساب الردع التقليدي عاجزاً عن التنبؤ بالتصعيد أو منعه، وفي هذا العصر - "عصر الردع المضطرب" - تتداخل أدوات القوة وتصبح الحروب الهجينة التي تمزج بين الوسائل العسكرية والاقتصادية والسيبرانية والإعلامية هي السائدة، حيث تتبنى القوى الكبرى استراتيجيات أمنية جديدة تعترف صراحةً بهذه التهديدات متعددة الأبعاد، وبذلك لم يعد السؤال يدور حول من يمتلك القوة العسكرية الأعظم، بل حول من يسيطر على الفضاء الإلكتروني، ومن يوجه سيل المعلومات، ومن يستطيع تنفيذ عمليات غير متماثلة تعيد تعريف مفاهيم الأمن والتهديد في القرن الحادي والعشرين.
3. اقتصاديات الصراع الجديدة: ففي قلب بؤر الصراع الحديثة، لم تعد الحرب مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل تحولت إلى نظام اقتصادي مظلم ومعقد يتسم بالعولمة والاستدامة الذاتية، ولقد أفرزت هذه النزاعات "اقتصادات ظل معولمة" متطورة، تعمل كآلة مالية ضخمة تعتمد على شبكات دولية معقدة للتهريب وتبييض الأموال والابتزاز، والتي تُدار غالباً عبر الحدود وباستخدام تقنيات متقدمة مثل العملات المشفرة لتجنب الكشف، وتُظهر التقارير أن حجم هذه الأنشطة هائل؛ ففي أوروبا وحدها، يُقدَّر أن 750 مليار دولار من الأموال غير المشروعة جرى تبييضها خلال عام 2023، وهو مبلغ يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، مع تدفق ما يقرب من 195 مليار دولار عابرة للحدود، وهذه الأموال لا تمول شراء الأسلحة والذخيرة فحسب، بل هي الوقود الذي يجعل الصراعات "ذاتية الاستدامة" أو "تتوالد ذاتياً"، حيث يصبح الاستمرار في القتال أكثر ربحية من السلم بالنسبة للعديد من الفاعلين، ويكمن الخطر الأعمق في التحالفات العضوية الغريبة التي تنسجها هذه الاقتصادات، فهي تخلق مصالح مشتركة بين النخب الفاسدة داخل أجهزة الدولة وبين قادة الجماعات المسلحة من خارجها، حيث يتقاسم الطرفان عائدات نهب الموارد والتهريب، ويعمل الفساد هنا كحجر زاوية، حيث يمكن لهذه الشبكات أن "تتجنب العدالة، وتقوض الحكم الرشيد، وتبسط نفوذها وتوسع عملياتها"، مما يخلق دائرة مفرغة يصعب كسرها: فالمال القذر يطيل أمد العنف، والعنف المستمر يفتح آفاقاً جديدة لتراكم الثروات غير المشروعة، مما يحول المجتمعات إلى ساحات مفتوحة لاستثمار الدمار.
وفي عصرٍ تذوب فيه الحدود بين السلم والحرب، ولم تعد التهديدات والحروب تقليدية تُعلن بصراحة، نجد أننا إزاء حروب جديدة تُشن في صمت عبر الفضاء الإلكتروني، وتُدار بذكاء آلي لا يعترف بالحدود، وتُخطط في ظل الغموض، إنها حروب بلا جيوش تقليدية، لكن بقدرة تدميرية تعيد تعريف الهزيمة والانتصار، حيث قد يكفي هجوم سيبراني لتعطيل اقتصاد، أو سرب مسير لانهيار إقليم، إنها تحدي وجودي يذيب الفروق بين الأمام والخلف، بين العسكري والمدني، ويجبر العالم على إعادة صياغة كل مفاهيمه الراسخة عن الأمن والسيادة:
1- المجال السيبراني: ساحة المعركة الخفية وحروب الإرباك الاستراتيجي، حيث يتحول الفضاء الإلكتروني من مجرد نطاق تقني إلى ساحة حرب دائمة وأحد أكثر الميادين الجيوبوليتيكية إثارة للقلق في عصرنا، ولم تعد الهجمات السيبرانية مجرد أعمال تخريب فردية، بل تحولت إلى "هجمات استراتيجية" مُمنهجة تشنها دول وكتل كبرى، تستهدف بشكل متعمد وشبه دائم البنى التحتية الحيوية التي تشكل عماد الحياة المدنية والعسكرية على السواء، فشبكات الطاقة، والمنشآت المائية، والأنظمة المالية والمصرفية، بل وحتى البنية التحتية الفضائية الحيوية للاتصالات والملاحة، أصبحت جميعها أهدافاً مشروعة في صراع غير مُعلن، وتهدف هذه الهجمات المتطورة، التي تمتلكها وتنفذها جهات فاعلة على مستوى الدول، إلى تحقيق ما هو أبعد من السرقة أو الإحراج المؤقت؛ إنها تسعى لزعزعة الاستقرار الوطني واختبار مرونة الدول وقدرتها على الصمود من خلال إرباك عميق قد يصل إلى مستوى "صدمة عالمية" تهدد النشاط الاقتصادي والعلاقات الدولية.
تكمن الخطورة الفائقة لهذا الشكل من المواجهة في طابعه "الهجين" وقدرته على خلق آثار تدميرية ملموسة دون تورط عسكري مباشر أو إعلان حرب تقليدي، مما يضع نظرية الردع الكلاسيكية على المحك، فقد شهد العالم هجمات أدت إلى تعطيل عشرات الآلاف من المحطات الطرفية للاتصالات عبر قارة بأكملها، أو عطلت خدمات الملاحة الجوية، وتكشف استراتيجيات الدول الكبرى عن سباق تسلح رقمي محموم، حيث تتحول الجهود من الدفاع إلى الهجوم، وتسعى الحكومات إلى تعزيز قدراتها الهجومية باستمرار، حتى عبر التعاون مع شركات تقنية خاصة، في سعي لتحقيق التفوق في هذه الجبهة غير المرئية، وهكذا يصبح الفضاء السيبراني أداة قوة مثالية، منخفضة التكلفة، صعبة الإسناد، وقادرة على حصد انتصارات استراتيجية من خلف الشاشات، مما يعيد تعريف مفاهيم السيادة والأمن في القرن الحادي والعشرين.
2. حروب المعلومات والأزمات الهوياتية: ففي المشهد الجيوبوليتيكي المعاصر، تتحول منصات التواصل الاجتماعي من مجرد أدوات للاتصال إلى ساحات معقدة لحروب المعلومات، حيث يتم تنفيذ حملات تضليل منظمة تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي من الداخل، وتتعمد هذه الحملات، التي تقودها غالباً جهات فاعلة على مستوى الدول، استغلال الانقسامات الطائفية والإثنية والهويات الفرعية، وتحويلها إلى أسلحة إستراتيجية في صراعات القوة، ولم يعد الصراع يدور فقط على الأرض، بل انتقل إلى العقل والقلب، حيث تُستخدم الخوارزميات والمحتوى المصمم لإثارة الغضب لزرع الشك وتمزيق أواصر الثقة المجتمعية، مما يجعل المجتمعات أكثر استقطاباً وهشاشة، وفي هذا السياق تصبح الهوية نفسها ساحة قتال، حيث يتم استدعاء التاريخ بشكل انتقائي وإعادة صياغة الروايات الجماعية لخدمة أجندات الحاضر، وهي عملية يصفها الباحثون بأنها "تصنيع للأصالة" أو استراتيجيات للهوية توظف لأغراض سياسية، ويؤدي هذا الاستغلال المتعمد للهوية إلى تعميق "أزمات الهوية" على المستوى الوطني، كما تُظهر الحالات الإقليمية، حيث تجد الدول ذاتها عالقة بين هوية تقليدية لم تعد قادرة على الحفاظ عليها وواقع جديد يتطلب إعادة تعريف، وهكذا تخلق حروب المعلومات واقعاً هجيناً، يذوب فيه الحد بين الحقائق والتزييف، حيث تكون المعركة الأهم هي معركة السرد والشرعية، والتي تُخسر نتائجها ليس في الميدان العسكري، بل في عمق المجتمع ووعي أفراده.
3. أمن الممرات البحرية: تحت أمواج الشرق الأوسط، تكمن شرايين حياة الاقتصاد العالمي ونقاط ضعفه الأكثر خطورة في آنٍ معاً، وهذه الممرات المائية ليست مجرد قنوات ملاحية عادية، بل هي شرايين استراتيجية حيوية لا يمكن تعويضها لأمن الطاقة والتدفق التجاري العالمي، ويحتل مضيق هرمز مكانة محورية حاسمة، حيث يعبر ما يقرب من ثلث تجارة النفط العالمية و 20٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر ممره المائي الضيق، وهو ومضائق أخرى مثل مضيق باب المندب وقناة السويس يشكلون معاً نظام نقل الدم للحضارة الصناعية الحديثة، حيث يرتبط انسيابها مباشرة بنبض المصانع في شرق آسيا والمنازل في أوروبا.
وفي القلب من هذه المعادلة، يبرز مضيق البوسفور في تركيا كحلقة وصل حيوية أخرى لا تقل أهمية، فهو ليس مجرد مضيق جغرافي يفصل بين قارتي أوروبا وآسيا، بل هو ممر مائي دولي بالغ الأهمية يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، ومن ثم بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط العالمي، وتُظهر الأرقام حجم هذه الأهمية: فقد مرّ عبر المضيق حوالي 47,000 سفينة في عام 2003 فقط، من بينها أكثر من 8,000 سفينة تحمل مواد خطرة كالنفط والغاز، وهذه الحركة الملاحية المكثفة - والتي يفوق حجمها في بعض السنوات حركة قناة السويس - تجعل من البوسفور واحداً من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً واستراتيجية في العالم، وتقليدياً يشكل البوسفور مع مضيق الدردنيل المخرج البحري الوحيد لدول البحر الأسود، بما فيها روسيا وأوكرانيا، إلى المياه الدافئة، مما يضفي عليه بعداً جيوبوليتيكياً بالغ التعقيد، وهكذا تُنسج خريطة القوة في المنطقة من خلال هذا التشابك الوثيق بين هرمز والبوسفور وقناة السويس وباب المندب، حيث يتحول كل مضيق إلى حلقة في سلسلة أمنية واحدة، وكل تهديد لأي منها هو هزة محتملة لاستقرار النظام العالمي بأسره.
ومع ذلك، فإن هذا الخط الحيوي مغلف بمخاطر جيوبوليتيكية متصاعدة، مما يحوله من ممر تجاري إلى ساحة حرب محتملة متعددة الأبعاد، والتهديدات ملموسة ومتنوعة؛ ففي البحر الأحمر وخليج عدن، أثبتت جماعة الحوثي قدرتها على تعطيل أو حتى إغراق السفن التجارية، حيث تؤدي الهجمات ذات الصلة مباشرة إلى ارتفاع تكاليف تأمين الشحن وإجبار السفن على التفاف يصل إلى آلاف الأميال البحرية، وفي مضيق هرمز، لم يختف شبح الإغلاق مطلقاً، حيث يحذر الخبراء من أن أي محاولة لتعطيله قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى "منطقة مجهولة" مع عواقب كارثية؛ وفي مناطق مثل البحر الأسود، استهدفت النزاعات بين الجهات الفاعلة الحكومية ناقلات النفط والموانئ التابعة للطرف الآخر بشكل مباشر، وتشكل هذه التهديدات مجتمعة بيئة أمن بحري يتميز بالاستمرارية في النزاع.
ويُضخم هذا الشعور المستمر بعدم الاستقرار، عبر آليات السوق العالمية المعقدة، ليصبح هزة اقتصادية واسعة النطاق، تؤدي إلى سلسلة من المخاطر والتهديدات كالإغلاق وتعطيل الشحن، وارتفاع حاد في تكاليف التأمين، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد؛ مما يؤدي إلى ذعر السوق من نقص الإمدادات وتحفيز سلوك المضاربة، وعلى الرغم من وجود أساسيات العرض والطلب، فإن علاوة المخاطرة سترفع أسعار الطاقة بشكل حاد، وهذا الارتفاع في الأسعار ليس حدثاً معزولاً، بل ينتقل عبر جميع الصناعات، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي، ويضرب في النهاية اقتصادات كبرى تعتمد بشدة على استيراد الطاقة، مثل الصين والهند والدول الأوروبية، لذلك فإن أمن الممرات البحرية في الشرق الأوسط لم يعد مجرد قضية إقليمية، بل هو حجر الزاوية للثقة الأساسية التي تحافظ على عمل الاقتصاد العالمي، وما إن تهتز، فلن يكون بوسع أحد إيقاف ردود الفعل المتسلسلة الحتمية.
الخاتمة: نحو نموذج أمني مرن في زمن التهديدات السائلة
تواجه دول الشرق الأوسط، في قلب ما يصفه علماء الاجتماع مثل أولريش بيك (Ulrich Beck) "بمجتمع المخاطر العالمي"، معضلة وجودية حادة، فلقد تجاوزت التهديدات المعاصرة - من السيبرانية والإرهاب العابر للحدود إلى الأزمات البيئية والاقتصادات الموازية - قدرة النماذج الأمنية التقليدية القائمة على الدفاع عن الحدود الصلبة والتحالفات الثابتة، وهذه التهديدات الجديدة هي بطبيعتها "بينية" أو "متداخلة" (Intermistic)، حيث تنشأ من خليط معقد من العوامل الداخلية والخارجية، وتستغل الروابط العابرة للحدود الإثنية والأيديولوجية لتقويض استقرار الدول، في هذا المشهد السائل، حيث يذوب الفارق بين الداخلي والخارجي وبين العسكري والمدني، يصبح السؤال الجوهري: كيف تبني الدول أمنها في عالم لا تأتي فيه المخاطر من اتجاه واحد، بل تتسرب من كل الحدود، الحقيقية والافتراضية؟
والجواب الاستراتيجي يكمن في التحول من عقيدة الردع الصلد إلى هندسة مرنة "لشبكات الأمن التكيفية"، وهذا التحول يتطلب التخلي عن الرؤية الأحادية والانخراط في بناء تحالفات تكتيكية وموضوعية حول تهديدات محددة، مثل الأمن المائي أو مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما يتطلب تعاوناً عميقاً في المجالات غير السياسية التقليدية - كالبيئة والصحة العامة وإدارة الموارد - التي تشكل خطوط دفاع أولى حيوية لصمود المجتمعات، وهذا النهج يستلهم بشكل ما، منطق "إعادة التوازن" الاستراتيجي الذي نادى به بعض صانعي السياسة، والذي يعترف بضرورة تركيز الموارد المحدودة على الأولويات الأكثر إلحاحاً عبر أدوات متنوعة ودقيقة، ومستقبل الاستقرار في المنطقة سيتحدد في النهاية، بقدرة النخب الحاكمة والفكرية على قراءة تعقيدات هذه العواصف المتقاطعة، وامتلاك الشجاعة لابتكار هندسة أمنية جديدة تكون مرنة كفاية للانحناء أمام العواصف دون أن تنكسر، وذكية كفاية للبقاء في قلب العاصفة وإدارتها.
---------------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش