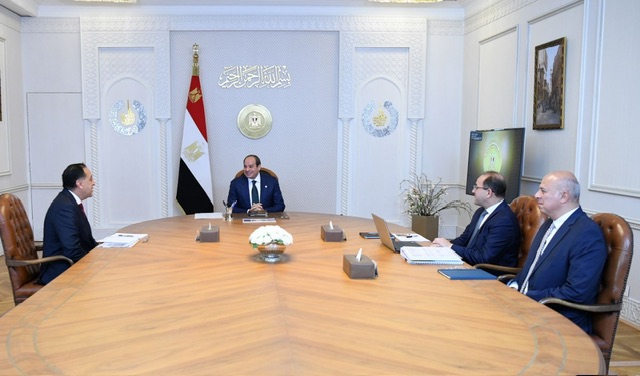لم يعد من الممكن تصور عدم الوفاء بالاستحقاق المدني الديمقراطي الذي تأخر لأكثر من سبعة عقود
- الانتخابات الأخيرة أضاءت إشارات حمراء على ما يبدو في دوائر الحكم
- الحوار حول الانتقال الديمقراطي ضروري كي لا تفلت أيادينا فرصة تضاف إلى قائمة طويلة من "الفرص الضائعة"
- ما الذي يمنع من تنفيذ توجيهات الرئيس بالتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة؟
- حين يتحول مبدأ "سيادة القانون" إلى واقع يبعث الاطمئنان في نفوس المواطنين بأن حقوقهم مُصانة
- قوى محافظة تخشى أي عملية للانتقال الديمقراطي، وهذه القوى ناصبت ثورة يناير 2011 العداء
- في 2013 لم تكن مصر بصدد انتقال نحو الديمقراطية، وانما "صراع على السلطة"، يُدار بمنطق وقف "أخونة" الدولة.
"أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبداً". ينطبق هذا المثل تمامًا على استحقاق أن تتحول مصر إلى "دولة مدنية ديمقراطية حديثة" بما يتماشى مع مشروعات التحديث وتغيير البنية الأساسية للدولة، كي تكون مواكبة للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في العالم بتأثير الثورة الرقمية والدور المتزايد الذي تلعبه الخوارزميات في الحياة اليومية لحياة مليارات البشر حول العالم. لم يعد من الممكن تصور عدم الوفاء بالاستحقاق المدني الديمقراطي الذي تأخر لأكثر من سبعة عقود، والذي كان مطلبًا رئيسيًا للجماهير التي انتفضت في عام 2011. وأصبح هذا الاستحقاق أكثر إلحاحًا في ضوء ما جرى في انتخابات مجلس النواب التي جرت مؤخرًا، وما شابها من مخالفات وممارسات تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية والتي استدعت تدخل رئيس الدولة وإصدار توجيهات ببحث ما ورد من تقارير وشكاوى واستغاثة من مرشحين مستقلين والتحقيق فيها، وقد ترتب على ذلك إعادة الانتخاب بالكامل في الكثير من الدوائر الفردية.
الآن، ومع اقتراب الذكرى الخامسة عشر لثورة 25 يناير، وفي ضوء ما جرى خلال تلك السنوات من ممارسات أوصلتنا إلى المشهد الذي رأيناه في الانتخابات البرلمانية لعام 2025، والتأثير الكبير للمال السياسي، وما يترتب على ذلك من وصول نواب لا يمثلون القاعدة الكبيرة للناخبين، خصوصًا في ظل المؤشرات الرسمية عن تدني الاقبال على التصويت، والذي تشير تقديرات غير رسمية لمراقبي الانتخابات إلى أنها أقل بكثير من الأرقام المعلنة. هذه المؤشرات أضاءت إشارات حمراء على ما يبدو في دوائر الحكم، وتحدث نائب مقرب للرئيس ولأجهزة نافذة في الدولة، عن تغييرات وشيكة بعد اكتمال انعقاد البرلمان بمجلسيه، الشيوخ والنواب والتي تطول وجوهًا كثيرة في الحكومة وتدفع بوجوه جديدة ودماء جديدة. ثمة ضرورة في ظل هذه التطورات لفتح النقاش العام حول الانتقال إلى الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. فالقضية ليست قضية شخوص ووجوه، وإنما الفلسفة العامة التي تحكم توجهات النظام السياسي.
قبل خمسة أعوام، وتحديدا في التاسع من ديسمبر 2020، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أثناء مشاركته في احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر "توجيهات بالتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة". وأبرزت صحف مصرية هذا التصريح، لكن لم تُتخذ أي خطوات لتحويل توجيهات الرئيس إلى برنامج أو خطة عمل قابلة للتنفيذ. ومن حقنا أن نسأل ما الذي يمنع تنفيذ هذه التوجيهات التي تعبر عن إدراك الرئيس لضرورة هذا التحول وأهميته؟ ولماذا لم تنصرف الجهود خلال الحوار الوطني الذي انطلق في سبتمبر 2023، أي بعد مرور عامين وتسعة أشهر على تصريح رئيس الوزراء، لتفعيل التحول لدولة مدنية حديثة تنفيذا لتوجيهات الرئيس؟ إن عدم الإجابة على هذين السؤالين يعزز الاعتقاد لدى كثير من المراقبين، في الداخل والخارج، بأن تصريح رئيس الوزراء كان تصريحًا به في مناسبة رسمية وانتهي الأمر عند هذا الحد.

صحوة ممكنة وصيحة للتصحيح
كان من الممكن أن تكون هذه التوجيهات بداية صحوة والمضي قدمًا للوفاء بالاستحقاق المؤجل كمقدمة لإصلاحات سياسية ضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتخطيط لترسيخ الديمقراطية كأسلوب للحكم، يبدأ بنظام انتخابي تتوافر فيه المعايير التي تضمن تشكيل برلمان يُعبر عن الإرادة الحقيقة للسواد الأعظم للمواطنين، ويمارس سلطته التشريعية باستقلالية وثقة بما يجعل المواطنين مطمئنين بأن التشريعات تحقق مصالحهم، وبما يحقق التوازن بين مصالح متعارضة بالضرورة، وبما يضمن أيضًا ترسيخ الديمقراطية كآلية في الإدارة لترشيد عملية اتخاذ القرارات، عبر تفعيل الآليات التي تضمن مشاركة المستويات المختلفة في الجهاز الإداري للدولة في عملية صنع القرار واتخاذه، ليتحول مبدأ "سيادة القانون" الذي هو ركن أساسي للدولة المدنية الحديثة إلى واقع يبعث الاطمئنان في نفوس المواطنين بأن حقوقهم مُصانة من خلال آليات واضحة للرقابة والمساءلة على مستوى الدولة. هذه هي المبادئ المرتبطة بالنظم الديمقراطية الحديثة التي توجه ممارسة السياسة والحكم، معلومة للجميع ولا يثور خلاف حولها، إنما الخلاف يثور بصدد كيفية تنفيذها في الواقع، وهي مسألة يزيدها تعقيدًا تراجع الثقة في فاعلية الديمقراطية، حتى في الدول التي ترسخت فيها العملية الديمقراطية.
لا يخفى على أحد أن الوضع الراهن في مصر تسببت فيه قوى محافظة تخشى أي عملية للانتقال الديمقراطي، وأن هذه القوى ناصبت ثورة يناير 2011 العداء، واحتشدت في مارس 2011، تأييدا لإدخال تعديلات على دستور 1971، لقطع الطريق على القوى المطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، كانت ترفع شعار "الدستور أولًا". وتنكَّرت هذه القوى للوثيقة الثانية التي أصدرها مثقفون من كل التوجهات اجتمعوا في الأزهر، في إبريل 2011، والتي حملت اسم وثيقة الأزهر "للدولة المدنية الحديثة"، رغم حذف كلمة "ديمقراطية" من هذه الوثيقة كحل توافقي بين الفرقاء الذين اجتمعوا. في ذلك الوقت، أصرت مجموعة من المثقفين الذين بادروا إلى إعلان "التحالف المدني الديمقراطي" في مارس 2011، على ربط فكرة "مدنية" الدولة بالديمقراطية والحداثة، وأكدوا أنه "لا مرجعية للدولة المدنية" سوى الفكر المدني الحديث، وأن الزج بأي مرجعيات أخرى هو نوع من الدجل لدغدغة مشاعر الجماهير وفرض تصور واحد لشكل الدولة، وأكدوا أن هذا التوجه هو نقطة البداية للاستبداد. صحيح أن قطاعًا واسعًا من النخبة السياسية والاستراتيجية وجد في الفكرة المدنية الديمقراطية مخرجًا من المأزق الذي ارتبط بحكم جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن هذا القطاع لم يبذل ما يكفي من جهد لتحويل التحول الديمقراطي إلى عملية متتابعة ترسم ملامح جديدة للدولة ومؤسساتها.
غير أن هذه النخبة التي انبثقت عنها لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014، استطاعت تضمين رؤيتها في مواد الدستور، الذي يتضمن الكثير من الاستحقاقات التي لم يتم الوفاء بها بعد. ثمة أحاديث تتردد عن مشاورات لتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، وهي من الاستحقاقات التي طال انتظارها، والتي تعد تتويجا لجهود قطاعات عريضة من المثقفين أواخر عهد الرئيس حسني مبارك لمعالجة مشكلة الطائفة والتمييز الديني. واحتشدت تلك القطاعات للعمل من خلال مبادرة "مصريون ضد التمييز الديني" والتي تحولت لاحقًا إلى مؤسسة "مصريون في وطن واحد". تم من خلال هذه المبادرة إصدار العديد من الدراسات والتقارير والتوصيات والاقتراحات للخروج من مأزق التمييز الديني والطائفية، الذي أصبح سمة مرتبطة بأسلوب الحكم والإدارة لأسباب عديدة، في مقدمتها غياب الديمقراطية ومشروع الإصلاح السياسي، والتي كادت أن تهدد ركيزة أساسية من ركائز الدولة المصرية الحديثة والتي استقرت في خضم ثورة مصر الوطنية الديمقراطية في عام 1919، بتأثير سلسلة من الحوادث كان آخرها تفجير استهدف كنيسة القديسين في الإسكندرية عشية أول أيام عام 2011، والذي كان مقدمة للانتفاضة في 25 يناير، وما سبقها من اعتداءات كانت سببًا لانطلاق عشرات المبادرات الأخرى.

الديمقراطية وروح المبادرة الفردية
تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية كان من بين الأهداف الأساسية التي أكدتها مبادرة "التحالف المدني الديمقراطي" في عام 2011، انطلاقًا من إيمان عميق بأن كثرة المبادرات المستقلة، الفردية والمجتمعية، يعد أحد المؤشرات الدالة على حيوية فكرة الديمقراطية في المجتمع. المبادرة ذاتها تبلورت في خضم التفاعل في أعقاب انتخابات عام 2005، واستندت إلى فرضية أساسية تبلورت في خضم النقاشات التي أعقبت حصول مرشحي جماعة الإخوان المسلمين على 88 مقعدًا في مجلس النواب، لتصبح أكبر كتلة معارضة في البرلمان. طرحت جماعة الإخوان في ذلك الوقت فكرة "الدولة المدنية بمرجعية إسلامية" والتي عارضها عدد من المثقفين الليبراليين الذين أكدوا فكرة "الحكم المدني"، و"التشريع الوضعي" و"سيادة القانون" كركائز للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، ودارت مناقشات وحوارات كثيرة حول هذه النقاط، ورأينا في أعقاب ثورة 2011، ضرورة أن يكون هناك فرزٌ سياسيٌ جديد على أساس الموقف من المرجعية المدنية الخالصة للدولة والحكم، ورفض أي مرجعية دينية للدولة. لا ينطلق هذا الموقف من العداء للدين، وإنما من الحرص على ضرورة وضع حدود فاصلة بين المجالين، السياسي والديني، تأكيدًا لمبدأ المواطنة، وهو ما أقره دستور 2014، والتعديل الذي أجرى على نص المادة 200 في عام 2019، بتكليف القوات المسلحة يصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، إلى جانب مهامها الأخرى المنصوص عليها في الدستور، وهو تعديل ضروري لتصحيح وضع القوات المسلحة ودورها، كضامن أساسي لتماسك المجتمع والدولة وحامي للمبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة.
ثمة معلومات تفيد بأن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية انخرطت أثناء ثورة 2011، في مراقبة وتحليل "الديناميكيات الاجتماعية والسياسية والدولية الأوسع"، انطلاقا من تقدير بأن ثورة 25 يناير لم تكن حدثًا سياسيًا، وإنما كانت تعبيرا عن "تحول مجتمعي شامل يعيد صياغة العلاقات الشخصية والعقليات والصراعات اليومية، حتى خارج نطاق الخطاب السياسي المباشر"، بتعبير الدكتور أحمد حمدي درويش في تعليقه على ملاحظة أبديتها على ما كتبه بخصوص توجيهات الرئيس للتحول للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، على حسابه الشخصي على الفيسبوك. وأشار في تعليقه إلى أن المعركة على مفهوم "الدولة المدنية" لم يقتصر على ندوات المثقفين، بل "كانت جزءاً من صراع وجودي أوسع". يسلط هذا التعليق بالغ الأهمية الضوء على كيفية تعامل الدولة المصرية، "ببنيتها العميقة ونخبها البيروقراطية والأمنية التاريخية"، مع صعود قوة سياسية قديمة، مثل جماعة الإخوان المسلمين في تلك المرحلة، ورأت أن في هذا الصعود "اختطاف للدولة" و"استباحة" لامتيازاتها المُتوارثة، مما أدى لاحقاً إلى سياسة منهجية تهدف إلى "استعادة الدولة" وقطع الطريق على التغيير السياسي وجعله "غير ممكن".
غير أن هذه الدوائر لم تغفل في الوقت نفسه عن التحولات العميقة في بنية المجتمع المصري والتي تبشر بصعود قوى اجتماعية وسياسية جديدة. يوضح درويش في تعليقه، أنه في هذا السياق، لم يكن الحوار حول مصطلحات وثيقة الأزهر، "حوارًا فكريًا وحسب، وإنما كان مناورة في معركة كبرى لتحديد هوية الدولة ومصادر شرعيتها، وهي معركة كانت الدولة العميقة وأجهزتها طرفاً رئيسياً فيها منذ اللحظة الأولى"، ويشير إلى إدراك لدى القيادات في الدولة بأن تحقيق "الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة" يتطلب ما هو أكثر من تغيير الدستور أو النخبة الحاكمة؛ ويتطلب تحولاً في بنى السلطة المُتعددة داخل المجتمع نفسه، ومواجهة شبكة مصالح مترسخة ترى في أي تغيير جوهري تهديداً لوجودها".
هذه شهادة مهمة تسلط الضوء على طريقة تفكير القيادة التي قادت التغيير في 2013، والتي توافرت عليها بيانات يمكن استخلاصها من بين سطور التصريحات التي صدرت من بعض رموزها في تلك الفترة. كان تقديري الشخصي من خلال تحليل المعطيات والبيانات المتوافرة، في ذلك الوقت، وقراءتي للمشهد وتحليل مواقف الأطراف المختلفة، أن مصر لم تكن بصدد انتقال نحو الديمقراطية، وأن ما تشهده البلاد هو "صراع على السلطة"، يُدار بمنطق الدفاع عن هوية الدولة وتراثها في مواجهة مشروع انقلابي كبير أطلق عليه اسم "أخونة" الدولة، كجزء من خطة "التمكين"، التي وضعها المخطط الاستراتيجي للجماعة، خيرت الشاطر، وجرى كشفها. هذه الخطة كانت ستضع مصر في تحالفات إقليمية تضم دولا وجماعات وتزج بها في صراعات إقليمية ودولية بغرض تعديل موازين القوى الداخلية وإحكام السيطرة على الدولة ومقدراتها.
غير أن هذه الخطة تصادمت، بشكل مباشر، مع تطلعات الشعب والقوى التي انتفضت لمواجهة الخطوة الأولى لتنفيذها والمتمثلة في التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس المخلوع محمد مرسي في 22 نوفمبر عام 2012، والتي جاءت كانقلاب على الإعلان الدستوري المكمل الصادر في يونيو من ذلك العام والذي قبلته جماعة الإخوان المسلمين، قبل إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة مباشرة، كمحصلة لما تم الاتفاق عليه في جولات من التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف بإدارة شؤون الدولة بموجب خطاب التنحي في 11 فبراير 2011. ولجأ المجلس إلى هذه الآلية في سياق إدارة الأزمة التي ترتبت على إعلان جماعة الإخوان المسلمين نتائج الفرز الذي أجرته للأصوات والذي يؤكد فوز مرشحها وإصرارها على رفض أي نتيجة مغايرة قد تعلنها الهيئة المشرفة على الانتخابات، وما أحدثه هذا الإعلان المبكر من انقسامات على مستوى النخبة السياسية، وما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد تماسك الدولة والمجتمع.
كان من المهم التذكير ببعض تفاصيل هذا التاريخ القريب والتي ضاعت في غمرة الأحداث التالية، للتفكير في كيفية طرح موضوع التحول إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به مصر، داخليًا وإقليميًا، وأظن أننا بحاجة إلى إجراء مصالحة فكرية وتاريخية بين فكرتي الاستقرار من ناحية، والصراع السياسي من ناحية أخرى. ثمة آراء منسوبة للرئيس عبد الفتاح السياسي وقت المفاوضات بين الإخوان والمؤسسة العسكرية تعكس رؤية الرجل للمشهد السياسي والحزبي في مصر في ذلك الوقت، وتعبر عن تقييم لمستوى نضح النخبة السياسية والأحزاب السياسية. لا يختلف اثنان على حقيقة هشاشة المجتمع السياسي المصري، رغم الخلافات الكبيرة حول أسباب هذه الهشاشة. في وضع كهذا لم نكن نملك سوى طرح رؤية من خلال "التحالف المدني الديمقراطي"، الذي سبق تجربة "جبهة الإنقاذ" بشهور، إلى أن تحين اللحظة المناسبة لإعادة طرحها. وتتمحور هذه الفكرة حول الإصرار على الربط الواضح بين المدنية والديمقراطية والحداثة، وأظن أنه بات واضحًا من خلال قراءة وتحليل المشهد الراهن ضرورة البدء في حوار بناء وجاد يتعامل مع التحديات التي تحول دون هذا الانتقال بغرض تذليلها، وليس بغرض تصديرها للتهرب من الوفاء بهذا الاستحقاق المؤجل، الذي أرى فيه خلاصًا من الأزمات التي تحيط بنا، مجتمعًا ودولة. وكم أسعدتني كلمات الدكتور أحمد حمدي درويش التي أكد خلالها "خطورة الصمت عن أي غموض أو تسوية في المرجعية" المدنية للدولة والتي تعني "فتح الباب أمام استعادة الأوضاع القديمة بثوب جديد".

مأسسة الحوار حول الانتقال الديمقراطي
أظن أن الحوار الذي أشرت إليه في السطور السابقة، قد يكون لفتة تشير إلى نوع الحوار الذي تتطلع إليه الكثير من القوى الإصلاحية والديمقراطية، وهو حوار شامل يجري على مستويات عدة، ترعاه الدولة ومؤسساتها المختلفة من ناحية، وتشارك فيه كطرف عبر ممثلين لتلك المؤسسات من ناحية أخرى، ولا يقتصر فقط على جلسات رسمية يجري ترتيبها، وإنما يمتد عبر المنصات الإعلامية المختلفة، ومراكز البحث والتفكير، والاستفادة مما تطرحه مختلف البحوث الاجتماعية والسياسية كي تكون الرؤية مؤسسة على بحوث علمية دقيقة، تضبط الميول والتقديرات الشخصية والانطباعات الأولية لدى المشاركين، وتستفيد من المبادرات والتجارب السابقة وتبني على التراكم الذي حققته، وأشير في هذا الصدد إلى كتاب مهم للدكتور علي الدين هلال، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، صدر أواخر عام 2019، حول الانتقال الديمقراطي. هذه اعتبارات أساسية تُثري النقاش حول شروط التحول الديمقراطي الناجح، وتُظهر التعقيدات العملية التي قد تعترض تطبيق في سياقات محددة، بغرض التعامل مع التحديات وتذليلها كما أشرت.
البدء في هذا الحوار ضروري كي لا تفلت أيادينا فرصة أخرى سانحة، لتضاف إلى قائمة طويلة من "الفرص الضائعة" بتعبير المفكر الاستراتيجي الراحل، أمين هويدي. الغاية الرئيسية من هذا الحوار هو بلورة واستئناف للعديد من المبادرات التي انطلقت، في سياق تجربة تحالف الأحزاب المدنية، والحوار الوطني، وما صدر عن هذه المبادرات من أوراق وتوصيات يمكن التعويل عليها في عملية اجتماعية وسياسية ممتدة لبناء توافق عام حول المقومات الأساسية لعملية الإصلاح السياسي التي تستهدف الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة. هذا الحوار يجب أن يشمل جميع القوى، بما في ذلك القوى المحافظة المتوجسة من الديمقراطية، وحتى القوى الرافضة للديمقراطية انطلاقًا من خلفيات أيديولوجية دينية أو بشرية، ويجب أن يكون مفتوحًا لكل من يرغب في المشاركة فيه دون شروط مسبقة يضعها أي طرف من أطرافه. وبهذا يكون الانعزال والإقصاء خيار للقوى التي ترفض المشاركة في الحوار. فبناء التوافق العام لا ينفي وجود قوى رافضة، ويتعين وضع تصورات للتعامل مع هذه القوى الرافضة ومواصلة الحوار معها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
من المهم في هذا الصدد الانشغال بإطلاق هذه الآلية، وألا يعوق الانشغال بالنتائج المرجوة إطلاقها، انطلاقا من شرط وحيد وأساسي وضروري وهو التفكير في كيفية إحداث التحول المنشود، الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. هذه الآلية مؤشر على جدية الرغبة في البدء في إصلاح سياسي شامل قد يكون ضرورة للتعامل مع الضغوط والتحديات المصاحبة لعملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي وما قد يترتب عليها من توترات واضطرابات، وأن يكون الحوار آلية حضارية للنقاش حول الرؤى المختلفة للمستقبل يحول دون فرض رؤية هذه القوة أو تلك من القوى السياسية المتنافسة، بل المتصارعة حول مفاهيم المفاهيم السياسية الكبرى، وفي مقدمتها مفاهيم المدنية والديمقراطية والحداثة. وقد يكون من الضروري استلهام الدروس المستفادة من التجارب السابقة والتعلم منها لعدم تكرار تجارب أفضت إلى نماذج للتوافق الهش، على النحو الذي بينته تجربة "وثيقتي الأزهر"، التي لا يستحضرها أحد بسبب عدم الجدية التي حالت دون صدور الوثيقة الثالثة الخاصة بحقوق المرأة المصرية رغم الانتهاء من صياغة مسودتها النهائية في 17 مارس عام 2013، وهي الصياغة التي أظهرت هيمنة القوى الإسلامية وهَمَّشت القوى المدنية، والتي تجسد تُفاوض القوى السياسية على المصطلحات في لحظات "التوافق الهش"، والتي تعكس التوتر البنيوي بين الرغبة في تحقيق توافق واسع، رغم وجود خلافات جوهرية حول مضمون المفاهيم، وهي إشكالية وتحدي ينبغي للحوار المنتظر التعامل معها، ويمكن في هذا الصدد الاستفادة من الحلول التي يقترحها نموذج "الديمقراطية التوافقية" وما يرتبط بها من مفاهيم، قد تستدعي التريث لبعض الوقت في الانتقال إلى صيغة "الديمقراطية التنافسية". وعلى الرغم من نموذج "الديمقراطية الليبرالية" بما ينطوي عليه من قيم ومبادئ تحمي الأقليات السياسية والاجتماعية من استبداد الأغلبية، استنادًا إلى مبدأ أغلبية الأصوات، إلا أن استدعاء هذا النموذج قد يلقى معارضة من القوى الرافضة لليبرالية استناد إلى مرجعيات أيديولوجية محافظة أو تقدمية.
الغرض من هذا الحوار المقترح هو الوصول إلى تفاهمات بخصوص الإشكاليات المركزية التي تعرقل الانتقال إلى الديمقراطية، وفي مقدمتها المرجعية، وهي إشكالية مركزية في "نظرية الدولة"، تتعامل مع أسئلة جوهرية من قبيل: هل المرجعية للشعب باعتباره صاحب الحق الأصيل وفق لنظرية السيادة الشعبية، والتي يعبر عنها الدستور؟ أم أن المرجعية مستمدة من قيم أو نصوص تتجاوز الإرادة الشعبية؟ مع ملاحظة أن النظرية الدستورية الحديثة قدمت حلا لهذه الإشكالية يتمثل في الدستور الديمقراطي هو الذي يجمع بين الشرعية الشعبية (الإرادة العامة)، وبين الضمانات الدستورية (حماية الحقوق)، والمراجعة القضائية (الرقابة الدستورية). لكن من المهم هنا الانتباه إلى أن الدساتير ليست نصوصًا جامدة أو مقدسة وأنها تفعل من خلال كيفية تطبيقها أو إدخال تعديلات عليها بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون إخلال بالمبادئ الأساسية والعليا للدستور، على النحو الذي تبينه التجربة الدستورية الأمريكية، أو استنادًا إلى التقاليد الراسخة التي تقوم مقام الدستور، على النحو الذي تبينه التجربة الديمقراطية البريطانية التي تستند إلى "الوثيقة العظمى" (الماجنا كارتا)، التي صدرت أوائل القرن الثالث عشر.
من المهم هنا تأكيد المواقف المبدئية التي لا يجوز أن تكون محل مساومات وحلول وسط، والموقف المبدئي في هذا الصدد هو ربط المدنية بالديمقراطية والحداثة، ذلك لأن المدنية بدون ديمقراطية قد تتحول إلى دولة تكنوقراطية استبدادية، والديمقراطية بلا مدنية: قد تتحول إلى استبداد الأغلبية، والحداثة بلا ديمقراطية ومدنية: قد تتحول إلى تحديث استبدادي، وهو أمر تثبته تجربة الدولة الحديثة في مصر التي أسسها محمد علي وتحولت إلى نموذج للتحديث السلطوي. ويجب التنبيه في هذا الصدد إلى خطورة استخدام المفاهيم كأدوات سياسية في الصراع لبناء تحالفات وشرعيات بديلة، وهو ما أظهرته تجربة جبهة الإنقاذ، ومن قبلها جملة المفاهيم والشعارات التي رفعتها بعض القوى السياسية في خضم الصراع في أعقاب تنحي الرئيس مبارك عن الحكم.
ثمة مبادئ خلص إليها الدكتور أحمد حمدي درويش من تحليله لمبادرة "التحالف المدني الديمقراطي" وما قدمته من مادة تستند إلى التجربة، لإثراء النقاش حول عدد من القضايا النظرية التي تتصل بمسألة التوظيف السياسي للمفاهيم كيف تتحول المفاهيم إلى ساحات صراع، وإشكالية بناء توافقات دستورية في مجتمعات منقسمة، والتي تؤدي عادة إلى توافقات هشة، وكيفية تجسير الفجوة بين النخب والجماهير، بخصوص المفاهيم السياسية وتقدير الموقف، وتأكيد الدور التاريخي للمثقفين خصوصًا في لحظات التحول وصياغة الوثائق التأسيسية. هذه المبادئ تؤكد حقيقة أن بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ليس مساراً نظرياً، بل هو عملية تاريخية معقدة تتشابك فيها "المبادئ والمصالح والصراعات والفرص"، ومن ثم فهي عملية متكاملة تتطلب إصلاحًا سياسيًا جذريًا وشاملًا، كما أشارت الأستاذة حنان عبد المنعم في تعليقها الصائب.
هذا المقال مقدمة للدعوة إلى حوار مؤسسي شامل ومفتوح، وهو استئناف لسجل حافل من الحوار الذي دار على صفحات الجرائد وفي برامج تلفزيونية وإذاعية وما طرحته برامج حزبية وتناولته كتب لسياسيين وباحثين وانشغلت به مراكز للتفكير والبحث في مصر وخارجها، ودعوة لاستخلاص الدروس من هذا السجل وبلورتها والبناء على ما تم التوافق عليه وتطويره من أجل المستقبل. وعلى المهتمين بهذه القضية المساهمة في هذا الحوار بالوسائل المتاحة لديهم لتطويره وتعميقه، فلم يعد الوقت يحتمل انتظارا لإرادة سياسية ما مفترضة، فالإرادة السياسية الحقيقة هي ما يملكه كل فرد، والتطور يحدث من خلال طرح الأفكار والتصورات والرؤى وخوض غمار التجربة السياسية. صحيح أن الإصلاحات التشريعية والدستورية ضرورية لإصلاح الشأن الحزبي من أجل وضع لبنات أساسية في بناء المجتمع السياسي، هو مسؤولية مباشرة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها والقائمين عليها، لكن الرهان هو أن مثل المناقشات والحوارات التي تطلقها مبادرات فردية قد تسهم في تشكيل وعي جديد يقود إلى الإصلاحات المنشودة.
----------------------------------
بقلم: أشرف راضي

العدد 343 من صحيفة المشهد ص 4