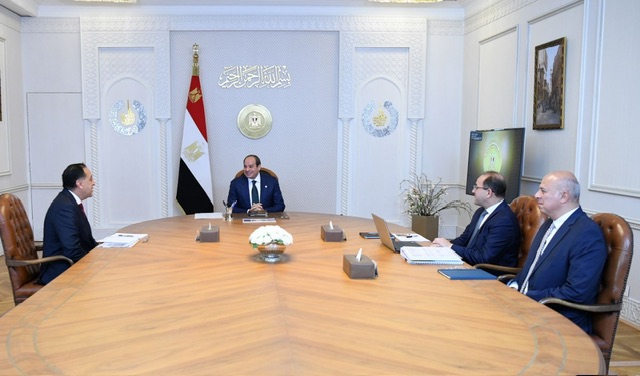ما كنت أظن أن للبيوت أرواحا تشبه أصحابها، حتى وطئت بيوتا وديعة تشبه قلوب أهلها؛ بيوتا متواضعة في ظاهرها، غير أن بساطتها كانت تنضح جمالا خفيا، وتفيض طمأنينة وحنانا، حتى ليخيل إليك أن الجدران تتنفس دفئا لا ينطفئ، وأن الزوايا تروي حكايات تبقى مضيئة وإن أسدل الليل ستاره.
وما كنت أظن أن خيوط الوهم تنسج حول القلوب، كما تنسج خيوط العنكبوت خفايا الزوايا والجدران، حتى إذا أمعنت النظر في كتاب الله، وتدبرت قوله جل وعلا:
﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ العَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ البُيُوتِ لَبَيْتُ العَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾
صدق الله العظيم.
هنالك أيقنت أن الحياة ليست طريقا واحدا، بل سلسلة من البيوت؛
بيت من يقين، وبيت من وهم؛
بيت من ذكر، وبيت من غفلة؛
بيت من عزيمة، وبيت من خور وضعف.
والإنسان إما أن يسكن بيتا متينا تشيده معاني الإيمان، أو يتقلب في بيوت واهية، يظنها حصونا، فإذا هبت رياح الابتلاء تهاوت، وتركته عاريا إلا من الحقيقة.
ثم تبينت أن العمر كله انتقال بين تلك البيوت.
أول هذه البيوت كان بيت الطفولة، ففي ذلك البيت تعلمت كيف أحبو، وتعلمت أول خطوات المشي والوقوف، وخضت فيه أول تجارب الاستقلال الصغيرة. هنا تعلّمت الصبر والمثابرة، واختبرت حدود جسدي وقدرتي على التعلم، وكل زاوية فيه كانت شاهدة على اكتشافاتي الأولى، وعلى نجاحاتي وإخفاقاتي المبكرة.
ثم جاء بيت الجد والجدة؛ بيت الدفء والذكريات، حيث نشعر بأمان خاص لا يشبه أي بيت آخر. بيت يفيض بالحنان، حيث القصص تُروى، والحكايات تتكرر، والضحكات الصغيرة تصنع ذكريات باقية. هناك تتشكل أول بذور الانتماء والدفء العاطفي، ويصبح القلب قادرا على التعاطف والمحبة فيما بعد.
نخطو بعد ذلك نحو بيت العلم والمعرفة، حيث المدرسة ليست مجرد جدران وأسوار، بل عالم تتفتح فيه أبواب العقل، وتتشابك فيه الأفكار، وتبدأ رحلة تشكيل الشخصية والثقافة. هنا تتلاقى الوجوه المؤقتة، وتُنسج الصداقات، وتبدأ التجارب التي تُبني على أساسها القيم والمعرفة.
وبين بيت وآخر، ندخل بيوت الأصدقاء؛ بيوتا نطرق أبوابها بدافع الألفة، ونمكث فيها ساعات نظنها قصيرة. في بعض تلك البيوت نشعر أننا لسنا ضيوفا، بل جزء من المكان، وفي بعضها نكتشف أن القرب لا يعني دائما الأمان. فكما أن البيوت تختلف، تختلف الصداقات؛ منها ما يكون مأوى في وقت الشدة، ومنها ما يتهاوى عند أول اختلاف، فنفهم أن الصداقة، هي الأخرى، قد تكون بيتا متينا أو بيتا واهنا.
وأحيانا نعبر بيوتا لا نمكث فيها طويلا؛ بيوتا ندخلها مرة واحدة، فإذا أغلق بابها خلفنا لم يعد يفتح ثانية، إلا في الذاكرة التي تثقلنا بالحنين، وتربك القلب بالسؤال.
وفي زحام هذه البيوت كلها، كان ثمة بيت مختلف، ندخله لا طلبا للمأوى، بل بحثا عن السكينة. بيت لا تُغلق أبوابه في وجه أحد، ولا يقوم على الألفة البشرية وحدها، بل على معنى أعمق وأبقى. في بيوت الله، المساجد، يتخفف القلب من أثقاله، ويشعر الإنسان أن له ملاذا لا تهدمه الخيبات، ولا تنال منه تقلبات العلاقات، وأن ثمة بيتا، مهما اضطربت البيوت من حوله، يظل مفتوحا لمن قصده بصدق.
وأما أعظم بيوت الله هو بيت الله الحرام، أول بيت وُضع للناس ، الذي تحفه الطمأنينة والسكينة، وتستظل تحت ظلاله القلوب من كل لون وطبقة ولهجة. بيت يجتمع فيه الجميع، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، محكوم عليهم جميعا بالعدل الإلهي والتقوى، لا فرق بين أحد إلا بمقدار إخلاصه وعمله الصالح. كل من استطاع إليه سبيلا، زاره مرات عديدة، فلا يمل قلبه من تكرار الزيارة، ولا يزول الشعور بالرهبة والسكينة عند دخوله. بيت تتجسد فيه أسمى معاني الإيمان، وملاذ يحتمي به العاقل من خيوط الوهم التي تلاحقه في بيوت الحياة الأخرى.
وأعجب البيوت في رحلتنا بيت لا ندخله باختيارنا، بل نقف على عتبته مكرهين بين الحين والآخر. ندخله ونحن مثقلين بالصمت والحزن، لأن دخوله لا يكون استقبالا، بل وداعا. بيت يذكرنا، كلما مررنا بجواره، أن للرحلة نهاية، وأن ما قبلها لا ينبغي أن يُبنى على وهم.
وهكذا بدأت رحلتي…
رحلة في أوهن البيوت، أفتش فيها عن خيوط الوهم التي تحاصر العقل والقلب، وأتلمس في ثناياها الطريق إلى البيت المتين؛ بيت الطمأنينة واليقين.
--------------------------------
بقلم: د. محمد أشرف الغمراوي