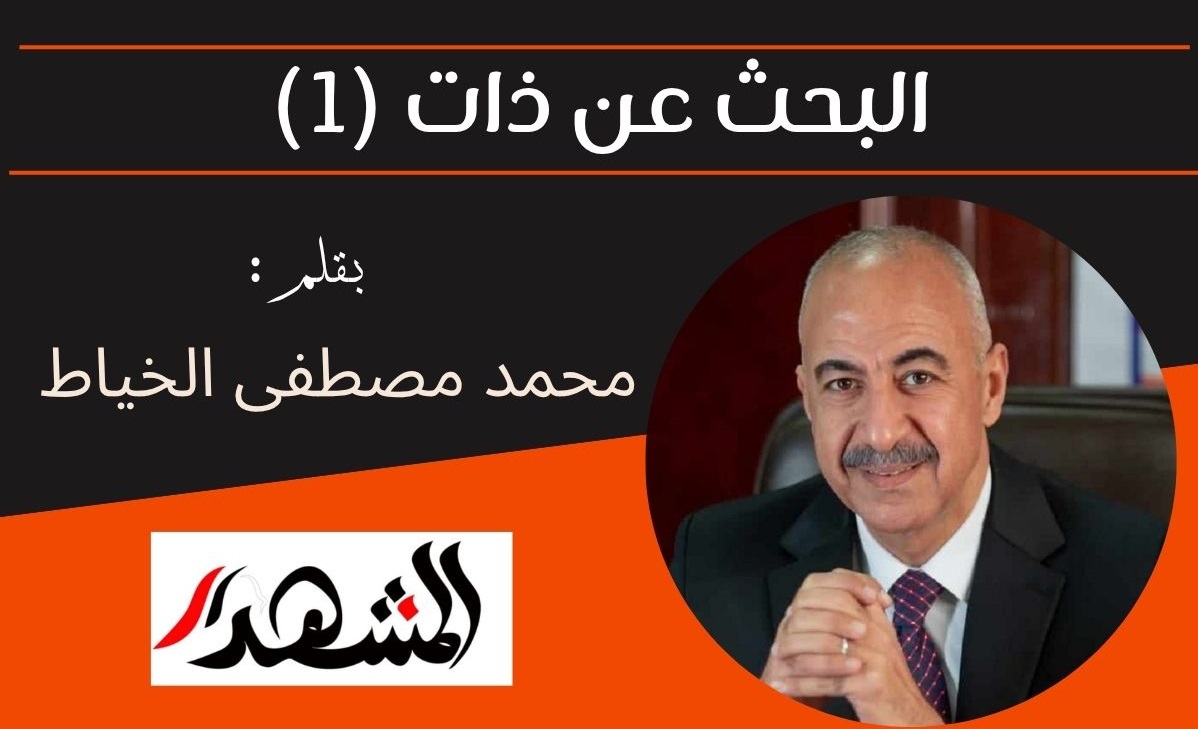تكمن أهمية رواية «ذات» للراحل صنع الله إبراهيم (1937- 2025) في رصدها الدقيق للتحولات الاجتماعية في مصر. ذات بتمثّيلها للطبقة الوسطى في مصر بانطلاقها وتفتّحها وتطلعاتها للمستقبل، تحوّلت مع الوقت إلى سيدةٍ تستجدي مرور الوقت، بعدما عجزت هي وأسرتها عن مجاراة المتغيرات المتسارعة.
لم تكمن قضيتها في أن قطار الزمن ينطلق بسرعة كبيرة فحسب، بل أيضًا في عدم القدرة على تحديد وجهته، وما يتطلبه ذلك من استعدادات!
تغيّرت البوصلة والاتجاهات، وسيطرت على قطار المجتمع فئات خرجت من بين شقوق فساد وعشوائية ومحسوبية، صار لها مسميات تليق بالعصر وتمنحها جوازات مرور أعادت تعريف وصياغة قيم وعادات وتقاليد المجتمع، كان لرحلات طائرات وبواخر تشيل وأخرى تحط، من المحروسة إلى الخليج، والعكس، دور كبير في إعادة صياغة وصباغة الهوية المصرية.
مهندسون وأطباء ومدرسون وأسطوات وصنايعية عادوا بملابس وسمات وهيئات وأفكار خليط من خليجية إلى آسيوية. وبدلاً من أن يحصنوا ويدعموا الطبقة الوسطى على المستويين الاجتماعي والمعيشي، فإذا بالأول ينخفض وبالثاني يرتفع استهلاكيًا، واكبه استنبات بذور تيارات فكر سلفي متشدد، يجافي ما أسسته طينة هذه الأرض ونشرته في أرجاء المعمورة من فكر وسطي.
تهاوت هيبة العلم في فراغ الجهل والفهلوة، وتحولت مراكز الثقل الاجتماعي نحو المال، أجاد مسلسل (بنت اسمها ذات)، المأخوذ عن الرواية، عرض تفاصيلها ومعالجة شخصياتها وتحولاتها.
صار لكل شيء ثمن، سواء كان ملموسًا أو معنويًّا، فركعت أشجار قيم وأصول على ركبتيها على وقع معاول الغطرسة، فلا صوت يعلو فوق صوت النقد، الأخضر، والأحمر، والأزرق، إلا اللون البني، صار يستجدي مكانًا فلا يجد. وجرت الألسنة بمفرداتٍ جديدة، وتقاليد وعادات مختلفة، وملابس وهيئات غريبة علينا. اختزل كل ذلك في كلمتين "عصر الانفتاح"، وصفه الأستاذ الكبير أحمد بهاء الدين بأنه "سداح مداح".
في لقطةٍ بالغة التعبير والدلالة من فيلم "انتبهوا أيها السادة"، لا يكاد الأستاذ الجامعي (حسين فهمي) يصدق عقله، ويتّهم الزبّال (محمود ياسين) بالجنون لتجرّئه على التقدّم لخطبة أخته الحاصلة على البكالوريوس، والأخير لا يفهم سببًا لهذه الثورة، فبماله يستطيع شراء ما تتمناه العروس وأهلها. لم يستطع فهم أن الفارق الاجتماعي أمر مختلف عن الفارق المادي، وحتى إذا سَلَمَ بأنها أمر مختلف، فالصعود إليها - من وجهة نظره - سهل وميسور على سلالم المال والثراء، الأمر الذي دعا الدكتور ليصرخ فيه: "إحنا بنربّي عقول، وأنتم بتربّوا عجول!".
ومع منطقية وجهة نظر الأستاذ الجامعي، إلا أنه للأسف خسر الجولة، فمع عجزه المادي، فشل مشروع زواجه، وانتهز الزبال الفرصة واحتل مكانه، تزوج بخطيبته السابقة، رافعًا رأسه فوق الجميع؛ كان يقف على خزائن أمواله.
يبدو أننا تغيّرنا "سنةً سنةً"، كما تقول "روبي"، أو كما حدث للضفدعة السابحة في إناء ماء فوق شعلة لهب، ارتفعت حرارته قليلاً قليلا، حتى بلغ درجة الغليان فدفعت حياتها ثمنًا لعدم إدراكها ما يحيط بها من تحولات، كما انسحقت طبقات اجتماعية تحت وطأة بلدوزر الماديات.
فعبد الحميد بك صفوت، الذي كان يشغل أعلى منصب قانوني في رواية "قليل من الحب.. كثيرٌ من العنف"، للروائي الكبير الأستاذ فتحي غانم، اضطرته الضغوط المادية - بعد خروجه إلى المعاش - للعمل بإحدى شركات الحاج مرسي فرج، المليونير، الذي شطب لقب "بك"، وأصبح يناديه باسمه مجردًا، أو الأستاذ عبد الحميد، عندما يرضى عليه، في الوقت الذي حرص معه عبد الحميد على مناداته بـ"مرسي بك".
مرسي الذي صعد خلال سنوات قليلة من ميكانيكي صاحب ورشةٍ صغيرة في أحد أحياء الإسكندرية، إلى مليونير بعد أن عرف طريق شركات البترول، لم يستطع رغم ثرائه ونفوذه أن يتخلّى عن جلد الميكانيكي القديم، وكان كلما أحسّ بعجزه ازداد حقده على عبد الحميد صفوت وأمثاله.
ولم يكتف مرسي بذلك، بل ورث حقده لهذه الطبقة لابنه طلعت، الذي ظل رغم تخرّجه من كلية الهندسة، يحمل ثقافة وعادات أبيه، مع حقد دائم على يونس ابن عبد الحميد بك، سببه شعوره الدائم بعجزه عن الوصول إلى طبقته الاجتماعية، حتى تحول ذلك العجز إلى عقدة، يقرر ذات مساء أن يتغلب عليها، فماذا فعل؟
نكمل في مقالة قادمة.
--------------------
بقلم: د. محمد مصطفى الخياط
[email protected]