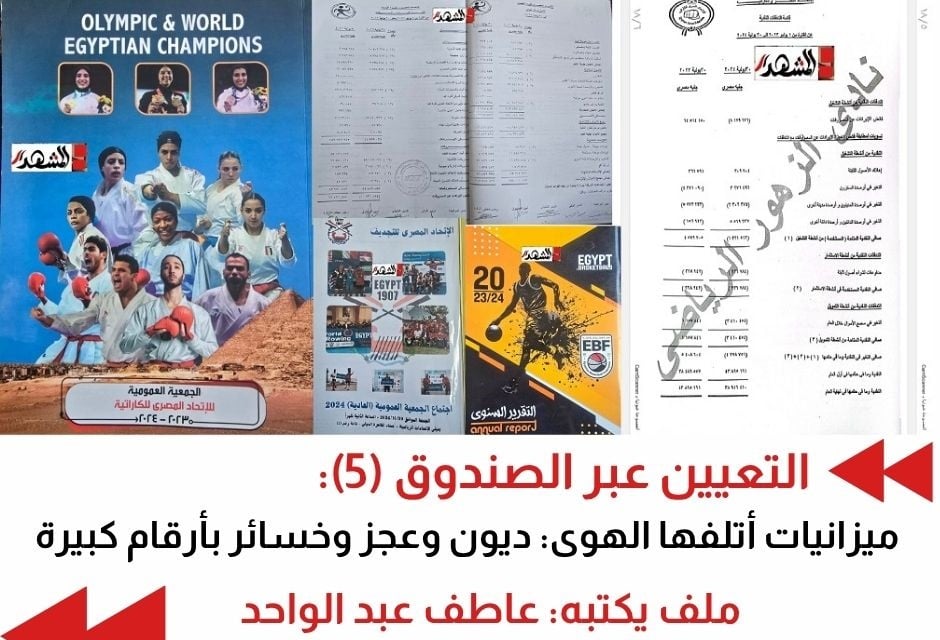في سياق احتفائها بالفائزين في دورتها التاسعة عشرة، نظّمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية جلسة فكرية خُصِّصت للفائز بجائزة فرع الدراسات النقدية، الباحث والأكاديمي الدكتور حميد لحمداني، المتخصّص في المناهج النقدية والدراسات السردية والترجمة، وأستاذ التعليم العالي سابقًا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – كلية الآداب بظهر المهراز في فاس (المغرب). أدار الجلسة الناقد د.أحمد المنصوي في مقر المؤسسة بدبي.
قدّم لحمداني خلال الندوة ورقة بعنوان "مفاهيم نقدية متصلة بنظرية الأدب وتلقيه"، انطلق فيها من مصطلحٍ متداولٍ في النقد العربي مرتبط بمفهوم القصد، وهو مفهوم هيمن طويلًا على الدراسات الأدبية قديمًا وحديثًا، وشكل جوهر التصور السائد للعلاقة التواصلية بين المبدع من جهة، والنقاد والقراء من جهة أخرى. وأكد لحمداني أن "مفهوم القصدية" حاضر في مختلف النظريات الإبداعية في العالم العربي والغرب، ولا يزال الأكثر تداولًا بين النقاد والمهتمين بالشأن الأدبي إلى اليوم.
غير أن لحمداني دعا إلى إعادة النظر في الفكرة التي ترى أن الشاعر أو الروائي أو القاص يمتلك وعيًا مطلقًا بكل ما يريد قوله في نصه، وأن غايته تتمثل دائمًا في نقل المعرفة إلى القارئ والتأثير فيه. فالكتابة الأدبية ـ كما أوضح ـ تتجاوز كثيرًا حدود القصد الواضح والمباشر، خاصة عندما يكون النص مشحونًا بالتخييل والاستعارة والإيحاء الرمزي، ما يجعل إخضاعه لقصدية مطلقة أمرًا مُقيدًا لطاقته الدلالية، ويقلّص من إمكانات التأويل لدى القارئ والناقد معًا.
وأضاف لحمداني أن الباحث في هذا الموضوع الشائك يواجه إشكاليتين أساسيتين: أولاهما أن افتراض القصدية التامة والنهائية لأي نص إبداعي يقوم على الاعتقاد بأن "خبرًا مُكتمِلًا" كان كامناً في ذهن المبدع، ثم تجسّد في نص أدبي غالبًا ما يتخذ شكل بنية تخييلية لا تُفصح مباشرة عن الأفكار، بل تومئ إليها بالاستعارة والتمثيل والتلميح. وهنا يبرز السؤال المُحيّر: ما الضامن لتحديد "القصد المرجعي" للنص؟
هل هو تصريح الكاتب خلال حياته بأنه أراد أن يقول كذا وكذا من خلال قصيدته أو روايته؟
أم أن الضامن هو ظهور ناقد "مُتفوق"، يمتلك مناهج التحليل ويملك الجرأة لإعلان أنه توصّل إلى "الحقيقة النهائية" لمقاصد النص، وأن البحث قد انتهى على يديه؟. لكن الواقع ـ كما يؤكد لحمداني ـ أن القراءات لا تتوقف؛ فالنقاد والقراء سيستمرون في إعادة قراءة النص ذاته، وقد يظهر من يصرّ على أنه هو من بلغ حقيقة قصدية النص، وأن ما سبق من محاولات لم يكن موفقًا، رغم ادعائها الوصول إلى الحقيقة.
الإشكالية الثانية: تزداد تعقيدًا في حال رحيل الكاتب دون أن يصرّح بمقاصده بوضوح. عندها يُترك النص مفتوحًا لاجتهادات لا نهائية، ويتواصل الجدل النقدي من دون إمكانية لإيقافه أو حسمه، إذ تتوالد القراءات والتأويلات باستمرار، وكل محاولة جديدة تدّعي مقاربة الحقيقة وتفسير النص من زاوية مغايرة.
وتابع لحمداني موضحًا "هذا الإشكال قائم منذ زمن بعيد، بسبب تلك الفرضية المطلقة التي تُسمّى في المجال النقدي والتعليمي: المعنى الحقيقي المقصود في النص الإبداعي. وهي تقوم على الاعتقاد بأن هذا المعنى كان حاضرًا بكامل تفاصيله في ذهن المبدع ساعة الكتابة، وانتقل كما هو إلى القارئ عند نهاية القراءة.»
ورأى لحمداني أن اللافت أن اختلاف القراءات وتباين التأويلات، وكل الصراعات التي رافقت تفسير النصوص الأدبية عبر تاريخ النظرية النقدية، لم تكن كافية لمراجعة فكرة "القصد النهائي" في ذهن المبدع. بل حدث العكس، إذ ترسخت مجموعة من المسلّمات، أهمها: أن مدلولات النص كانت كاملة ونهائية في ذهن الكاتب قبل كتابتها ـ أن هذه المدلولات مرتبطة بإرادة قصدية واعية للمبدع ـ أن للنص جوهرًا دلاليًا ثابتًا ومحدّدًا يجب على القراء والنقاد استخراجه في كل عصر.
وأشار لحمداني إلى أن القارئ أو الناقد الذي يتبنى هذا التصور غالبًا ما يتوهم أنه وحده من وصل إلى المعنى الحقيقي للنص، وأن غيره قد أخطأ الطريق إلى ما أراده المبدع. وبذلك يتحول المبدأ الضمني الحاكم لعملية القراءة إلى صيغة صريحة:
"أنا على صواب في كشف الحقيقة، وأنت على خطأ"
وهذا يتعارض ـ برأي لحمداني ـ مع طبيعة النصوص الإبداعية التي تقوم على التركيب والإيحاء، وتستدعي حوارًا نقديًا مفتوحًا لا يمكن إيقافه. فكل قراءة جادة إنما تقترب من «حقائق نسبية» للنص، لا من حقيقة مطلقة. والدليل أن الادعاء بالوصول إلى التفسير النهائي لم يمنع ـ ولن يمنع ـ استمرار الأسئلة، وبقاء النص حيًّا ومفتوحًا أمام التأويل عبر الزمن. فالمقاربات النقدية الجادة لا تدّعي الاكتمال، وإنما تساعد على الاقتراب من النص، وفهمه فهمًا أعمق وأوسع.
ورأى أن نظرية النظم عند الجرجاني توحي بأنها قريبةُ الشَّبه من النظرية التواصلية في الفكر المعاصر التي تنطلق من مركزية المُرسِل، أي الذات ومن رسالة مُحدَّدة تمرُّ عبر قناة النص، وينبغي أن تُستقبلَ هذه الرسالة من قبل القراء على نفس الصورة التي تم إرسالها بها وبنفس المعنى المقصودِ منها، أي أن الأمر دائما يَبقى في نطاق بحث شمولي عن حقيقة المعاني وثباتها على الدوام، وهذا قد يجعل القارئ مصرا على " إغلاق المعنى" مع العلم أن النصوص الإبداعية تبقى منفتحة في أغلبها على تعدد المعاني واختلاف القراءات، كما تذهب إلى ذلك النظريات التأويلية.

ولفت لحمداني إلى أن حصر وظيفة الإبداع الأدبي في مفهــوم القصدية، لا يفيد المبدع ولا يضيف إليه شيئا جديدا، فالمتلقي في هذه الحالة هو المستفيد، والمبدع يبقى محصورا فقط في دائرة الإخبار. وإذا كانت نظريةَ القصدية ظلت تحاول الحفاظ على بقائها في معظم الدراسات النقدية، فإن التحول لصالح المبدع بدا حاليا آخذا بزمام المبادرة، لكي تعيد الاتجاهات النفسانية والتأويلية النظرَ في منزلة قصدية المتكلم وفي طبـيعة النصوص الأدبية وثرائها الدلالي المتجاوز لقصدية المعاني، كما شَمِل ذلك توجيه الاهتمام نحو الفائدة التي يمكن أن يكتسِبها المبدعون من فائض العوالم التخييلية عند ممارسة إبداعهم الأدبي بما يتعدى وظيفة الإخبار والقصدية؟ وبالتأكيد سيتضاعف أيضا شغفُ القراء والنقاد عند استقبال النصوص المُحَمَّلة بالإيحاءات والرموز والاستعارات، مما يجعلهم أيضا يعيشون في حضن العوالم الممكنة التي يلتبس فيها ما كان واقعا و يُمكن الإخبارُ عنه، بما هو محتمل الوقوع.
وأوضح أن فرويد ذكر أن مجالي أحلام اليقظة والإبداع يشتركان في كونهما لا يُعبران عن وعي الكاتب وإرادته فقط، بل أيضا عن لاوعيه وانقياده غالبا في الكلام التخييلي نحو كشف ما لم يكن تحت سيطرة وعيه التَّام. والأدب بعوالمه التخييلية يبدو نوعا من أحلام اليقظة الطامحة لجعل الكينونة الذاتية بمنزلة أرقى. وهذا تحول حاسم في الخلفيات النفسية لعملية الإبداع، لأنه يعيد النظر في قولة ديكارت المشهورة: " أنا أفكر إذن أنا موجود " لتتحول في كثير من وضعيات الفرد المبدع إلى الصيغة التالية "أنا أتخيل إذن أنا أبحث عن وجود متجدد". لقد جاء مفهوم اللاشعور إذن ليثبت ما يخالف ذلك التماسك الذاتي والوجودي الذي تُعبر عنه فكرةُ إرادة المتكلم القاصد والواثق من نفسه، أما البحث عن وجود مُتجدد في الأدب والفنون عامة، فهو دال على أن الذوات البشرية تعاني على الدوام نقصا في كينوناتها، وتطمح دائما إلى تطوير مستوى حضورها الوجودي بمستوى أفضل. هنا يصبحُ الإبداع الحالم مُحاولةً لجعل الذات تتجاوز وجودها المَشروخ لتحقق التوازن والحضور المتماسك، والنتيجة الأساسية هي أن الأدب لا يفيد الأديبُ به غيَرَهُ فحسب ، وإنما يفيد به نفسَه أولا وقبل كل شيْ. ومن المُستغرب أن نجد من يتحدث من النقاد في زمننا الحاضر عن تبخيس الأدب أو موته والأمر يذهب الى حد القول أحيانا بموت المؤلف وموت النقد الأدبي، مع أن الإنسان كان سابقا ويبدو حاليا وقد أصبح بدرجة أعلى مما سبق تعلقا بكل ما يساعده على تحقيق توازنه النفسي في عصر تطورت فيه وسائل التواصل وما تجلبه من منافع، بأشكال من الفنون وأنواعٍ من النتاجات الأدبية والعروض الحكائية والسينمائية وغيرها من المُسليات، علما بأن هناك أيضا كثير من المشاهد المفزعة التي من شأنها أن تجعله الانسان يحذر الوقوع فيها متشبثا فقط بما يفيده يجعله حاصلا على كينونة متوازنة.
وقال لحمداني أن الأديب لا يمكن أن يكون مستفيدا من أدبه إذا كان عارفا تمام المعرفة بمضامينه سابقا. لأن الأمر سيكون عندئذ مجرد تحصيل حاصل، لذا تبدو نظرية القصدية التامة عاجزة عن إثبات جدوى كتابة الأدب بالنسبة لصاحبه، وقد أثبتت الدراسات التأويلية المعاصرة أن ما لم يكنْ الأديب قادرا عن التعبير عنه بالكلام العادي قبل الشروع في ممارسته الإبداعية، سيفلح أثناء تشغيل حركيته الأدبية الإبداعية، في رسم صور بديلة عنه بالوسائل التخييلية. بمعنى أنه لم يكن أمامه من مسلك للقبض على المعاني العصية إلا باسخدام حِيل التعابير المجازية والاستعارية والتمثيلية وأحيانا الأسطورية والرمزية، وهذا هو السبب الذي يجعل الاقتراحات التأويلية للنقاد والقراء بعد مواجهة زخم التخييل، تضربُ في شتى الاتجاهات المتعارضة أو المتناقضة، لأنهم يواجهون أيضا نفس المعاني الهاربة منهم بسبب استخدام الشعراء والكتاب تلك اللغة التخييلية التي توحي بالمعاني ولا تبوح بها مباشرة.
وأشار إلى أن الأدب لا يتحرك فيه فعل التخييل فقط بدافع المقاصد، بل بالانجذاب أكثر نحو ذلك الشيء الذي عجَزنا عن جعله مقصودا وواضحا، فعوض الفشل في أن نجذبه نحونا نشعر في ممارسة الأدب بأنه هو الذي يجذبُنا إليه من خلال فعل التخييل وما فيه من الاندماج بالعوالم المحتملة الحاملة لأحسن صورة نرضاها.

وختم لحمداني كلامه بعد هذه الممارسة النقدية والتنظرية، بقراءة مقطوعة شعرية عربية قديمة للشاعر عنترة بن شداد، وهي تجسد بطريقة تخييلية ونموذجية ما تحدثنا عنه، بخصوص أن الطبيعة البارزة للأدب، لا تكمن فقط في الخاصية الإخبارية، بل بصورة أعلى وأكثر أهمية في تلك المبادرات الاستكشافية الموغلة في التصوير الخيالي، مما يجعل الشاعر يبني البدائل الافتراضية التي تعبر عن حالة وجودية ترقى به عاليا لتجاوز حياته الواقعية المألوفة. وقد ورد في هذه المقطوعة ما يلي:
دَع ما مَضى لَكَ في الزَمــــــانِ الأَوَّلِ
وَعَلى الحَقيقَةِ إِن عَزَمتَ فَعَوِّل
إِن كُنتَ أَنــــت قَطَـــعتَ بَرّاً مُقفِراً
وَسَلَكتَهُ تَحتَ الدُجى في جَحفَلِ
فَـأَنـــا سَرَيـــتُ مَـــــعَ الثُرَيّا مُـــــــــــفـــــــــــرَداً
لا مُؤنِسٌ لي غَــــــــــيرَ حَــــــــدِّ المُنصُلِ
وَالبَدرُ مِن فَوقِ السَّحابِ يَسوقُهُ
فَيَسيرُ سَـــيرَ الراكِــــبِ المُســتَـعجٍل
وَالنّسْرُ نَحوَ الغَربِ يَرمـي نَفـــــسَهُ
فَيَكادُ يَعـثُرُ بِالسِماك الأَعـزَلِ
وَالغولُ بَيــنَ يَدَيَّ يَخفَـى تارَةً
وَيَعودُ يَظهَرُ مِثلَ ضَوءِ المَشْعَلِ
بِــنَواظِرٍ زُرقٍ وَوَجٍه أَســـــــوَدٍ
وَأَظافِرٍ يُشبهنَ حَدَّ المِنجَلِ
وَالجِنُّ تَفرَقُ حَولَ غاباتِ الفَـلا
بِهَـماهِمٍ وَدَمادِمٍ لَم تَغفَلِ
وَإِذا رَأَتْ سَيفي تَضِجُّ مَخافَةً
كَضَجيجِ نوقِ الحَيِّ حَولَ المَنزِلِ
تِلكَ اللَيالي لَو يَمُــرُّ حَديثُها
بِوَليدِ قَــومٍ شابَ قَبــلَ المَحـمِلِ
فَاكفُفْ وَدَع عَنكَ الإِطالَةَ وَاِقتَصِر
وَإِذا آستَطَعتَ اليَومَ شَيئــاً فَــآفعَلِ