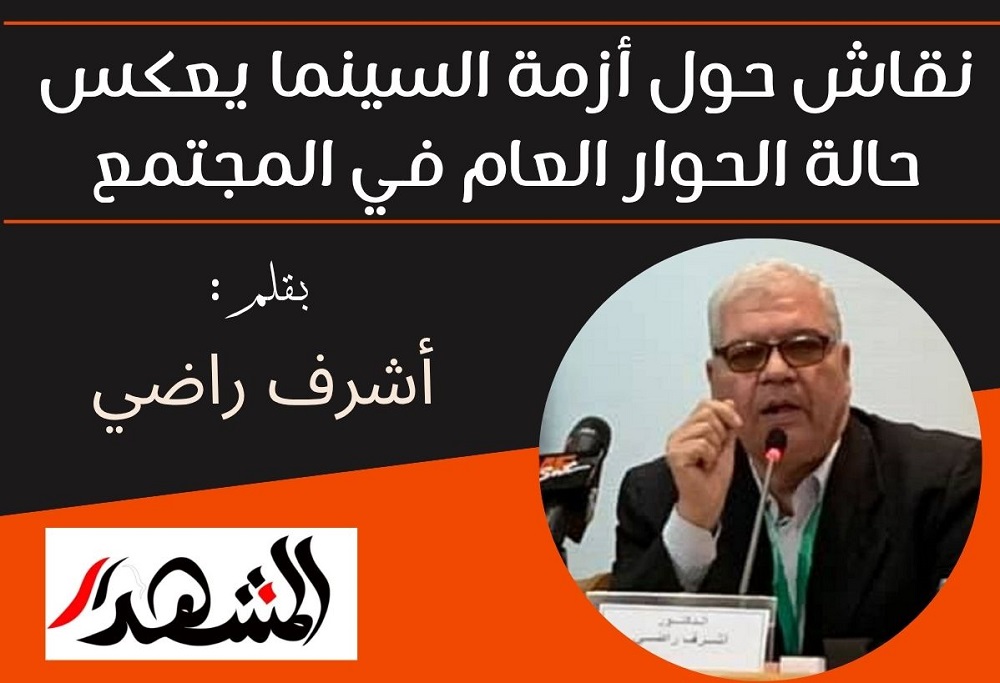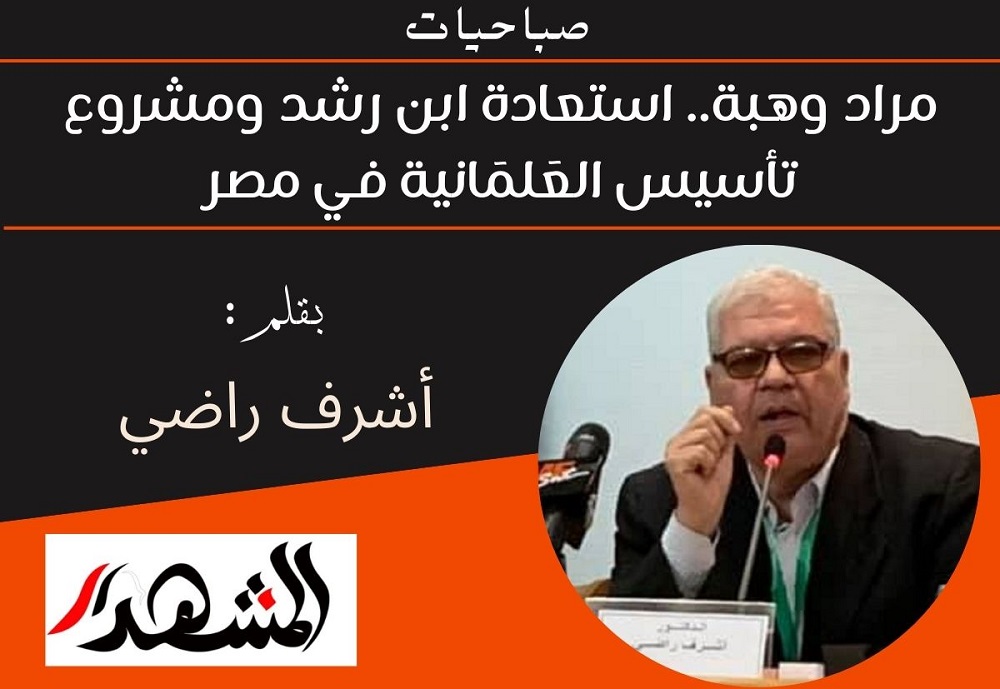أتيح لي بدعوة كريمة من الدكتورة ثناء هاشم، أستاذ السيناريو بمعهد السينما، المشاركة في ندوة حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها صناعة السينما في مصر. تصادف أنني نشرت قبل ساعتين من بدء الندوة منشوراً بعنوان "مشكلات "تشخيص الحالة" بين الطب والسياسة"، تساءلت فيه عما إذا كان لدينا حقًا تشخيص دقيق للحالة في أي قضية من قضايا الشأن العام نتناولها، وأشرت فيه إلى أحد المشكلات الأساسية في التفكير السياسي لدينا، أننا لا نعير اهتمامًا كافيًا بوصف ما نتناوله، بزعم الانشغال بالتحليل، وأن الاستغراق في التحليل لا يساعدنا على الوصول إلى تشخيص دقيق للحالة، يمكننا من أن نضع يدنا على الأسباب الجذرية للمشكلة، ولا يساعدنا غالبًا على تقديم توصيات عملية للتعاون مع الأزمة. غير أن النقاش الذي دار بالأمس، عكس أيضًا مشكلات أعمق في الحوار، لا تقتصر فقط على السينمائيين وإنما تمتد إلى كثير من الدوائر السياسية والثقافية في مجتمعنا، وقد تطرقت لبعضها في ختام منشور الأمس.
دعوتي للمشاركة جاء انطلاقًا من كوني أحد مؤسسي "مبادرة النهوض بقوى مصر الناعمة"، التي أُطلقت قبل أكثر من عام، من قبل مجموعة من المثقفين والمبدعين، للدعوة إلى ضرورة الاهتمام بالثقافة والإبداع في كافة المجالات بوصفها الركيزة الأساسية لقوة مصر الناعمة وريادتها في المنطقة في محيطها الإقليمي ودورها العالمي. ورغم تأكيد شيخ السينمائيين، المصور المبدع، سعيد الشيمي، أهمية ومحورية الثقافة في أي مشروع للنهضة، إلا أنني سمعت تكراراً للسؤال الذي يدل على اهتمام النخبة المثقفة بالشخصيات التي تقف وراء أي فكرة يفوق اهتمامهم بالفكرة نفسها، وهذا سبب رئيسي في "شخصنة" القضايا والخلافات، وهذا أحد العيوب القاتلة في الحوار فيما بين جماعات المثقفين، التي لا نريد الاعتراف بها والتصدي لها بشجاعة، الأمر الذي يساعدنا على الانتقال إلى مناقشة الفكرة والموضوع، لا الشخص.
من السجال إلى الحوار
أشرت في مقالات سابقة إلى ضرورة الانتقال من منطق "السجال"، الذي يعد سمة عامة للحوارات التي تدور فيما بين الجماعات المختلفة، إلى منطق "الحوار" الذي يبدي اهتمامًا بما يقول الآخرون المشاركون في الحوار، سعيًا لبناء الأفكار من خلال تبادل الآراء والمعلومات، والتخلي عن أسلوب الهجوم أو الدفاع عن وجهات النظر التي يطرحها المشاركون، ذلك أن الهدف المرجو من أي حوار هو الخروج بجديد من خلال تفاعل الفكرة ونقيضها بشكل جدلي. فالمنطق الجدلي في التفكير سواء مارسه الفرد أو مارسته مجموعة من الأفراد من شأنه أن ينقلنا إلى حالة من التفكير المشترك، خصوصًا إذا كان الهدف من تنظيم الحوار هو الحرص على تجربة أفكار جديدة تساعد على حل أزمة أو مشكلة من المشكلات التي نسعى لمعالجتها. للأسف كثير من النقاش الذي دار بالأمس غالب غليه طابع السجال، والاستغراق في مناقشة البديهيات، وطرح أفكاراً تعكس حنينًا إلى دولة الستينيات قد يكون مُبررًا وعبر عن أزمة جيل من صُنَّاع السينما أكثر مما عبر عن أزمة السينما نفسها. غير أن النقاش لم يخل من بعض الأفكار التي تصلح كنقطة انطلاق لمواصلة الحوار الجاد حول "أزمة السينما" في مصر.
ثمة نقطة بديهية لا بد من تأكيدها خلال الحوار كي لا تستنزف المجهود في أي نقاش مستقبلي بخصوص مستقبل السينما المصرية، مفادها أن صناعة السينما تعد أحد الركائز الأساسية لقوة الدولة وللتأثير على الجمهور، سواء على المستوى الوطني والمحلي أو على المستوى الخارجي، وقدم المتحاورون أمثلة عديدة على الدور الذي لعبته السينما، سواء في مصر أو في الولايات المتحدة، في التأثير على مجتمعات أخرى. وقدمت أمثلة لانتباه دول أخرى صاعدة، مثل الصين لهذه الصناعة ومزاياها المتعددة، سواء فيما يتعلق بالنفوذ الخارجي للدولة أو ما قد تحققه هذه الصناعة من أرباح طائلة، أو دورها الرئيسي في تعزيز الانتماء والثقافة الوطنية وفي تحقيق نهضة اقتصادية. ورغم هذا لم يتمكن المتحاورون من تقديم تفسير منطقي ومدعوم بالبيانات لموقف النخبة الحاكمة من هذه الصناعة ولم يتوقفوا كثيرًا لتفسير قرار إلغاء المؤسسة العامة للسينما بعد حرب عام 1967، وهو القرار الذي أشار إليه الأستاذ سعيد الشيمي، وكان بداية تحول الموقف الرسمي من هذه الصناعة التي لها تاريخ عريق وممتد في مصر يعود لعشرات العقود التي سبقت هذا القرار. إن الاهتمام بدراسة هذا القرار ومبرراته قد يساعدنا على فهم الموقف الرسمي الراهن الرافض للاستجابة لكثير من التوصيات التي يقدمها المختصون لحل أزمة السينما والتي تبدو بديهية وواضحة إلى حد يثير الكثير من التساؤلات. هذه الدراسة التي من المهم أن تكون مستندة إلى بيانات ومعلومات أهم بكثير من التركيز على أن هذا القرار والتحول في موقف النخبة الحاكمة من بين الأسباب الرئيسية وراء تدهور صناعة السينما ومستوى الفيلم المصري.
هناك نقطة أخرى بديهية ولا يساعد الاستغراق في مناقشتها وتأكيدها النقاش حول التوصل إلى حلول لأزمة السينما بأبعادها المختلفة. لا يمكن لأحد أن يختلف على صناعة السينما، التي تتضافر فيها أنواع شتى من الفنون الإبداعية، لا يمكن أن تزدهر إلا في مناخ من الحرية، شأنها في ذلك شأن الفنون الإبداعية الأخرى. وعلى الرغم من اتفاق الحضور على هذه الحقيقة، إلا أنها تتصادم مع ما أبداه كثير من المشاركين بخصوص انتعاش السينما في عقد الستينات، رغم ما هو معروف عن القيود التي فرضت على الحريات السياسية والحريات العامة في هذه الحقبة، وهي مسألة تشير إلى إمكانية النهوض بصناعة الفيلم المصري بغض النظر عن حالة الحريات في المجتمع، وهو ما تؤكده أيضًا حالة السينما الإيرانية أو حتى السينما الصينية ولا السينما السوفيتية في فترة الاتحاد السوفيتي. ربما كان القيد الأخطر على هذه الصناعة يتمثل في تلك القيود التي تفرضها المؤسسة الدينية وهيمنة الفكر السلفي عليها وعلى المجتمع الأمر الذي يفرض قيودًا أكبر على حرية التفكير والإبداع. وفي تقديري، أن مسألة الحرية قد تجد الآن حلولًا في ظل التحولات الحادثة على مستوى ثورة التكنولوجيا والاتصالات.
محاولة لتشخيص الأزمة
في تقديري، أن هناك شيئا ما مفقوداً في النقاش الذي دار بالأمس. لا خلاف على أن صناعة السينما من الصناعات التي تتطلب استثمارات كبيرة، خصوصًا مع تزايد تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يمنح المنتج مساحة كبيرة في القرار المتعلق بنوعية الأفلام التي تنتجها، والغاية العليا التي يسعى وراءها هي حجم الإيرادات التي سيحققها الفيلم من خلال عرضه تجاريًا في دور العرض أو توزيعه خارجيًا أو بيع حقوق عرضه. ومن القيود الجديدة التي يفرضها المنتج أو ممول الفيلم هي الإصرار على الملكية الحصرية للنسخ الأصلية للفيلم، وهو أمر له تأثير بالغ الخطورة على الذاكرة السينمائية الوطنية التي يحفظها الأرشيف السينمائي. هذا المنتج قد يكون القطاع العام (الدولة) أو المؤسسات العامة التي تنشأ من خلال الاكتتاب الشعبي الذي اعتمدت عليه صناعة السينما المصرية في عقودها الأولى، أو القطاع الخاص ممثلًا في شركات الإنتاج الخاصة، أو كبار المنتجين من الأفراد. وقد ينافس المنتجون الأجانب في المنتجين المحليين لأسباب تتعلق بالربح أو رغبة في التأثير على صناعة السينما على المستوى الوطني، لاعتبارات تتعلق بالتنافس على التأثير على المستوى المحلي أو الإقليمي والتسابق على النفوذ والريادة، الأمر الذي ينقل صناعة السينما إلى مستوى آخر يمس السياسات الثقافية للدول. هذه التحولات تخضع الصناعة إلى صراع شديد بين المصالح والإرادات المتصارعة والمتعارضة.
ورغم تركيز المشاركين على الإنتاج باعتباره السبب الرئيسي أو الجذري في الأزمة، إلا أن تقديم اقتراحات بخصوص حل مشكلة الإنتاج لم يحظ بما يكفي من الاهتمام. وقد يستحق الاقتراح الذي قدمته الدكتورة ثناء هاشم بالدعوة إلى فكرة الاكتتاب العام لتوفير بدائل للإنتاج اقتراح جدير بالتفكير في كيفية تنفيذه. هذا الاقتراح الذي نوقش في البداية في مجموعة تشكلت لمناقشة أزمة السينما في مبادرة النهوض بقوى مصر الناعمة، كان ثمرة جهود بذلتها الدكتورة ثناء وآخرون من المعنيين بهذه الصناعة من أجل إيجاد حلول من خلال التواصل مع المسؤولين المعنيين عن الصناعة في مؤسسات الدولة أو وزارة الثقافة أو شعبة السينما في الغرفة التجارية. وكشفت هذه الاتصالات مدى الممانعة من قبل المسؤولين للتعامل بجدية مع أزمة السينما في مصر لأسباب تتعلق بعدم الرغبة في محاسبة المتورطين في قضية سرقة وبيع أرشيف السينما المصرية لمنصات عربية وأجنبية، وهي من أخطر الأمور التي تهدد مستقبل الصناعة.
هناك مشكلة أخرى تتعلق بأزمة دور العرض التي تقلصت كثيرا لصالح صالات العرض في المجمعات التجارية الكبيرة التي تقدم الخدمة بأسعار تفوق قدرة الغالبية الساحقة من جمهور السينما. وترتب على تقلص عدد دور العرض التي يمكن من خلالها عرض الأفلام على مستوى المدن الكبرى، خارج القاهرة والإسكندرية، بل تقلصها في المدينتين إلى تراجع سوق الفيلم المحلي وصعود المنصات التي تفرض شروطها على المنتجين وصُنًاع الفيلم. أيضًا موقف الدولة من مسألة دور العرض، وخصوصًا دور العرض التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الثقافة الجماهيرية، يثير العديد من علامات الاستفهام، ويعد مؤشرًا قويًا على موقفها السلبي فيما يخص صناعة السينما في مصر وعدم انتباهها إلى خطورة انتقال هذه الصناعة إلى دول أخرى طامحة لأن تحتل مكانة مصر الريادية في مجال الثقافة في المنطقة، وهو موقف غير مفهوم من النخبة الحاكمة والنخبة الأوسع، والذي لا يعبر فقط عن أزمة ادراك لأهمية هذه الصناعة وما يمكن أن تحققه من مكاسب مالية واقتصادية للدولة وما تحققه من مكانة ونفوذ ثقافي في الداخل والخارج. ويبدو أن المختصين في صناعة السينما أعيتهم الحيل والحجج في تعديل موقف مسؤولي وزارة الثقافة والدولة واستعادة دور الدولة في الصناعة أو على الأقل تقديم حوافز للمنتجين بدلًا من إرهاقهم بفرض تكاليف مالية باهظة على التصوير في الأماكن العامة. وسمعنا في المناقشة ما يتصل بتراجع الدولة وانسحابها من صناعة السينما، الذي يأتي ضمن انسحابها من قطاعات كثيرة منها التعليم والصحة والثقافة، تكرارًا لعبارة غياب الإرادة السياسية.
جيل الشيوخ والوسط في مواجهة التحولات
هناك عبارات ذكرت في النقاش، تترك انطباعًا بأن الأزمة ليست أزمة قطاع، وإنما أزمة جيل نشأ وتربى في ظل أوضاع اجتماعية وسياسية مغايرة، وجيل آخر يجري التضحية به من أجل أجيال أصغر. هنا نرى وجوها كثيرة للشبه بين ما يحدث في صناعة السينما وصناعة الإعلام في مصر، وهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد حاضر ومستقبل السينما والإعلام في مصر. إن محاولة تصدير فكرة أن الأمر يتعلق بصراع أجيال، هدفها الأساسي إخفاء حقيقة مسؤولية المتحكمين في هذين القطاعين عن التدهور الشديد الحادث، والذي قد يراه البعض جزءًا من سياسة ممنهجة تستهدف مصر وريادتها، وربما تستهدف وجودها. إنني شخصيًا لا أميل لمثل هذه التفسيرات المسرفة في تبسيط المشكلة والتي لا تجيب على كثير من الأسئلة ولا تساعد على طرح حلول وآليات للخروج من الأزمة. سأحاول هناك إعادة طرح الإشكالية بشكل مغاير، لعل ذلك يسهم في تقدم النقاش في جلسات حوار قادمة.
بداية، علينا أن نرصد التحولات البنيوية الاجتماعية والسياسية والثقافية، الداخلية والخارجية، والتي من بينها التحولات الناجمة عن الثورة العلمية والتكنولوجية والمعرفية التي تمضي بخطى متسارعة، مع الانتقال من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس وما بعده في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تؤثر على جانب كثيرة من النشاط الإنساني وتغير من آليات اتخاذ القرار ومن الأدوار والوظائف في المستقبل. ويلاحظ أن جانبًا كبيرًا من هذه التحولات بدأ يقتحم مجالات كانت وإلى عهد قريب تُعد اختصاصًا حصريًا للإنسان، في مقدمتها الأنشطة الإبداعية. وأشار الدكتور عادل يحيى، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، ونائب رئيس أكاديمية الفنون، إلى أن التكنولوجيا الرقمية الجديدة أتاحت للأفراد إنتاج فيلم كامل بهاتف ذكي مزود بإمكانيات تصوير متقدمة. ويتحدث البعض عن إمكانية صناعة فيلم كامل من خلال تطبيقات للذكاء الاصطناعي. ودون الدخول في مناقشة تفصيلية حول ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعله وما لا يستطيع عمله، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل إبداع الآلة محل الإبداع البشري الحقيقي والأصيل، وأنه لا يزال في مقدور الإنسان توظيف الإمكانيات الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات. اقترح هنا كاختبار لهذه الفرضية أن نستعين بالذكاء الاصطناعي لاقتراح حلول لأزمة السينما في مصر، ونقارن ما يقترحه بما لدينا من أوراق ودراسات حول هذا الموضوع. قد يساعد هذا الاختبار على اكتشاف حلول جديدة ومبتكرة، نفكر في المعوقات التي قد تحول دون تنفيذها، وقد تساعدنا الاقتراحات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في تطوير النقاش حول أزمة السينما في مصر ومعالجتها.
هذا الاقتراح ليس من باب التسلية، وإنما يكشف عن طريقة الجيل الأصغر سنًا، الذي يمتلك مؤهلات أكبر في التعامل مع التكنولوجيا الجديدة من جيل الوسط وجيل الشيوخ، في التفكير في المشكلة وكيفية التعامل معها ومعالجتها. ولا يعيب عدم امتلاك الجيل الأكبر مهارات تمكنه من الاستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا الجديدة. المشكلة لا تكمن هنا وإنما تكمن في غياب الحوار والتواصل بين الأجيال، وفي هذا الأمر خطورة على عملية تراكم الخبرات والمعرفة الضرورية للتنمية والتطور، بما يتناسب مع ظروفنا وأوضاعنا وتمايزنا الثقافي. وتجدر الإشارة إلى أنه في حين تعمل التكنولوجيا على التنميط الذي يخفي التمايز والخصوصية التي تميز أي مجتمع، فإن الإبداع هو الآلية الأساسية للتعبير عن هذا التمايز والتنوع، اللذين يلبيان احتياجًا أساسيًا لدى الإنسان. إن هذا التواصل والحوار فيما بين الأجيال هو ما غاب بشكل لافت للنظر عن حوار الأمس، وهو أمر يجب الحرص على عدم حدوثه في أي جلسات للنقاش في المستقبل. فمن شأن هذا التواصل الوقاية من خطر الجمود والتفكير في حلول للمستقبل، ويجسر الفجوة بين الأجيال ويحقق التكامل بين الخبرات المتراكمة وبين المستقبل الذي نتطلع إليه جميعًا، مع ملاحظة أن السينما كانت باستمرار مشروعًا للمستقبل، بقدر ما هي وسيط مهم للتعبير عن خصوصيتنا وهويتنا الثقافية المتميزة. ومن شأن هذا التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل وتضافر الخبرات وتبادل الأفكار والاحتكاك بأنماط تفكير مختلفة أن يجعل الحوار أكثر تأثيرًا ويساعد على الخروج بحلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ، ويمنع انهيار صناعة السينما في المستقبل، نتيجة لفرض شباب يفتقر إلى الدراية والموهبة ويمنع الفرصة عمن هم أكثر موهبة ودراية.
بين الحنين للماضي والتطلع للمستقبل
لا خلاف على أن السينما المصرية بتاريخها العريق والممتد شهدت حقبة ذهبية في الستينات، وأنها استفادت من عصر النهضة الفكرية في مصر طول النصف الأول من القرن العشرين، ولا خلاف على الدور الذي لعبته الدولة في تحقيق هذه النهضة من خلال إشرافها كي تضمن تضافر المساهمات الإبداعية من أجل إنتاج أفلام عالية المستوى من حيث القيمة الفنية والحرفية والمحتوى الفكري، ومن حيث المتعة أيضًا. ولكن لا يعني ذلك أن السينما المصرية التي أثرت كثيراً في المحيط العربي ونشر اللهجة المصرية والثقافة المصرية بلغت مستوى رفيعًا، لكن قيمتها تتجلي عند مقارنتها بما أنتجته السينما التجارية أو ما يعرف بأفلام المقاولات في فترات لاحقة لاسيما في السبعينات، التي شهدت أيضا أفلامًا عالية المستوى والجودة. وظلت السينما المصرية متربعة على عرش السينما الناطقة بالعربية وأثرت الدراما التلفزيونية حتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي، قبل أن يحدث التراجع الملحوظ في الإنتاج مع صعود الدراما التلفزيونية بشكل عام والدراما التلفزيونية العربية والتركية، واحتلالها مساحات متزايدة من أوقات المشاهدة في السوق المصري، نتيجة للقنوات الفضائية العابرة للحدود. لكن لا ينبغي لهذا العصر الذهبي للسينما المصرية أن يستحوذ على تفكيرنا إلى الحد الذي لا يرى معه كثير من العاملين في الصناعة أنه لا حل بدون عودة دور الدولة في الإنتاج السينمائي إلى سابق عهده.
إلا أن هناك تقدمًا مهما في النقاش، نتيجة للطرح الذي قدمه الدكتور عادل يحيى والدكتورة ثناء هاشم في مسألة انتقال التفكير في كيفية تعديل موقف الدولة المعوق للصناعة والإنتاج السينمائي، مع التأكيد على المكاسب الأكبر التي من الممكن أن تجنيها على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى استعادة ريادتها الثقافية في المنطقة وعلى مستوى حماية الأمن القومي وحدوث نهضة في الفكر والإبداع في المجتمع. والتفتت مبادرة النهوض بقوى مصر الناعمة إلى محورية الدور الذي مكن أن تلعبه السينما كقاطرة للنهوض بقطاعات الثقافة الأخرى، وكان المحور الخاص بالسينما ضمن أربعة محاور ناقشتها الندوة التعريفية الأولى بالمبادرة إلى جانب قطاعات الثقافة الجماهيرية والمسرح والكتاب وصناعة النشر. لكننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من جلسات العصف الذهني وتبادل الأفكار والرأي في كيفية تعديل موقف النخبة الحاكمة وموقف النخبة الأكبر المعوق للصناعة من خلال دراسة وتحليل أسباب هذا الموقف ومرتكزاته، مع اتاحة مساحة أكبر للأفكار الجديدة والحلول المبتكرة والاستماع إلى أصوات الشباب المعنيين بمستقبل السينما.
-----------------------------
بقلم: أشرف راضي