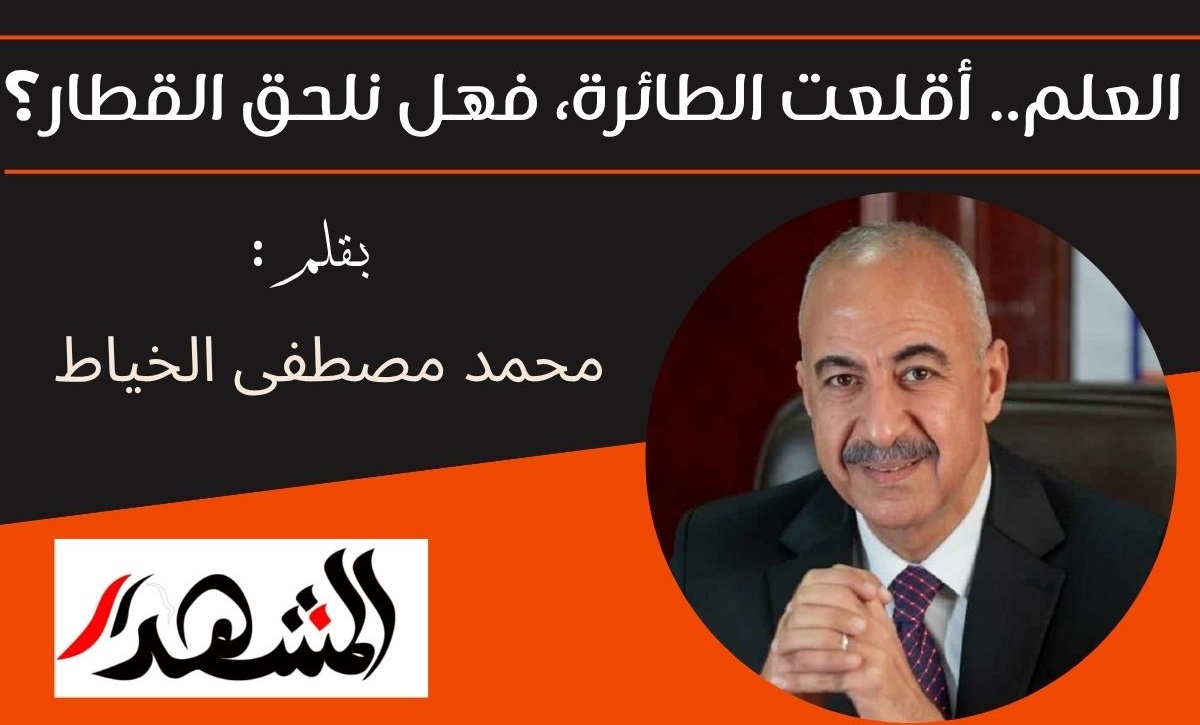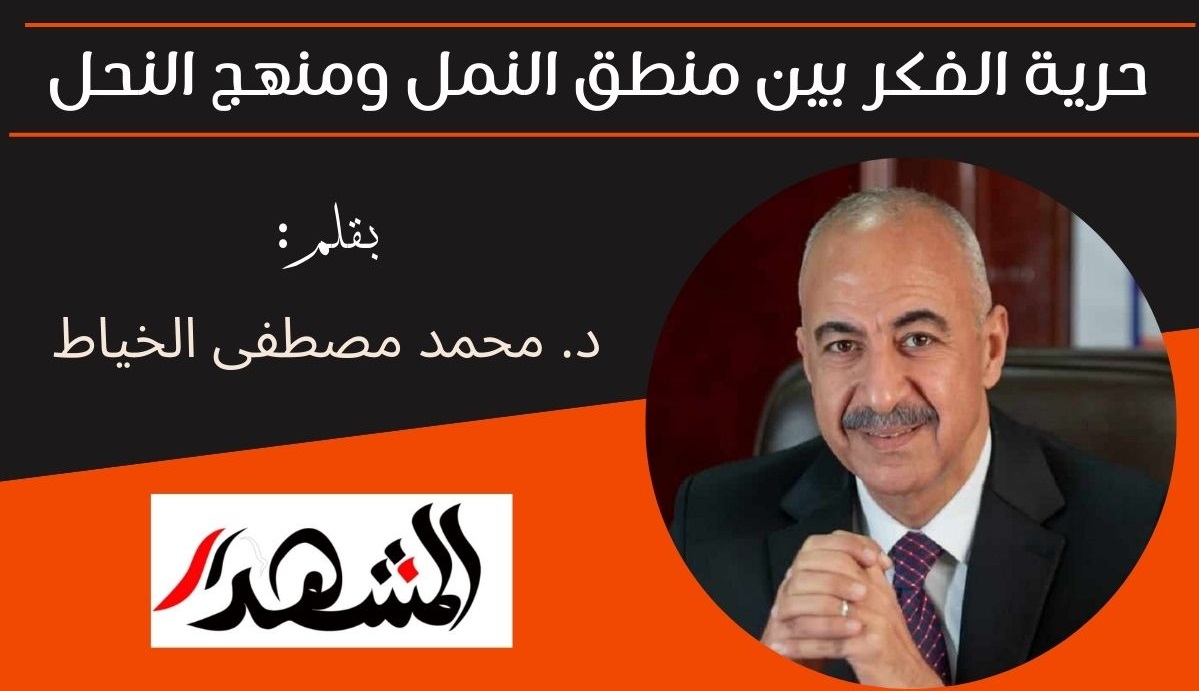ذكر الكاتب الكبير الأستاذ عبد الله عبد السلام، في مقال له تحت عنوان "تحلية المياه أم تحلية إسرائيل"، بجريدة المصري اليوم، أن إحدى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في تحلية المياه قد عقدت تحالفًا مع شركة سويسرية لتكون بمثابة حصان طروادة يتيح لها تسويق منتجاتها في المنطقة العربية؛ للالتفاف على حظر نشاطها في بعض البلدان العربية، واستحواذ الشركة الإسرائيلية على حصة معتبرة من سوقٍ عربي يحتضن أكثر من 50% من قدرات التحلية عالميًا.
وأنه لولا الخلاف الذي وقع بين الشركتين والذي أدى إلى لجوئهما إلى القضاء، لما انكشف الأمر، في تطبيق عملي للمثل القائل، "إذا اختلف اللصان ظهر المسروق".
في هذا الصدد، طرح الأستاذ عبدالله سؤالاً مفاده: "أين العرب، وتحديدًا الحكومات، التي تعاقدت مع الشركة الإسرائيلية؟. وهل يمكن أن تقام دعاوى قضائية دولية ضدها ومطالبتها بتعويضات مالية ضخمة، لأنها مارست الاحتيال وأخفت هويتها؟"، وهذا أمر تحسمه الجهات ذات الاختصاص.
بشكل عام، تسعى الشركات إلى التوسع عالميًا ومحاولة اختراق الأسواق بسلاح المعرفة والتكنولوجيا، مع ضرورة احترام القوانين وعدم الالتفاف عليها، ومن ثم لا يُعد هذا تبريرًا لمسلك الشركة الإسرائيلية ولا الشركات الإسرائيلية الأخرى التي باتت تنافسها، وتفسد عليها السوق، سعيًا لإيجاد موطئ قدم في سوقٍ ثريٍّ ودائم الطلب على منتجٍ يمكن اختزال أهميته في أنه "الحياة". سوق مستدام ومستمر إلى قيام الساعة.
لكن التساؤلات التي يثيرها هذا الأمر، حتى وإن اتُخذت ضدها إجراءات قانونية، تظل قائمة، من قبيل: ألم تكن البلدان العربية الأشد احتياجًا لنقطة مياه مُحلاة أولى بامتلاك تلك التكنولوجيا وتلبية احتياجاتها المحلية، وربما تصديرها إلى الخارج لتكون أحد مصادر ناتجها القومي؟.
ما حدث هو أنه مع غياب البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق المحلي، لجأت الأسواق العربية إلى شراء المنتج الجاهز، في تعارضٍ مع الحكمة الصينية التي تقول، "بدلًا من أن تعطيني سمكة كل يوم، علّمني كيف أصطاد السمك".
ومثل هذه التقنيات سيدي القارئ لا تُمنَح كهدية، فهي ثمرة علمٍ وتجريبٍ ومحاولاتٍ متكررة بين الخطأ والصواب في المعامل وقاعات الدرس والمؤتمرات في بيئة تسمح لها بالنمو والازدهار، إلى أن تُختزَل في معرفةٍ تقدم منتجاتٍ متميزة تفتح أسواقًا جديدة.
ولعل هذا يقودنا لطرح السؤال نفسه في موضوعاتٍ أخرى، مختلفة في ظاهرها، متشابهة في جوهرها؛ فهذه المنطقة نفسها هي التي تعمل فيها أجهزة التكييف ليل نهار طوال العام، وكلها تقنيات مستوردة من الخارج، تقف وراءها شركات عالمية تنتشر فروعها في أنحاء المعمورة كشبكة العنكبوت، وتدرّ عوائد سنوية ضخمة.
وينسحب الأمر ذاته على موضوعاتٍ أخرى عديدة تمس احتياجات المنطقة، في مجالاتٍ حيوية كالزراعة والصحة والطاقة والمياه والصناعات التحويلية، حتى أصبحت منطقتنا سوقًا خصبة وواعدة لشركات عالمية تبحث فيها عن المستهلك قبل الشريك، وعن السوق قبل المعرفة التي اتخذت اليوم أشكالاً تتداخل مع تفاصيل حياتنا الخاصة والعامة، تشير إلى أن المستقبل المعرفي هو ميدان التنافس في العقود المقبلة؛ وصار من غير اللائق إنكار الفجوة المعرفية، بعد أن تحولت إلى فجوة وجود وحضور في ظل السيد/ Chatgpt وأقرانه من أسرة الذكاء الاصطناعي سريعي التكاثر والتداخل في المجالات كافة.
تجاوز الفجوة المعرفية لا يكون بالاستهلاك أو النقل وتمهيد التُربة لتتحول الدول إلى أسواق، بل بالاستثمار في التعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان القادر على الإبداع والإضافة.
ولنعلم أن الأمم المتقدمة قد تركت قطار العلم جانبًا، وصارت تنطلق بطائراتٍ نفاثة في فضاءات التقنية والابتكار، بينما ما زالت منطقتنا تقف أمام شباك تذاكر القطار وتجادل: هل نحجز تذكرة، أم ننتظر الرحلة التالية!
------------------------
بقلم: د.م. محمد مصطفى الخياط
[email protected]