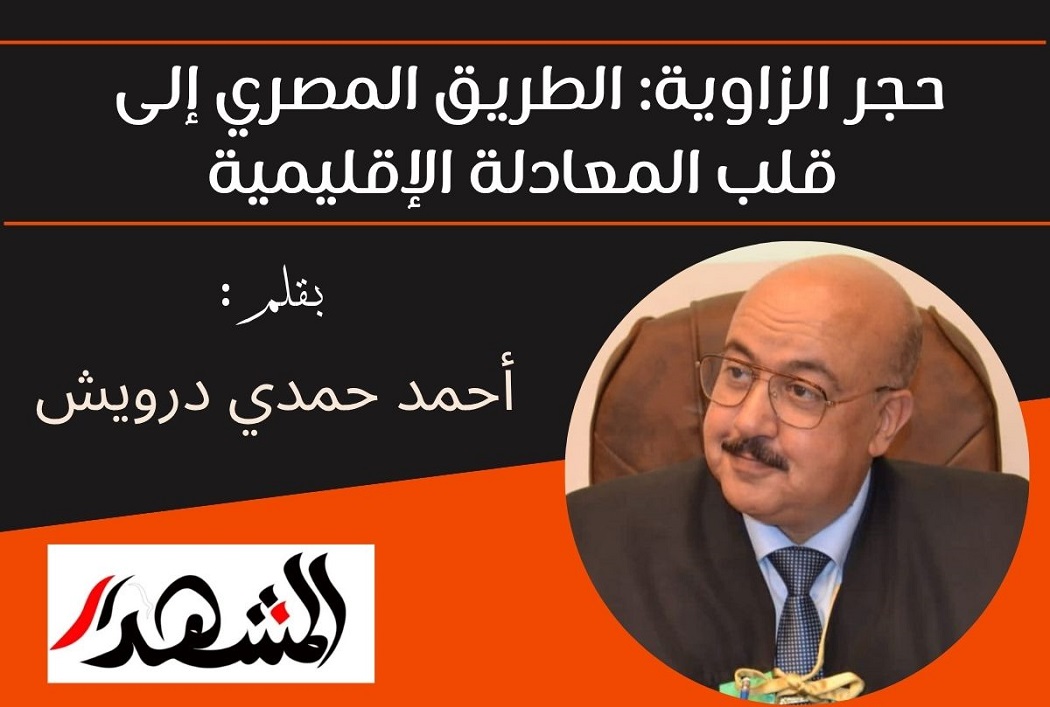لا يمكن اختزال تصاعد الحضور المصري في المحافل الإقليمية والدولية في مجرد تفاعلات سياسية ظرفية، بل ينبغي تفسيره من خلال جدل يربط بين فلسفة الأرض والمكان (الجيوفلسفي)، وبين حتميات الجغرافيا وإرادة التاريخ، نحو طبيعة الوجود (أنطولوجيا).
الدور المصري؛ من الظواهر التي تُختبر في الوعي البشري (فينومينولوجيا المكان) إلى فن التفسير والفهم للزمان (الهيرمينوطيقا)، فمصر - بحسب التصور الهيجلي - تمثل روح العالم المتجسدة في موضع، حيث تحتل ذلك المكان الجيوبوليتيكي الفريد في قلب العالم، الناتج من تأثير قوة الأرض على العلاقات الدولية، الذي جعلها بحسب نظرية ماكيندر "قلب العالم الإسلامي" الذي يتحكم في الهلال الجزري (insular crescent) الممتد من أوروبا إلى آسيا وإفريقيا.
وهذه الضرورة الجيوبوليتيكية التي أدركها الفراعنة عندما أسسوا أول دولة مركزية في التاريخ، ثم وعاها العرب عندما جعلوا من مصر قاعدة للانطلاق الحضاري، تُترجم اليوم في استراتيجية مصرية تجسد الجدلية الهيرمينوطيقية بين ثوابت المكان ومتغيرات الزمان، فالجغرافيا هنا ليست مجرد خريطة صماء، بل هي متن زمني تحكي فيه الأمم حكاياتها، وتصنع فيه مصائرها.
فمن بروكسل - عاصمة الاتحاد الأوروبي - حيث وقف الرئيس السيسي ليعلن عن "مرحلة تاريخية" في الشراكة الاستراتيجية، إلى غزة حيث قوافل العزاء والإغاثة تعبر حدود الجغرافيا والتاريخ، كانت الرسالة الفلسفية العميقة: لم تعد مصر مجرد وسيط تقليدي بين أطراف متنازعة، بل أصبحت حجر الزاوية الأنطولوجي في المعادلة الإقليمية، تجسيداً لفلسفة "الجيوبوليتيك الواعي" الذي يستشرف المستقبل من خلال استحضار عمق الماضي وإدراك اتساع الحاضر.
وهذا التحول الجوهري في الدور يمثل نقلة من الوجود في المكان إلى الوجود من خلال المكان، حيث تتحول الجغرافيا من قدرٍ سلبي إلى أداة فاعلة في تشكيل التاريخ، إنها الظاهرة الجيوبوليتيكية في أعمق تجلياتها، حيث تتحول مصر من موضوع للتاريخ إلى فاعل فيه، من خلال ذلك الوعي الجيوفلسفي الذي يجعل من الموقع الاستراتيجي وسيلة لصناعة التوازنات، ومن التاريخ رافعةً للمستقبل.
- تحليل الدور المصري:
تمثل السياسة الخارجية المصرية نموذجاً أنطولوجياً متقدماً للواقعية الجديدة، تتجاوز فيه النموذج الميكيافيللي الكلاسيكي الضيق المعتمد على التوازن، لتتجاوزه وتؤسس لواقعية "حكيمة" تستوعب تعقيدات النظام العالمي الجديد، فبينما تنسج مصر شراكات اقتصادية استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تصل إلى 32 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، تحافظ في الآن ذاته على تحالفاتها التاريخية مع روسيا، وشراكاتها الصاعدة مع الصين والهند، في نموذج دبلوماسي فريد يعبر عن "جدل التحالفات" في عصر التعددية القطبية.
وهذه الاستراتيجية المتعددة الأبعاد لا تنطلق من فلسفة "توازن القوى" بالمعنى الواقعي التقليدي، بل تؤسس لفلسفة أعمق هي "توازن المصالح" التي تستند إلى الرؤية الهيجلية للدولة ككائن أخلاقي عاقل، إنها تحول العلاقات الدولية من صراع إرادات إلى فضاء للتفاعل الحضاري، حيث تتحول مصر من مجرد "موضوع" للتفاعلات الدولية إلى "فاعل" في تشكيل المعادلات الجيوبوليتيكية.
وقد تجلى هذا التحول الأنطولوجي في انتقال التصور الأوروبي لمصر من كيان جغرافي إلى شريك استراتيجي وجودي، فلم تعد العلاقة تقتصر على تبادل المصالح الظرفية، بل أصبحت مصر شريكاً جيوبوليتيكياً في صناعة الأمن الإقليمي، ومركزاً للطاقة المستدامة، ونموذجاً للتنمية المتوازنة، وهذا الانتقال من "الوجود في النظام الدولي" إلى "الوجود من خلال تشكيل النظام الدولي" يمثل نقلة فلسفية في فهم دور الدولة في العلاقات الدولية.
إن مصر بهذه الرؤية الاستراتيجية تؤسس لواقعية مقاصدية تجمع بين حسابات القوة ومتطلبات القيم، بين ضرورات الجغرافيا وإرادة التاريخ، في نموذج يجسد "الجَدَلَ الحضاري" بين الأصالة والمعاصرة، وبين الخصوصية والعولمة. وفي التعامل مع أزمة غزة، تتجاوز مصر النموذج الوضعي التقليدي في الوساطة، لتؤسس "فينومينولوجيا سياسية" جديدة تعيد تعريف مفهوم الفعل الدبلوماسي من خلال رؤية ليبرالية مؤسسية متطورة في محاولة نحو أنطولوجيا التكامل، وهذه الرؤية لا تنظر إلى الأزمة كمجرد صراع مصالح، بل كنص معقد يتطلب فهماً هيرمينوطيقياً للفعل الجمعي بطبقاته الرمزية والمادية معاً.
فإن نجاح الدبلوماسية المصرية في صياغة ما يشبه "تحالفاً إقليمياً مصغراً" يمثل تجسيداً عملياً لفلسفة "العقد الاجتماعي" الروسوية (نسبةً إلى جان جاك روسو) على المستوى الإقليمي، حيث تتحول المصالح المتعارضة إلى إرادة جمعية عبر آليات الحوار والمؤسسات، وهذا النموذج لا يعبر فقط عن عقلانية كانطية (فلسفة إيمانويل كانط) تبحث عن سلام دائم، بل عن "عقلانية تواصلية" على طريقة هابرماس، تخلق فضاءً عمومياً إقليمياً للحوار العقلاني. وتميزت الجهود المصرية بعملها على ثلاثة مستويات متكاملة أنطولوجياً: المستوى الرئاسي بوصفه تجسيداً لفلسفة السيادة التي تعيد إنتاج الشرعية من خلال الفعل السياسي المؤسسي، والمستوى الأمني والاستخباراتي ممثلاً لابستمولوجيا (طبيعة المعرفة) المعرفة العملية التي تحول المعلومات إلى حكمة سياسية، والمستوى الإنساني تجسيداً للأخلاق التطبيقية التي تضع الإنسان في مركز المعادلة الجيوبوليتيكية. وهذا التكامل الثلاثي الأبعاد لا يعبر فقط عن براجماتية سياسية، بل عن "جدل مؤسسي" يستوعب تعقيدات الواقع الإقليمي بكل تناقضاته، إنه نموذج يستلهم فلسفة هيجل في الجدلية، حيث تنتج التركيبات الجديدة من صراع الأضداد، ليخلق توليفة متعالية تجمع بين ضرورات السياسة ومتطلبات الأخلاق.
إن هذه المقاربة المتعددة المستويات تمثل "أنطولوجيا للفعل السياسي المتكامل"، حيث تتحول الدبلوماسية من مجرد تبادل مصالح إلى "فن الممكن" يصوغ المعنى من رحم المأساة، ويصنع الأمل من وجع التاريخ. وتكشف السياسة الخارجية المصرية عن وعي وجودي عميق بجدلية الهوية والشرعية في تشكيل الخطاب السياسي، متجاوزةً النموذج الوضعي في العلاقات الدولية إلى فضاء البنائية التأويلية، فمصر لا تتفاعل مع المحيط الإقليمي والدولي انطلاقاً من حسابات القوة المادية فحسب، بل تستمد مشروعية فعلها السياسي من "الروح الجمعية" المتجسدة في هويتها التاريخية كمركز إقليمي حامل لرسالة وجودية تتجاوز الجغرافيا إلى التاريخ.
ويتمظهر هذا التجلي الأنطولوجي في تشبث مصر بثوابت وجودية، مثل رفض التهجير القسري للفلسطينيين، الذي لا يمثل مجرد موقف سياسي عابر، بل هو تعبير عن كيفية تشكيل الذات المصرية للمعنى وفهمه "سيميائيات الذات"، التي تدرك نفسها كحارسة للكيان العربي في مواجهة أنطولوجيا التفكيك، وهذا الرفض يشكل أركيولوجيا (علم الآثار) المعرفة السياسية المصرية التي تستعيد من خلالها دورها كضمير جمعي وحامل لمشروع المقاومة الوجودي.
فإن المصلحة القومية المصرية هنا لا تنغلق في إطار النفعية البراجماتية، بل تتسع لتصبح "فينومينولوجيا القيم" التي تدمج الأخلاق بالسياسة، والمبادئ بالضرورات، في تركيب جدلي يستحضر فلسفة هيجل في "الروح المطلقة" المتجسدة في تاريخ الأمم، إنها عقلانية متعالية تدرك أن الهوية ليست معطى جاهزاً، بل هي سيرورة تشكَّل باستمرار عبر الزمان.
- الأبعاد الجيواقتصادية للدور المصري:
أدركت مصر بحسِّ فيلسوف مادي، أن مقاييس القوة في النظام العالمي الجديد لم تعد تُختزل في الحسابات العسكرية التقليدية، بل انتقلت إلى فضاء "الجيو- أنطولوجيا" حيث يتحول الموقع الاستراتيجي إلى وجود سياسي من فينومينولوجيا الموقع إلى هيرمينوطيقا القوة الناعمة للموقع، وتتحول الطاقة إلى خطاب ثقافي كأنطولوجيا للوجود الجيوبوليتيكي، فلقد تجاوزت مصر النموذج الوضعي في فهم القوة إلى تبني "فينومينولوجيا المكان" التي ترى في الجغرافيا نصاً مفتوحاً على احتمالات الوجود السياسي.
وتتجلى هذه الرؤية في تحول "منتدى غاز شرق المتوسط" من مجرد تجمع اقتصادي إلى "أركيولوجيا للمعرفة الجيوبوليتيكية" تعيد تشكيل الخريطة الجيوبوليتيكية للمنطقة، فاحتياطيات الغاز في البحر المتوسط لم تعد مجرد ثروة طبيعية، بل أصبحت "استعارة وجودية" لمكانة مصر كمركز كوني للطاقة، و"نقطة ارتكاز أنطولوجية" لأمن الطاقة الأوروبي. فإن تحول ملف الطاقة إلى قلب المباحثات المصرية - الأوروبية يمثل تحولاً في "سيميائيات القوة" من خطاب التهديد إلى خطاب التعاون، ومن لغة الهيمنة إلى لغة التكامل، فمصر لم تعد مجرد مصدر للطاقة، بل أصبحت "حلقة وصل أنطولوجية" بين الجغرافيا والتاريخ، بين الماضي والمستقبل.
ويظهر البعد الفلسفي العميق في تحول مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، الذي لا يمثل مجرد تحول تقني، بل هو "انزياح جيوفلسفي" من مفهوم القوة القائمة على الندرة إلى مفهوم القوة القائمة على الوفرة، من عقلية الصراع إلى عقلية التعاون. وهذا التحول الجذري يجعل من التعاون المصري - الأوروبي ليس مجرد شراكة اقتصادية، بل "تكويناً وجودياً" جديداً يربط بين أمن القارة الأوروبية ومصير المنطقة العربية، في نسيج جيوبوليتيكي معقد يعيد تعريف مفهوم القوة في القرن الحادي والعشرين.
وتمثل القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تجسيداً لأنطولوجيا تكامل جديدة للشراكة الاستراتيجية، حيث يتحول الاقتصاد من مجال تبادلي محض إلى فضاء للتفاعل الوجودي بين الأمم، فمصر لم تقدم نفسها كمجرد سوق استهلاكي وفق الرؤية الرأسمالية التقليدية، بل كشريك إنتاجي وجودي قادر على استيعاب الخطوط الإنتاجية الأوروبية وتحويلها إلى جسور حضارية تصل بين الشرق والغرب. ويتجلى البعد الجيوفلسفي العميق في هذه الشراكة من خلال تحول الموقع الجغرافي من مجرد "معطى طبيعي" في الخطاب الوضعي، إلى "متن أنطولوجي" في الخطاب الجيوبوليتيكي المعاصر، فقدرة مصر على تمكين الشركات الأوروبية من الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك لم تعد مجرد ميزة تنافسية، بل أصبحت "استعارة وجودية" لتحول الجغرافيا إلى قدرة جيوفلسفية فاعلة.
وهذا التحول الجذري يمثل نقلة من "الجيوبوليتيك الكلاسيكي" القائم على حسابات القوة والإكراه، إلى "الجيوفلسفة" القائمة على منطق التكامل والتعايش، فالموقع الاستراتيجي لمصر لم يعد مجرد نقطة على الخريطة، بل أصبح "نصاً مفتوحاً" على احتمالات الوجود السياسي والاقتصادي في النظام العالمي الجديد. وبهذا تصبح الشراكة المصرية الأوروبية نموذجاً يمثل "فينومينولوجيا التعاون الاستراتيجي" التي تدمج بين المصلحة والوجود، بين الاقتصاد والهوية، في نسيج معقد يعيد تعريف دور الدولة في عصر ما بعد الحداثة الجيوبوليتيكية.
- المسارات الاستراتيجية: نحو مستقبل الدور المصري:
1. تعزيز الريادة الإقليمية: أنطولوجيا الحضور وميتافيزيقا التواجد الجيوبوليتيكي؛ حيث ينبغي لمصر أن تواصل صياغة أنطولوجيا خاصة بها كحجر الزاوية في هندسة الاستقرار الإقليمي، من خلال تحويل وجودها الجيوبوليتيكي إلى مشروع حضاري يتجاوز النموذج الوظيفي في العلاقات الدولية إلى نموذج وجودي يدمج بين المادة والروح، وبين الجغرافيا والتاريخ، وهذا يستلزم توظيف القوة الاقتصادية كاستعارة وجودية من خلال تحويل مصر من مجرد كيان جغرافي إلى "متن إنتاجي" قادر على استيعاب الخطوط الصناعية والتكنولوجية الأوروبية والعالمية، ليس كمجرد مساحة استثمارية، بل كورشة "حضارية" تعيد تعريف مفهوم الإنتاج من الفعل الاقتصادي المحض إلى الفعل الحضاري الشامل.
كما يستلزم أيضاً تعظيم المكاسب الجيواستراتيجية كتأويل للوجود من خلال تحويل موقعها كجسر بين القارات من مجرد حقيقة جغرافية إلى "استعارة فلسفية" للوساطة الحضارية، فقناة السويس التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، لم تعد مجرد ممر مائي، بل أصبحت "نصاً جيوفلسفياً" يربط بين الشرق والغرب، بين الماضي والمستقبل، بين المادة والرمز. وهذا التحول الأنطولوجي في فهم الدور المصري يستلزم نقلة من "الوجود في المكان" إلى "الوجود من خلال المشروع"، حيث تتحول مصر من كيان جغرافي إلى "فكرة جيوبوليتيكية" قادرة على صياغة عقد اجتماعي إقليمي جديد، يعيد تعريف مفاهيم السيادة والتعاون في ظل النظام العالمي المتعدد الأقطاب.
2. توازن التحالفات واستقلالية القرار: أنطولوجيا السيادة في عصر التعددية القطبية؛ حيث أنه في ظل التحولات الجيوفلسفية العميقة للنظام الدولي المتعدد الأقطاب، تواجه مصر تحدياً وجودياً يتمثل في الحفاظ على "الذات الجيوبوليتيكية" في فضاء عالمي تتقاطع فيه الإرادات وتتصارع المشاريع، فإن استقلالية القرار السياسي هنا ليست مجرد خيار تكتيكي، بل هي "شرط أنطولوجي" لاستمرار الوجود الفاعل في المعادلة الدولية.
وهذا الاستقلال لا يعني الانكفاء، بل يعني "انفتاحاً جدلياً" يستوعب تناقضات النظام العالمي دون أن يفقد جوهره، وهذا يتطلب تنويع الشراكات الاستراتيجية كتأويل للهوية؛ حيث تتحول الدبلوماسية من فعل تبادلي إلى "خطاب وجودي" يزاوج بين مرونة الانفتاح ومتانة الثوابت، فالحفاظ على الهوية الوطنية والقومية لم يعد مجرد شعار، بل أصبح "مقاومة وجودية" في وجه مشاريع التفكيك والذوبان.
كما يتطلب الاستفادة من التنافس الدولي كفن للوجود؛ من خلال تحويل صراع القوى الكبرى على الإقليم من تهديد إلى "مساحة للفعل السيادي"، فمصر لم تعد موضوعاً للتنافس الجيوبوليتيكي، بل أصبحت "فاعلاً" في هندسة هذا التنافس، تحول تناقضات الآخرين إلى طاقة لتعزيز مصالحها.
وهذه الرؤية تستلهم فلسفة "الجدل الهيجلي" ولكن بتجاوزها، حيث تتحول التناقضات الدولية إلى وقود للصعود السيادي، والتحالفات إلى أدوات للتعبير عن الذات الجمعية، إنها "أنطولوجيا المرونة السيادية" التي ترفض منطق القطبية الأحادية دون الوقوع في فخ التبعية المتعددة..
3. العمق الأفريقي والعربي: أنطولوجيا الجوار وتأويل الاستمرارية الحضارية؛ حيث يجب أن تبقى مصر بمثابة "الوعاء الأنطولوجي" للأمن القومي العربي، حيث يشكل ارتباط أمن الخليج باستقرارها تجسيداً لجدلية المصير المشترك التي تتجاوز التحالفات الظرفية إلى التواشج الوجودي، فليس ثمَّة فصل بين أمن مصر وأمن محيطها العربي، بل ثمة استمرارية وجودية تجعل من الجسم العربي كلاً عضوياً لا يقبل التجزئة.
وهذا الاستمرار الحضاري يستلزم تعزيز التعاون العربي المشترك كإعادة إنتاج للذات الجمعية؛ حيث يصبح التكامل ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة أنطولوجية في مواجهة مشاريع التفكيك، فمواجهة السياسات التوسعية لم تعد مجرد دفاع عن الجغرافيا فقط، بل أصبحت حفاظاً على "النسيج الحضاري من سيادة وكرامة" للعالم العربي بوصفه كياناً تاريخياً وثقافياً متجانساً.
كما يستلزم تفعيل العمق الأفريقي كاستعادة للذاكرة الجيوبوليتيكية؛ انطلاقاً من دور مصر كبوابة وجودية تربط العالم العربي بإفريقيا، فمصر ليست جسراً جغرافياً فحسب، بل هي "وعاء للذاكرة الحضارية" التي تختزن في طبقاتها اللا واعية تاريخاً من التداخل الثقافي والاقتصادي مع العمق الأفريقي. وهذه الرؤية تستند إلى "فينومينولوجيا المكان الحضاري" التي ترى في الجغرافيا مستودعاً للتاريخ، وفي التاريخ سجلاً للهوية، فإن تعامل مصر مع محيطها العربي والإفريقي هو بمثابة "حوار وجودي" مع الذات عبر مرايا المكان والزمان، حيث يصبح الأمن القومي ليس مجرد حماية للحدود، بل حفاظاً على الاستمرارية الحضارية في وجه مشاريع القطع والتفكيك.
الخاتمة:
تشير التحولات في الخطاب السياسي المصري إلى بلورة "أنطولوجيا جديدة" للفعل الدولي، هي أنطولوجيا الفعل الحضاري، كفلسفة للاستمرار والتجدد، وتنتج نموذجاً هجيناً يجمع بين "الواقعية المتعالية" في قراءة موازين القوة، و"الليبرالية الحكيمة" في بناء التحالفات، و"البنائية العميقة" في صياغة الهوية، وهذا التركيب الجدلي يضع مصر في موضع "الفاعل الأنطولوجي" القادر على إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية من خلال "هيرمينوطيقا القوة" التي تفكك النصوص الجيوبوليتيكية وتعيد تركيبها في صياغة سيميائية جديدة للوجود الجيوبوليتيكي.
فمصر لم تعد مجرد قناة اتصال بين غزة وتل أبيب، بل أصبحت "ضامناً وجودياً" لأي تصور مستقبلي، و"مرجعية أنطولوجية" للاستقرار الإقليمي، والدرس الفلسفي الجوهري الذي تقدمه التجربة المصرية هو أن الدور الإقليمي لم يعد هبة من النظام الدولي، بل هو "نتاج حوار ذاتي" بين الإرادة والوعي، بين "الجوهر" و"العرض" في المصطلح الأرسطي.
وتكمن المرتكزات الأنطولوجية للسياسة المصرية التي ينبغي التمسك بها ولا حياد عنها في الآتي:
- الجغرافيا مصير واختيار: حيث توظيف الموقع الاستراتيجي كأداة فاعلة في السياسة الدولية، بتحويله من "قدر طبيعي" إلى "مشروع سياسي"، فتتحول الثوابت المكانية إلى متغيرات تاريخية فاعلة.
- التوازن حكمة ووجود: فالمحافظة على الاستقلالية ليست تكتيكاً سياسياً بل "شرطاً أنطولوجياً" للوجود الفاعل في زمن التعددية القطبية.
- الهوية عودة وانطلاق: حيث الربط بين الثوابت القومية والمصالح الوطنية، بين الأصالة والمعاصرة، وليس جمعاً بين المتناقضات، فهو "تركيب جدلي" ينتج وعياً جديداً بالذات والعالم.
- الشراكة حوار وتكوين: فبناء تحالفات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ، هو "تفاعل وجودي" يُنتج باستمرار كيانات سياسية جديدة كمنصات التعاون الإقليمي، والمجالس الاقتصادية المشتركة، وشبكات الأمن المشترك، والتجمعات الثقافية والفكرية، والشراكات الاستراتيجية، وتحالفات التنمية المستدامة.
وهكذا، تمضي مصر في مسارها كحجر الزاوية الأنطولوجي لاستقرار الإقليم، مجسدةً رؤية فلسفية عميقة تقوم على أن القوة الحقيقية ليست في الهيمنة بل في "القدرة على الخلق والتشكيل"، وليس في الانكفاء بل في"الانفتاح الحواري"، وليس في ردود الفعل بل في"الفعل الإبداعي"، فمصر لا تحتل مكاناً في الخريطة فحسب، بل تحتل "مكاناً في العقل العالمي".. لا تتفاعل مع التاريخ بل "تصنع التاريخ".. ولا تستجيب للواقع بل "تنتج الواقع"..
-------------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش