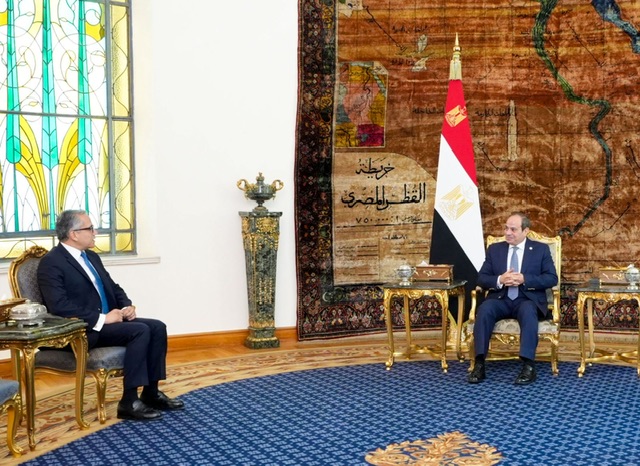منذ أن قرر ألفريد نوبل تخصيص جزء من ثروته لجائزة تُمنح لمن "يعمل من أجل السلام"، كان في ذهنه ضميرٌ إنساني يسعى للتكفير عن اختراعه للبارود. لكن التاريخ ماكر، إذ سرعان ما تحولت الجائزة إلى سلاح جديد من أسلحة النفوذ، لا تكريمًا لضمير البشرية، بل مكافأة لمن يخدم "النظام الدولي" كما تراه القوى المهيمنة. وهكذا، لم يكن الطريق من أوسلو إلى واشنطن طويلًا؛ إذ انتقلت المعايير من الأخلاق إلى المصالح، ومن القيم إلى التحالفات.
لقد مُنحت نوبل لرجالٍ جاءوا إلى السلام بعد أن أشعلوا الحروب، ولرؤساء صنعوا المجازر ثم وقّعوا على الهدنة بأيديهم الملطخة بالدماء. مُنحت لبيغن بعد دير ياسين، ولرابين بعد الانتفاضة، ولأوباما قبل أن يبدأ ولايته، فقط لأنه كان وعدًا بأملٍ لم يكتمل.
وفي كل مرة، كانت الجائزة تقول شيئًا واحدًا للعالم: إن السلام الذي يُعترف به هو ذلك الذي يخدم ميزان القوى، لا ميزان العدالة.
ترامب لم يكن استثناءً في هذه القصة، بل حلقة جديدة فيها. لم يصنع سلامًا، بل سعى إلى احتكار رمزيته. أراد أن يجعل من "السلام" منتجًا أمريكيًا مسجلاً، لا قيمةً إنسانية مشتركة. وحتى حين تحدّث عن نوبل، كان يتحدث كمن ينتظر صفقة جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاته: "لقد أوقفت ثماني حروب"، قالها كما يقول تاجر عقارات إنه أنجز ثمانية مشاريع في أسبوع واحد.
حين وقف دونالد ترامب يتحدث عن "إنهاء ثماني حروب"، بدا كما لو أنه يروي ملحمة لم يشهدها أحد غيره. تحدّث عن صراعات استمرت ثلاثين عامًا وأربعين عامًا، وكأنه يصف فتوحاتٍ غابرة أنهى فصولها بجرّة قلم.
غير أن مراجعة الوقائع تكشف أننا لم نكن أمام انتصارات في ساحات قتال، بل أمام دعاية انتخابية صاغها رجل أعمال بلغة الصفقة لا بلغة التاريخ.
الحروب التي تحدث عنها لم تكن حروبًا من الأصل.
في كوسوفو وصربيا، لم يكن هناك قتالٌ دائر، بل نزاعٌ مجمّد منذ عقدين، أعاد ترامب تسميته "اتفاقًا اقتصاديًا" واحتفل به كـ"سلام تاريخي"
وفي رواندا والكونغو، كانت نيران الحروب قد خمدت منذ سنوات طويلة قبل أن يدخل ترامب البيت الأبيض، ولم يكن لأمريكا دور مباشر في إطفائها.
أما الهند وباكستان، فبينهما توترات دائمة لا تنطفئ ولا تشتعل تمامًا، وادّعاء "إيقاف الحرب" هناك لا يتجاوز الادعاء بأن الهاتف الرئاسي الأمريكي قادر على إطفاء بركان القارة الآسيوية.
وفي الشرق الأوسط، حوّل ترامب اتفاقيات إبراهام للتطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية إلى شهادة سلام مزوّرة، بينما كانت فلسطين تزداد احتلالًا ومعاناة.
كل تلك الملفات التي عدّها انتصارات لم تكن سوى مشاهد رمزية بلا مضمون واقعي، صنعتها الكاميرات وأجهزة العلاقات العامة، لا جهود الوساطة ولا إرادة السلام.
أعاد ترامب تعريف الحرب لتناسب خطابه: فكل خلاف يمكن أن يُقال إنه "حرب"، وكل اتصال يمكن أن يُعلن "سلامًا".
وهكذا أصبح "صانع السلام"في روايته الخاصة هو من ينسحب من الميدان ويترك الحروب قائمة كما كانت، شرط ألا تُخصم من رصيده السياسي في الداخل الأمريكي.
وهكذا اختُزل السلام من معنى إنساني إلى أداة من أدوات الهيمنة الناعمة: تُمنح لمن يكرّس الواقع لا لمن يغيّره، ولمن يثبت النظام لا لمن ينصف الضحايا. فصارت نوبل شهادة تزكية من القوة العظمى للعالم الذي ترسمه كما تشاء، لا وسامًا تُعلّقه الإنسانية على صدر من أنقذها من الجنون.
آخر ما أضافه ترامب إلى سجلات "سلامه" جاءت خطته لحكم غزة وإسناد الهيمنة عليها لمجلس يترأسه هو بنفسه، وتأسيس ما سمّاه سلامًا مستدامًا أو "سلامًا تاريخيًا" بين العرب وإسرائيل. لكن لا أحد جاد يمكنه أن يؤكد أن هذا "السلام" وُجد إلا في بياناته التي تنذر الفلسطينيين بالجحيم، ظل يردد ذلك وهو يطمح إلى نوبل جديدة.
يتحدث ترامب عن سلامٍ متخيَّل لا عن حقائق الصراع العربي الإسرائيلي. سلامٌ لا يعترف بالجذور ولا يعالج الأسباب، بل يراهن على الإنهاك والزمن كي يفرض واقعًا جديدًا.
يتحدث عن شرقٍ أوسط آمن، بينما الخرائط تُعاد رسمها بالنار، والاحتلال يزداد تغوّلًا، والحقوق تُطوى تحت ركام المدن المهدّمة.
إنه سلامٌ بلا عدالة، وبلا ضمير، وبلا شريك حقيقي في الميدان سوى القوة.
إنه لا يتحدث عن "السلام العادل"، بل عن تصفية القضية. يريد أن يكتب الفصل الأخير في كتابٍ لم يُغلق بعد، وأن يُخرج العرب من التاريخ إلى هامش الصفقة. لكن الحقيقة الكبرى التي لا يمكن تزويرها هي أن سلامًا يولد من الظلم لا يعيش، وسلامًا يتجاهل الجرح لا يلتئم.
لقد تحوّل السلام في الخطاب الأمريكي من غايةٍ إنسانية إلى وسيلةٍ للهيمنة، ومن وعدٍ بإنهاء الحروب إلى غطاءٍ لإدامتها بأشكالٍ جديدة. وما يطرحه ترامب اليوم تحت عنوان "السلام التاريخي" ليس إلا امتدادًا لذلك المعنى المقلوب؛ سلام القوة لا سلام العدالة، وسلام الصفقات لا سلام الضمائر.
كانت نوبل، في بدايتها، محاولة لإنقاذ الضمير الإنساني من جراح الحرب، فإذا بها اليوم تُكرَّس لمن يُتقن فنون "السلام الموجّه" فنذهب هذا العام إلى إحدى أدوات السياسة الأمريكية في التدخل السافر لتغيير النظام في فينزويلا.
ومن هنا تصبح مأساة عصرنا أن المعنى يُقتل مرتين: مرة بالسلاح، ومرة حين يُمنح القاتل جائزة على حسن سلوكه.
السلام الحقيقي لا يولد من موازين القوة، بل من توازن الضمائر، ولا يُصنع في المؤتمرات، بل في ضمير العالم حين يختار أن يرى الحقيقة كما هي، لا كما ترويها أكاذيب ترامب الساذجة.
----------------------------
بقلم: محمد حماد