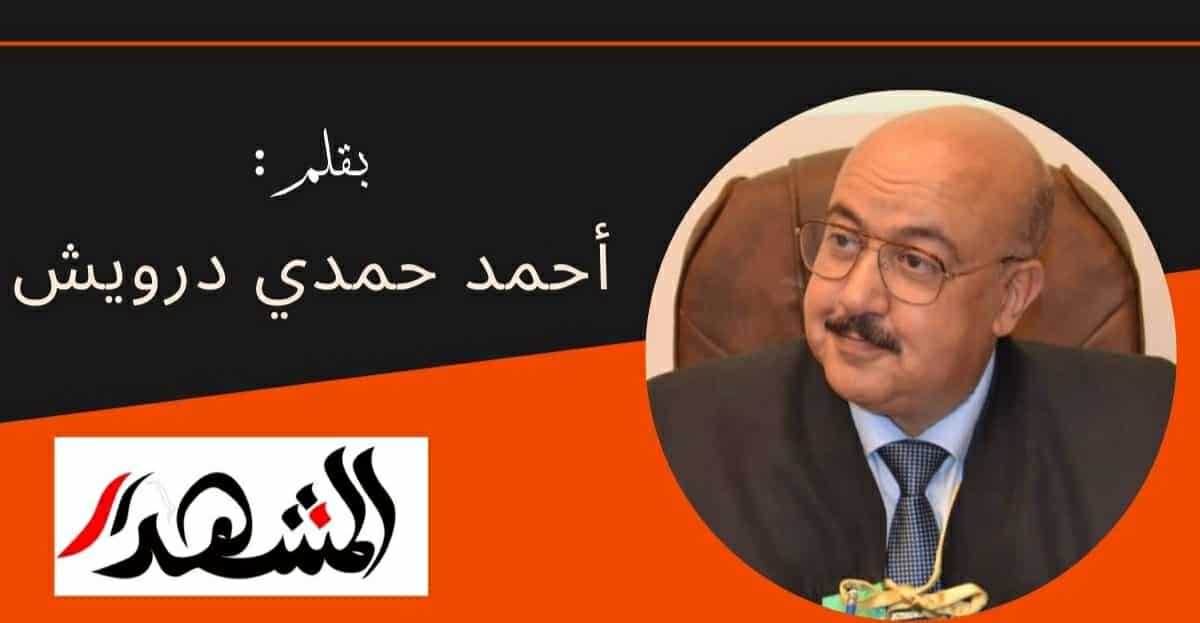في مدينة شرم الشيخ، على هذه الأرض المقدسة بالتفاهم والحوار، وحيث تلتقي مياه البحر الأحمر برمال الفيروز والآمال البشرية، تنصهر حدود الجغرافيا مع أبعاد الميتافيزيقا، ويولد اتفاقٌ جديدٌ يحمل في طياته تناقضات الوجود الإنساني نفسه، هو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد عامين من الدمار والمعاناة، هذا الاتفاق الذي يُوصف بأنه "انتصار لإرادة السلام على منطق الحرب" يطرح أسئلة مصيرية تطل برأسها من بين ركام الماضي عن مستقبل المنطقة، ليس عن مدى استدامة هذه الهدنة، بل عن طبيعة السلام نفسه.
فهل نحن إزاء تحول جذري في وعي المنطقة، أم أننا ببساطة نشهد لحظة استراحة في مسرحية مأساوية تتكرر فصولها مراراً وتكراراً منذ عقود؟ فالاتفاق الذي يُوصف بأنه "انتصار إرادة السلام" يثير استفهامات عميقة عن ماهية الإرادة البشرية حين تواجه قَدَراً مصنوعاً بأيدٍ بشرية، إنه يعيد إلى الأذهان ذلك التناقض الأبدي بين رغبة الإنسان في السلام وقدرته المستمرة على خلق الحروب. وفي هذه اللحظة التاريخية، حيث تتداخل خطوط الزمن، يصبح الماضي ليس مجرد ذاكرة، بل قوة فاعلة في تشكيل الحاضر، فذاكرة الغضب والمعاناة تواجهها رغبة جامحة في الأمل، وكأن المنطقة تقف على حافة الوجود والعدم، حيث كل خيار مصيره أن يصبح جزءاً من سجل تاريخي سيطالعه أحفادنا ذات يوم ليسألوا: لماذا فعلوا ما فعلوا؟ ولماذا لم يفعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله؟
إنها اللحظة التي تُختبر فيها الإنسانية جمعاء معنى أن تكون إنساناً - ذلك الكائن القادر على خلق الجحيم وعلى تخيل الفردوس، الحامل في صدره قلباً للسلام ويداً للحرب، الذي يتوق دائماً لما وراء الأفق رغم عدم قدرته على تجاوز حدود ذاته. ويمثل الاتفاق المعلن من قبل الوفود التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، التي أصبحت "أيقونة" عالمية للسلام، لحظة فاصلة حقيقية، فهو ليس مجرد هدنة، بل خطوة عملية ضمن خطة ترامب للسلام، تشمل بنودًا محددة وآليات تنفيذ واضحة، على الرغم من طابعها التدرجي، فالبنود المعلنة للمرحلة الأولى تشمل؛ وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال الحربية، وتبادل الأسرى حيث سيتم الإفراج عن 20 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق سراح ما يقرب من ألفي معتقل فلسطيني، بينهم 250 محكومًا عليهم بالسجن مدى الحياة، كما تشمل الانسحاب العسكري الإسرائيلي من أجزاء من غزة إلى "الخط المتفق عليه" في غضون 24 ساعة من الموافقة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية (400 شاحنة مساعدات يوميًا كحد أدنى خلال الأيام الخمسة الأولى)، وكذلك تشمل البنود تمكين النازحين من العودة إلى شمال ووسط قطاع غزة.
ولفهم الثقل الحقيقي لهذه اللحظة، يجب وضعها في سياقها التاريخي الأوسع للصراع، الذي تمتد جذوره إلى أواخر القرن التاسع عشر مع ظهور الحركة الصهيونية وبدء الهجرة اليهودية إلى فلسطين في ظل الانتداب البريطاني، الذي أصدر وعد بلفور المشؤوم، ولقد شهد هذا الصراع الطويل حروبًا عدة واتفاقيات سلام لم تنجح في تحقيق حل عادل وشامل، من اتفاقية كامب ديفيد مع مصر إلى اتفاقيات أوسلو في التسعينات. وما يميز الاتفاق الحالي هو السياق الكارثي الذي ولد منه؛ فقد جاء بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر هجمات 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي، وتلاها هجوم عسكري إسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتدمير هائل لقطاع غزة، وهذا الدمار الهائل هو ما خلق "إرادة السلام" التي يتحدث عنها الجميع.
يمكن قراءة هذا الاتفاق من خلال عدسة ترى السلام كعملية وليس نتيجة، وتطرح عدة تساؤلات جوهرية؛ هل السلام هو غياب الحرب أم بناء نظام عادل؟ فالاتفاق يركز على وقف القتال وتبادل الأسرى، لكنه لم يحسم بعد القضايا الجوهرية مثل مستقبل حكم غزة، ونزع سلاح حماس، ومصير المستوطنات في الضفة الغربية، وهذا يذكرنا بأن السلام الحقيقي ليس مجرد توقف لإطلاق النار، بل هو بناء لتنظيم سياسي واجتماعي يحقق العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية للجميع. كما أن هناك تناقضاً واضحاً بين الإرادة والقدرة؛ حيث قد ترغب الأطراف في السلام، لكن هل تمتلك القدرة السياسية والداخلية لتحقيقه؟! في داخل إسرائيل يعتمد بنيامين نتنياهو على تحالف مع أحزاب يمينية متطرفة هددت بالإطاحة بالحكومة إذا تم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب، وفي الجانب الفلسطيني هناك سؤال حول قدرة حماس على تسليم سلاحها، المطلب الإسرائيلي الأساسي للمراحل القادمة.
وفي العمق الفلسفي لهذه اللحظة التاريخية، يمكننا أن نستدعي رؤية الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط الذي تصور السلام في مؤلفه "السلام الدائم" ليس كمجرَّد حالة سلبية من انعدام القتال، بل كبناء مؤسسي معقد يقوم على ثلاثة أركان أساسية هي الدستور الجمهوري في كل دولة، والاتحاد الفيدرالي بين الدول، وقانون الضيافة العالمي، فالاتفاق الحالي في شرم الشيخ يمثل محاولة للانتقال من "سلام الصمت" - حيث تهدأ الأصوات لكن تظل الجروح نازفة - إلى "سلام الحوار" النشط الذي يعترف بجذور الأزمة ويتعامل معها عبر آليات تدرجية.
غير أن المعضلة الجوهرية تكمن في أن هذا البناء المؤسسي النبيل يقف على أرضية من اللا يقين الوجودي، فالاتفاق يحاول أن ينسج خيوط الثقة بين طرفين تآكلت بينهما مساحات الثقة عبر عقود من الصراع، حتى أصبحت الذاكرة الجماعية لكل منهما سجلاً للمظالم والآلام، وهذا يذكرنا بثنائية الذات والموضوع في فلسفة هيغل، حيث تظل كل ذات عاجزة عن فهم الموضوعية الكاملة للآخر، مما يخلق حاجزاً وجودياً أمام أي محاولة للتفاهم الحقيقي. ويزيد من تعقيد هذه المعضلة ذلك الثقل التاريخي الذي يشكل وعي الأطراف وخياراتهم، فالاتفاق السابق الذي بدأ في يناير ثم انهار بعد شهرين ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو تجسيد لمقولة الفيلسوف جورج سانتايانا: "من لا يتذكر الماضي محكوم عليه بإعادة تكراره"، ولكن الأمر يتجاوز مجرد التذكر إلى إشكالية أعمق، وهي أن الماضي لا يموت بل يتحول إلى هوية، وهذه الهوية تصبح بدورها سجناً يصعب الخروج منه.
هنا نستحضر فريدريك نيتشه حول "العود الأبدي" - تلك الفكرة التي ترى أن الأحداث تتكرر إلى ما لا نهاية إذا لم نتمكن من تجاوز أنفسنا، فاتفاقيات السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تشبه شخصيات تراجيدية تحاول كسر حلقة القدر، لكنها تظل أسيرة منطق الصراع ذاته، فكل اتفاق يحمل في داخله بذور فشله، لأنه يولد من رحم موازين القوة لا من رحم العدالة المطلقة. وفي الخلفية من كل هذا يقف سؤال بول ريكور الجوهري: "كيف يمكن أن نغفر دون أن ننسى؟". فالاتفاق الحالي يحاول أن يكون إجابة عملية على هذا السؤال الفلسفي العميق، من خلال محاولة خلق مستقبل جديد دون محو الذاكرة، والوصول إلى تسوية سياسية دون تنازل عن الحقوق الجوهرية، لكنه يظل محاولة هشة في مواجهة تناقض وجودي أكبر هو كيف نصنع السلام بين طرفين مؤمنين بأن وجود أحدهما يهدد وجود الآخر؟
وفي قلب هذا الاتفاق التاريخي، تكمن تحديات جوهرية تعيد إنتاج نفسها عبر حقب الصراع المتعاقبة، كأشباح من ماضي لم يُحاسب ومستقبل لم يُستحق بعد، وهذه التحديات ليست مجرد عقبات عملية قابلة للحل، بل هي تجليات لصراعات هوياتية عميقة تتطلب غوصاً عميقاً في جذورها. فتشكل قضية حكم غزة امتحاناً لجوهر المفهوم الهيجلي للدولة كتعبير عن "الروح الموضوعية" للمجتمع، فخطة ترامب التي تستبعد حماس وتقترح "لجنة تكنوقراطية" تطرح إشكالية الشرعية السياسية في أعلى تجلياتها، فمن أين تستمد هذه اللجنة شرعيتها؟ هل من القوى الدولية الراعية؟ أم من الإرادة الشعبية للفلسطينيين؟
هنا نجد أنفسنا أمام مفارقة وجودية، فحماس التي قد تفتقر للشرعية الديمقراطية بعد سنوات من انقسام فلسطيني مرير، تمثل جزءاً من الإرادة الشعبية التي لا يمكن تخطيها، وفي المقابل يعارض نتنياهو مشاركة السلطة الفلسطينية، مما يخلق معادلة ثلاثية الأبعاد: قوة فلسطينية لا يمكن تخطيها، وسلطة فلسطينية لا يقبل بها الجانب الإسرائيلي، ولجنة تكنوقراطية تفتقر إلى الجذور الشعبية. كما تشكل قضية نزع سلاح حماس نموذجاً حياً لمعضلة الثقة والخشية التي تناولها توماس هوبز في "اللوياثان" حيث يستخدم هوبز هذا الاسم كرمز للدولة القوية التي تتمتع بسلطة مطلقة، فمن منظور إسرائيلي، يمثل السلاح تهديداً وجودياً يتطلب تحييداً مسبقاً، ومن منظور فلسطيني، يمثل السلاح ضمانة للتفاوض وورقة ضغط في مواجهة قوة غير متكافئة.
وهذه المعضلة تذكرنا بمفارقة السجين في نظرية الألعاب، حيث كل طرف يفضل خيار التعاون، لكن عدم الثقة يدفعه لخيار المواجهة، والنتيجة هي ذلك المأزق الوجودي حيث يصبح السلام نفسه رهينة لشروط مسبقة يتعذر تحقيقها، إنها حلقة مفرغة تطرح سؤالاً جوهرياً: "هل الأمن شرط للسلام، أم أن السلام هو الشرط الأساسي للأمن؟"وفي العمق، يعاني الاتفاق من تناقض وجودي يتجاوز المسائل السياسية إلى مسائل الهوية والذاكرة الجماعية، فالإسرائيليون يحملون ذكرى هجوم 7 أكتوبر، التي تحولت إلى جزء من سردية "عدم إمكانية التعايش" مع طرف يرفض وجودهم، وفي المقابل يحمل الفلسطينيون ذكرى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، والتي تعزز سردية "التضحية من أجل الوجود". هنا، نجد أنفسنا أمام إشكالية فلسفية عميقة تناولها الفيلسوف بول ريكور حول صراع الذاكرات، فكل جماعة تختزل هويتها في معاناتها، وتجعل من هذه المعاناة مصدراً للشرعية الأخلاقية، والنتيجة هي حرب ذاكرات حيث يصبح النسيان خيانة، والتسامح ضرباً من المستحيل.
فما تواجهه اتفاقية شرم الشيخ ليس مجرد تحديات سياسية، بل هو اختبار لقدرة الإنسان على تجاوز ذاته وهويتها المصنوعة من رحم المعاناة، إنه يتطلب ما أسماه الفيلسوف كانط "الثورة في طريقة التفكير"، حيث يتحول الطرفان من منطق "الوجود ضد الآخر" إلى منطق "الوجود مع الآخر". فالسلام الحقيقي ليس انتصار طرف على آخر، بل هو انتصار على النزعة التدميرية الكامنة في كل إنسان، وهو يتطلب شجاعة للخروج من سجن الذاكرة نحو فضاء أوسع من التفاهم المتبادل، حيث لا يعني النسيان التنازل عن الحقوق، بل يعني التحرر من أسر الماضي لبناء مستقبل مختلف. وبلا شك، إن تحليل السياق الإقليمي لاتفاق شرم الشيخ يتطلب قراءةً أعمق للنزعة التعددية الآخذة في التشكل في هندسة العلاقات الدولية بالمنطقة، فالاتفاق لا يمثل محطةً منعزلة في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بل هو تجلٍّ لتحوّل جيوبوليتيكي أوسع، يشير إلى ولادة "نظام إقليمي جديد" في طور المخاض.
ولم تعد الدول العربية مجرد متفرج أو داعم مالي، بل تحولت إلى "فاعل حوكمة إقليمية" من خلال وساطاتها النشطة، فمصر - بعمقها الاستراتيجي وثقلها التاريخي - وقطر - بحنكتها الدبلوماسية وعلاقاتها المتشعبة - وتركيا - بثقلها الإقليمي وتأثيرها الجيوبوليتيكي - تمثل معاً نموذجاً للدبلوماسية التعددية التي أعادت تعريف مفهوم الوساطة من مجرد نقل رسائل إلى دور فاعل في صياغة الحلول وضمانات التنفيذ، وهذا التحول ليس طارئاً، بل هو نتاج تراكمي لإدراك هذه القوى أن الأمن الإقليمي أصبح غير قابل للتجزئة، وأن نار الصراع في غزة قد تلتهم الاستقرار الإقليمي بأكمله. وفي هذا السياق، يمكننا قراءة المشهد الإقليمي عبر مفهوم "الفوضى الخلاقة" التي تجاوزت حيزها النظري إلى التطبيق العملي، فلقد أثبتت الصراعات في سوريا واليمن وليبيا - والتي ذهب ضحيتها مئات الآلاف - أن "حروب الوكالة" لم تعد تحقق انتصارات حاسمة، بل خلقت دوامات من عدم الاستقرار استنزفت الجميع، هذا الإدراك المشترك ولّد حاجة موضوعية نحو إعادة تعريف مفهوم "القوة" من القدرة على الإضرار بالآخر إلى القدرة على خلق حالة من "التوازن التعاوني".
والاتفاق الحالي بهذا المعنى، قد يكون النواة الأولى لعقد إقليمي جديد يقوم على ثلاث ركائز:
- الركيزة الأمنية: الانتقال من منطق الردع الأحادي إلى منطق الأمن التعاوني، حيث يصبح تهديد أي طرف تهديداً للجميع..
- الركيزة الاقتصادية: تحويل التكامل الاقتصادي من أداة للمنافسة إلى جسر للتعاون، عبر مشاريع الطاقة والربط الكهربائي والطرق التجارية التي تعود بالنفع على الجميع.
- الركيزة السياسية: تحويل الدبلوماسية من وسيلة للمناورة إلى أداة لبناء الثقة عبر حوارات إقليمية مؤسسية.
هذا التحول الجيوبوليتيكي يذكرنا بصراع التاريخ والإرادة في الفلسفة الهيجيلية، حيث تتحول التناقضات والصراعات الدموية في النهاية إلى محركات للتطور وصعود أشكال أكثر تقدماً من التنظيم السياسي، فكما أن حرب الثلاثين عاماً في أوروبا أنتجت "سلام ويستفاليا" الذي أسس لنظام الدولة القومية، قد تكون الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط تدفع نحو ولادة نظام إقليمي أكثر استقراراً وتكاملاً. وخلاصة اتفاق شرم الشيخ هو أنه أكثر من مجرد وساطة ناجحة؛ إنه مؤشر على نضج إقليمي، وخطوة أولى نحو "عصر ما بعد الهيمنة الأحادية" حيث تدرك القوى الإقليمية أن مستقبلها لا يكمن في إضعاف جيرانها، بل في بناء نظام إقليمي قائم على توازن المصالح والتعايش الوظيفي.
وبعد توقيع اتفاق شرم الشيخ، يقف الشرق الأوسط عند مفترق طرق وجودي، حيث تتبلور ثلاثة سيناريوهات كبرى لمستقبل المنطقة، كل منها يحمل رؤية فلسفية عميقة لماهية السلام وطبيعة التحول الإقليمي.
السيناريو التكاملي نحو نسق إقليمي عضوي. في هذا المسار لا يقتصر النجاح على تنفيذ بنود الاتفاق فحسب، بل يتعداه ليصبح نموذجاً لحل الصراعات الإقليمية المتشابكة، فاتفاق غزة يشكل لحظة تأسيسية للعقد الاجتماعي الإقليمي الجديد، حيث تتحول الدبلوماسية من أداة لإدارة الأزمات إلى آلية لبناء نظام إقليمي متعدد الأقطاب، وهنا تتحول التسويات في اليمن وسوريا وليبيا من كونها أزمات منفصلة إلى حلقات في سلسلة التحول الكبرى، وتظهر مشاريع الطاقة والربط الكهربائي والبنية التحتية كأدوات للتكامل بدلاً من التنافس، وهذا المسار هو القادر على إعادة الروح في التاريخ، حيث تتحول التناقضات والصراعات إلى محركات لتشكيل كيانات سياسية أكثر تطوراً وتعقيداً.
السيناريو الانتكاسي؛ عودة شبح التفكك. في هذا المسار، يتحول الاتفاق إلى مجرد هدنة مؤقتة في حرب وجودية ممتدة، فخلافات التفاصيل - مثل نزع السلاح ومستقبل الحكم في غزة - تعيد إنتاج منطق الصفرية الذي طبع الصراع لعقود، والانهيار هنا ليس مجرد فشل دبلوماسي، بل هو إعلان عن عجز الإرادة البشرية أمام ثقل التاريخ وصراع الهويات، وهذا السيناريو يذكرنا برؤية الفيلسوف توماس هوبز عن "حرب الكل ضد الكل"، حيث يغيب العقد الاجتماعي وتعود الفوضى الأصلية، وهو يعيد إنتاج "لعبة الموت" الهيجيلية بامتياز، حيث يفضل الأطراف المجازفة بالوجود كله على التنازل عن جزء من هويتهم.
السيناريو التراكمي؛ صراع الإرادات في الزمن المنكسر. هذا المسار يجسد "السلام الهش" – حالة غياب الاستقرار المستدام حيث تتعايش دوامات العنف المتقطع مع مفاوضات لا تنتهي، إنه يعيد إنتاج النمط التاريخي للصراع لكن مع تحول جوهري: تحول الصراع من مواجهة عسكرية صرفة إلى حرب إرادات في ظل نظام إقليمي متغير، وهذا السيناريو يعكس رؤية الفيلسوف الفرنسي ألان باديو للحدث (Event) كانزياح في بنية الوضع القائم دون أن يصل إلى نقطة القطع الجذرية، إنه السلام كعملية لا تنتهي تشبه سيزيف (Sisyphus) الذي يعيد دحرجة الصخرة إلى القمة، ولكن بمجرد وصولها إلى القمة، تتدحرج إلى الأسفل مرة أخرى، لكن مع تراكم تأثيري لحفريات آثار أقدام سيزيف وهو يصعد الجبل فقد يتغير الجبل ويصبح أقل انحداراً بمرور الزمن.
الحقيقة الجوهرية التي تكشفها هذه اللحظة التاريخية تتجاوز السياسة إلى فلسفة الوجود ذاته، فالسلام ليس حالة نصل إليها، بل هو نمط وجود نعيشه، إنه يشبه النهر الذي لا يتوقف عن التدفق، يجرف في مساره رواسب الماضي بينما يحفر مجرى جديداً للمستقبل. واتفاق شرم الشيخ في هذا السياق، ليس نهاية الرحلة بل "لحظة وعي" في مسار طويل، إنه يعيدنا إلى الجدل الهيجلي بين السيد والعبد: فكلا الطرفين اكتشفا أن النضال من أجل الاعتراف لا يمكن أن ينتهي بإبادة الآخر، لأن قيمة الاعتراف تأتي من كائن حر قادر على منحه طواعية. والشعوب في المنطقة - سواء في ساحات الرهائن في تل أبيب حيث انتشى الأهالي بأنباء الإفراج عن أبنائهم، أو في شوارع خان يونس حيث ابتهج الفلسطينيون بنهاية الحرب - تثبت أن "إرادة الحياة" أقوى من أي أيديولوجيا، وهذه الإرادة التي وصفها الفيلسوف شوبنهاور كقوة كونية عمياء، تظهر هنا كقوة أخلاقية واعية ترفض أن تظل رهينة لصراعات النخب.
والسؤال المصيري الذي تطرحه هذه اللحظة: هل تستطيع النخب السياسية ترجمة هذه الإرادة الشعبية الجبارة إلى رؤية سياسية مستدامة؟ أم أنها ستظل أسيرة حسابات القوة القصيرة التي تفضي دائماً إلى نفس النهاية؟
وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن هذا الاتفاق "لا يغلق صفحة الحرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة بمستقبل قائم على العدل والاستقرار"، لكن الأمل هنا ليس حلماً طوباوياً، بل هو "الفضاء الوجودي" حيث تتحول إرادة الحياة من قوة بيولوجية صامتة إلى مشروع سياسي ناطق، ومستقبل الشرق الأوسط سيتحدد بقدرة أبنائه على خلق لغة جديدة للحوار، تكون قادرة على قول ما لا يمكن قوله، وسماع ما لم يُقل بعد.
----------------------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش