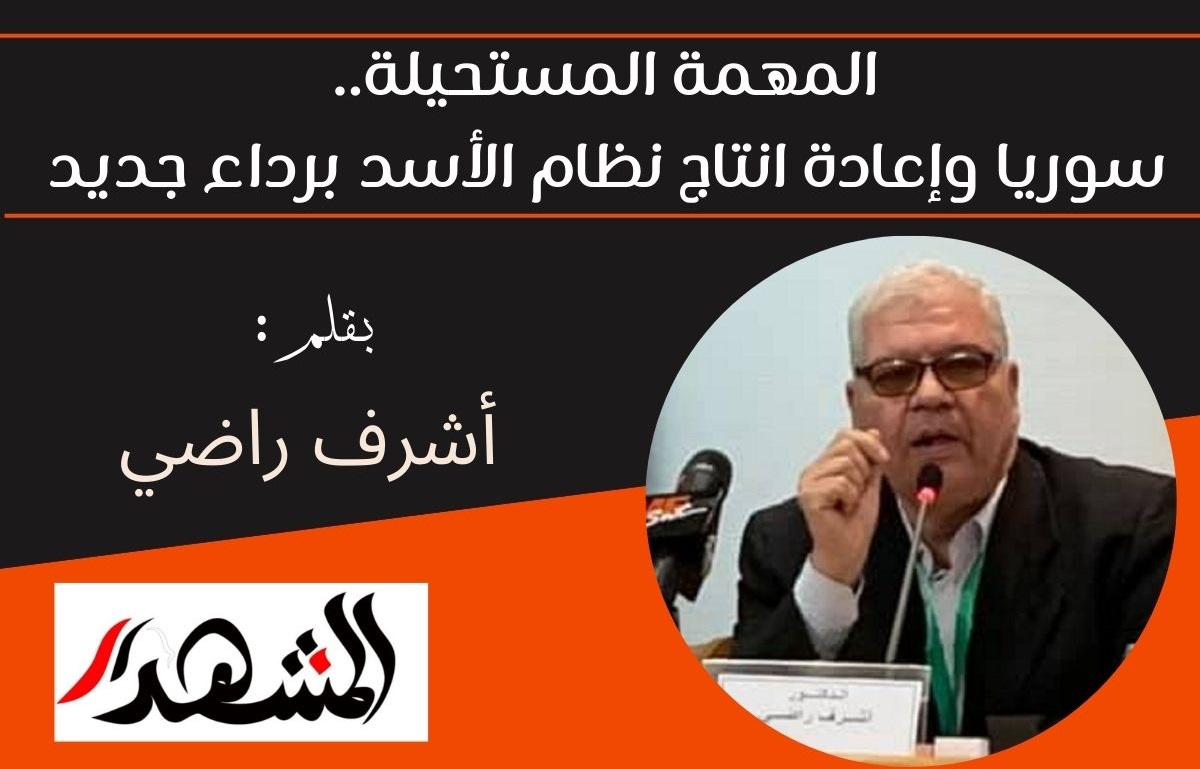أشرت في مقال سابق - كي لا يصبح "التهجير" واقعًا (المشهد 7 سبتمبر) - إلى ضرورة نقد أطروحة الدكتور عبد الوهاب المسيري للصراع مع إسرائيل، لأنها مسؤولة إلى حد كبير عن تجذر فكرة حتمية زوال إسرائيل في العقل العام، وتكرس بالتالي لنهج في مواجهة إسرائيل، حان الوقت لأن نعيد التفكير فيه وأن ننقده. وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة التي تكتنف محاولة كهذه، إلا أن خطورة عدم الإقدام على نقد هذه الأطروحة، بل وإعادة تفسير معنى عبارات مثل "الصراع الوجودي" و"التهديد الوجودي"، والتي تعطي للصراع مع إسرائيل طابعًا استثنائيا ومتفردًا، ومستعصيًا على الحلول والتسويات السياسية وتجعله قدرًا ملازمًا للمنطقة. هذه المراجعة باتت ضرورية، خصوصًا في ضوء النتائج المترتبة على حرب غزة، والتي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا، لمستقبل التجربة الفلسطينية في النضال من أجل التحرر الوطني وبناء الدولة الفلسطينية، وسيكون لهذه النتيجة تداعيات أكثر خطورة بالنسبة للدول العربية، لا سيما في ضوء الضربة الإسرائيلية لقيادة حماس في قطر (الاثنين 8 سبتمبر)، وكذلك مع تصعيد الحرب في غزة، واستمرار الضربات المتبادلة بين إسرائيل والحوثيين.
اللافت أن الضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله في لبنان وفي سوريا، وأيضًا الضربات التي وجهتها لسوريا وتلك التي لا تزال توجهها للحوثيين وحماس، أكثر تأثيراً من الضربات التي توجهها تلك الفصائل لإسرائيل. فقد أخرجت الضربات الإسرائيلية تلك الفصائل، أو تكاد تخرجها من معادلة المواجهة المسلحة، وأعطت للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، إحساسًا بانتصار، قد يكون زائفًا، لكن من المؤكد أنه عدل من ميزان القوة العسكرية لصالح إسرائيل خصوصًا بعد تحييد القدرات العسكرية الإيرانية، في الوقت الراهن على الأقل، بعد حرب دامت 12 يومًا مع إسرائيل، وانهتها ضربة عسكرية أمريكية استهدفت عدة مواقع في إيران، بزعم توجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني. وباتت إيران أكثر اقتناعًا بنهج التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، للحفاظ على التقدم الذي أحرزه هذا البرنامج، وهي مستعدة الآن، على ما يبدو، لتقديم كل الضمانات اللازمة كي تصبح كل الأطراف الأخرى مطمئنة بخصوص أن هذا البرنامج للأغراض السلمية فقط. لقد اتخذت إيران نهجًا تفاوضيًا، لا يختلف عن النهج الذي اختاره الرئيس أنور السادات بعد حرب 1973، وهو نهج يبحث عن أدوات ووسائل ممكنة لتغيير الوضع، استنادًا إلى تقييم موضوعي ينظر إلى المتغيرات الفعلية على الأرض، ويقبل بإدخال تعديلات على الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في ضوء التناسب بين القدرات والتكلفة من ناحية، وتحليل لميزان القوة الشامل الذي يأخذ في اعتباره التحالفات الدولية والإقليمية.
قد تكون هذه الحقيقة مزعجة لمعسكر الممانعة الذي لا يزال يراهن على إيران، التي يرى البعض أنها "الدولة الوحيدة التي ردت على التجبر الإسرائيلي"، وهو ما قاله بوضوح الأستاذ عبد العظيم حماد، في تعليق كتبه بمناسبة الضربة الإسرائيلية لقطر، والتي وضعها في سياق سلسلة من الضربات شنتها القوات الجوية لإسرائيلية، من بينها ضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981، وضرب مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في أول أكتوبر 1985، وضرب قوافل تهريب السلاح لحماس في شرق السودان في 29 مارس عام 2009، وأضيف هنا الضربات الجوية المتكررة لسوريا ولجنوب لبنان واليمن. ويُلاحظ أنه في كل مرة نفذت الطائرات الإسرائيلية مهامها وعادت سالمة، والأمر نفسه ينطبق على حالتي إيران والحوثيين، فلا رادارات ترصد ولا دفاعات جوية تفُعّل للتصدي لهذه الطائرات. من الواضح، أن القدرات الصاروخية للحوثيين غير قادرة، إلى الآن، على رفع كُلفة الصراع بالنسبة لإسرائيل، ومن ثم فإن تأثيرها محدود ولا يردع إسرائيل من مواصلة الحرب ضد حماس في غزة، ولا استهداف الحوثيين أنفسهم في اليمن، بينما خرجت القدرات الصاروخية الإيرانية الأكثر تأثيرًا من المعادلة، بعد المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين.
رصد التحولات ومراجعة التصورات
تؤكد هذه التحولات، مرة أخرى، أن الصراع بات صراعًا إسرائيليًا- فلسطينيًا بامتياز، وأن امتداده إلى ساحات أخرى وبلدان أخرى، أو تورط أطراف غير فلسطينية فيه أمر عارض ولم يؤثر في جوهر هذا الصراع وأصله، وينبغي إيجاد حلول له من هذا المنطلق، والتفكير في كيفية تعزيز موقف الطرف الفلسطيني وتثبيت وجوده على الأرض، ومنع إسرائيل من تأطيره وحصره في الصراع مع حركة حماس، وما يترتب على ذلك من استغلال للتناقضات بين حماس وخصومها الأيديولوجيين والسياسيين في المنطقة. هذا الهدف بات على قدر كبير من الأهمية، خصوصًا أن الاستراتيجية الإسرائيلية نجحت أيضًا في تأطير صراعها مع حماس في سياق "الحرب على الإرهاب"، الأمر الذي كانت له تداعيات كبيرة بالنسبة للأطراف المختلفة في المنطقة وخارجها، وفي مقدمتها الطرف الفلسطيني الذي يواجه حرب تهجير وإبادة وتصفية لقضيته الوطنية.
إن نقطة الانطلاق الأساسية في التفكير في تحولات الصراع وما أفضت إليه هذه التحولات، ينبغي أن تكون الواقع، لا التصورات عن هذا الواقع. وكي لا يسيء أحد من صقور "الممانعة" فهم ما أقول ويصوره وكأنه دعوة للاستسلام، أؤكد أنه بات واضحًا، أن نهج المقاومة المسلحة النهج الذي يدعو إليه فريق "الممانعة"، يأتي بنتائج عكسية تمامًا، وتخالف توقعاتهم أو تطلعاتهم التي تستند إلى إيمانهم بحتمية "زوال إسرائيل"، وما الذي يعنيه القضاء على إسرائيل عمليًا على الأرض، خصوصًا أنه لا توجد مؤشرات تدل على تغيير هذا الوضع، في الأفق المنظور على الأقل، وأن ما نراه هو تدمير القوى الساعية للقضاء على إسرائيل أو حتى التي تقف في وجه خططها الرامية إلى إحكام قبضتها على الفلسطينيين، سكانًا وأرضًا، الأمر الذي يزيد الفارق الكبير في القدرات العسكرية وأن هذا الفارق آخذ في التزايد نتيجة للتطورات الحادثة في التسليح وفي الذخائر، وأيضًا في المعلومات نتيجة للاعتماد بشكل متزايد على منجزات الثورة التكنولوجية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أكده أكثر من تقرير عن حرب غزة.
وعليه، أصبحنا في وضع يفرض علينا ضرورة الانشغال الجدي لاستكشاف طرق بديلة لحالة التدمير المستمر للقضية الفلسطينية، ويتطلب هذا أول ما يتطلب إعادة التفكير في كثير من المسلمات والأطروحات التي ننطلق منها ونقدها، وتحفيز الحوار فيما بين الرؤى النقدية، والتحرر من حالة "الإرهاب الفكري" التي تمارس من خلال تصدير ما يرى البعض أنه ثوابت لا يجوز الاقتراب منها أو التفكير فيها ومناقشتها، وهي الحالة التي تدفع الكثير من المثقفين الذين قد يوافقون في قرارة أنفسهم على أن زعماء حماس ارتكبوا خطأ فادحًا في هجوم السابع من أكتوبر وفي تقديراتهم وتوقعاتهم لمسار الأحداث، الأمر الذي أثر على إدارتهم للحرب، لكنهم لا يجرؤون على التصريح بانتقاداتهم ومناقشة ما يطرح من رؤى ونقدها وتطويرها، وهو وضع قد يشعر من يجرؤ على طرح مثل هذه الرؤى النقدية باليأس.
لذا أسعدني كثيرًا تعليق الدكتور عمرو الزنط، وهو من أبرز من يكتبون في موضوعات تتصل بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، رغم تخصصه في فيزياء الفلك. والتعليق الذي قدمه يصلح لأن يكون مقدمة لنقد أفكار المسيري، الذي يرى في تعليقه أن المسيري لم يقدم "أي شيء حقيقي له أي قيمة" يساعدنا في فهم الصهيونية، وأن أعماله لم تقدم تحليلاً دقيقًا لكيفية فهم الصهاينة أنفسهم للصهيونية، "بتشعباتها وتفريعاتها ومؤثراتها الفكرية والسياسية المعقدة". والأهم أنه أشار إلى من يأخذ كلام المسيري كمرجع من فريق "الممانعة" يحارب صورة كاريكاتورية خلقها "للعدو الصهيوني" لا علاقة لها بالواقع. وهذه ملاحظة دقيقة ومهمة في مشروع تفكيك السرديات الحاكمة لهذا الصراع والبحث في بدائل للسياسات الراهنة في المواجهة والتي باتت نمطية ومكررة ولا تحدث أي تقدم لا في وقف الحرب ولا في احتواء النزعة التوسعية للمعسكر المرشح لحكم إسرائيل لعقود قادمة، وأقصد معسكر اليمين الصهيوني بشقيه، الديني والقومي. وأشار إلى أن أفكار المسيري لا تساعد على تفسير العدوانية الإسرائيلية من خلال التحليل الدقيق لفهم "الصهاينة" لتاريخ اليهود، وهو ما حاول الدكتور عمرو أن يفعله في مقال له عن "تحول صورة حزب الله لدى العقل الصهيوني"، منشور في جريدة "المصري اليوم"، سبتمبر 2006.
المقال محاولة جادة ومهمة في تفسير نقطة الانطلاق عند الصهاينة الذين يتعاملون مع اليهود كأمة وشعب ممتد عبر التاريخ، واللافت أن الآخرين، ومن بينهم الخصوم والأعداء، ربما يتعاملون معهم هكذا. أدى هذا الوضع إلى خصوصية تتفرد بها إسرائيل، دون غيرها من الدول، ويتفرد بها الصراع معها، دون غيره من الصراعات، الأمر الذي يستدعي ضرورة الاهتمام بالجوانب النفسية الحاكمة للنخبة والجمهور اليهودي العام في إسرائيل، وللتحولات التي طرأت عليهم، وكذلك فهم الأبعاد النفسية للصراع وللأطراف المنخرطة فيه. فهذه الجوانب على قدر كبير من الأهمية لأنها تلعب دورًا في طرائق إدراك الصراع. في تقديري، أن جانبا مهما في عملية السلام التي بدأها الرئيس السادات اهتم بفهم الجوانب النفسية والتعامل معها وهذا ما لم يفهمه الآخرون، رغم وضوح موقف الرئيس السادات الذي لطالما، حذر الفلسطينيين من ضرورة التحرك بكل الوسائل الممكنة لكبح توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يؤدي إليه من تغيير للواقع، وللأسف لم يتحرك الفلسطينيون على هذا الطريق، إلا بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982.
الرؤية التي يقدمها الدكتور عمرو في هذا المقال وفي غيره من مقالات ذات صلة بالموضوع، تكشف عن خبرة عميقة وتقييم مؤسس على الملاحظة الدقيقة والاهتمام الكبير بالصراع، والرؤية التي يقدمها تساعد في تطوير استراتيجية لاحتواء التوسعية الإسرائيلية، ولا تركز على البعد المتعلق بردعها فقط، على الرغم من أهمية الردع. قد يكون العنصر الأهم في استراتيجية الاحتواء هذه هو تبني استراتيجية التمايز التي تعمل على تحييد نقاط القوة لدى الخصم وعدم استدعائها، والسعي في الوقت نفسه إلى تحقيق توازن فيما بين نقاط الضعف والهشاشة لدى الأطراف المتصارعة. كذلك من المهم التخلي عن الصور النمطية التي تفترض نوعًا من الثبات والجمود في صورة العدو الذي يتم تصويره على أنه يتحرك ككتلة صلبة ومصمتة لا يمكن اختراقها أو استغلال تناقضاتها الداخلية، ورصد التغيرات في البيئات الثلاث للصراع.
نهجان في الاستجابة للواقع المتغير
لقد برز منهجان رئيسيان في العالم العربي للتعامل مع الواقع في تغيراته وتحولاته. النهج الأول، تبناه الرئيس السادات، وربما كانت له جذور سابقة عليه تبلورت في أعقاب حرب عام 1967. يقوم هذا النهج على البحث عن وسائل أخرى لتغيير معادلة الصراع، بطرح "مبادرة السلام" وحل الصراع مع إسرائيل بوسائل سياسية وأدوات دبلوماسية، وهو النهج الذي تنتهجه مصر إلى الآن وتتبناه العديد من الدول العربية التي كان كثير منها من قبل في جبهة الصمود والتصدي المعادية للسادات ومصر، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح.
النهج الثاني، هو النهج الذي تبناه الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وحزب البعث، ويقوم على فكرة مفادها الانتظار والسعي من أجل تطوير "التكافؤ الاستراتيجي" مع إسرائيل، كشرط ضروري لاستكمال تحرير ما تبقي من أرض سورية محتلة. ومحصلة هذا النهج واضحة بعدما بات واضحًا أنه لم يتبق لسوريا أي خيار آخر بعد فشل محاولات التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات، وقرار إسرائيل ضم مرتفعات الجولان السورية. بل إن التطورات على الجبهة السورية الآن، بعد الإطاحة بحكم الأسد، تشير إلى فصل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل والنظام الجديد في سوريا دون المساس بالترتيبات التي فرضتها إسرائيل على الأرض بعد سقوط النظام.
لقد كانت ورقة القوة الأساسية في نهج الانتظار لحين الوصول إلى نقطة "التكافؤ الاستراتيجي"، هي العمل على استنزاف القوة الإسرائيلية من خلال دعم فصائل المقاومة المسلحة والعمل على بناء تحالفات إقليمية لتعديل ميزان القوة. هذه الورقة تحديدًا، هي ما خسره هذا النهج بعد حرب غزة إذ تمكنت إسرائيل من توجيه ضربات قوية لفصائل المقاومة، وداعميها، لاسيما إيران الأمر الذي حد من قدرتها على استنزاف القوة العسكرية لإسرائيل أو إنهاكها، ولو من خلال ضربات محدودة لكنها مؤثرة. وفي ضوء هذا التطور بات السؤال المطروح بإلحاح هو ما العمل لاحتواء الروح العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي يدعمها صعود الأحزاب الصهيونية اليمينية وما تتبناه من رؤى أيديولوجية تسعى لفرضها على الواقع بقوة، وأن هذا الصعود بات يشكل بالفعل تهديدًا وجوديا للقضية الفلسطينية ولحل الدولتين، ولا شك أن الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني مسؤول إلى حد كبير عن هذا الوضع. ومن اللافت أن هذا الانقسام هو تجسيد للتباين في نهج إدارة الصراع مع إسرائيل، على نحو يعكس التباين بين نهج الإدارة السياسية للصراع وبين نهج بناء التكافؤ الاستراتيجي.
لغة القوة والجوانب النفسية للصراع
هناك مقولتان أساسيتان تتحكمان في إدراك الأطراف المختلفة المنخرطة في هذا الصراع، سنجد استخدامًا متكررًا للمقولتين في الخطاب السياسي الإسرائيلي من ناحية والخطاب السياسي الفلسطيني، وإلى حد ما العربي، من ناحية أخرى. المقولة الأولى "الخصم لا يفهم لغة غير لغة القوة"، والمقولة الثانية هي إن التهديد الذي يوجهه الخصم أو العدو هو تهديد وجودي، وعليه فإن الصراع هو "صراع على الوجود وليس صراعًا على الحدود. إن تحليل المقولتين وما طرأ عليهما من تحولات ضروري لتفكيك التصورات الحاكمة للصراع وللبحث في مساراته الحالية والمتصورة مستقبلًا، والبحث عن استراتيجيات بديلة لإدارته. سنركز في هذا المقال على صراع الوجود، ونرجئ تناول المقولة الثانية "لغة أو منطق القوة" لمقال آخر.
لا يمكن فهم عبارة "صراع الوجود" التي تتحكم في قطاعات كبيرة على الجانبين، الصهيوني من ناحية والعربي الفلسطيني من ناحية أخرى، دون فهم الأبعاد النفسية الحاكمة للطرفين والتي لها ثقل كبير على الصراع واستمراريته بدرجات متفاوتة من الحدة. "صراع الوجود"، يشير في أحد معانيه إلى تصور يرى أن الصراع لن يحسم إلا بتدمير أحد طرفيه والقضاء عليه تمامًا. هذا التصور لا يقتصر فقط على الأطراف العربية أو إيران التي تعلن أن محو إسرائيل من على الخريطة أحد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. فالمعنى الأول لفكرة "صراع الوجود" إنما تعني نفي الوجود، والذي يعني من المنظور الإسرائيلي، نفي الوجود الفلسطيني من أرض فلسطين التاريخية أو نفي أي وجود غير يهودي من أرض الميعاد لتأسيس "إسرائيل الكبرى"، إما بالترحيل أو بالإبادة. والتجربة الأوروبية في أمريكا الشمالية، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأسست على إبادة الشعوب الأصلية، ملهمة للمخيلة الصهيونية، رغم صعوبة تحقيقها وعدم واقعيتها في العالم الراهن الذي تحكمه منظومات من القيم التي تطورت مع تطور البشر. ويعني صراع الوجودي من المنظور العربي والإيراني، إلحاق هزيمة ساحة بإسرائيل وتدمير قوتها العسكرية وإقامة دولة فلسطينية على أنقاضها، أو إقامة دولة كبرى في المنطقة، لا تنفي وجود اليهود كأتباع ديانة، وإنما تفكك الصهيونية التي تتعامل مع اليهود كأمة. ويستند هذا التصور على الخبرة التاريخية الخاصة بالإمارات الصليبية التي أقيمت في المشرق العربي نتيجة للتسويات مع الممالك الأوروبية التي أرسلت حملات عسكرية للسيطرة على المشرق العربي التي استمرت قرابة مائتي عام بين عامي 1091 و1291، وتحرير الجزائر في عام 1962، بعد احتلال استيطاني فرنسي دام نحو 123 عامًا.
على الرغم من أن تفكيك المشروع الصهيوني من خلال دمجه في دولة أكبر قد يوفر آليات تضمن حقوق الجماعات المختلفة، على أساس فردي أو حتى على أساس قومي أو جماعي، من خلال تطبيق مفاهيم حديثة مثل مفهوم المواطنة أو الديمقراطية، يظل السؤال هل بوسع مثل هذا الحل أن يتعامل مع الجوانب التاريخية لتشكل الدول المعاصرة في الشرق الأوسط، الحريصة على تأكيد وجودها وتعزيز هوياتها الوطنية الخاصة؟ وهل بوسعه التعامل أيضًا مع الجوانب النفسية المرتبطة بالخبرة التاريخية لليهود كجماعة عانت من سلسلة طويلة من الهزائم التي أدت إلى إذلالهم وإخضاعهم، والتي وجدت الحل التاريخي في إقامة دولة لليهود؟ وهل سيقبل الإسرائيليون المعاصرون بحل آخر غير حل الدولة اليهودية التي تملك قوة عسكرية قادرة على سحق أعدائها، وما الذي يجبرهم على ذلك؟
"صراع الوجود" بمعني نفي العدو، شاغله الرئيسي هو إضعاف الخصم أو استنزافه أو إنهاكه، لكن هناك معنى آخر لصراع الوجود يؤسس على منطق الدولة في صورتها المعاصرة والتي تشكلت في منطقة الشرق الأوسط نتيجة لتسويات الحرب العالمية الأولى وعمليات تاريخية أخرى، لعبت فيها القوى الاستعمارية التي خرجت منتصرة في الحرب دورًا في تشكيلها وتعيين حدودها وبناء مؤسساتها. وظلت هذه الملامح سارية حتى بعد حصول هذه الدول على استقلالها، على الرغم من أن الدولة التي نشأت، هضمت حقوق أقليات قومية أو عرقية أو دينية كانت تتطلع إلى بناء دولتها المستقلة، وتبرز المشكلة الكردية هنا بشكل خاص. في هذا السياق تشكلت الهوية القومية اليهودية بإشراف الحركة الصهيونية على أرض فلسطين استنادًا إلى الهجرات اليهودية الكبيرة التي بدأت تتدفق بشكل منتظم منذ أواسط النصف الأول من القرن التاسع عشر، ووعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود.
المعنى الآخر لصراع الوجود والذي غاب لعقود عن توجيه السياسات لدى الفلسطينيين وبعض القوى العربية هو ما عبر عنه خالد محمد خالد في كتاب "من هنا نبدأ"، أو رصده أحمد بهاء الدين في كتاباته لتحليل هزيمة 1967، وكلاهما يركز على أهمية بناء الوطن في العالم العربي. إن مفهوم "الوطن" مفهوم حديث نسبيًا في الثقافة السائدة في المنطقة التي ظلت لقرون جزءا من امبراطوريات كبيرة، سواء تمثلت هذه الإمبراطوريات في الإمبراطورية الفارسية أو البيزنطية أو دولة الخلافة العربية الإسلامية أو دولة الخلافة العثمانية. وتأثرت الأفكار الأولى لفكرة الوطن بمفهوم القومية الذي برز في سياق أزمة الدولة في دول وسط وشرق أوروبا التي كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية ثم من الإمبراطورية النمساوية المجرية، ونشأ هذا المفهوم مشوشًا بسبب تداخله مع أفكار أخرى نشأت في الشام تحديدًا حول البعث العربي والقومية العربية كنقيض للعثمانية. في هذا السياق يصبح مفهوم الدولة القطرية التي تشكلت ضمن حدود جغرافية ساهمت عوامل كثيرة في تشكيلها مفهومًا عابرًا وغير مستقر، وأصبحت النخب التي تحكم هذه الدول تشعر بتهديد مستمر لوجودها من الدول الأخرى المجاورة، الأمر الذي أوجد معضلة أمنية تعاني منها كل دول المنطقة ولم تتطور بعد أي أطر للتعامل معها ومعالجتها ووضع ترتيبات بديلة للتعامل معها، وهو أمر عمق من مسألة التهديد الوجودي والصراعات الوجودية، والتي وجدت في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ساحة لاختبارها، واستمرار هذا الوضع مسؤول إلى حد كبير عن استمرار الصراع بمستويات مختلفة من الاتساع والحدة.
قد يؤدي ترسخ فكرة الدولة الوطنية ضمن حدودها الحالية وانخراط النخب في مشروعات جادة لبناء الدولة أو بناء الوطن إلى فرض منطق جديد لمعالجة المعضلة الأمنية، وقد يكون توسيع مبدأ تقييد قدرة الدول على شن حروب هجومية أو عدوانية الذي أعلنته الولايات المتحدة بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في أعقاب الغزو العراقي للكويت في عام 1990، ليشمل إسرائيل بات مسألة ملحة في اللحظة الراهنة من أجل الاستقرار الإقليمي والدولي، وهذه مهمة غير قابلة للتحقيق بدون ضغط أمريكي مباشر لضبط سلوك الحكومة الإسرائيلية. وإذا لم تكن الإدارة الأمريكية الحالية غير مدركة لخطورة هذا الوضع فعليها الاستماع مرات ومرات لخطاب نتنياهو الأخير، لعلهم يتعلمون شيئًا من التكرار.
--------------------------
بقلم: أشرف راضي