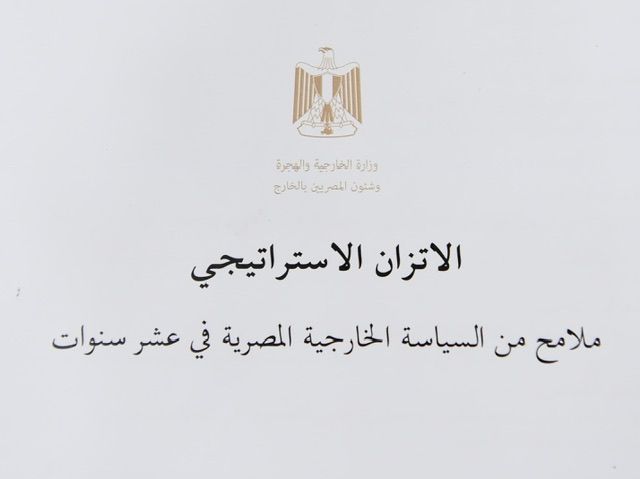المشهد التربوي المصري اليوم يحتاج إلى تسمية دقيقة. نحن أمام ظاهرة «تغيير دائم» أكثر منها إصلاحًا منظَّمًا. المشكلة ليست فقط أن تتغير سياسات أو مناهج، بل أن التغيير صار سريعًا، يأتي من أعلى ويُعمّم دفعةً واحدة، ويغيب عنهُ التخطيطُ التراكمي الانضباطي. هذا النهج يأخذ أشكالًا متعددة: استيراد أنظمة تربوية أجنبية أو تبنّي نماذج تعليمية متطوّرة ظاهريًا، ثم تبديلها سريعًا؛ فمثلا تغيير كتب اللغة الإنجليزية أربع مرات أو أكثر خلال سنوات قليلة؛ طرح أجهزة التابلت كمشروعٍ قومي بمليارات الجنيهات ثم فشل تنفيذ الامتحانات أونلاين كما كان مخططا لها، تعديل نظام الثانوية العامة من جذوره ثم إلغاؤه أو تعديله على نحوٍ يحسِم مصائر طلاب وأسرهم. ومؤخرا تخبط الطلاب وأولياء الأمور بين الثانوية العامة والبكالوريا، كلّ هذا يحدث من دون رؤية واضحة وثابتة للتعليم، ومن دون مراعاة للطبيعة التراكمية للمعرفة، ومن دون مراعاة لطبيعة بيئة الطالب المصري الذي يختلف عن الطالب الأمريكي والياباني والصيني… لذا أي تغيير يجب أن يكون نابعًا من دراسة حقيقة لبيئة الطالب والمعلم والمدرسة، وملائمًا لروح المجتمع المصري، وملبيًا لاحتياجات سوق العمل، وليس مستوردًا من بيئات ومجتمعات غريبة عنا.
أولًا: لماذا التغيير المتكرر يؤذي التعليم؟ لأن التعليم نظام تراكمِي. المناهج، طرق التدريس، مهارات الامتحان، والقدرات المعرفية تُبنى عبر سنواتٍ متصلة. عندما يُغيَّر الإطار العام، طريقة القياس أو توزيع المقررات أو مستوى المخرجات، بصورة مفاجئة أو شاملة على كلّ المراحل دفعةً واحدة، يضيع «سلم التعلم» الذي تسلَّم من قبل الطالب والمعلم. هذا ما حدث عند تغيير كتب اللغة الإنجليزية مرارًا: كلُ سلسلةٍ (Hello ثم New Hello أو Time for English ثم Connect ثم الإصدار الذي يُشار إليه الآن باسم العام «English» في بعض التسميات) ليست مجرد غلاف جديد، بل منهجية جديدة وأهدافا مختلفة وأساليب تقييم متباينة. تطبيق هذه التغييرات على مراحل متعددة دفعةً واحدة يخلق فجوات: طلاب في مرحلة أعلى يُطالبون بمهارات لم تُدرَّس لهم على نحو تراكمي، والنتيجة ضعف الاستعداد الجامعي والمهارات العملية، وشعور عام بعدم العدالة في التقييم.
ثانيًا: التبني المستورد لأنظمة تربوية دون توطين علمي هو أحد أسباب التخبط. كثير من المصطلحات والأساليب التي تُطرح على أنها «جديدة» مثل ملفات البورتفوليو، أو أساليب تقييم تعتمد على مشروعات، أو ممارسات اجتماعية/ نفسية مستوردة. ومشروعات تعليمية كـ"توكاتسو" تُنفّذ أحيانًا على استحياء أو دون تدريب كافٍ للمعلمين، أو تُدمج مع نظم امتحان تقليدية لا تتوافق معها. حين تُستورد الأسماء والمفاهيم دون دراسات تطبيقية محكمة، تتحوّل المبادرة إلى لافتة إدارية لا أثر لها في الميدان. برامج الإصلاح الكبرى التي حظيت بدعم جهات دولية أو مؤسسات تمويل كانت تستلزم آليات تنفيذ وتقييم بعيدة المدى، لكن التطبيق العملي سرعان ما اصطدم بنقص البنية التحتية وبضعف التدريب، ومن ثم تضاءلت النتائج.
ثالثًا: مشروع التابلت مثالٌ واضح على كيف تتحوّل خطوة رقمية طموحة إلى أعباء مالية وتنفيذية تهدر الاستقرار. أعلن توزيع تابلت لتلاميذ المرحلة الثانوية كجزء من خطوات التطوير، وتُقدِّر تقارير إعلامية العقد الأولي بعشرات المليارات، بينما تبقى أسئلة أساسية عن صيانة الأجهزة، تأمين الشبكات، ظهرت انتقادات أن تنفيذ مثل هذه المشاريع سرعان ما أصبح عرضة لمشكلات تقنية وقانونية ما يفتح الباب لهدر المال دون تحقيق نتائج تربوية ملموسة. التابلت إذن لم يعالج جذور المشكلة — ضعف المناهج، نقص تدريب المعلمين، الكثافة الصفية — بل أضاف عبئًا مالياً وتقنيًا كبيرًا.
رابعًا: تغيير المناهج مرارًا واستيراد سلاسل كتب جديدة للغة الإنجليزية بالذات يضرّ أكثر من غيره لأن اللغة مادة تراكمية بامتياز. تعلم لغة يتطلب استمرارية في المفردات، قواعد، ومهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وكل طبقة تُهيئ التي تليها. تغيير الكتاب الوطني أو المنهج العام دون خطة انتقالية يترك الجيل الأوسط في فراغ معرفي: مديرو المدارس يضطرون إلى «ترقيع» أجنداتهم لتلبية كُلّ نسخةٍ جديدة، والمعلم يواجه ضغطًا لاحتواء مناهج مختلفة مع عدم وجود تدريب حقيقي أو موارد مساعدة. هذا ينعكس في اختبارات قياس الازدهار اللغوي على مستوى الثانوية والجامعة، ويُضعِف قدرة الخريج على مواكبة متطلبات الدراسة أو العمل بالخارج.
خامسًا: ثمن هذا التخبط يدفعه الطالب وولي الأمر. المال العام يُنفق على مشاريع باهظة، والأهل يضيعون أموالهم على الدروس الخصوصية والتجهيز للامتحانات، والطالب يتعرَّض لقلق وعدم استقرار معرفي ونفسي؛ وفي النهاية من يتحمّل الخسارة الفعلية هو جيلٌ كامل. تغيّر نظام الثانوية العامة أو أسلوب احتساب المجموع أو إدخال «التحسين» ثم تغييره لاحقًا يعيد كتابة قواعد القبول الجامعي ويقلب آمال الأسر ذات الموارد المحدودة. هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التحسين وظهور سوقٍ اقتصادي جديد حول تحسين الدرجات، أي من يملك مالا يستطيع أن يحسن ومن لا يملك فله الله، وبهذا نكون خرجنا بالتعليم كحق للمواطنين جميعا إلى حق يقتصر على القادرين لدفع تكاليف التحسين، وبالمثل أيضا القادر فقط هو من يستطيع أن يلتحق بكليات القمة (وش القفص) في الجامعات الخاصة والأهلية وغيرها، أما غير القادر وبنفس المجموع القادر، لا يجد أمامه سوى المعاهد الفنية في المرحلة الثالثة والأخيرة (قعر حقيبة) التنسيق الرسمي بالجامعات. أما الكليات الرسمية استحدثت هي الأخرى برامج مدفوعة ولا يقدر عليها الجميع، فمثلا في كلية تجارة برنامج البنوك نظام الساعات المعتمدة، قسم قد تصل تكاليفه إلى مئة آلاف جنيه في العام ربما لأنه يضمن وظيفة محترمة في البنوك، أما خريج النظام العادي في نفس الكلية قد يضطر إلى العمل في بوفيه البنك ويقدم المشروبات لزميل له في نفس الجامعة ونفس الكلية، لكن الزميل استطاع أن يدفع مصروفات القسم المدفوع.
سادسًا: ماذا نطالب به عمليًا؟ أوجز المقترحات التالية كحد أدنى ضروري للخروج من دائرة التجريب والضياع:
1. منع التعميم الفوري: لا تُطبّق مناهج جديدة أو نظم امتحان على كل المراحل دفعةً واحدة؛ بل تُجرَّب في محافظات محددة لمدّة سنتين على الأقل وتقيَّم نتائجها.
2. خطة انتقالية للمناهج التراكمية: خاصةً للغات، يفرض قانون تنفيذ أن تكون أي تغييرات مصحوبة بجدول زمني انتقالي يضمن تدريس كل مستويات المهارات على مدى سنوات، مع آليات معادلة لطلاب الدفعات المختلفة.
3. تأهيل المعلم قبل التغيير: لا تغيير دون تدريبٍ إلزامي شامل قبل البدء بثلاثة أشهر على الأقل، مع دعم فني مستمر وحوافز مالية.
4. نشر دراسات جدوى وتقارير أثر مالية وتعليمية: كل مشروع كبير (تابلت، مناهج جديدة، نظام امتحان) يجب أن يُرفَق بدراسة جدوى منشورة وتقارير تقييم دورية تتيح المحاسبة.
5. إشراك النقابة والجامعات وأولياء الأمور وخبراء التربية والتعليم والمجالس النيابية المختصة: قرار المناهج وأنظمة الامتحان يجب أن يكون محصنًا بتمثيل حقيقي للمجتمع التربوي لا أن يُفرض من فوق.
6. أولوية لاستدامة المحتوى على التقنية: التقنية أداة لا غاية؛ فبدون مناهج متسقة ومعلمين مؤهلين وبنية تحتية مدرسية أساسية، لن تحقق الأجهزة نتائجها.
إذا لم نخرج من منطق «كل وزير يهدّم نظام السابق ثم يترك كارثة زمنية ومادية» فسنبقى ننتقل بين أسماء مناهج وكتب وشعارات، بينما يدفع الثمن أجيالنا. الإصلاح الحقيقي يتطلّب رؤية تربوية وطنية ثابتة، تخطيطًا تراكميًا، وإدارة رشيدة للمال العام، واعترافًا بأن التعليم ليس تجربةً تسويقية تُغيَّر مع كل حملة إعلامية. فقط بهذا التصويب سنعيد للمدرسة دورها في بناء إنسان قادر على المقاومة والتغيير والإبداع، وإلّا فسنبقى ندوِّر في حلقة التغيير المستمر والتعميم الإجباري ونخسر الوطن والجيل معًا.
-------------------------------
بقلم: هاني منسي
كاتب وناقد وخبير تربوي