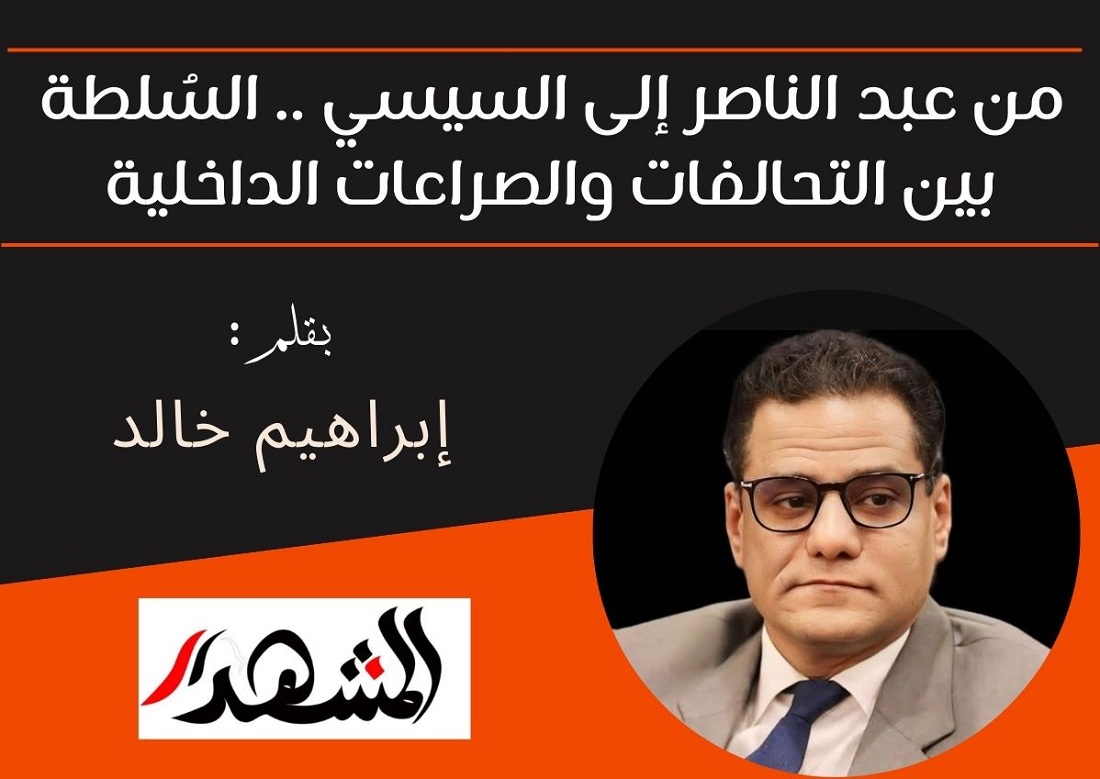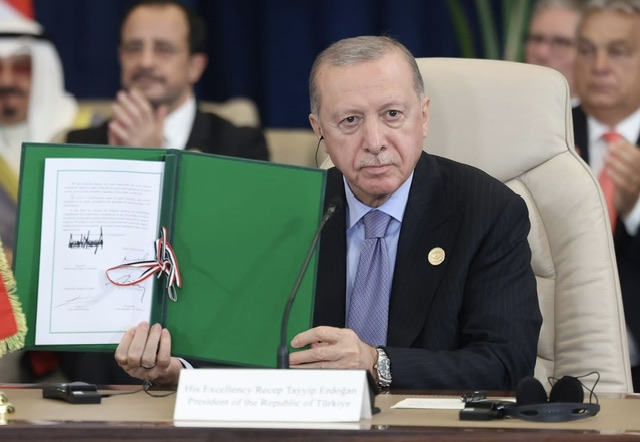لم تكن إدارة الحكم في مصر، منذ ثورة يوليو 1952، مجرد قرارات سياسية أو توجهات أيديولوجية؛ بل كثيرًا ما ارتبطت بأسلوب القيادة في ضبط توازنات القوة داخل النظام نفسه. وعلى مدار العقود، تنوّعت هذه الأساليب بين التحالفات الشخصية، وإثارة الصراعات الداخلية، والرقابة المحكمة على مراكز النفوذ.
اتسم حكم جمال عبد الناصر بتحالف شخصي قوي مع المشير عبد الحكيم عامر، وهو تحالف كان سببًا من أسباب كثيرة أدت إلى نكسة يونيو 1967، ليكون درسًا قرأه السادات جيدًا، لكنه استخدمه بأسلوب مختلف، قائم على ما يمكن وصفه بـ"التفجير الذاتي المنظَّم" داخل النظام، وهو ما ارتد عليه في النهاية، عندما تم اغتياله في أكتوبر 1981.
قدّم الرئيس الراحل أنور السادات نموذجًا لافتًا في إدارة التناقضات داخل السلطة، إذ لم يكن يسعى إلى توافق كامل بين رجاله، بل حرص على خلق توازنات متضادة تُضعف إمكانية التمرد أو التكتل ضده. فإذا اقترب وزير الحربية من المعسكر السوفيتي، جاء برئيس أركان يميل إلى الغرب. استعان بشخصيات مثيرة للجدل مثل صفوت الشريف، وأفرج عن معارضين سابقين مثل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، والصحفي مصطفى أمين – رغم اتهامات التخابر –؛ليستخدمهم في مواجهة الناصريين والماركسيين داخل الجامعات والمجتمع.
حتى في لحظات مفصلية مثل الاستعداد لحرب أكتوبر، استدعى السادات اللواء أحمد إسماعيل من التقاعد، وعيّنه وزيرًا للدفاع، رغم مرضه وخلافه مع الفريق سعد الشاذلي، الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس الأركان، وجمعهما معًا في القيادة. لم يكن الهدف تحقيق تماسك عسكري، بقدر ما كان ضمانًا لعدم بروز قائد يملك قرارًا منفردًا. وعندما وعد السادات قائد الحرس الجمهوري الليثي ناصف، بالإفراج عن المعتقلين (مراكز القوى) بعد أحداث مايو 1971، تراجع عن وعوده؛ ما دفع ناصف إلى الاستقالة.
بين السادات والسيسي، جاء حكم محمد حسني مبارك ليقدّم نموذجًا أكثر هدوءًا في ظاهره، لكنه لم يخلُ من هندسة دقيقة لمعادلات الولاء والتنافس داخل النظام. اعتمد مبارك على شبكة واسعة من مراكز النفوذ؛ أبرزها: جهاز أمن الدولة، والحزب الوطني، وبعض أجنحة رجال الأعمال، لضمان سيطرته على مفاصل الدولة. لم يكن ميّالًا إلى قرارات حادة أو تغييرات مفاجئة، بل فضّل إدارة التوازنات بصمت؛ وهو ما سمح ببقاء نظامه طويلًا، لكنه أدى في الوقت نفسه إلى تراكم الاحتقانات.
أبقى على رموز قوية مثل: صفوت الشريف وحبيب العادلي، مع مراقبة دقيقة لأي صعود محتمل داخل المؤسسة العسكرية. ومع صعود نجله جمال داخل الحزب الوطني، ظهر انقسام مكتوم بين "الحرس القديم" و"الحرس الجديد"، لم يعالجه مبارك، بل استخدمه كأداة لضبط ميزان القوة. لكن هذا النهج، الذي قام على إدارة الجمود بدلًا من تغييره، انتهى بثورة شعبية في يناير 2011، أطاحت بالنظام بعد ثلاثين عامًا من الحكم.
أما الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتبع نمطًا ثالثًا يعتمد على منظومة رقابية صارمة، وتوزيع دقيق للنفوذ، دون تحالفات ظاهرة أو صراعات داخلية معلنة. يسعى لضبط إيقاع الدولة من خلال مؤسسات يضمن ولاءها، بما يمنع نشوء قوى موازية داخل الحكم. لكنه يواجه واقعًا مغايرًا، أزمة اقتصادية حادّة، تصدّعًا في البنية الاجتماعية، وذاكرة وطنية تختزن الكثير من الأسئلة بشأن الحكم والدولة والديمقراطية.
هل يكفي هذا النموذج الرقابي للحفاظ على استقرار الدولة؟
أم أن تجاهل الاحتقان الشعبي، كما حدث مع من سبقوه، قد يؤدي إلى إعادة إنتاج دائرة السقوط ذاتها؟
اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها.
-------------------------
بقلم: إبراهيم خالد