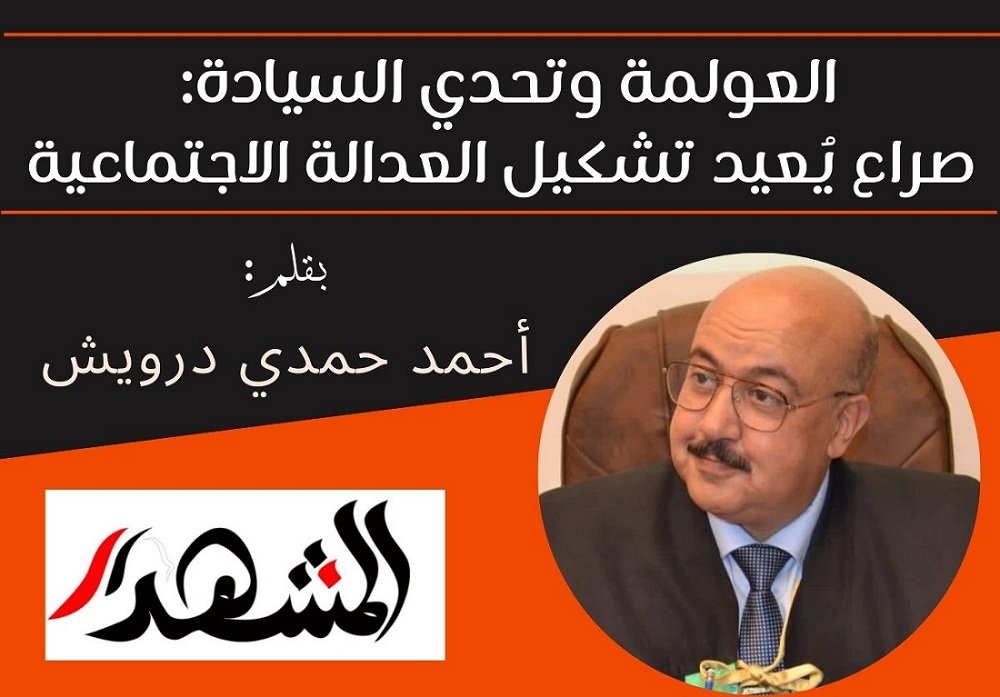بين مطرقة السيادة وسندان العولمة؛ توجد معركةٌ على جسد الإنسان الحديث، والدولة هي اختراع الإنسان لتحقيق العدالة، لكنّها أداةٌ قد تُكسَر أو تتحول إلى شظايا إن استسلمت لقوىً تبتلع سيادتها فتُعيد تشكيل مصائرنا، بهذا التنبُّؤ المُقلِق لخص الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو إحدى الإشكاليات التي يُخيِّم شبحُها اليوم على عصرنا أكثر من أي وقتٍ مضى، حيث الصراع بين سيادة الدولة كحصن منيع ضامنٍ للحقوق وتوزيع الثروات، وقوى العولمة الجارفة التي تعيد رسم الخرائطبتعريفات جديدة للحدود والهُويات مع إعادة توزيع الأدوار على فواعل جديدة.
فلم تعد العولمة مجرد تبادلٍ تجاري أو ثقافي، بل تحولت إلى إعصارٍ يقتلع جذور المفاهيم الراسخة؛ شركاتٌ عملاقة ونيوليبرالية جديدة، تتحكم في اقتصادات دولٍ بأكملها، بينما تُعيد الخوارزميات تشكيل وعي المواطن قبل أن تُعيد الحكومات تشكيل سياساتها، والمؤسسات المالية الدولية تفرض شروطها كما لو كانت قوانينَ سماوية، وحتى الموارد الطبيعية لم تعد ملكاً لأصحابها، بل سُلعةً في سوقٍ يتحكم فيه لوبيهات الاستثمار العالمي..
وفي قلب هذا الإعصار، تُطرَح أسئلةٌ مُلحَّة تُلامس صميم وجودنا؛ كيف تُحافظ الدولةعلى دورها كحامية للعدالة الاجتماعية في عالمٍ تُسيطر فيه "اليد الخفية للسوق" على مقدرات الشعوب؟ وهل يُمكن للأمن الاقتصادي أن يصمد أمام إغراءات الشركات العابرة للقارات، التي تتنقل بين الدول كما تتنقل بين تطبيقات الهاتف؟ وأخيراً، ما مصير دول الجنوب - من نيجيريا إلى بنغلاديش - التي تُشبه ساحاتٍ مفتوحة لهذا الصراع، حيث تُستنزف مواردها تحت شعار "الانفتاح"، بينما تزداد هوةُ اللامساواة عمقاً؟
هذه ليست مجرد أزمة سياسية أو اقتصادية، بل اختبارٌ لماهية الإنسان ذاته؛ هل سيظل المواطن سيداً لقراره، أم سيتحول إلى رقمٍ في معادلة خوارزمية، أو عميلٍ استهلاكي في سوقٍ بلا ضمير؟وهنا في هذا الاشتباك بين السيادة كحق مقدس والعولمة كواقع لا يرحم، تُولد أسئلة القرن الحادي والعشرين المصيرية.
الفصل الأول،
الدولة الحديثة.. بين ميثاق وستفاليا ومُثُل العدالة
في عام 1648، مع توقيع معاهدة وستفاليا التي أنهت حروباً دينية دمَّرت أوروبا، وُلد كيانٌ سياسي غيَّر وجه التاريخ؛ هو الدولة القومية الحديثة، فلم تكن تلك المعاهدة مجرد اتفاق سلام، بل كانت وثيقة ميلاد نظام عالمي جديد، قائم على سيادة مطلقة داخل حدود جغرافية واضحة، وهكذا تحوَّلت الدولة إلى حارسٍ شرعي للعنف، وفق ماكس فيبر، وإلى أداةٍ لتحقيق "العقدالاجتماعي" الذي تحدث عنه جان جاك روسو، حيث تمنح الدولة مواطنيها الأمن والعدالة، ويمنحونها في المقابل شرعيتها وولاءهم.
لكن هذه الصورة المثالية لم تكن مُجرَّدةً أبداً، خاصة في دول الجنوب العالمي، ففي مصر بعد ثورة 1952 التي أنهت الحكم الملكي المُتخندق مع المصالح البريطانية، لم تكن مصر تُقاتل فقط لطرد المستعمر، بل لإعادة تشكيل عقدها الاجتماعي من الصفر، تحت شعار "العدالة الاجتماعية"، فقاد جمال عبد الناصر ثورةً مزدوجة؛ من تحرير الأرض باستخدام العدالة الاقتصادية كسلاح ضد التبعية، وبناء دولة الرعاية الاجتماعية، وهنا كانت السيادة الوطنية تعني التحرر من الاستعمار وبناءالعدالة الداخلية. ولكن.. لماذا انحرفت المسيرة؟
فكما الهند وجنوب أفريقيا، واجهت مصر تناقضات العقد الاجتماعي؛ وتحوَّل القطاع العام من أداةٍ للتنمية إلى بيروقراطية فاسدة، تُدار لخدمة النخب الجديدة بدلاً من الشعب، ثم أعادت سياسات الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، إنتاج الاستعمار عبر بوابة الاستثمار، فبيعت شركات القطاع العام لرأسماليين محليين وأجانب، بينما تراجعت خدمات الصحة والتعليم، ووفقاً لتقرير البنك الدولي (2023)، يعيش 60% من المصريين على أقل من 3 دولارات يومياً، بينما تُهرب الشركات متعددة الجنسيات 45 مليار دولار سنوياً عبر التهرب الضريبي.
ومع انهيار جدار برلين وانزياح القطب الأوحد في التسعينيات، بدأ زلزال العولمة يهز أركان هذا النموذج، فلم تعد الدولة القومية - خاصة في الجنوب العالمي - سيدة قرارها الاقتصادي أو السياسي، وشروط صندوق النقد الدولي القاسية، مثل خصخصة المياه في بوليفيا أو إلغاء دعم الغذاء في مصر، تحوَّلت إلى "عقد اجتماعي معكوس" حيث تُقدِّم الدولة ولاءها للسوق العالمي، وتتخلى عن ضمان حقوق مواطنيها، حتى المشاريع الوطنية التي كانت مصدر فخرٍ، مثل الصناعة الثقيلة في الهند والحديد والصلب في مصر، تحوَّلت إلى أصولٍ تُباع في سوق المزادات العالمية..
وهكذا لم يعد السؤال، هل ما زال نموذج وستفاليا صالحاً؟ بل أصبح؛ كيف ندفن دولةً لم تعد قادرةً حتى على دفن موتاها؟ ففي عصرٍ تُحدِّد فيه شركات مثل "جوجل" و"نستله" سياسات الضرائب والبيئة، وتتحكَّم منصات مثل "فيسبوك" و"إكس" في الرأي العام، تبدو الدولة القومية كعملاق من الطين، يقف عاجزاً أمام أعاصير لم يكن جزءاً من صنعها.فالسيادة الوطنية ليست شعاراً، بل معركة يومية مستمرة، ومصر اختبرت أن الاستقلال السياسي لا يكفي، فالاستعمار الداخلي (الفساد، وترنح العدالة، والتبعية الاقتصادية) قد يكون أقسى من الاستعمار العسكري، لكن التجربة تثبت أن "العقد الاجتماعي" ليس حلماً، بل خياراً ممكنًا، حيث تُصبح السيادة الوطنية سلاحاً لكتابةعقدٍ اجتماعي جديد، لا يكرر أخطاء الماضي، بل يبني مستقبلاً لا يُفرِّط في العدالة، حتى لو اختلفت الوسائل.
الفصل الثاني،
العولمة.. تفكيك الحدود وإعادة تشكيل النفوذ
العولمة لم تكن مجرد تدفقٍ للسلع ورؤوس الأموال، بل كانت ثورة في مفهوم السيادة، أفرغت سيادة الدولة من مضمونها، ففي مصر، تحولت قصة العولمة من سردية اقتصادية إلى ملحمة درامية تكشف كيف تُستبدل السيادة الوطنية بوهم الانفتاح، بينما تُسرق الثروات وتُدفن الأحلام، فخلال أزمة الطاقة العالمية 2022، صدَّرت الشركات الأجنبية المتحكمة في 70% منانتاج الغاز المصري، الطاقة إلى أوروبا بأرباحٍ خيالية، بينما عانت مصر من انقطاعات كهرباء متكررة بسبب نقص الإمداد المحلي، واضطرت الحكومة المصرية لاستيراد الغاز بأسعارٍ أعلى من تلك التي باعته بها، مُكرِّسةً دورة الفقر الطاقوي. كما حوَّلت منصات مثل "أوبر" و"كريم" آلاف السائقين المصريين إلى عبيدٍ رقميين، فتستحوذ الشركات على 25% من أجرة كل رحلة، بينما يدفع السائقون تكاليف الصيانة والوقود من جيوبهم، ووفقًا لتقرير "مركز الأرض لحقوق الإنسان"، يعيش 70% من سائقي التطبيقات تحت خط الفقر، دون تأمين صحي أو معاش، فالعولمة هنا لا تعني "التقدم التكنولوجي"، بل استغلالٌممنهج يُحوِّل البشر إلى أرقام في تطبيق.
وفي 2021، أطلقت الحكومة المصرية منصة "ذاكر" التعليمية بالشراكة مع "مايكروسوفت"، لكن الثمن كان تسليم بيانات 23 مليون طالب إلى خوادم الشركة في الولايات المتحدة، والنتيجة؛ تحوَّل الطلاب إلى منتجاتٍ رقمية تُباع بياناتهم لشركات الإعلانات، وفشلت المنصة في تحقيق العدالة التعليمية، حيث حُرِم 60% من طلاب الريف من استخدامها بسبب انعدام الإنترنت.
مصر ليست دولةً فاشلة، بل ضحيةٌ لنظام عالمي يُعيد إنتاج التبعية عبر آلياتٍ أكثر دهاءً من الاستعمار التقليدي، والعولمة هنا لا تعني "التكامل"، بل الاختراق، فالمواردتُنهب باسم "الاستثمار"، والسياسات تُكتَب في واشنطن، والمواطنون يُحوَّلون إلى مستهلكين وعبيد رقميين. ولكن العولمة أيضاً حملت تناقضاتها، فبينما سمحت لبعض دول الجنوب - مثل سنغافورة - بالاندماج في السوق العالمي والازدهار، فإنها عمَّقت الفجوات في دول أخرى، فوفقاً لجوزيف ستيجليز؛ أدت شروط صندوق النقد الدولي (الخصخصة وتقليل الإنفاق الاجتماعي) إلى إفقار ملايين في الأرجنتين وتركيا ومصر، مما أثار تساؤلات حول شرعية التدخل الخارجي في السياسات الوطنية.
الفصل الثالث،
صراع الهويات.. السيادة أم البقاء؟
الصراع بين السيادة والعولمة ليس مجرد نزاعٍ سياسي، بل هو زلزالٌ يُعيد تشكيل مفاهيمَ ظلت راسخةً لقرون، ففي مختبر هذا العصر، تذوب الحدود بين "الدولة" و"السوق"، وتتصادم قيمٌ كان يُظنُّ أنها ثوابت؛ فكيف تُمسك الدولة بمطرقة السيادة - كفرض رسوم جمركية لحماية صناعاتها الناشئة - دون أن تُحطم يدها نفسها بعزلةٍ اقتصادية؟ إنها معادلةٌ أشبه بالسير على حبل مشدود فوق بركان.
وفي مصر، يتجسد الصراع بين السيادة الوطنية وضغوط العولمة في مشهدٍ درامي يُعيد تعريف مفاهيم الحكم والحرية والعدالة، فعندما وقَّعت مصر على اتفاقية صندوق النقد الدولي عام 2016 (بقرض 12 مليار دولار)، لم تكن توقع على ورقةٍ مالية، بل على تنازلٍ عن سيادتها الاقتصادية، بشروط قاسية تضمنت؛ تحرير سعر الصرف، الذي تسبب في انهيار الجنيه بنسبة 300%، مُحوِّلاً حياة 30 مليون مواطن تحت خط الفقر إلى جحيمٍ يومي، وخصخصة قطاعات حيوية مثل الكهرباء والنقل، حيث اشترت شركة "سيمنس" الألمانية حصصاً في شبكات الكهرباء المصرية، بينما ارتفعت الأسعار على المواطنين بنسبة 40%، وهنا تحولت "السيادة" إلى كلمة فارغة، بينما تحكمت "اليد الخفية" للسوق العالمي في مصير الشعب، وكأنما مصر تُدار عبر الأسواق المالية.
وهل يجوز التدخل الحكومي أم أن حريةالسوق تحول دون ذلك؟ فمن يملك الحق في تشريح جسد الاقتصاد؟ فهل يحق للحكومة أن تستخرج - عبر ضرائب تصاعدية - جزءاً من ثروة الأغنياء لتمويل مستشفيات الفقراء؟ أم أن هذا انتهاكٌ لمقدسات الرأسمالية (حرية التملك والاستثمار)؟ ففي 2023، أقرت الحكومة المصرية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على سلع أساسية (مثل الأرز والسكر)، بينما خفضت الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات من 40% إلى 22.5%، والنتيجة؛ تضاعفت معاناة الفقراء، بينما ازدادت أرباح شركات مثل "فودافون" و"أوراسكوم" بنسبة 30%، وفقاً لتقارير البورصة المصرية، وكذلك ارتفعت رسوم الجامعات الخاصة (المُدارة بشراكات أجنبية) إلى 10 أضعاف، بينما تدهورت جودة التعليم الحكومي، مما حوَّل "الحقفي التعليم" إلى امتيازٍ للطبقة العليا، فهذه ليست سياسات اقتصادية، بل إعادة هندسة اجتماعية تُكرس الفوارق الطبقية، وتُحوِّل المواطن العادي إلى وقودٍ لآلة العولمة.
ورغم هذا المشهد القاتم، تظهر ومضات أمل، ففي قطاع الطاقة المتجددة، حاولت مصر الموازنة بين الانفتاح والعدالة؛ حيث مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية (الأكبر عالمياً) بتمويلٍ ألماني صيني، لكن مع اشتراط توظيف 80% من العمالة المحلية، ونتيجة المشروع؛ توفير 20% من حاجة مصر للكهرباء، مع خلق 10 آلاف فرصة عمل، هنا أثبتت مصر أن الصراع بين السيادة والعولمة ليس مجرد جدال أكاديمي، بل معركة يومية على الخبزوالكرامة، والتوازن ممكن لكنه يحتاج إرادةً سياسية للقدرة على تحويل عوائد الانفتاح إلى رصيدٍ اجتماعي.
فهي ليست معادلةً لوغاريتمية، بل معركة إرادات، فبينما تُجيد النخبُ السياسية في الشمال العالمي لعبةَ "التنازل المُربح" (مبادلة التنازلات السياسية بمكاسب اقتصادية)، تدفع شعوب الجنوب العالمي ثمناً من دمائها، فكلَّما ارتفع مؤشر البورصة، انخفض مؤشر الكرامة الإنسانية، وهنا يصبح السؤال: هل نُصلح النظام العالمي بدمج العدالة في معادلاته، أم أن "التعافي" - ذلك الشعار البرَّاق - مجرد غطاءٍ جديد لاستعمارٍ أشدّ فتكاً؟.
الفصل الرابع،
الجنوب العالمي.. ساحة معركة العولمة
ليست دول الجنوب مجرد متفرجٍ على صراع السيادة والعولمة، بل هي ساحة المعركة الأكثر دمويةً، حيث تُختبر نظريات الاقتصاد السياسي على جسد شعوبٍ حية، وثلاث سماتٍ تجعل منها مختبراً مفتوحاً لهذا الصدام:
- الهشاشة المؤسسية؛ فهي الفريسة التي تُغري الذئاب بالاقتراب، فليست المؤسسات الضعيفة في دول الجنوب مجرد خللٍ إداري، بل هي كسرٌ استراتيجي في جدار السيادة، فحين يتم إعداد موازنة الدولة في مصر وفقاً لشروط صندوق النقد الدولي، وليس وفقًا لأولويات الشعب، حيث خُصص أقل من 8% فقط للصحةوالتعليم، بينما خُصص 25% لسداد الديون الخارجية (وفقاً لتقرير البنك المركزي 2023)، يصبح "القرض الدولي" مجرد غطاءٍ لاستعمارٍ جديد، وتحوَّلت مؤسسات الدولة إلى واجهة لتطبيق الأجندة الدولية، فوزارة التضامن الاجتماعي - مثلاً - تُنفق على برامج تعويضية هزيلة (مثل "تكافل وكرامة")، بينما يُهمش دورها الأساسي في ضمان العدالة الاجتماعية، ومن ثمة تُحوِّل الحوكمة إلى مسرحية هزلية، تُوزَّع أدوارها من واشنطن وبروكسل.
- التبعية الاقتصادية؛ فاعتماد الدولة على تصدير المواد الخام يجعلها رهينة لتقلبات الأسعار العالمية، وتصدير مصر للبترول الخام يجعلها سجينة سلسلة القيمة العالمية، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذيكان مأمولًا له إنقاذ الاقتصاد المصري فكان واقعه مريرًا، بسبب شروط عقود الشركات الأجنبية (مثل "إيني" الإيطالية و"شل" الهولندية) التي تمنحهما 70% من الأرباح، وتسمح لهما ببيع الغاز المصري في السوق العالمي بأسعار مضاعفة، وحين ارتفعت أسعار الغاز عالمياً بسبب حرب أوكرانيا، باعت الشركات مخزون مصر (بدلاً من تلبية احتياجات السوق المحلي)، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء صيف 2023، وزيادة فاتورة الاستيراد مجدداً. بينما قناة السويس شريان التجارة العالمي، فالشركات الأجنبية (مثل "الموانئ العالمية DP") التي تُسيطر على موانئ مصرية مجاورة للقناة، تستحوذ على 70% من أرباحها، وفقاً لتقارير "الشبكة العربيةلمعلومات حقوق الإنسان"، وكذلك يسيطر سادة العالم على القمح، فتحوَّل الأمن الغذائي - وهو حقٌ أساسي - إلى سلعةٍ يتحكم فيها السوق العالمي، بينما تُركت الزراعة المحلية تموت بسبب شروط صندوق النقد من إلغاء دعم المزارعين، وهذه التبعية ليست حظاً عاثراً، بل جريمة مُخطَّط لها، جعلت من مصر ودول الجنوب عامة "بنوكاً متنقلة" لتمويل رفاهية الشمال.
- التأثير الاجتماعي؛ حين يُصبح الفقر سياسةً مُتعمَّدة، فوفقاً لتقرير الأمم المتحدة (2023)، حوّلت سياسات التقشف في مصر - التي فُرضت تحت ذريعة "الإصلاح الاقتصادي" - المجتمع إلى غابةٍ من التناقضات؛32% من السكان تحت خط الفقر، بينما تزداد ثروة الطبقة العليا بنسبة20%، وهذا ليس خللاً في التوزيع، بل إعادة إنتاجٍ مقصودةٍ للعبودية، حيث يُصبح المواطنُ خادماً لأسواق الاستهلاك، ومُستنزَفاً حتى النخاع.
لكن التاريخ لا يسير في اتجاه واحد، ففي تشيلي - التي كانت تُعتبر "النمر الاقتصادي" لأمريكا اللاتينية - انفجر بركان الغضب الشعبي عام 2019، محطماً نموذجاً نيوليبرالياً عمره 30 عاماً، ولم تكن الاحتجاجات مجرد رفضٍ لزيادة أجور المواصلات، بل هزّةٌ وجودية ضد عقدٍ اجتماعي بائد، حيث قرر الشعب أن يكتب بنفسه دستوراً جديداً، يُحوِّل النمو الاقتصادي من هدفٍ دولي مقدس إلى وسيلةٍ محلية لتحقيق العدالة. وهنا، في هذا التناقض بين الاستنزافوالمقاومة، تكمن مفارقة العصر؛ فدول الجنوب العالمي، قد تحمل مشعل التغيير العالمي، وينتظر العالم الآن ما سيكتبه شباب تشيلي وسنغافورة وبوينس آيرس، فهم يرفضون أن يكونوا وقوداً لآلة لم يختاروها.
الفصل الخامس،
المستقبل: السيادة المرنة.. أم الفواعل غير الدول
السنوات القادمة لن تكون مجرد صفحةٍ جديدة في كتاب التاريخ، بل حرباً باردةً تُحدد مصيرَ مَن يملك الحق في تشكيل العالم، وأمام دول الجنوب خياران مصيريان، كلاهما يحمل في طياته إما بصيص أمل أو شبح كارثة:
السيناريو الأول: "السيادة المرنة".. عندما تتعانق التكنولوجيا مع كرامة الإنسان، هنا ترفع الدولة شعار "ننفتح على العالم، لكننا لا ننكسر أمامه"، فرواندا - التي تحوَّلت من مذبحة الإبادة الجماعية عام 1994 إلى وادي سيليكون أفريقيا - تقدم نموذجاً ملهماً، حيث السيادة تُبنى بدمج الذكاء العالمي مع العدالة المحلية، فبينما تجذب الاستثمارات التكنولوجية العملاقة (مثل بناء مصانع الذكاء الاصطناعي)، تحتفظ ببرامج حماية اجتماعية صارمة، من تأمين صحي مجاني لأصحاب الدخل المحدود، ومنح دراسية في القرى النائية، والسيادة هنا ليست أسواراً عالية، بل شبكة ذكية تلتقط الفرص العالمية وتُرشحها عبر مصفاة العدالة الاجتماعية.
السيناريو الثاني: إعادة البناء بالوهم الذي يخفي استعماراً رقمياً، فتحت ذريعة مساعدة الدول على النهوض من أزماتها، تتحول الشركات العابرة للقارات ومنظمات التمويل الدولية إلى أوصياء جدد على مقدرات الشعوب، والصورة ليست مُبالغاً فيها، فصندوق النقد الدولي هو المهندس الخفي للسياسات المصرية، ووفقاً لتقرير "المركز المصري للدراسات الاقتصادية"، تحوَّلت مصر إلى حقل تجارب لسياسات الصندوق، فضلًا عن سارقي الذهب الأسود والذهب الأزرق. والأسوأ أن الاستعمار الجديد لا يحتاج إلى دبابات، بل يكفيه السيطرة على البيانات والموارد، كما في كينيا، حيث تبيعالحكومة بيانات المواطنين لشركات التأمين العالمية لتحديد أسعار الخدمات، وكذلك عندما أطلقت الحكومة المصرية منصةً إلكترونية لخدمات المواطنين بالشراكة مع "مايكروسوفت"، كان الثمن تسليم بيانات 100 مليون مواطن لخوادم الشركة في الولايات المتحدة، ووفقاً لتقرير منظمة "الخصوصية العالمية، Privacy International. تُستخدم هذه البيانات من قبل شركات التسويق العالمية لتوجيه الإعلانات، بينما تُحرم مصر من استثمارها في بناء ذكاء اصطناعي محلي، أما السيطرة على الموارد فالأمثلة بشركات النفط والغاز العابرة للقارات في مصر تكفي..
والخطير في هذا السيناريو الأخير هو أنه يُقدَّم كشر لابد منه للتعافي الاقتصادي، بينما هو في الحقيقة إعادة إنتاج للاستعمار بمهندسي النظام العالمي الجديد (الفواعل غير الدول) ومصر هنا ليست دولة فاشلة، بل دولة مُفككة بفعل التعاقدات الدولية، حيث تُباع سيادتها قطعةً -قطعة، وهكذا تُختزل مصر من دولةٍ ذات تاريخٍ عريق إلى "رقم في محفظة استثمارية"، بينما تُصَفِّق النخبُ المحلية للنهب المنظم، وتُستبدل الرايات الاستعمارية بشعارات برَّاقة مثل "الإصلاح" و"الشراكة العالمية"، و"التنمية المستدامة".
الخاتمة،
ثورة أم إصلاح؟ حين يصير السؤالَ وجودك ذاته
ليست المسألة مجرد خيار بين إصلاحنظامٍ متهالك أو إشعال ثورة، بل هي استحقاقٌ وجودي يُحدد مَن سنكون بعد قرنٍ من الآن؛ أحفادَ شعبٍ اختار أن يُدافع عن كرامته، أم أرقاماً في سجلٍّ استعماري جديد، والصراع بين الدولة والعولمة ليس جدالاً في ندوات الفكر، بل هو حربٌ على جثث الفقراء تُدار في مكاتب "وول ستريت" وقاعات "دافوس"، حيث تُباع سيادة الشعوب كسلعةٍ في سوق المزادات. وأمام شعوب الجنوب العالمي طريقان؛ إما قبول التبعية لمراكز القوى الجديدة، والخضوع لأمركة العالم أو "صيننته"، حيث تُصبح مجرد سوقٍ استهلاكي أو ساحةٍ لتصفية الحسابات بين العملاقين، وهنا تُدفن العدالة تحت أنقاض "الاستثمارات الأجنبية"، ويُصبح المواطن خادماً رقمياًفي منصات التوصيل، أو مُستنزَفاً في محاجر الرمال السوداء.
الطريق الثاني؛ هو إعادة ابتكار نموذج سيادة يعترف بالترابط العالمي دون التفريط في العدالة، كما فعلت كوبا حين حوَّلت الحصار إلى فرصةٍ لبناء أقوى نظام صحي في أمريكا اللاتينية، أو فيتنام التي هزمت الاستعمار الفرنسي ثم الأمريكي، والآن تُهزم شروط صندوق النقد بإنهاض زراعتها المحلية. فالعالم لن ينتظرنا، وكما قال عالم الاجتماع البريطاني من أصل هندي، أمارتياصن: "الحرية ليست أن تملك طبقاً من الأرز، بل أن تختار مَن يزرعه، ومَن يأكله".
هذا المقال ليس مجرد سؤالٍ فلسفي، بل صرخةٌ في وجه كل مَن يستطيع أن يسمع: هل نرضى بأن نكون "شعوباً للاستئجار" في عصر العولمة، أم نصنع عالماً لا يُكرِّس القهر بل يدفن جذوره؟ والنقاش ليس ترفاً.. إنه الباب الأخير للعدالة قبل أن يُغلق.
-----------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش