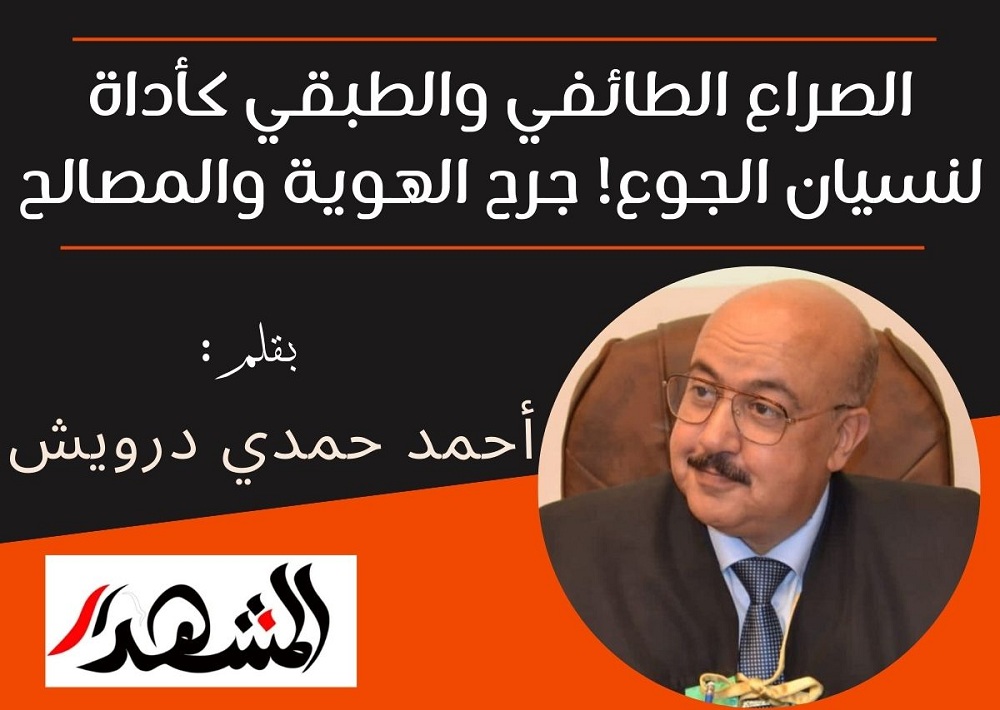قصتان تعبران عن شرائح من واقع مرير تكشفُ عُري المجتمع.. الأولى قصة ياسين الطفل، تختزل مأساةٌ فرديةٌ أزمةً هويةٍ جمعية، حيث تتحول جريمةٌ بشعةٌ إلى مرآة تعكس شرخًا طائفيًّا متجذرًا، وعلى الجانب الآخر، القصة الثانية حيث تتحول قاعة البرلمان إلى ساحة صراعٍ مصغرةٍ بين ملاك ومستأجرين، تكشف عن مجتمعٍ يلهث وراء المصلحة الفردية كأنما العدالة ضريبةٌ لا يُطيق دفعها..
هاتان الحكايتان ليستا منفصلتين، بل هما وجهان لعملة واحدة: تحولاتٌ نفسيةٌ واجتماعيةٌ عميقةٌ أعادت تشكيل العقل الجمعي المصري.
فبينما كان ياسين الصغير يلهو في فناء المدرسة، لم يكن يعلم أن يدًا ستُسلَب منه براءته قبل أن تُسلَب لعبته، فيتحوَّل الضحيةُ الصغير إلى رمزٍ لصراع تعصب بين "نحن" و"هم"، وعلى بعد أميالٍ من تلك المدرسة، تتكرَّر المأساةُ بلغةٍ أخرى؛ نوابٌ يتصارعون في قاعة البرلمان كأنهم في حلبة مصارعة، ليس عن العدالةِ يختصمون، بل عن إيجاراتٍ تتحوَّل إلى سكاكينَ تقطعُ أواصر التضامن الاجتماعي.
هنا في مصر، لم يَعُد الشرخُ بين مسلمٍ ومسيحيٍّ مجرد خلافٍ ديني، ولم يَعُد الصراعُ بين مالكٍ ومستأجِرٍ معركةً اقتصاديةً عابرة، هذان المشهدان هما انعكاسٌ لتحوُّلٍ وجوديٍّ، لمجتمعٌ كان يومًا ما يُغنّي "أنا المصري كريم العنصرين"، صار اليوم يُعيد إنتاجَ عنفه بطريقتين؛ إما بالتعصُّبِ الذي يُحوِّل الإنسانَ إلى وحشٍ طائفي، أو بالأنانيةِ التي تُحوِّل القلبَ إلى حجر.
كيف وصلنا إلى هنا؟ هل فقدنا إنسانيتنا لأن الفقرَ أكل أحلامنا، أم لأن الخوفَ من "الآخر" شُربَ في دمائنا جيلًا بعد جيل؟ الأسئلةُ مُرعبة، لكن الأكثر إرهابًا أن الإجابةَ ليست في كتب الفلسفة، بل في هاتين القصتين: طفلٌ تُذبحُ براءته، وشعبٌ يُذبحُ ضميره.
الفصل الأول: التشريح النفسي للتعصب
- الصدمة والذاكرة الجمعية:
العنف الجنسي ضد ياسين ليس مجرد جريمة، بل صدمةٌ تُفعِّل ذاكرةً تاريخيةً من التوتر الطائفي، ووفقًا لنظرية "الصدمة الجمعية" (جيفري ألكساندر)، تتحول الأحداث الفردية إلى رموزٍ تُستدعى لتعزيز الهوية الجماعية، حيث يستيقظ الماضي الدامي من سُباته كشبحٍ يطارد الحاضر، ويمثل "رصاصةٌ رمزية" بحسب نظرية الصدمة الجمعية تُطلَقُ عمدًا لتفجير الغضب المكبوت، وهنا تُستغل الجريمة - بوعي أو لاوعي - لترسيخ الانتماء الطائفي، حيث يصبح "الآخر" المسيحي تهديدًا وجوديًّا للمجموع المسلم، في عمليةٍ من "التَشيُّؤ" (حنة آرندت)، تُجرد الفرد من إنسانيته لتصويره كعدو. هذه اللعبة الخبيثة لا تتوقف عند حدود الدين؛ إنها عمليةٌ مُمنهجةٌ لسرقة الإنسانية - كما تحذِّر حنة آرندت - حيث تُختزَل المديرة المسيحية إلى مجرد "فكرةٍ شيطانية"، تُجرَّد من أي بُعدٍ إنساني؛ أمٌ ربما، أو أبُ، أوصديقٌ، أو مواطنٌ شارك ذات يومٍ في بناء الوطن، ولكن في ظل الصدمة الجمعية، لا مكان لهذه التفاصيل، فالغضبُ الجماعي يحتاج إلى عدوٍّ بلا وجه، لا إلى إنسانٍ من لحمٍ ودم..
- الاقتصاد وغريزة البقاء:
في نزاع الإيجارات، يتحول القانون إلى ساحة حربٍ طبقية، تفسر "نظرية التدرج الاجتماعي" (علم النفس الاجتماعي) كيف تدفع الأزمات الاقتصادية الأفراد إلى تبني سلوكياتٍ عدوانيةٍ لحماية مواردهم، عندما يصل الفرد إلى حافة الفقر (حسب ماسلو)، تنهار قيم التضامن، وتسيطر "أخلاقيات البقاء" (زيجمونت باومان)، حيث تُقدَّم المصلحة الفردية على أي اعتبار أخلاقي. وهذا ما يفسر كيف حَوَّلت أزمة الإيجارات المصريين إلى ذئابٍ تفترس بعضها؟! فليست معركة الإيجارات مجرد نزاعٍ بين جدران المحاكم، بل هي حربٌ اقتصاديةٌ مفتوحة تُعلِنُ انهيارَ آخرِ جسورِ التضامن الاجتماعي، فتحت ذريعة "الدفاع عن الحقوق"، يتحوَّل الجارُ إلى غريم، والصديقُ إلى خصم، وكأنما القانون -الذي وُضِع لإنصاف الضعفاء - صار أداةً لذبحِ الفقير بأيدي الفقير! وهنا، تُجيبنا "نظرية التدرج الاجتماعي" بلغةٍ قاسية: حين يُحاصَر الإنسانُ بجوعِه (كما يصف ماسلو)، لا يعود يرى في مَن يجاوره إلا منافسًا على لقمة العيش، فيُحوِّل شقته المتواضعة إلى قلعةٍ يُدافع عنها بأنيابِه وأظافره.
هذا ليس مجرد صراعٍ على أربعة جدران، بل انتحارٌ جماعيٌ لأخلاقِ مجتمعٍ بأكمله، حيث تُطبَّق "وصفة زيجمونت باومان" للبقاء في عصر العولمة؛ "اقتَلْ أو تُقتَل"، فالمواطن الذي كان يُقسِم بالأمس أن "العرق لا يُخضَب بالدم"، يجد نفسه اليوم يُلطِّخ يديه بكشف ستر جاره، او حتى بدمائه ليس لأنه شرير، بل لأن النظام الاقتصادي حوَّله إلى وحشٍ جائعٍ يشم رائحة المال في دماء الضعفاء.
الفصل الثاني: الخفايا السياسية والبنى الخفية
- الاستقطاب كأداة حكم:
تاريخيًّا، استخدمت الأنظمة السياسية سياسة "فرق تسد" لإدارة المجتمع، فالصراع الطائفي والإيجاري يشتت الانتباه عن إخفاقات الحوكمة، مثل الفساد وعدم الكفاءة الاقتصادية، وهنا تُحوَّل الطاقة الغاضبة للجمهور من مطالبته بالحقوق إلى صراعاتٍ جانبية، في إستراتيجيةٍ تُعرف باستراتيجية "الإلهاء السياسي" (نعوم تشومسكي).وليست استراتيجية "فرِّق تَسُد" مجرد خُطّةٍ سياسيةٍ عابرة، بل هي لعبةُ عروشٍ ملوَّثةٍ بدماء الشعب، لُعبتها الأنظمةُ المصريةُ المفضلةُ منذ عهد الفراعنة! فكلما اشتدت الأزماتُ وارتفعت أصواتُ الغضب، تُلقى ورقةٌ طائفيةٌ هنا، وورقةٌ إيجاريةٌ هناك، كأنما الشعبُ قطيعٌ يُلهى عنه بصراعاتٍ مصطنعةٍ بينما يُسرَقُ آخرُ ما تبقى في جيوبه. فالصراعُ الطائفي والإيجاري ليس سوى دخانٌ أسودُ يُطلق عمدًا لتحويل أنظار المصريين عن وحشٍ حقيقيٍّ يلتهم مستقبلهم: فسادٌ يُنهش جسد الدولة، واقتصادٌ يعاني من انفصام في الشخصية، وحُكامٌ يتبارون في إتقان دور "الساحر الماهر في خفة اليد وأنت تَصفق" فذلك هو الإلهاء السياسي..
وهنا تُصبح الطاقةُ الغاضبةُ للشعب - التي كان يمكنها أن تُغير - مجرد ألعاب ناريةٍ زائفة تُضيء سماءَ النظام ليلًا، بينما هو يستعد لألعاب سحرية جديدة في وضح النهار، فالفتنةُ الطائفيةُ والطبقيةُ ليستا "خطأً" في الحسابات، بل معادلةٌ مُحكَمة لتحويل المواطن من مُطالبٍ بحقوقه إلى جنديٍّ مجنونٍ في حروبٍ لا ناقة له فيها ولا جمل!..
- الإعلام وتضخيم الهويات:
يلعب الإعلام - عبر خطابٍ تحريضيٍّ أو انتقائيٍّ - دورًا في تعميق الانقسامات، فتغطية حادثة ياسين قد تُبرز البُعد الطائفي (متجاهلةً عوامل كالفساد الإداري)، بينما يُصوَّر نزاع الإيجارات كمعركةٍ بين "الأغنياء" و"الفقراء"، مما يعزز الانقسام بدلًا من البحث عن حلولٍ عادلة .الإعلام هنا ليس ناقلًا للأخبار، بل مُصنعٌ محترفٌ للواقع المُزيَّف، يُديرُ معملَ كيمياءٍ خبيثًا يحوِّل جرحَ طفلٍ إلى سمٍّ طائفيٍّ، وشقّةً متداعيةً إلى ساحة حربٍ طبقية! ففي قضية ياسين، تتحوَّل الكاميراتُ إلى سكاكين إعلامية تُجرح الذاكرة الجمعية، فتُكبِّرُ لقطةَ "المسيحي المجرم" وتُصغِّرُ صورةَ "الفساد المُؤسسي" إلى درجة الاختفاء، وكأنما السؤال الحقيقي هو؛ "هل الإعلام هنا مرآةٌ تعكس الواقع أم عدسةٌ مشوّهةٌ تصنعه؟"..
أما في معركة الإيجارات، فالقنواتُ تتبارى في تحويل النزاع إلى مسرحيةٍ درامية؛ فتُصوِّر المالكَ كتمساحٍ رأسمالي والمستأجِرَ كضحيةٍ فقيرة، وكأنما العدالةُ مجرد حلبة مصارعةٍ يُشعلها الإعلام ليربح رهانَ المشاهدات! الغائب الأكبر هنا هو الحقيقةُ المُركَّبة؛ فالمالك قد يكون مواطنًا متوسط الحال خائفًا على مستقبله، والمستأجِر قد يكون محتالًا يستغل القانون، والعكس بالعكس، لكن الإعلام يرفض هذه التفاصيل لأنها لا تُشعل السوشيال ميديا... وهكذا، يُصبح الإعلامُ شريكًا في جريمةِ تقسيم الوطن إلى قبائلَ متناحرة، حيث تُقدَّم الحقائقُ على طبقٍ من ذهبٍ للمُشاهد، لكن الذهبَ مغطى بسمٍّ بطيءٍ اسمه "الكراهية المُرَكَّزة"!
الفصل الثالث: التشابك بين الفلسفة والواقع
- أزمة الأخلاق في عصر الرأسمالية المتوحشة:
تحليلٌ فلسفيٌّ (بحسب سلافويجيجك) يشير إلى أن الرأسمالية الحديثة تنتج "لا أخلاقيةً نظامية"، حيث يُقدَّس النجاح المادي، وتُهمَّش القيم الإنسانية، وفي مصر أدت السياسات الاقتصادية الليبرالية المتسرعة إلى تفاقم الفقر، مما حوَّل المجتمع إلى سوقٍ تنافسيٍّ قاسٍ، تُختزل فيه العلاقات الإنسانية إلى معاملاتٍ مادية .فلم تعد الرأسمالية مجرد نظامٍ اقتصادي، بل أصبحت "دينا جديدا" بآلهةٍ من ذهب، كما يحذّر الفيلسوف سلافويجيجك، ففي عصرها الحديث، صارت اللا أخلاقيةُ نظامًا مُقدسًا؛ حيث تُسحقُ القيمُ تحت أقدام "عجلة النمو"، ويُحوَّل الإنسانُ إلى سلعةٍ تُعرض في سوبر ماركت الحياة! مصر هنا ليست استثناءً، بل مختبرًا مفتوحًا لهذا الكابوس؛ سياساتٌ اقتصاديةٌ متسارعةٌ - كفزاعةٍ رأسمالية - حوّلت الشوارعَ إلى غابةٍ يتبارى فيها الجياعُ على فتات أحلامهم، بينما تذوب روابطُ الدمِ والجيرةِ في حمضِ الأنانية..
والنتيجة؟ مجتمعٌ يتحوَّل إلى "سوقٍ سوداء" تُباع فيه المشاعرُ والعلاقاتُ بأرخص الأثمان، ولم يَعُد الجارُ جارًا، بل منافسًا على لقمة العيش، والصديقُ لم يَعُد إلّا زبونًا محتملًا في معرض المصلحة، وحتى الحبُّ صار صفقةً استثماريةً تُقاس بموازين البنك الدولي! هنا تتحقّق نبوءة جيجك المرعبة: "الرأسمالية لا تنتج سلعًا فقط، بل تنتج بشرًا بلا روح"..
- العدالة كضحية للذاكرة المثقوبة:
الفيلسوف جون رولز يرى أن العدالة يجب أن تُبنى على "جهلٍ بأوضاعنا الاجتماعية"، لكن الواقع المصري يعكس "عدالةً انتقائيةً"، حيث تُطبَّق القوانين بتفاوتٍ طائفيٍّ أو طبقي، وهذا يخلق شعورًا بالظلم المتراكم، يدفع الأفراد إلى تبني تعصباتٍ كآلية دفاعٍ نفسية. فكيف بهذه "العدالة المُقنَّعة" أن حوَّلت الظلمُ للمصريينَ إلى سجَّاني أنفسهم؟!
تخيَّل لو أن القضاةَ يحكمون بين الناس وهم معصوبي الأعين، لا يعرفون من هو الغني أو الفقير، المسلم أو المسيحي، كما يطمح جون رولز في عدالته المثالية، ولكن في مصر، تُرفَعُ العصابةُ عن عيون العدالة لتصبح "مُصفِّحة هويات" قبل إصدار الأحكام! فالقانون هنا ليس ميزانًا، بل سكينٌ ذو حدين؛ يقطعُ لصالح الأقوى دينيًّا أو طبقيًّا، بينما يُترك الضعفاءُ ينزفون أحلامًا مُجهَّضة.. وهذا التفاوتُ ليس خطأً عابرًا، بل "مؤامرة صامتة" تدفع المظلومين إلى تبني التعصُّب كدرعٍ نفسيٍّ ضدّ عالمٍ يرفض إنصافهم، فالمسيحيُّ المقهور يلتحفُ بطائفيته خوفًا من انقراض هويته، والفقيرُ المحاصرُ يتحوَّل إلى وحشٍ طفيليٍّ بعد أن سرقوا منه حتى حقه في الحقد! هكذا يُنتِج الظلمُ المُمنهجُ أجيالًا مشوَّهةً، تحملُ قلوبًا مليئةً بالشكِّ كأنما العدالةُ نفسها "لعبةٌ مُزوَّرة" في كرنفال السلطة..
النهاية: نحو استعادة الإنسانية المشتركة
الخروج من هذا النفق المظلم ليس مستحيلًا، لكنه يحتاج إلى "زلزالٍ أخلاقي" يهزُّ أساسات النظام القديم، وإعادة بناء "العقد الاجتماعي" (روسو)، ليست مجرد حبرٍ على ورق، بل على أسسٍ جديدة بمثابة إعلانُ حربٍ على الوحوش التي تنام في أعماقنا:
- عدالة مؤسسية؛ محاسبةٌ تُجرد الجناة من أرديتهم الطائفية والطبقية، كمحاسبة الجناة في جرائم مثل حادثة ياسين بغض النظر عن انتماءاتهم، وإصلاح قوانين الإيجارات لتحقيق توازنٍ مصلحي، يُعيد للفقير كرامته كإنسانٍ قبل أن يكون مستأجرًا أو مالكًا.
- تعليمٌ يعزز القيم النقدية؛ تفكيك الخطابات التعصبية عبر مناهج تعلم التفكير النقدي بدلًا من الحفظ، تُعلِّم الأطفال كيف يُشكِّكون في الخطابات المسمومة، بدلًا من أن يحفظوا شعاراتٍ جوفاء، ومناهجُ تحوِّل الفصلَ الدراسي إلى مختبرٍ لصناعة مواطنينَ بمرايا نقدية، تُريهم الخداعَ خلف أقنعة الخطاب.
- سياسات اقتصادية شاملة تُصلح ما مزقته الرأسمالية؛ مشاريعُ تنمويةٌ تُحوِّل الفجوةَ الطبقيةَ من هاويةٍ سحيقةٍ إلى جسرٍ تعبر عليه الأحلام المنسية، وسياساتٌ تقلل الفجوة الطبقية وتُعيد الثقة في فكرة "المصلحة العامة"، بدلًا من أوثان المصلحة الفردية.
وأخيرًا، ربما تكون هذه الأزماتُ مخاضًا عسيرًا لميلاد مصر جديدة، إلا أن تلك الأزمات فرصةً لإعادة اكتشاف الذات الجمعية، حيث يُدرك المصريون أن عدوتهم الحقيقية ليست "الآخر" المختلف، بل تلك التحولات النفسية والهيكلية التي حولتهم من مجتمعٍ إلى غابةٍ تحكمها قوانين البقاء للأقوى..
----------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش