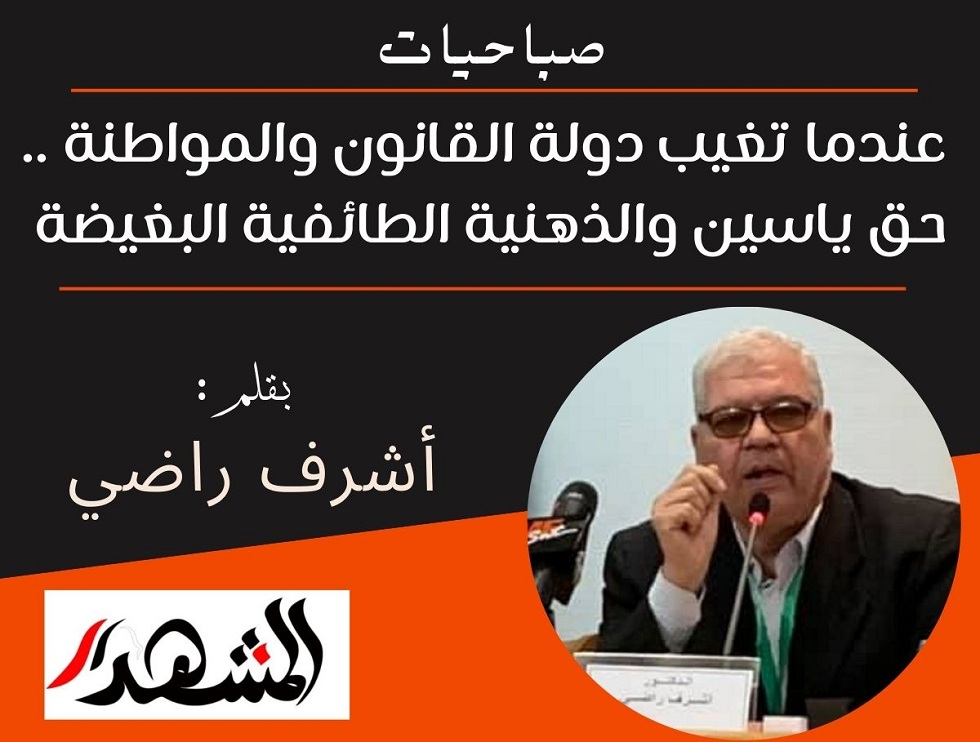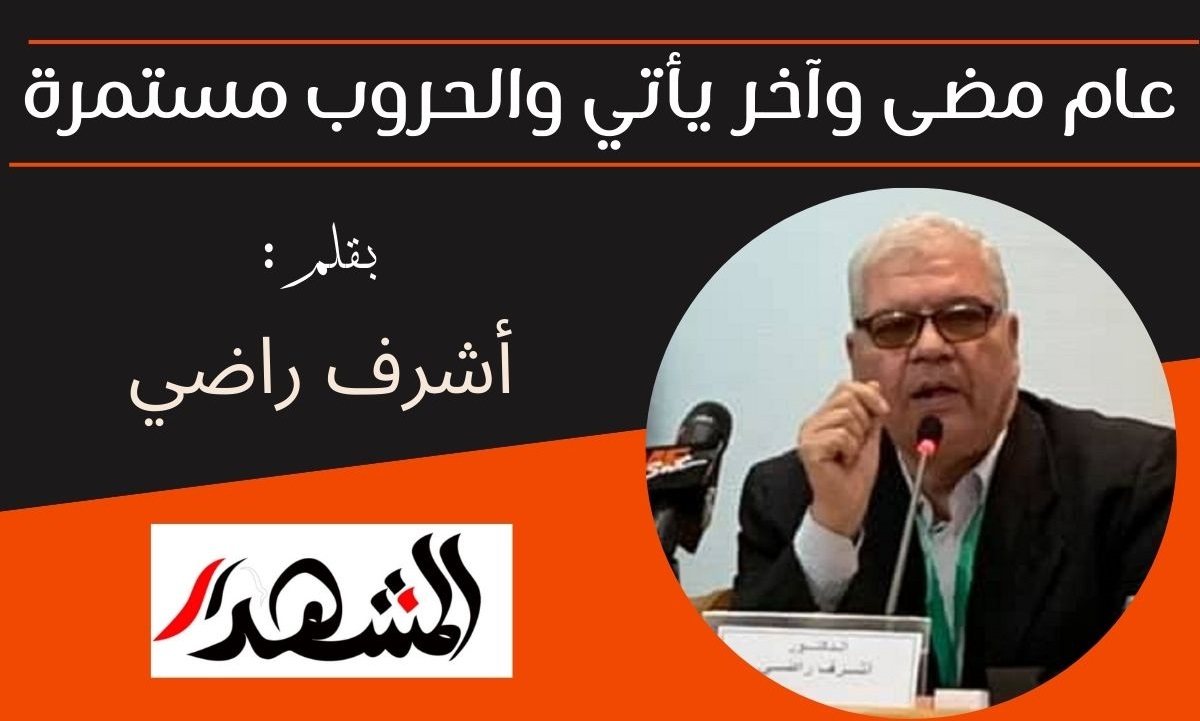عندما يتراجع الإحساس بالانتماء إلى الوطن، تعلو الانتماءات الأخرى الموروثة والمتوارثة، وهذا هو المعنى الدقيق لأزمة الحداثة التي تعاني منها مجتمعنا المصري ومجتمعاتنا العربية. فالحداثة تعني تراجع الولاءات المستندة إلى الانتماءات الأولية التي لم يخترها الفرد، لصالح الانتماءات التي يختارها ويدخل فيها بإرادته الواعية، أو تلك التي تتشكل نتيجة لعمليات التنشئة في المؤسسات الحديثة، والناجمة عن التفاعل الاجتماعي في المجتمع الحديث. وهكذا يقاس تقدم المجتمعات والأمم وفق مؤشر الحداثة من خلال المعايير التي يعتمدها المجتمع لإصدار الأحكام وبناء المواقف، وكلما كانت هذه المعايير مجردة، وتخاطب الأفراد في المجتمع دون تمييز على أساس النوع أو الديانة أو العرق أو الطائفة، كلما كنا إزاء مجتمع حديث، وكلما كان تطبيق هذه المعايير يتم دون تمييز بين الأفراد بوصفهم مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، كلما اقتربنا من الدولة المدنية الحديثة. لكن المجتمعات والدول لا تنتقل إلى الحداثة بقرارات تتخذ، وإنما عملية الانتقال هذه عملية صعبة، وتحدث غالبا عبر صراع طويل وممتد، وتشهد لحظات من التقدم وموجات من التراجع والتقهقر حسب موازين القوى بين المنخرطين في هذا الصراع الاجتماعي الممتد.
إن أي مراقب لحالة المجتمع المصري خلال القرن الأخير، يُلاحظ أننا في حالة تراجع عن المجتمع الحديث وعن الدولة المدنية الحديثة، وأن هناك زحفاً للولاءات الأولية، التي تعلي من شأن الانتماءات المتوارثة، سواء كانت دينية أو جهوية أو قبلية وعشائرية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها، والنخبة المدنية الحديثة، لتحديث المجتمع والانتقال إلى الروابط المدنية وتعزيز قيم المواطنة. هناك نظريات كثيرة تفسر حالة الانتكاس والتردي التي نعاني منها في العقود الخمسة الأخيرة من تاريخنا، وتحديداً بعد هزيمتنا العسكرية في حرب عام 1967، وطريقة استجابتنا لتحدي الهزيمة التي أسماها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر "النكسة". والحقيقة أننا ما زلنا نعيش في ظل هذه النكسة، على الرغم من "إزالة آثار العدوان"، عبر "حرب الاستنزاف" التي استمرت ثلاث سنوات (1967-1970)، وحرب أكتوبر 1973، والعملية السياسية التي أطلقتها حتى تم تحرير أرض سيناء بالكامل في عام 1982. لكننا لم نطرح إلى الآن للنقاش العام، كيفية استجابة المجتمع المصري ونخبته الصاعدة للهزيمة وتحليل أسبابها، ولماذا انتصر التيار الذي اختزل أسباب الهزيمة في الابتعاد عن الدين، على التيار الذي رأى أن الهزيمة كانت بسبب عدم الأخذ بأسباب العلم والتقدم التي يأخذ بها العدو، سواء كان هذا العدو إسرائيل أم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون.
حتى شعار "دولة العلم والإيمان"، الذي رفعه الرئيس السادات، كان محكوماً وموجها بالدين، وكان للأهداف السياسية للقيادة دور كبير في هذا التحول اللاحق على الانتصار في حرب أكتوبر 1973، كما تجلى من خلال التعديلات التي أدخلت على بعض مواد الدستور الدائم الذي صدر في عام 1971، لا سيما تعديل نص المادة الثانية من الدستور بجعل "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، مقابل تعديل المادة الخاصة بمدة الرئاسة.
تراجع وصعود
لقد كان تراجع العلم والمدنية وصعود المسجد والكنيسة، أحد النتائج المباشرة لكيفية استجابتنا لتحدي الهزيمة، حتى انتصار 1973، جرى تصويره على أنه نتيجة لرجوعنا للدين، في حين كانت هزيمتنا في عام 1967 نتيجة ابتعادنا عنه، وجرى تسخير الأجهزة الدعائية والإعلامية في الدولة لترسيخ هذا الاعتقاد في أذهان العوام والخواص من المصريين، وكانت برامج "العلم والإيمان" و"نور على نور" ثم لقاء الشيخ الشعراوي، من خلال القناة الأولى، القناة العامة، للتلفزيون المصري أكثر البرامج ترويجاً ورواجاً بين الجمهور والنخبة، في وقت تزايدت فيه القيود على الإبداع والتفكير النقدي وتراجعت فيه الجامعة ودورها ورسالتها التي يأتي في مقدمتها "الحرية الأكاديمية"، وباتت هناك قضايا كثيرة لا يقبل النقاش أو الجدل أو حتى التفكير والمراجعة، وبات الشيخ الشعراوي، رحمة الله عليه، مرجعاً حتى في أدق القضايا والموضوعات العلمية المتخصصة. لم يقتصر الأمر على المسجد فقط، بل امتد للكنيسة أيضاً مع احتشاد المصريين بعد يونيو 1967 أمام كنيسة العذراء في حي الزيتون لمتابعة ظهور "أم النور" السيدة مريم العذراء على قبابها، لتواسي المصريين في محنتهم. وعلى الرغم من أن السنوات ما بين 1967 و1973، كانت سنوات الإعداد لمعركة تحرير الأرض واسترداد الكرامة وإزالة أثار العدوان، والتي توجهت كل الجهود خلالها لدعم المجهود الحربي، الذي شارك فيه المصريون جميعاً، ولم يبخل أي منهم على دفع ضريبة الدم، والدفاع عن مصر والمشاركة في معركتها، إلا أن السنوات اللاحقة على حرب 1973، وما ترتب عليها من تغييرات في مصر وفي المنطقة العربية، كان عنوانها هزيمة قوى التقدم أمام الرجعية في أسوأ صورها وطبعاتها.
لقد تجلت مظاهر هذا التحول، في حادثة الفنية العسكرية عام 1974، وخطف وقتل الشيخ محمد حسين الذهبي، على يد جماعة تكفيرية في يوليو عام 1977، ثم ظهور الجماعات الإسلامية بفصائلها المختلفة وبتشجيع من السلطات الرسمية، السياسية والدينية، في خضم التحريض على الغزو السوفيتي لأفغانستان ودعاوى الجهاد في أفغانستان، وسيطرة الملالي على الحكم في طهران والخوف من تأثير خطابهم الإسلامي على الشباب في المنطقة، والذي استدعى تشجيع التيارات السلفية السنية لمواجهة الإسلام الحركي الشيعي، وتسخير حركة القومية العربية والبعث في المعركة ضد إيران الشيعية، فيما كان نظام الرئيس السادات يواجه حصاراً إقليميا بسبب زيارة القدس وتوقيع معاهدة للسلام مع العدو الإسرائيلي، واجه أيضاَ معارضة مزدوجة في الداخل من فصائل اليسار والقوميين بسبب المعاهدة ومن الإسلاميين للسبب ذاته ولأنه قبل استضافة شاه إيران المخلوع، فضلا عن صعود التوتر الطائفي وما أدى إليه من حوادث، كان أبرزها في عهد السادات حادث الخانكة في عام 1972، والتي استدعت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل مجلس الشعب، أصدرت تقريرا حمل العديد من التوصيات لحل المشكلة، عرف باسم "تقرير العطيفي"، نسبة إلى الدكتور جمال العطيفي، رئيس اللجنة لم يفعل أي منها إلا بعد عام 2011، ولا يزال الكثير منها غير مفعل إلى الآن. ثم أحداث الزاوية الحمراء عام 1981.
لقد كانت هذه الحوادث الطائفية انعكاسا لتوتر العلاقة بين الدولة والكنيسة، التي رصدها الأستاذ محمد حسنين هيكل في القسم الرابع من كتابه "خريف الغضب"، الصادر في عام 1982، والذي خصصه للكنيسة القبطية وعلاقتها بالدولة والمجتمع، وكانت أيضا انعكاساً لصعود التيار السلفي المتأثر بالوهابية، وصعود الجماعات الإسلامية المتأثر بالثورة الإيرانية، وتواطؤ الدولة مع تيار الإسلام السياسي، الذي خصص له الأستاذ هيكل القسم الثالث من الكتاب ذاته. لم تكن الحوادث الطائفية تعبيرا عن القطاعات النشطة المدفوعة بالدين على الجانبين الإسلامي والمسيحي فقط، وإنما كانت أيضاً نتيجة أسباب يطول شرحها، لترسيخ الذهنية الطائفية والتي تجلت بشكل واضح في قضية الطفل ياسين التي تفجرت مؤخراً، بعد أن شاهد الملايين في مصر وخارجها مسلسل "لام شمسية"، والذي حمل رسالة واضحة بخصوص الصمت على جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي تُرتَكب بحق الأطفال خوفاً من الوصمة الاجتماعية، والتي كانت تشجع منتهكي الأطفال على التمادي في جرائمهم مستفيدين من صمت المجتمع وتواطؤ البعض على هذه الجرائم.
معالجة صحيحة وتوظيف خاطئ
لعل السؤال الذي تطرحه قضية الطفل ياسين الذي تعرض للاغتصاب بشكل متكرر على يد عامل في مدرسة في محافظة البحيرة: لماذا اتخذت هذه القضية هذا المنحى الطائفي؟ وما إذا كان الحكم الذي صدر بحق العامل المسن (79 عاماً) حكماً مشدداً بسبب خلفيته الدينية وتحويل القضية إلى قضية رأي عام؟ لقد حملت قضية الطفل ياسين وجوها كثيرة للشبه مع قضية الطفل يوسف وغيره من الضحايا في مسلسل "لام شمسية"، لعل أهمها الفارق الكبير في السن بين المجرم وبين الضحايا، واستغلال المجرم مكانته ونشاطه في مدرسة تملكها والدته، اللذين سهلا له الوصول إلى ضحاياه. لم يلتفت المعلقون إلى عقوبة الحبس المؤبد التي أصدرتها المحكمة ضد الجاني في المسلسل، والذي وصفه وكيل النيابة بأنه "متحرش متسلسل"، والعقوبة التي أصدرتها المحكمة في قضية الطفل ياسين ضد عامل المدرسة والتي اعتبرها البعض عقوبة مغلظة بسبب الشحن الطائفي ضده وضد المدرسة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نسي جميع المنخرطين في النقاش على الجانبين، اتجاه المشرع المصري لتغليظ العقوبة في مثل هذا النوع من الجرائم، بما فيها جرائم الاغتصاب، في محاولة لردع الجناة، وأن العقوبة وصلت في كثير من القضايا إلى عقوبة الإعدام. إن تناول مثل هذه القضايا من خلال مسلسلات وأعمال درامية مدروسة بدقة أمر محمود لتشجيع المجتمع على تناول قضايا كان يصمت عنها خوفاً من الوصمة الاجتماعية ويلجأ أحيانا للوم الضحية، كما هو الحال في قضية التحرش بالفتيات والمرأة والتحرش بالأطفال، وهي قضايا كانت تُعد من المحظورات حتى وقت قريب.
غير أن الجدل الذي أثارته حادثة مدرسة البحيرة، تدق لدينا نواقيس خطر وتدعونا للانتباه إلى حالة الذهنية الطائفية التي باتت تسيطر على كثير منا في الآونة الأخيرة، والتي تصاعدت بعد عام 1981، وهي الفترة التي شهدت الكثير من المصادمات الطائفية، المحدودة والكبيرة، والتي كان هناك توظيف سياسي ملحوظ وراءها. وما كان للفضية أن تأخذ هذا المنحى إذا كان أطرافها ينتمون إلى الديانة ذاتها. لتكن هذه القضية، وهذا المنحى الذي اتخذه الجدل بخصوصها، مناسبة للانتباه إلى خطورة المستوى الذي بلغته حالة الشحن الطائفي والذهنية الطائفية التي وصلنا إليها، وضرورة الانتباه إلى خطورة هذه الحالة على تطلعاتنا لأن تجسد الجمهورية الجديدة التي نحلم بها الدولة المدنية الحديثة التي ترسخ مفهوم المواطنة على مستوى القيم وعلى مستوى الممارسة. وأدعو كل من شارك في هذا الجدل أن يُعيد التفكير في حادثة الطفل ياسين وينظر إليها في حقيقة كونها حادثة طفل مصري تعرض للانتهاك، وأن الجاني في هذه الجريمة، مذنب مصري ارتكب فعلا يستوجب عقوبة مغلظة لكي يكون عبرة لأي شخص يقدم على ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة بغض النظر عن خلفيته الدينية. وفي تقديري، أن النخبة المشاركة في الحوار حول هذه الحادثة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تغيير الذهنية الطائفية والتوظيف الصحيح لوسيلة من وسائل الحداثة الفائقة، شبكات التواصل الاجتماعي، لتكون آلية تساعد على انتقال مجتمعنا إلى القيم الإنسانية للحداثة وبناء علاقات اجتماعية سليمة لا تميز بين الناس على أساس الدين أو المعتقد، وإنما تميز بينهم على أساس من الفكر السليم والسلوك القويم.
إن النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في حاجة ماسة إلى وضع ما يشبه بالميثاق الأخلاقي الذي يمكنهم من تحويل هذه الوسائط من أدوات للتنابذ والشحن الطائفي إلى منصات لتنوير المجتمع وتغييره نحو الأفضل. أعلم أن هذا التعليق قد يستفز بعض المتابعين ضيقي الأفق ومحدودي البصيرة، الذين سينصرفون عن هذه الدعوة للتركيز على الهجوم الدعوة للحداثة والتنوير، هؤلاء المتعصبون دينياً والتابعين لأفكار غريبة ووافدة على المجتمع المصري، استوردوها من ثقافة مجتمعات أخرى تغيرت وتحولت عن هذه الأفكار، هؤلاء هم السدنة الحقيقيين لمثل هذه الذهنية الطائفية، وليعلموا أنني بالمرصاد لما يطرحونه من تعليقات وآراء، وسأفضح سوء طويتهم وضحالة أفكارهم وموقفهم المعادي للإنسانية والكاره للآخر المختلف معهم. فليحذروا.
-----------------------------
بقلم: أشرف راضي