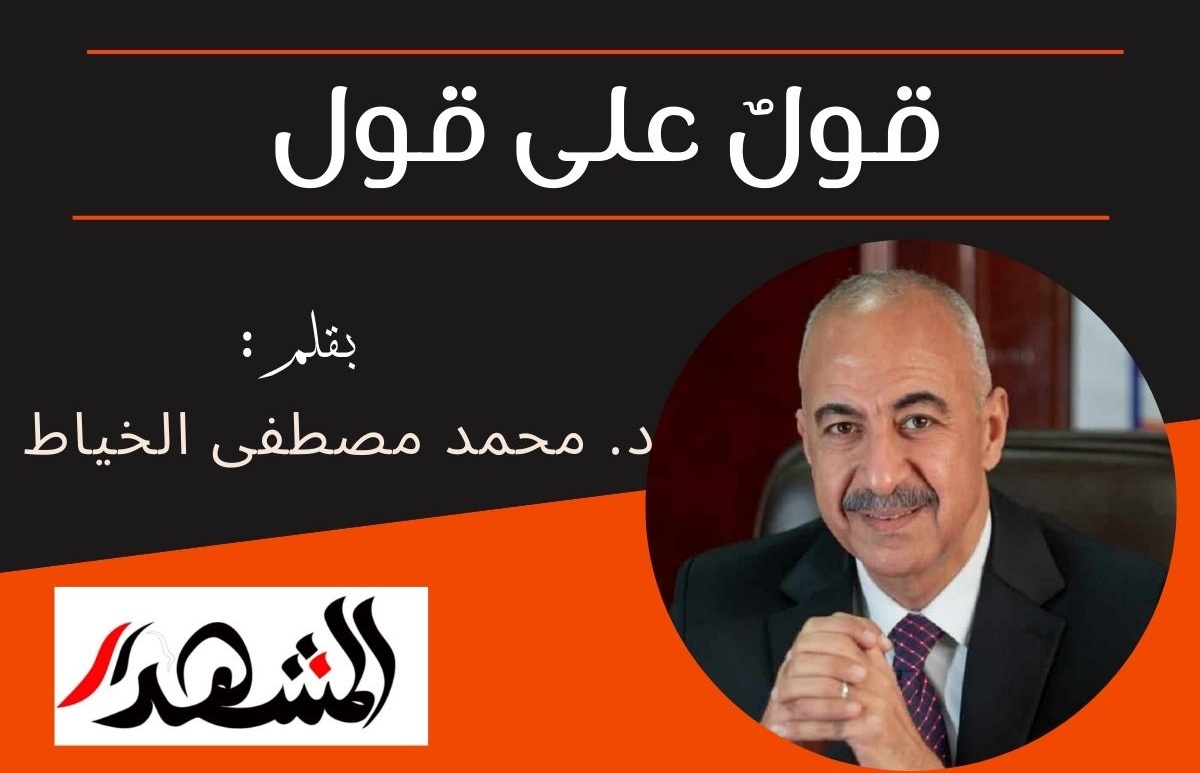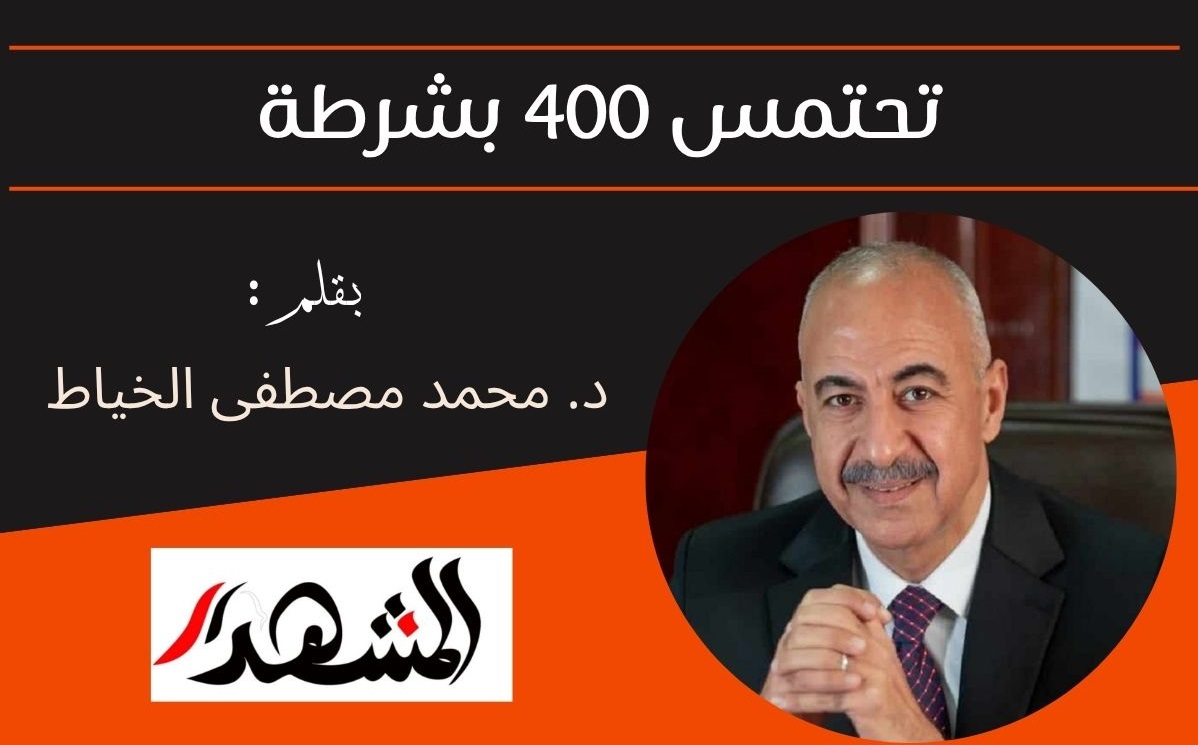عادة ما يحظى ما ينشر في هذه الزاوية من مقالات الأدب العربي، بتفاعل وحيوية يدلّان على عطش القارئ لأنهار اللغة العربية، برافديها من الشعر والنثر من جانب، وما يصاحبهما من مواقف اجتماعية، وسياسية، أهلك بعض منها أصحابها.
تربّص فاتك الأسدي، ورجاله بأبي الطيب المتنبي، في طريق عودته من بلاد فارس إلى الكوفة، وعندما شرع المتنبي في الهرب خوفًا على حياته، عايره فاتك بأبياتٍ له؛ وصاح مخاطبًا: (ألست أنت القائل؛ الخيل والليل والبيداء تعرفني/ والسيفُ والرمحُ والقرطاسُ والقلمُ؟) فعزَّ عليه أن يفرَّ، ويوصف بالجبن، أو الكذب، فلوى عنق فرسه، وعاد يقاتل حتى هلك.
وكان المتنبي قد هجا ضبّة بن يزيد، ابن أخت فاتك، بقصيدة مطلعها (ما أنصف القومُ ضبة)، أفاض فيها من فاحش القول في ضبة، وكل من له صلة قرابة به، ما أظن معه أنه لم يَدَعْ منقصة إلا وذكرها؛ فترصد فاتك مع رهط من صحبه بالمتنبي، كما سبق، وإن أنكر البعض ذلك، وقالوا: بل هو كافور الإخشيدي من حرَّض فاتكًا، بعد ما هجاه المتنبي بقصيدة؛ لرفضه تقليده منصبًا في الدولة. الخلاصة أن هلاك المتنبي كان لقصيدة هجاء!
وما الهجاء بالأمر اليسير، فما بالك وقائله عمدة شعراء العرب، حيث القصيدة نار أسطورية، تسري بين القبائل على ألسنة الرواة، وهم يمثلون أدوات إعلام اليوم في مجالسهم، وأسواقهم، ومنتدياتهم، ويمتدُّ تأثيرها متجاوزًا المكان والزمان، فيمتدّ لقرون، تعكس ما فيها من حكمة وبلاغة وفلسفة؛ اقرأ معي عزيزي القارئ عمق حكمة المتنبي في قوله (ما كل ما يتمنى المرء يدركه/ تجري الرياح بما لا تشتهي السفنُ)، أو فلسفة وحكمة أبي العلاء، صاحب سقط الزند واللزوميات (خَفِّفِ الْوَطْءَ مَا أَظُنُّ أَدِيمَ/ الأَرْضِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَجْسَادِ)، وما هذا بغريب على رجل سبق عصره، وكتب رسالة الغفران، التي يجزم المؤرخون والنقاد أنَّ الكاتب الإيطالي دانتي آليجيري، أبو اللغة الإيطالية، استلهم منها مؤلفه المعنون (الكوميديا الإلهية).
ولعلك حين تقرأ فلتة المعري هذه تسأل نفسك، كيف ألَمَّ رجل فقد بصره منذ نعومة أظافره، بكل هذه التفاصيل؟ وتجاوز خياله وصف الجنة والنار؟ وكيف ابتدع ذلك الشكل من الأدب، فسبق غيره؟ ثم لكأنّي به يرد على من يسأله من أنت؟ ببيته الأشهر (وإني وإن كنتُ الأخير زمانه.. لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل).
ومن جميل ما يذكر في هذا السياق: ذلك البرنامج الذي كان يقدمه الأستاذ حسن الكرمي (1905-2007) في إذاعة لندن، بصوته الرخيم، تحت عنوان "قولٌ على قول" لأكثر من ثلاثين عامًا، يجيب فيه على أسئلة المستمعين في شؤون الشعر العربي. كان دائرة معارف كاملة، حافظًا لآلاف الأبيات، مع معرفة عميقة بالتراث، يمتلك ذاكرة قويَّة حاضرة؛ تمكّنه من استعراض أبيات الشعر، وتراجم أصحابها، ومناسباتها.
أذكر له حلقة افتتحها كعادته بقوله: "السؤال: من القائل؟ وفي أية مناسبة؟
يقولون حصن ثم تأبى نفوسُهم **** وكيف بحصنٍ والجبال جنوحُ؟
وَلَمْ تَلفِظِ المَوتى القُبورُ وَلَم تَزَل **** نُجومُ السَماءِ وَالأَديمُ صَحيحُ
الجواب: هذا البيت لزياد بن معاوية بن ضباب الذبياني، المشهور بالنابغة الذبياني، عاش قبل الإسلام، ويصنف من شعراء الطبقة الأولى، أنشد قصيدته تلك؛ ناعيًا حصنَ بن حذيفة من بني فزارة، وكان سيّد قومه، حيث آثر حذف الفعل (مات) بعد قوله (حصنٌ) ليفجّر سؤالًا وجوديًّا: كيف يموت الإنسان والكونُ لم يتغير بعد؟ فيستعظموا نطقها غير مصدقين، ثم يتساءلون: كيف يموت والجبال لم تنسف بعد، والنجوم لم تنكدر، والقبور لم تخرج موتاها، وأجرام السماء ما زالت على حالها؟".
رحم الله الأستاذ حسن الكرمي، والحمد لله أنه جمع حلقاته في مجلدات، بلغت اثنتي عشر؛ لتصبح ذخائر ومراجع للمهتمين.
----------------------------
بقلم: د. محمد مصطفى الخياط
[email protected]