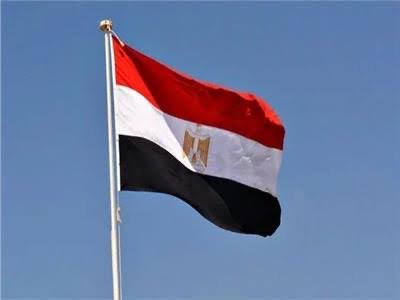كانت أولى جامعة لقاء التعارف بيني وبين القاهرة. جمعتني الصحبة بالمدينة الجامعية، بالمغتربين من أمثالي. كانت حياة "المدينجيه"، كما كانوا يطلقون علينا، خليطًا من الدراسة بالنهار وارتِياد المقاهي الرخيصة بالليل، حين لم يكن في يدنا من تكنولوجيا سوى الخيال، وكانت إضافة قناة ثالثة إلى التلفزيون وقتها أكبر ما دخل من ترفيه إلى حياتنا. من حسن حظي أن صحبتنا كانت تفضل مقهى في أحد شوارع العباسية المنسية. مكان بلا أبهة، كراسيه الخشبية المقوسة الأرجل توحي بأن عمرها يفوق أعمارنا. كل ميزته أن صاحبه قبل جلوسنا لساعات على دور مشاريب واحد. رغم مهابته الظاهرية وجلسته في صدر القهوة كأبي الهول، كان يبتسم أحيانًا على أحاديثنا الصاخبة. كان رواد المقهى، عدا عنّا، من الحرفيين وأرباب المعاشات، باستثناء رجل خمسيني يحمل آثار عزٍ قديم. يأتي غالبًا بعد منتصف الليل، يجلس في زاوية المقهى، مميزًا بحقيبته الجلدية الأسطوانية الشكل التي لا تفارقه. كان صبي القهوة يناديه: "عم حسن". لم يكن يهتم بوجودنا إلا بإلقاء السلام حين يأتي. استمر الحال على هذا النحو حتى تفرَّقت صحبتنا مؤقتًا بسبب امتحانات منتصف العام. لم أكن أذهب إلى المقهى إلا مع أصدقائي، كأنني أخشى مواجهة القاهرة ليلًا بمفردي. لكنني غامرت ذات ليلة وذهبت وحدي. لم أجد من أعرفه سوى صبي القهوة وعم حسن. بحثًا عن أي ونيس، اقتربت منه وسلمت:– إزيك يا عم حسن؟ – إزيك يا بني. فينكم؟ كنتم عاملين حس للقهوة.
– امتحانات، كلنا ملخومين. - طيب وإيه اللي جايبك؟ مش قاعد تذاكر ليه؟ ثم استطرد: على فكرة، شكلك فلاح، مش من مصر، وأهلك متعشمين فيك. أطلق الجملتين كطلقات من مدفع رشاش دون تمهيد. إذن، الرجل الصامت ليس كما تصورت، بل كان متابعًا، فزادني ذلك ألفة نحوه. – صح، والله عندك حق، حاضر يا عم حسن. بس ممكن أسألك عن الشنطة دي؟
– دي العِدة. – عدة إيه؟– عدة الشغل.فتحها قليلًا، فإذا بها مجموعة مختلفة الأطوال من النايات.– إيه ده؟ إنت بتاع مزيكا يا عم حسن؟ قلتُها بفرحة طفل في السابعة، فضحك لسذاجة النبرة، خاصة عندما تابعت: – وبتشوف مطربين وكده؟ – هههه أيوه، باشوف وكده. - معلش، أصل أنا أول مرة أتكلم مع فنان، حتى الافراح عندنا قليلة. – ما أنا برضه بعزف في الأفراح، وساعات حفلات بسيطة. - طيب، ممكن أجي أتفرج على حفلة؟ عمري ما حضرت حاجة زي كده. - ماشي، لما تخلص امتحانات.
وفى الرجل بوعده. ذهبت معه إلى إحدى حفلات قصور الثقافة. وجدت شبابًا في سني أو أكبر قليلًا، حتى المغنين كانوا في نفس العمر، بينما اختلفت أعمار العازفين، ومعظمهم يقتربون من سن عم حسن. رغم ضيق المكان وتواضع التنظيم، كان الجو مبهجًا، جعلني أشعر بغبطة كالدرويش في الحضرة. صرت كلما سنحت الفرصة أذهب معه. بدا وكأنه آنس لوجودي، حتى أنه بدأ يتباسط معي أمام زملائه، يقول لي ممازحًا: "إيه رأيك يا أستاذ؟"، وكنت أخجل من اللقب لصغر سني، لكنني علمت أنه كان يقصد التباهي بي. وذات مرة، كان لديَّ متسع من الوقت وطلبت الذهاب معه، فرفض في البداية قائلاً إن الشغل في شادر فرح صغير. أصررت، فوافق. كان المكان مكتظًا، وجلست بجوار فرقة مختلفة عن المعتاد. معهم سيدة كثيرة الألوان في وجهها وزيها، بدت في الأربعينات، فهمت أنها صاحبة الفرقة ومطربتها. لم يعجبها وجودي: - مين أبو نضارة ده يا حسن؟ ابنك؟ ارتبكت، ونظرت إلى عم حسن ألتمس منه الدعم، فقال مقتضبًا: -لأ، ده بيقعد معايا على القهوة وعايز يتفرج. ردت ضاحكة بسخرية: - ماشي يا خويا، اللي جابلك يخليلك.
حزَّ ذلك في نفسي، فقد شعرت أن الرجل كاد يتبرأ مني بعد أن كان يفاخر بي. المكان لم يكن كما اعتدت. حتى عم حسن كان يعزف بلا اهتمام، ويتبادل الشتائم مع زملائه، ثم يضحكون وكأن شيئًا لم يكن. واختتم الليلة بشجار مع المطربة على نسبته في "النقطة"، أنهاه بقوله: - والله إنتِ ولا بتفهمي فيها، واللي خلاكي عالمة ظلمك. إياك تبعتيلي على فرح تاني. عدنا إلى المقهى، وقد لاحظ تجهمي، فقال كأنه أحس بما أفكر فيه: - ايه رأيك في الليلة؟ – الفرح ظريف، والمعازيم البنات كانوا حلوين، بس الست دي لسانها زفر. – ههه دي الليلة كانت محترمة. - محترمة؟ دي خلتني في نص هدومي! وبعدين سامعك بتقول مش هتشتغل معاها تاني. – يا ابني، ده كلام. بكره تبعت تصالحني. ده أكل عيش. أنا برضه قديم ولي سمعتي. – طب وليه بتشتغل في الأماكن دي؟ – عشان المصاريف. – هو عندك ولاد؟– عندي بنتين، أصغر منك شوية. – ما بتروحش البيت ليه؟ – أنا وأمهم سيبنا بعض من زمان. هما قاعدين معاها. – يعني مش بتشوفهم؟– لأ، بشوفهم وبصرف عليهم. لما كبروا بقى ييجوا لوحدهم. يمكن علشان كده اتكلمت معاك في القهوة، كنت عايز أعرف شباب اليوم بيفكر إزاي. – هو أنتم سبتوا بعض ليه؟ كأنما التقى فضولي برغبته في الفضفضة، فاستمر الحديث. – كنت صغيرا، والشغل كتير، وكنت شايف نفسي. كنت فاكر نفسي هبقى زي "عفت"، عازف عبد الحليم. على فكرة، اشتغلت معاه شوية. كنت بحب المزيكا وفاشل في الدراسة. أبويا، الله يرحمه، حاول يعدل حالي، بس ركبت دماغي. قاطعني شوية، وبعد كده عيّي ومات. أخواتي بعد الدفنة قالوا إني السبب. من بعدها باعرف أخبارهم من بعيد. حتى جوازات عيالهم باعرفها من الأغراب. – ووالدتك؟ – دي ماتت وأنا صغير. شعرت أن الرجل ازداد عمرًا فوق عمره مع نهاية الحكاية، فخفت عليه أن يشيخ أكثر، فقاطعته بلطف: - ياه، ده انت حكاية يا عم حسن. فابتسم وقال: - كل واحد فينا يا ابني حكاية. – يا ترى هيتكتب لي إيه؟ – ما تستعجلش. ركز بس، عشان اللي بيتكتب ما بيتمسحش.
مرت الشهور وتسربت الأعوام وبت أذهب إلى المقهى قليلًا، وأرى الرجل مراتٍ أقل. وأخذتني الطرق بعيدًا عن العباسية وقهوة أبو الهول. صرت لا أخاف القاهرة، بل استوطنتها، وتبدلت الوجوه والمشاعر. لكن صوت نايه وحديثه ما زالا يرنّان في أذني حين أحن للبداية.
-------------------------
بقلم: مدحت جاد الرب
...