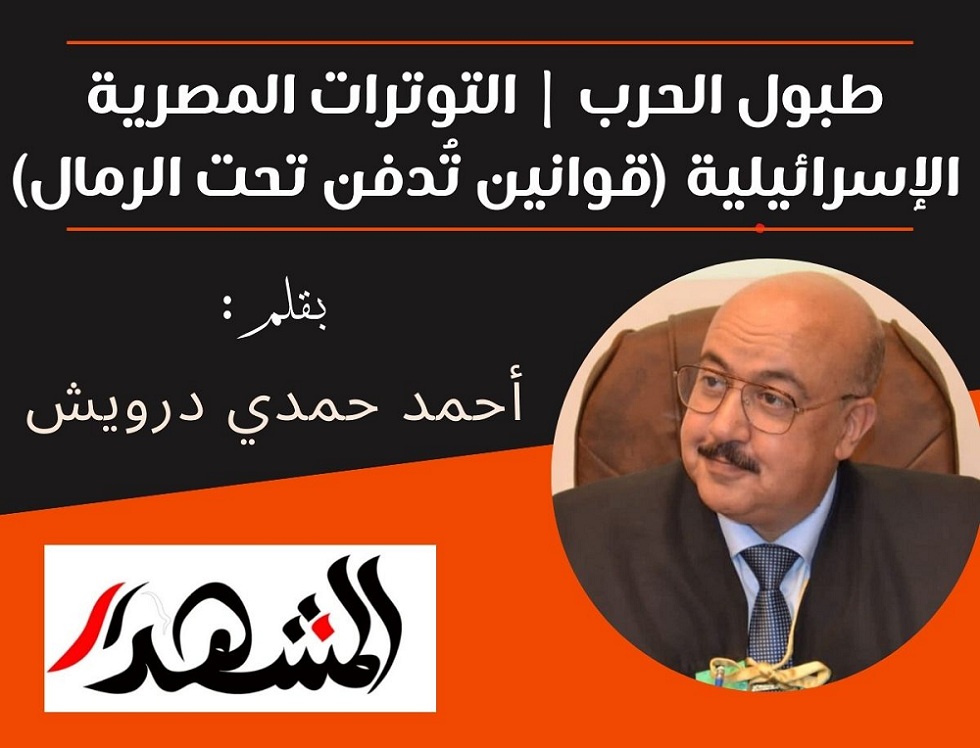* قراءة في موازين القوة والتداعيات
في ظلّ ضجيج صواريخ غزة التي لا تتوقف منذ أكتوبر 2023، وصراخ الأطفال تحت الأنقاض، تتنفَّس المنطقة هواءً مشحونًا بأسئلةٍ مصيرية: هل تتحوَّل الحدود المصرية - الإسرائيلية، التي ظلَّت نحو 45 عامًا نموذجًا هشًّا للسلام البارد، إلى جبهةٍ جديدةٍ تهدد بانفجار الشرق الأوسط؟ المشهد اليوم يشبه لعبة الدومينو المعقَّدة: حربٌ مستعرة في القطاع، وتهديداتٌ إسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية إلى رفح، ورفضٌ مصريٌّ قاطعٌ لأيّ اختراقٍ لسيادة سيناء، بينما يترنح العالم بين صمتٍ دوليٍ مُريبٍ وتحالفاتٍ تتشكل خلف الكواليس.
هذا التوتر، وإن لم يصل بعدُ إلى اشتباكاتٍ ميدانية، إلَّا أنه يُعيد إحياء أشباح حروبٍ سابقة، ويُذكِّر بالجولات العربية الإسرائيلية (1948، 1956، 1967، 1973)، لكن في عصرٍ تغيَّرت فيه موازين القوة، وتصاعدت فيه أدوار الفاعلين غير التقليديين - من ميلشيات مسلحة إلى منصات إعلاميّة تُضخِّم الخطاب العدائي - فمصر الحارس التاريخي للقضية الفلسطينية، توازن بين التزامها بمعاهدة كامب ديفيد وغضب شعبها من خشية مشاهد التهجير القسري للفلسطينيين نحو صحرائها، وإسرائيل التي حوَّلت نفسها إلى "قلعة تكنولوجية"، تُصارع لإقناع العالم بأن عملياتها في غزة هي "دفاعٌ شرعي"، بينما تُعيد ترسيم حدودها الأمنية على حساب جيرانها.
نحن هنا لسنا أمام سيناريو صراعٍ عادي، بل أمام اختبارٍ مصيري "للعقلانية السياسية" في زمنٍ يبدو أن القانون الدولي فيه أضعف من أن يَحقن الدماء، والسؤال الذي يُطارَدُ به القارئ من السطور الأولى؛ هل ما نشهده هو مجرد لعبة ضغطٍ سياسي؟ أم أنّ المنطقة تقف على حافة الهاوية، حيث قد تُغيِّر رصاصةٌ طائشةٌ وجه التاريخ إلى الأبد؟
فبينما تستمر حرب غزة في دخول شهرها التاسع عشر، المشهد يتأجج على حدود سيناء، هذا التوتر وإن بدا مفاجئًا للبعض، فهو نتاج تراكمات سياسية وعسكرية تعكس تحولًا جيوبوليتيكيًا خطيرًا في الشرق الأوسط، فبعد عقود من السلام البارد بين مصر وإسرائيل، تطفو على السطح تساؤلات عن مدى قدرة معاهدة كامب ديفيد (1979) على الصمود في ظل حربٍ إقليمية تهدد بإعادة رسم التحالفات، وكيف وصلت العلاقات إلى هذا المنعطف؟ وما مدى جاهزية الجيشين المصري والإسرائيلي لمواجهة محتملة؟ وما تأثير ذلك على استقرار المنطقة؟
أولًا، جذور التوتر والسياق الراهن
منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد 1979، ظل السلام المصري-الإسرائيلي هشًّا كجمر تحت الرماد، لكن حرب غزة فجّرت تحولات جذرية، وأعادت تشكيل التحالفات، فمصر التي لطالما مثّلت وسيطًا إقليميًّا، وجدت نفسها في قلب العاصفة مع توسع العمليات الإسرائيلية في رفح وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو حدود سيناء، ما أثار رفضًا مصريًّا قاطعًا لتحويلها إلى "منطقة عازلة" دائمة، في مقابل إصرار إسرائيل على تفكيك بنية حماس تحت الأرض، مما خلق أزمة ثقة متبادلة، وتتصاعد اليوم ثلاث بؤر توتر: معبر رفح (صراع السيادة بين تدمير الأنفاق وحماية الحدود)، التفاوت النووي (ترسانة إسرائيلية غير خاضعة للرقابة)، والصراع على حدود المتوسط (غازٌ يُشعل التنافس الجيوبوليتيكي)، وهذه الاحتكاكات ليست مجرد خلافات عابرة، بل شرارات قد تُعيد إشعال مواجهة إقليمية تطيح ببقايا السلام الهش.
- معبر رفح (صراع السيادة بين تدمير الأنفاق وحماية الحدود)
محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على معبر رفح، المنفذ الوحيد بين غزة والعالم خارج السيطرة الإسرائيلية المباشرة، فتحوَّل إلى بؤرة توترٍ استثنائية، فبينما تُصر إسرائيل على توسيع عملياتها العسكرية حوله بحجة "تدمير الأنفاق" التي تستخدمها حماس لتهريب الأسلحة، تُرد مصر بأن هذه الخطوة تُكرس انتهاكًا لسيادتها على أراضي سيناء، وتُحوِّل المنطقة إلى ساحة عملياتٍ مفتوحة دون تنسيقٍ مسبق، والخلاف هنا ليس تقنيًّا فحسب، بل هو اختبارٌ لمدى التزام إسرائيل ببنود معاهدة كامب ديفيد (1979)، التي تُلزمها بالامتناع عن أي نشاط عسكري قرب الحدود المصرية دون موافقة القاهرة، والوضع يُذكِّر مصر بسيناريو الأنفاق عام 2014، حين أدى تدمير إسرائيل لشبكات مماثلة إلى تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء، مما يُهدد أمنها الداخلي ويُعيد إحياء مخاوف من تحويل سيناء إلى "مستوطنة لاجئين دائمة"، وهو ما ترفضه مصر جملةً وتفصيلًا..
- التفاوت النووي (ترسانة إسرائيلية غير خاضعة للرقابة)
حيث السلاح الخفي، فعلى مدى عقود ظلّت إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية (تُقدّر بحوالي 90 رأسًا) دون خضوعها لنظام الرقابة الدولية، لاسيّما مع رفضها التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، ومصر التي تخلت عن برنامجها النووي العسكري في السبعينيات تحت ضغوط أمريكية، تُشدد اليوم على أن هذا التفاوت يُشكل تهديدًا وجوديًّا للأمن القومي المصري والعربي، خاصةً مع تصاعد الخطاب الإسرائيلي حول "الحرب الشاملة" ضد خصومها، والقضية تتجاوز الجانب العسكري إلى سياسي، فمطالبة مصر بمنطقة خالية من الأسلحة النووية (مبادرة 1974) تُصطدم بحقيقة أن المجتمع الدولي – بقيادة الولايات المتحدة – يتغاضى عن البرنامج النووي الإسرائيلي، بينما يُشدد على إيران، وهذه الازدواجية تُغذي شكوكًا مصرية بأن "التفوق النووي" الإسرائيلي هو جزءٌ من استراتيجية لفرض هيمنة إقليمية مطلقة، حتى لو أدى ذلك إلى سباق تسلحٍ قد يطال دولًا عربية أخرى..
- التمدد في البحر المتوسط (غازٌ يُشعل التنافس الجيوبوليتيكي)
حيث توجد حرب الاستنزاف الخفية، منذ اكتشافات الغاز الضخمة في شرق المتوسط (مثل حقل "لفيتان" الإسرائيلي وحقل "ظهر" المصري) حوَّلت المياه الإقليمية إلى ساحة صراعٍ جيوبوليتيكي، فالخلاف المصري-الإسرائيلي يدور حول ترسيم الحدود البحرية، حيث تطالب إسرائيل بمنطقة اقتصادية خالصة تتداخل مع المطالب المصرية، خاصةً قرب حقل "أفروديت" المشترك مع قبرص، والأزمة تُعيد إنتاج سيناريو النزاع التركي-اليوناني، لكن مع تعقيدات إضافية مثل:
• اقتصاديًا: تحاول إسرائيل تصدير غازها إلى أوروبا عبر مصر (مشروع تصدير الغاز المسال في دمياط) لكن الخلافات الحدودية قد تعوق هذا التعاون الهش.
• عسكريًا: نشطت كلتا الدولتين في تعزيز وجودهما البحري، فمصر تسلحت بغواصات ألمانية متطورة، بينما تعتمد إسرائيل على غواصات "دولفين" المجهزة بصواريخ كروز.
• سياسيًا: مصر تُحذّر من أن التمدد الإسرائيلي في المتوسط قد يُحيّد دورها كبوابة إقليمية للطاقة، بينما تُلمح إسرائيل إلى أن التعاون مع اليونان وقبرص قد يكون بديلًا عن الشراكة المصرية.
ثانيًا: التوترات المصرية الإسرائيلية عبر عدسة القانون الدولي والبروتوكولات الدولية
في خضم تصاعد التهديدات العسكرية، تبرز أسئلة جوهرية حول مدى توافق التوترات الحالية مع الأطر القانونية الدولية، وكيف يمكن للبروتوكولات الدبلوماسية أن تُشكّل سدًّا منيعًا ضد الانزلاق نحو حربٍ شاملة، والمقال هنا يُحلل الأزمة من زاوية القانون الدولي والعلاقات الدولية، مستكشفًا الثغرات والضمانات التي قد تحمي النظام الإقليمي من الانهيار.
- الإطار القانوني: معاهدة السلام والاتفاقيات الدولية
- كامب ديفيد 1979:
تُعتبر المعاهدة العمود الفقري للعلاقات الثنائية، حيث حددت بنودًا واضحة حول ترسيم الحدود (المادة الثانية)، وعدم الاعتداء (المادة الثالثة)، وتقييد الوجود العسكري في سيناء (الملحق الأول)، لكن الخلافات الحالية حول معبر رفح وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية قرب الحدود المصرية تُثير تساؤلات حول انتهاك البند الرابع من المعاهدة، الذي يُلزم الطرفين بعدم "التهديد باستخدام القوة".
- القانون الدولي الإنساني:
تصاعد العمليات العسكرية في غزة، وخاصةً التهجير القسري للسكان نحو سيناء، قد يُشكّل انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، وهنا تُواجه إسرائيل ضغوطًا قانونية متزايدة، بينما تُطالب مصر بتحميل المجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين.
- الحدود البحرية وقانون البحار:
النزاع حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يُلامس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS 1982)، خاصةً المادة 15 التي تنظم ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، وعدم انضمام إسرائيل إلى الاتفاقية يُضعف آليات الحل القانوني، مما يدفع الطرفين نحو تسييس الأزمة بدلًا من تقنينها.
آليات المُسَاءلة الدولية: بين العجز والانتقائية
- مجلس الأمن الدولي:
تاريخيًا يُظهر المجلس انقسامًا حادًّا في التعامل مع الصراعات العربية - الإسرائيلية بسبب حق النقض (الفيتو) الأمريكي، ففي مارس 2025، فشل مشروع قرار مصري بفرض حظر على التحركات العسكرية الإسرائيلية قرب رفح بسبب الفيتو الأمريكي، مما يعكس إشكالية هيكلية في النظام الدولي.
- محكمة العدل الدولية (ICJ):
في يناير 2025، قدمت مصر طلبًا استشاريًّا إلى المحكمة حول شرعية الوجود العسكري الإسرائيلي الممتد في غزة، مستندةً إلى رأيها الاستشاري السابق عام 2004 حول "الجدار العازل" في الضفة الغربية، ولكن تنفيذ أحكام المحكمة يظل رهنًا بإرادة الدول، وهو ما تُظهره إسرائيل عبر رفضها الاعتراف باختصاص المحكمة في قضايا "تخص أمنها القومي".
- المحكمة الجنائية الدولية (ICC):
مع انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي عام 2015، أصبحت جرائم الحرب المحتملة في غزة خاضعة لتحقيقات المحكمة، ولكن الملاحقة القانونية لإسرائيل (غير المنضمة للمحكمة) تبقى معقدة، لاسيما مع تصنيف المحكمة كهيئة سياسية من قبل خصومها.
- البروتوكولات الدبلوماسية: اختبارٌ للعقلانية السياسية
- الدبلوماسية الوقائية:
تُلزم المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة الدول باللجوء إلى المفاوضات أو التحكيم لحل النزاعات، ولكن غياب وسيط دولي مُحايد (كالدور الذي لعبته الولايات المتحدة سابقًا) يُفاقم الأزمة، خاصةً مع انكفاء واشنطن النسبي تحت إدارةٍ أمريكية جديدة تُركز على آسيا.
- قنوات الاتصال السرية:
تكشف الوثائق المسربة أن اجتماعاتٍ بين مسئولي المخابرات المصرية والإسرائيلية استمرت حتى أبريل 2025، في إطار ما يُعرف "بدبلوماسية الأنفاق"، لكن عدم إضفاء الطابع الرسمي عليها يجعلها عرضة للانهيار مع أي صدمة أمنية.
- الدبلوماسية العامة:
استخدام الطرفين لخطابٍ تحريضي في الإعلام (مثل اتهامات مصر بالتخاذل أو وصف إسرائيل بالكيان العنصري) ينتهك مبدأ "الحفاظ على علاقات حسن الجوار" المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ويدفع نحو تصعيدٍ غير محسوب.
التداخل بين القانون والسياسة: هل تُجدي القواعد الدولية؟
- معضلة السيادة مقابل الأمن الجماعي:
مصر تُصر على أن أي تدخل إسرائيلي في رفح انتهاك لسيادتها (المادة ٢ من ميثاق الأمم المتحدة)، بينما تدعي إسرائيل أن عملياتها تستند إلى المادة ٥١ (حق الدفاع عن النفس)، وهذا الجدل يعكس إشكالية أوسع في القانون الدولي؛ من حيث غموض تعريف "التهديد المباشر" الذي يبرر استخدام القوة.
- دور المنظمات الإقليمية:
جامعة الدول العربية، التي أعلنت في قمة ٢٠٢٤ رفضها "التطبيع مع إسرائيل حتى تحقيق السلام العادل"، تدفع مصر نحو مواقف متصلبة، بينما تحاول إسرائيل استمالة دول أفريقية عبر اتفاقيات اقتصادية لتجاوز العزلة الدبلوماسية.
- القوة الناعمة كبديل:
قد تُشكل المبادرات الثقافية أو الاقتصادية المشتركة (مثل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين) جسرًا لتخفيف التوتر، لكنها تظل هشة في ظل غياب إطار قانوني ملزم.
ثالثًا، موازين القوة العسكرية لعام 2025
استنادًا إلى تقرير جلوبل فاير باور (Global Firepower) لعام 2025، يُلاحظ أن كلا البلدين يحتلان مراكز متقدمة في التصنيف العسكري العالمي (مصر في المركز 19، وإسرائيل في المركز 15)، ولكن طبيعة القدرات تختلف جذريًا.
1- الجيش المصري: الكم مقابل الجودة
- العتاد البشري؛ يُعتبر الأكبر في المنطقة بما يقرب من 450 ألف جندي نشط، و 800 ألف في الاحتياط، مدعومين بتجنيد إلزامي.
- القوة الجوية؛ تمتلك مصر 560 طائرة مقاتلة، منها 24 (رافال) فرنسية و220 (F-16) أمريكية، لكنها تفتقر إلى طائرات الجيل الخامس مثل (F-35) التي تمتلكها إسرائيل.
- الدفاع الجوي؛ شبكة متطورة من أنظمة "S-300" و"Pantsir-S1" الروسية، والتي قد تشكل تحديًا للتفوق الجوي الإسرائيلي.
- القوات البحرية؛ 245 قطعة بحرية، بما فيها غواصات تايب 209 الألمانية، لكنها تفتقر إلى نظم صواريخ بحرية متقدمة.
- التحديات؛ اعتماد كبير على تصدير الأسلحة الأمريكية (1.3 مليار دولار سنويًا) الذي قد يتعرض للتعليق في حال الصراع، وضعف الصناعة العسكرية المحلية مقارنة بإسرائيل.
2 - الجيش الإسرائيلي: التكنولوجيا والتحالفات
- الذراع النووي؛ تُقدَّر ترسانتها بحوالي 90 رأسًا نوويًا، مما يعتبر عامل ردع استراتيجي.
- القوة الجوية؛ 350 طائرة، منها 50 طائرة (F-35) و200 طائرة (F-15/16)، مدعومة بنظام "القبة الحديدية" وطائرات مسيرة مثل "هاروب".
- الاستخبارات والفضاء؛ تتفوَّق إسرائيل في الحرب الإلكترونية والأقمار الصناعية التجسسية (مثل "أفق 16").
- التحالفات؛ دعم أمريكي سنوي يقدر بحوالي 3.8 مليار دولار، وتعاون مع حلف الناتو عبر "الشراكة من أجل السلام".
- التحديات؛ محدودية الاحتياط البشري (465 ألفًا فقط) واعتماد الاقتصاد على الاستقرار الأمني.

3 - المقارنة في سيناريو المواجهة
- حرب خاطفة؛ قد تتمكن إسرائيل من تحقيق تفوّق جوي سريع باستخدام طائرات F-35، لكن اختراق الدفاعات الجوية المصرية لن يكون سهلاً أبدًا.
- حرب استنزاف؛ فمع عمق مصر الجغرافي وعدد جنودها، وإمكانية الحشد الشعبي المتوفرة لديها، قد تتحول المواجهة إلى كابوس لإسرائيل كما حدث في حرب أكتوبر 1973.
- البُعد البحري؛ التفوق الإسرائيلي في الغواصات النووية (دولفين 2) قد يهدد الملاحة في قناة السويس، الشريان الحيوي للاقتصاد المصري.
- حظر استخدام القوة؛ تهديدات الجانبين العلنية تُناقض روح المعاهدة، لكن كليهما حتى الآن يتجنب خطواتٍ عمليةً تلغيها (مثل سحب السفراء أو تعليق الاتفاقيات الاقتصادية).
رابعًا، التداعيات الإقليمية والعالمية
تفجير المنطقة: من يحتمل الخسارة؟
فالأردن ولبنان؛ قد يُجبران على الانحياز لأحد الطرفين، خاصة مع وجود لجان فلسطينية فيهما، بينما إيران ومعها حزب الله؛ ستستغل الفرصة لفتح جبهة ثانية ضد إسرائيل، مما يعقد المشهد، أما تركيا؛ فقد تدعم مصر علنًا لتعزيز نفوذها في المتوسط، مقابل تحالف إسرائيل مع اليونان وقبرص.
اقتصاديات الحرب: النفط والغاز على المحك
أي إغلاق لقناة السويس سيُسبب صدمة في أسواق النفط العالمية، مع احتمالية ارتفاع السعر إلى 200 دولار للبرميل، كما أن تعطيل حقول الغاز الإسرائيلية (مثل لفياثان) قد يُضعف أوروبا التي تعتمد على الغاز المسال بعد حرب أوكرانيا.
الدور الأمريكي: بين المصلحة والتحالف
الولايات المتحدة، كضامن لسلام كامب ديفيد، ستواجه معضلة دعم إسرائيل، فقد تفقدها حليفًا استراتيجيًا في مصر، بينما الضغط على مصر قد يدفعها نحو روسيا أو الصين، اللتين تتنافسان على تعزيز وجودهما في أفريقيا.
الخاتمة:
هل السلام أكثر تكلفة من الحرب؟
في الوقت الذي تُقدِّم فيه الحسابات العسكرية المصرية والإسرائيلية كفتين متقاربتين، تبقى الحسابات السياسية والاقتصادية هي الفيصل، فمصر التي تعاني من ديون خارجية ضخمة، لا تستطيع خوض حرب طويلة، وإسرائيل رغم تفوقها التكنولوجي، تدرك أن صمودها يعتمد على دعم أمريكي قد يترنح في حال تغييرالإدارة الأمريكية موقفها، وربما يكون الخيار الوحيد المتاح هو العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن مع تغيير جذري في النهج؛ باعتبار الفلسطينيين طرفًا رئيسيًا لا ورقة مساومة، فكما قال هنري كيسنجر ذات يوم: "الحرب خيار الميئوس منهم، أما الحكماء فيجدون طريقًا للسلام حتى في ظل الجحيم".
هذه النقاط بالمقال ليست منفصلة، بل هي حلقات متصلة في سلسلة أزمةٍ يعود جذرها إلى غياب تسويةٍ عادلة للقضية الفلسطينية، وتفاوت موازين القوة الناجم عن الدعم الغربي غير المحدود لإسرائيل، فسيطرة إسرائيل على رفح تُكرس إحكام القبضة على غزة، ورفضها الشفافية النووية يعكس إصرارًا على التفوق عبر الترهيب، والتمدد في المتوسط جزءٌ من سعيها لتحقيق اكتفاءٍ استراتيجي بعيدًا عن الجوار العربي، وفي المقابل مصر – التي تخشى تحوّلها إلى "دولة تابعة" – تُحاول استخدام أوراق الضغط المتاحة (مثل التعاون العسكري مع روسيا والصين، أو إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية) لفرض معادلةٍ جديدة، والصراع هنا ليس على الأرض فحسب، بل على هوية النظام الإقليمي القادم؛ هل سيكون خاضعًا لمعايير القوة الصلبة، أم لقواعد القانون الدولي؟
فالتوتر المصري - الإسرائيلي ليس مجرد نزاع ثنائي، بل هو اختبارٌ لمصداقية النظام الدولي والقانون الدولي وقدرته على فرض حلول سلمية، فالعجز عن تطبيق قرارات مجلس الأمن، والازدواجية في التعامل مع الانتهاكات، وتسييس القانون الدولي، جميعها عوامل تُغذي تصعيدًا قد يُعيد المنطقة إلى حقبة ما قبل كامب ديفيد، وفي هذا السياق يصبح تحديث الآليات الدولية – مثل إصلاح مجلس الأمن أو تعزيز دور التحكيم الإلزامي – ضرورةً ليس لوقف الحرب فحسب، بل لإنقاذ الشرعية الدولية نفسها من الانهيار، وكما قال (ألبير كامو): "السلام ليس غياب الحرب، بل هو وجود عدالةٍ تُلزم الجميع".
هذا المقال يهدف إلى تحفيز النقاش حول ضرورة تجنب الصراع عبر حلول سياسية، مع الإشارة إلى أن التكلفة البشرية ستكون هائلة لكلا الجانبين، فالتاريخ يُعلِّمنا أن الحروب العربية - الإسرائيلية، رغم نتائجها التكتيكية، لن تحقق سلامًا دائمًا إلا بالاعتراف المتبادل وحل القضية الفلسطينية.
----------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش