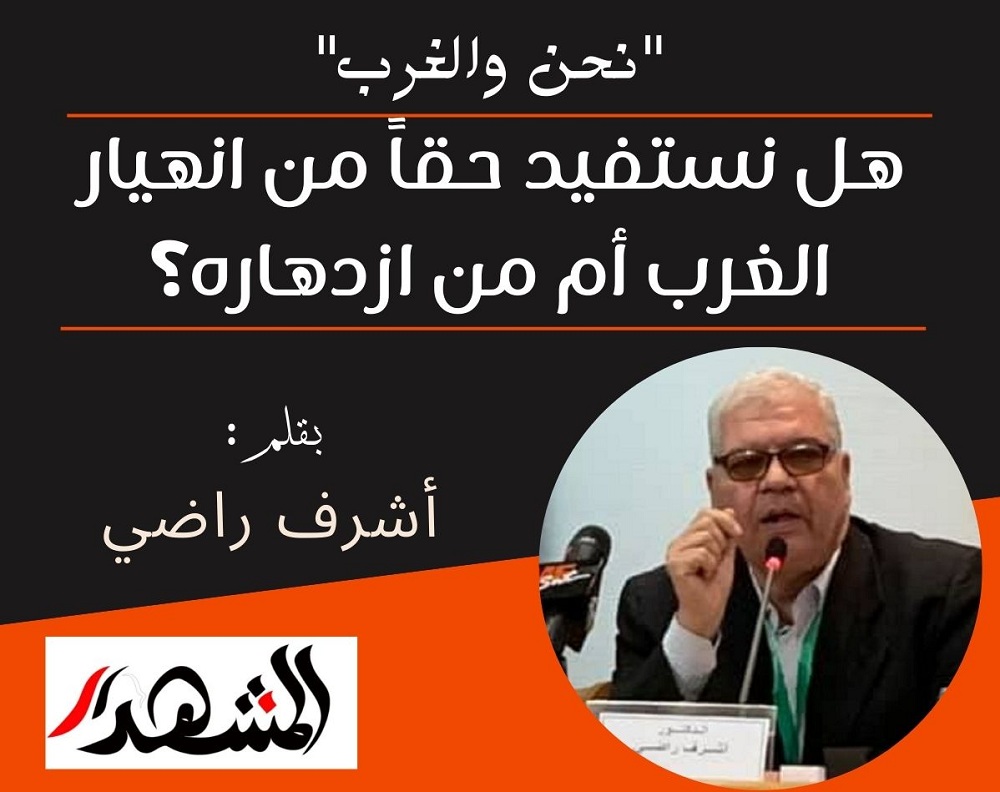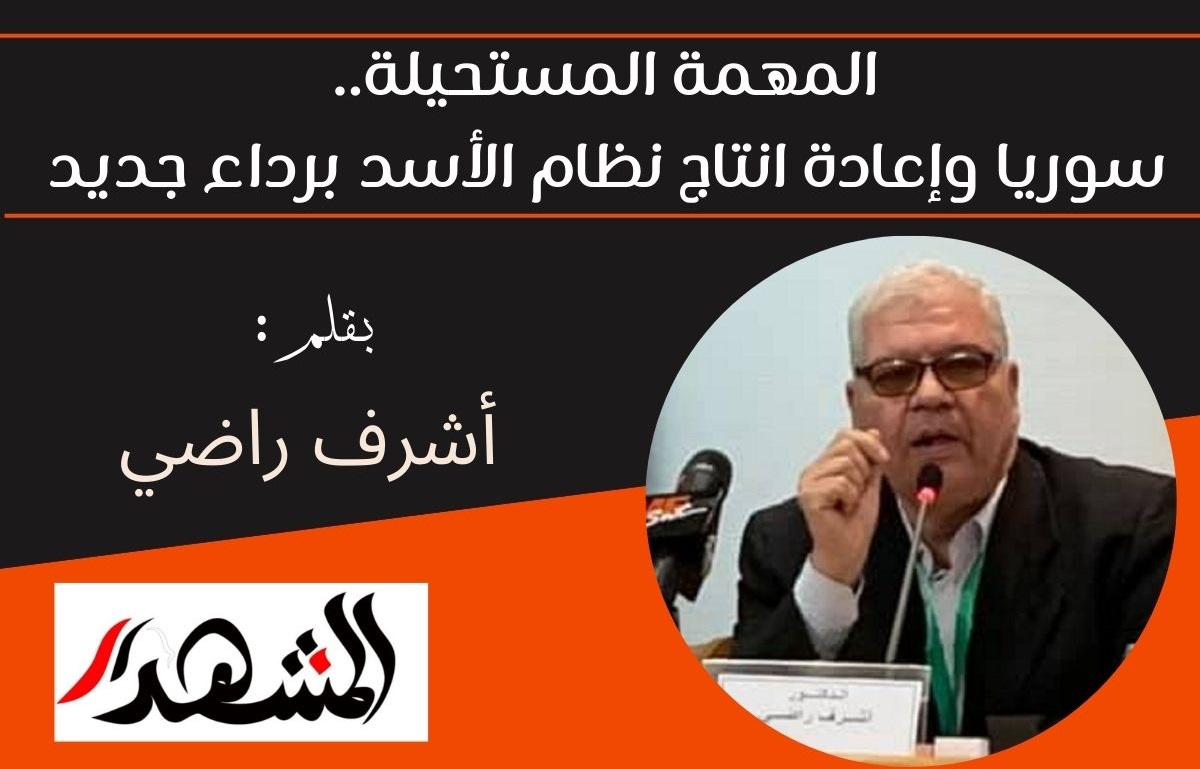يسود اعتقاد لدى قطاعات واسعة من النخب المثقفة في المجتمعات العربية والإسلامية، ومن ثم لدى الجمهور الأوسع، بأن استعادة مجدنا مرهون بانهيار الغرب ومجتمعاته، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاعتقاد مرتبط بالملابسات التي صاحبت التوسع الاستعماري الأوروبي في مجتمعات الشرق الأوسط بانهيار الدولة العثمانية، والتي دفعت كثير من المثقفين إلى التركيز على العوامل الخارجية للانهيار، وإغفال الأسباب والعوامل الداخلية، الأمر الذي يثير شكوكاً جدية في امتلاكنا مقومات لقيادة البشرية على طريق التقدم والحضارة، التي يمتلكها الغرب الآن، لاسيما تلك المقومات المرتبطة بالثورات الفكرية والعلمية المتعاقبة، والتي مكنت البشرية من تحقيق تقدم كبير على مستوى انتاج الثروة وتحسين شروط الحياة، على الرغم من التأثيرات الخطيرة على البيئة. غير أن الوعي بهذه التأثيرات وبروز حركات اجتماعية وسياسية وفكرية مناهضة للسياسات التي أثرت على البيئة وتبني سياسات الحفاظ على التنوع البيولوجي والثقافي والحفاظ على البيئة، هي أيضا منتجات غربية بالأساس، ومن الملاحظ أن المثقفين المرتبطين بالتيار الإسلامي يعتمدون على الآراء النقدية لمثقفين أوروبيين وامريكيين ينتمون إلى اليسار أو جماعات الخضر والمدافعين عن البيئة، للتدليل على صدق توقعاتهم بانهيار الغرب، أو إفلاسه أخلاقياً، متجاهلين حقيقة أن الرؤى النقدية التي يعتمدون عليها، رؤى غربية، لا يرى أصحابها في المجتمعات العربية والإسلامية القوى المرشحة لخلافة الغرب، وإنما يركزون على الصين والثقافات الآسيوية.
وعززت جبهات القتال المشتعلة الآن في غزة وفي اليمن، والتهديد المستمر بشن حرب ضد إيران بسبب برنامجها النووي، مشاعر الغضب لدى الجمهور العام في العالم العربي والإسلامي ومشاعر الكراهية للغرب بشكل عام ودون تمييز، بسبب سياسات حكومات دوله الداعمة لإسرائيل أو بسبب السياسات الأمريكية المعادية، كما تجلت في الغزو الأمريكي والغربي لأفغانستان في عام 2001، وللعراق في عام 2003، ومن قبلهما عقود من الاستعمار الفرنسي البريطاني لبلدان المنطقة وتقسيمها إلى دول بعد عقود من التدخل في شؤون الدولة العثمانية، في سياق ما عرف بالمسألة الشرقية. وترى قطاعات واسعة من النخب العربية والمسلمة أن هذه الحروب، التي يندرج معظمها تحت لافتة "الحرب على الإرهاب"، ما هي إلا حرب على الإسلام والمسلمين.
لقد كان انتشار الإسلام في كثير من الدول الواقعة على الضفاف الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط، والتي كانت خاضعة للإمبراطورية الرومانية حتى منتصف القرن السابع الميلادي، وتوسع دولة الخلافة الإسلامية، في العقود التالية، على أنقاض الدولة الفارسية شرقا والإمبراطورية الرومانية شمالاً وغرباً ووصولها إلى شبه جزيرة أيبيريا في عهد الأمويين، وما استتبعه ذلك من صراعات مريرة وحروب متكررة استمرت لقرون، بين الشعوب والممالك الأوروبية وبين شعوب ودول المنطقة، التي شهدت موجات من المد والجزر والتوسع والانحسار بلغت ذروتها مع قيام الدولة العثمانية وتوسعها في مناطق شرق ووسط أوروبا، في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، الذي كان بداية لانهيار الإمبراطورية الرومانية الشرقية (بيزنطة) وصعود الإمبراطورية العثمانية التي أصبحت عاصمة دولة الخلافة الإسلامية.
ورسم التوسع الإسلامي حدود العلاقة التاريخية بين البلاد الإسلامية من ناحية وبين البلاد الأوروبية من ناحية أخرى والتي كان الصراع هو السمة الغالبة عليها، لكنها لم تخل كذلك من صور للتفاعل الإيجابي والتعاون والمؤثرات الثقافية المتبادلة التي ساهمت في نهضة الشعوب على ضفتي المتوسط، كما شهدت تحالفات عابرة للهويات الثقافية والدينية بين كتل متحاربة على خلفية تباين المصالح الاقتصادية والتجارية، وإن جرى تغليف هذه الحروب بشعارات دينية. لم يكن صعود الغرب نتيجة فقط لتراجع المسلمين وتأخرهم، وإنما ارتبط بتفاعلهم مع تيارات فكرية في الغرب الإسلامي، في الأندلس، رفضتها السلطة الدينية والسياسية في المجتمعات الإسلامية، إذ لعبت المدارس الرشدية التي استندت إلى أعمال الفيلسوف العربي والإسلامي ابن رشد الحفيد المتوفي عام 1198م، والتي تأسست في المدن الأوروبية دوراً في حركة النهضة الأوروبية والإصلاح الديني والفكري. أي نهض الغرب حين أخذ بالمنهج العقلي في مواجهة الانغلاق الفكري والجمود الذي شكلته المؤسسة الدينية الأوروبية ممثلة في الكنيسة الكاثوليكية، فيما تراجعت المجتمعات الإسلامية نتيجة للجمود الفكري الذي أصابها مع غلق باب الاجتهاد، الذي لم يقتصر تأثيره على المسائل الفقهية والشرعية والدينية، وإنما امتد إلى الجوانب الأخرى للتفكير والإبداع وحركة الترجمة، والتي كانت تشكل الرافعة الأساسية للنهضة العلمية والفكرية وقيادة النهوض الحضاري ليس للمجتمعات الإسلامية وحدها وإنما لمختلف المجتمعات.
هذا التبدل في المواقف فيما يخص الانفتاح الفكري والتبادل الثقافي، عامل أساسي في توفير الأجواء التي توجه التراكم العلمي والمعرفي من ثقافة لأخرى ومن منطقة جغرافية لأخرى.
عملية التراكم هذه بلغت مستويات غير مسبوقة مع انتقال المجتمعات البشرية إلى عصر التنوير والثورة الصناعية وما واكبها من ثورات اجتماعية وسياسية وعلمية كان لها تأثير كبير على مختلف المجتمعات في أنحاء العالم الذي أصبح أكثر ترابطاً وقابلية للتأثر بأي حدث يقع في أي مكان، على النحو الذي كشفته جائحة كوفيد-19، التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021، ولم يتمكن العالم من احتواء أثارها والتعامل معها إلا من خلال التعاون والجهود المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات العملية. بالتأكيد لعبت مراكز البحوث والمعامل في الجامعات الغربية الدور الأكبر في تطوير الأمصال اللازمة مستفيدة من تراكم الخبرة والعلوم فيها. وباتت البشرية أكثر إدراكا لمواطن الضعف التي قد تدفع بمجتمع من المجتمعات إلى الهاوية، وأكثر إدراكاً كذلك للمخاطر التي قد ترتبت على ذلك بالنسبة للمجتمعات الأخرى، لكن هذا الإدراك الناشئ لم يصل بعد حداً من القوة يكفي لدفع العالم في إعادة النظر في كثير من الصراعات والتناقضات والتفاوتات فيما بين المجتمعات ومدى خطورتها على الحضارة الإنسانية المعاصرة. ولم يعد للتباينات والاختلافات الثقافية تأثير كبير في ظل الثورات العلمية المتلاحقة التي تفرض على البشر تحديات مغايرة.
الوعي الكوكبي بالمخاطر
لم تعد لعبة الريادة في الحضارة الإنسانية الراهنة مباراة صفرية بين الدول والمجتمعات المتنافسة على الزعامة، بل بات هناك إدراك متزايد للمخاطر التي قد تترتب على انهيار هذه الدولة أو تلك من الدول القائدة في العالم، ويكفي النظر إلى تأثير سلسلة القرارات الاقتصادية الحمائية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكي ندرك مدى تأثر المجتمعات المختلفة بما يحدث في مجتمع مثل المجتمع الأمريكي، وما الذي يمكن أن يترتب على اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة تهدد الاستقرار في هذه الدولة القارية المتعددة الثقافات والقوميات والأعراق، كذلك الأمر فيما يخص دولة بجحم روسيا أو أي دولة أوروبية كبيرة. حتى الدول التي لا تساهم بنسبة مؤثرة في التجارة العالمية أو التي لا تؤثر في كثير من العمليات الدولية، فإن تأثير أي اضطراب فيها قد يتجاوز حدودها، ولعل اليمن يقدم نموذجاً واضحاً لذلك. فالتأثير الذي ترتب على مشاركة جماعة الحوثي في الحرب في غزة، سواء بإطلاق صواريخ ومسيرات بعيدة المدى تستهدف إسرائيل أو بالتأثير على حركة الملاحة الدولية المتجهة إلى إسرائيل عبر باب المندب، كان لها تأثيرات بعيدة المدى على التجارة والاقتصاد العالمي. المشكلة تتمثل أن هذا الإدراك المتنامي للمخاطر المشتركة، لم يصاحبه إدراك بأهمية التعاون من أجل النفع العام للبشر، بسبب طبيعة الاقتصاد السياسي العالمي الموجه بمبدأ الربح.
هناك مفكرون في المجتمعات الغربية ينبهون لأهمية هذا الأمر، مثل نعوم تشومسكي، بل إن التفكير النقدي الذي يعد أحد المكتسبات الأساسية للحداثة وما يطرحه من إشكاليات أخلاقية، وما يقترحه من ضوابط أخلاقية على بعض جوانب النشاط البشري المختلفة، قد يمثل بداية تحول تحتاجه البشرية في هذه المرحلة. إن النقاش العالمي حول قضايا البيئة الناجمة عن التغير المناخي وما ينتجه من تغيرات تؤثر على الكثير من المجتمعات، دفع العلماء والباحثين والمفكرين والنشطاء المعنيين إلى التركيز على ضرورة التحرك الواعي من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيولوجي، وكذلك الانتباه إلى مسألة التنوع الثقافي واحترام الثقافات المختلفة، ومحاولة فرض احترام الحقوق الطبيعية والمكتسبة للإنسان على الحكومات المختلفة، والابتعاد عن تسييس هذه القضايا. لكن البشرية لا تزال تخطو خطواتها الأولى على هذا الصعيد. لقد بدأت الدول التي كانت حاضنة للفكر الإسلامي المنغلق والمعادي للمجتمعات الغربية تدرك خطورة سياساتها وتشجيعها للحركات الإسلامية المتشددة والمتطرفة واستغلالها في الصراعات السياسية الأوسع، على النحو الذي بينته تجربة الاعتماد على هذه الجماعات للتصدي للغزو السوفيتي لأفغانستان في فترة الثمانينات، والتي تمت بإشراف ومباركة من الولايات المتحدة بوصفها زعيمة العالم الغربي. وبدأت المجتمعات جميعا تدرك خطورة هجمات 11 سبتمبر 2001، التي كانت تعبيراً واضحاً على موقف هذه الجماعات المعادي للمراكز الرئيسية في الغرب في أمريكا الشمالية وفي أوروبا الغربية والساعي لتدميرها باللجوء إلى العنف الذي يستهدف المدنيين دون تمييز، وكيف امتد تأثير هذه السياسات سلباً على المجتمعات الأخرى، نتيجة لتعزيز التدابير الأمنية وتقييد الحرية في كثير من المجتمعات.
ومع الانتباه إلى الأشكال المختلفة لأنشطة الجماعات الإرهابية التي تسعى للتأثير على أساليب الحياة في المجتمعات الغربية، بدأت الدول والحكومات المختلفة تدرك أن تأثير هذا الإرهاب نتيجة للعولمة التي باتت سمة رئيسية لهذه المرحلة من مراحل تطور الحضارة الإنسانية لن يقتصر على مجتمعات دون غيرها، بل سيؤثر على المجتمعات المختلفة الأمر الذي دفع كثيراً من الدول إلى وضع السياسات الأمنية والتعاون في هذا المجال بغض النظر عن الاختلافات الثقافية فيما بينها، بل بدأت الدول في البحث في الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف ووضع البرامج للتعامل معه ومكافحته. ويعبر هذا التحول عن إدراك متنامي لدى قطاعات من النخب في المجتمعات العربية والإسلامية إلى المخاطر التي قد تواجهها إذا واجهت المجتمعات الغربية أزمات تهدد استقرارها وازدهارها. وليست مظاهر التعاون فيما بين المجتمعات المختلفة لمواجهة المخاطر المشتركة سواء الناجمة عن التغير المناخي أو عن السياسات المزعزعة للاستقرار سوى بداية لوعي جديد لمسألة المنافع التي قد يجري تحقيقها من خلال الازدهار المشترك.
إن التناقضات المصاحبة للعولمة والتي تشجع الكثير من الحركات المضادة لهذه العملية سواء في المجتمعات الغربية، والتي تجسدها التيارات الشعبوية وقوى اليمين الجديد العنصرية والفاشية، تهدد النموذج الذي تطور في هذه المجتمعات وسمح لها بقيادة الحضارة الإنسانية في الحقبة الرأسمالية، في المقام الأول، وقد يكون التهديد الذي تشكله للمهاجرين الأجانب ثانوياً. وقد تتلاقى أهداف هذه الجماعات مع أهداف الجماعات الدينية الأصولية في المنطقة، على الرغم من التناقض الشديد بين تصوراتهما والعداء الواضح الذي يصنف المجتمعات وفق تعميمات متصورة وأيديولوجية. وربما كانت حرب غزة ومستوى العنف والوحشية الذي كشفت عنه تجلياً من تجليات هيمنة مثل هذه الجماعات على القرار في مجتمعاتها. والاختبار الذي تمر به المجتمعات البشرية في اللحظة الراهنة نتيجة لصعود القوى المضادة للعولمة وتوجيهها للسياسات في اتجاه مضاد لحركة التاريخ، هذا الاختبار يضع البشرية أمام احتمالات قوية للدخول في حرب مفتوحة لن تنتهي إلا بتدمير أسس وركائز الحضارة الإنسانية الراهنة وتفكيكها. البديل، في السعي لبناء تحالفات مضادة لهذه القوى على المستويات الوطنية والعالمية للتصدي للقوى المضادة للعولمة والإنسانية، وفي هذا السياق يجب إدراك أن انقاذ المجتمعات الغربية من الدمار مصلحة للبشرية كلها.
---------------------------
بقلم: أشرف راضي