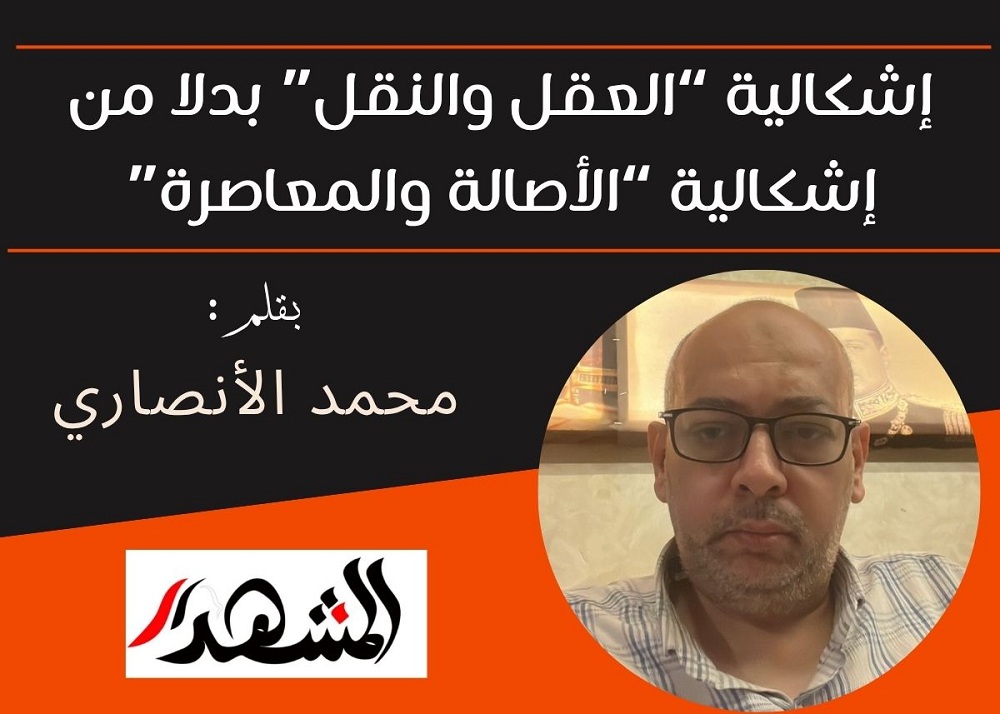بقلم / محمد الأنصاري
(لعبت الأكاديميا دورا بارزا و مؤثرا في العلاقة بين العالم العربي الإسلامي و أوروبا، و لاحقا الولايات المتحدة بمراكزها الاستشراقية و معاهدها العلمية المتخصصة في دراسة الإسلام و الشرق الأوسط. ولكن هل كان هذا الجهد العلمي - الذي اتى أغلبه من الطرف الأقوى - جهدا خالصا لا تشوبه بعض الأوهام و المغالطات والتي تم تمريرها بوعي أو بدون وعي؟ وهل كان للطرف الأضعف أوهامه و مغالطاته؟ و هل تختلف البواعث التي أدت الي هذه الأوهاموالمغالطات بين الطرفين.؟ تحاول هذه المقالة القاء الضوء على ثلاثة أوهام مركزية في الخطاب الاكاديمي لكلا الطرفين. ثم يلي ذلك الحديث عن بواعث و دوافع ذيوع هذه الأوهام . ثم الختام بإطلالة حول مستقبل الخطاب الأكاديمي سواء العربي أم الغربي و هل هو قادر على حل الأزمات العديدة الناتجة عن قصور النظرة للأخر في كلا المنظومتين المعرفيتين؟ يأتي ذلك في إطار محاولة إثراء الملف المهم الذي أفتحته جريدة المشهد حول موضوع (نحن و الغرب) منذ حوالي ثلاثة شهور
وهم امتلاك الهيمنة من خلال جدلية الاستغراب و الاستشراق
يجادل عن حق ثلة من المفكرين الغربيين المرموقين من أمثال كارل دويتش و بندكت أأندرسون و إرنست جلنر و إيلان بابي (مؤرخ إسرائيلي من حركة المؤرخين الجدد في إسرائيل)، أنه في إطار دراسات ما بعد الاستعمار، فان تاريخ نشوء القوميات يوضح أن نشوء الشعور القومي للمستعمَر ما هو الا مرآة للشعور القومي للمستعمِر و رد فعل على تبرير الاستعمار عدوانه بمبررات قومية و عرقية و دينية. نفس المعادلة تنطبق تماما على جدلية الاستشراق والاستغراب. طبعا في الحالة الثانية ربما كان ظهور المفهوم في مرحلة متأخرة عن ظهور الاستشراق و الذي يرجعه البعض الى أواخر القرن الثالث عشر حين أقدم راهب فرنسي على أول محاولة أوروبية لترجمة معاني القرآن الكريم. ولكن جزء كبير من الأزمة أنه من وجهة نظر معرفية، فإن ما يسمى ب " علم الاستغراب " هو رد فعل على الاستشراق و أدواته التي فسرها كثير من المفكرين العرب بدءا من أنور عبد الملك في الستينات و حتى حسن حنفي في الثمانينات بمحاولة الهيمنة من خلال المعرفة. ولكن سنلاحظ في هذا المقال أن هذا التفسير للهيمنة و الهيمنة المضادة من خلال الاستغراب -و إن كان يحمل شيئا من الحقيقة-غير كافي لتفسير إشكالية أوهام الاستغراب و الاستشراق بين الشرق و الغرب. و يلاحظ ان حدود هذا المقال هو اقتصار وصف الشرق على الإنتاج المعرفي العربي الإسلامي دون التطرق لمحاولات معرفية أخرى من طرف ثقافات الشرق الأقصى كاليابان و الصين نظرا لقلة بضاعة الكاتب في هذا الشأن.
أحدث ظهور كتاب إدوارد سعيد " الاستشراق" عام 1978 ما يشبه طفرة معرفية في الغرب و الشرق على السواء فيما يخص الكتابات و التعريفات حول المفهوم. أما الاستشراق كمفهوم علمي أكاديمي فلم يظهر في أوروبا الا في بدايات القرن التاسع عشر حينما أدرجت الكلمة في القاموس الاكاديمي الفرنسي عام 1838. وكان قد تم تداول المصطلح بشكل محدود في إنجلترا بدءا من عام 1779. سبق كتاب إدوارد سعيد المذكور آنفا مقالة مهمة لأنور عبد الملك ظهرت عام 1963 في مجلة "ديوجين" بعنوان " الاستشراق في أزمة." كانت هذه المقالة ذات سمة نقدية للاستشراق على مستوى النظرية و الممارسة إذ انتهى فيها الكاتب الى إن الاستشراق انتقل من علم دراسة الاخر الى ترسيخ فكرة " الذوات و العبيد". و رغم قامة أنور عبد الملك العلمية الا إنه في هذه الدراسة قام بتعميم كاسح لم يرى من خلاله أية جهود غربية استشراقية تهدف الى دراسة العرب و المسلمين دون ان تتوخى الهيمنة المعرفية و السياسية باعتبار الصلة الوثيقة في رأيه بين الاستشراق و السلطتين الاستعمارية و الامبريالية. و ربما استثنى عبد الملك بعض الجهود الاستشراقية الروسية . و يبدو أنه كان متأثرا هنا بخلفيته الماركسية. و قبل إدوارد سعيد أيضا كتب اللبناني نجيب العقيقي موسوعة " المستشرقون" في ثلاثة أجزاء. و كتب عبد الرحمن بدوي موسوعة بنفس الاسم ظهرت عام 1984 لكن كلا العملين كانا جهدا تجميعيا ببليوغرافيا لأعمال المستشرقين و ترجمة لحياتهم دون رؤية نقدية تذكر.
الولوج الى غابة التعريفات المتعلقة بالاستشراق أمر يتعدى نطاق هذا المقال. لكن يمكن الإشارة الى كتاب ادوارد سعيد كمقدمة للحديث عن وهم امتلاك الهيمنة من خلال الاستشراق قبل الحديث عن ذات الوهم فيما يخص الاستغراب او كما يسميه صادق جلال العظم في كتابه "ذهنية التحريم" : الاستشراق المعكوس. قدم ادوارد سعيد في كتابه ثلاثة تعريفات للاستشراق مختلفة و متداخلة في نفس الوقت. أولا هناك الاستشراق كمجال أكاديمي يهدف الي دراسة الشرق الأدنى و الأقصى في أفكاره و قيمه و مبادئه من وجهة نظر غربية . هناك أيضا الاستشراق كرؤية للعالم الغير غربي تهدف الي إعادة تمثله. و أخيرا عرف سعيد الاستشراق أنه نمط من الخطاب يعتمد على التمييز بين الشرق و الغرب أنطولوجيا و ابستمولوجيا. لم يذكر أيا من التعريفات الثلاثة مفهوم الهيمنة من خلال الخطاب، لكن مدار كتاب " الاستشراق" و محوره هو تفكيك الاستشراق من خلال تعرية رغبة امتلاك الهيمنة الكامنة خلفه من خلال الاستعانة بمنهج المفكر الفرنسي ميشيل فوكو المتعلق بأنظمة بالمعرفة و السلطة. و حقيقة فان الاستعمار و الإمبريالية في الأساس هما نتاج عمليات تاريخية مادية أنتجت نسق من الهيمنة الغربية بدافع النمو الاقتصادي المركانتيلي ثم الصناعي و حاجة الغرب للمصادر الطبيعية و الأسواق المحلية. هذا ما ولد خطاب الاستشراق و ليس العكس. أي أن الخطاب الاستشراقي لم يفعل سوى شرعنة الاستعمار من خلال إيجاد مبرر معرفي و أخلاقي له و بالأساس في نفس و عقل المواطن الغربي قبل أن يؤثر بشكل أو بأخر على العربي أو ألمسلم. بمعنى أخر فإن الاستعمار هو الاب الشرعي للاستشراق الذي لم يكن ليمارس أي نوع من الهيمنة الفكرية على أساس ديني أو عرقي الا من خلال السفن و المدافع التي أتى بها الاستعمار المادي. و بعد ذلك بلور المستشرق خطابا يبرر به" أخلاقيا " دوافع الهيمنة المادية. قبل وصول الغرب الى سواحل العالم الإسلامي كان الاستشراق القديم -منذ ما بعد الحروب الصليبية- يمارس دورا دفاعيا و ليس مهيمنا أمام نجاحات الإسلام النسبية في رد الحملات الصليبية. لذلك انصب جل اهتمام الاستشراق قبل الغزو الغربي الحديث في أواخر القرن الثامن عشر، على التنفير من الدين الإسلامي و من شخصية الرسول الكريم و من مضمون القرآن الكريم . و هذا موقف دفاعي في الأساس. أما الموقف الذي يسعى الى الهيمنة فقد ظهر كتبرير عرقي و ديني للهيمنة على العرب و المسلمين بغرض "تنويرهم""والارتقاء" بهم بعد وليس قبل ظهور المدافع والسفن. الاستشراق في حد ذاته لا يحمل هيمنة الا بقدر ما يوفره له الاستعمار. لذلك هو لصيق بظهور الاستعمار
وبطبيعة الحال ، لا يمكن النظر الى الاستشراق بشكل تعميمي موحد. فحتى في بواكير الاستشراق توجد كتابات قليلة متعاطفة مع الإسلام و العرب. و قد استمر هذا التيار الى وقتنا هذا. و يحلو لوائل حلاق في كتابه المهم " قصور الاستشراق" تسمية هذا التيار بالتيار العلمي و هو نقيض التيار الأيديولوجي الذي كان محوره الانتقاص من الاخر بغرض تبرير استعماره. ما يهمنا في هذا القال أمرين: أولا، التأكيد على أن الهيمنة ليست ملازمة تلازما حتميا للاستشراق منذ بدايته حتى الان. و ثانيا، استحالة حدوث الهيمنة بدون الوجود المادي و المعنوي للاستعمار كظاهرة تاريخية احلالية و أحيانا استيطانية و تهجيرية. بالنسبة لادوارد سعيد، فقد قام بأقصى ما يستطيع في كتابه للبرهنة على استخدام الاستعمار للاستشراق كعامل أساسي مساعد في احكام السيطرة الغربية على المستعمرات سواء في مرحلة الاستعمار أو ما بعد الاستعمار. حتى في مرحلة ما بعد الاستعمار يمارس الاستشراق دورا متعدد الطبقات والمستويات بعد أن تعقد الخطاب و تعددت أدواته المنهجية. المشكلة أن الكثير من أصحاب الاتجاه الإسلامي و القومي-و أحيانا الماركسي- غير قادرين على فهم تعقد و تعدد مستويات الخطاب الاستشراقي المعاصر . فهم يرونه بشكل اختزالي مكرسا للهيمنة ليس الا ولا يستطيعون ادراك ان الهيمنة في الأساس هي نظام سياسي اقتصادي يلعب فيه الاستشراق-او على وجه الدقة الاستشراق الأيديولوجي- دورا مرسوما بدقة ليس بالضرورة من زاوية التآمر. أنما كأي خطاب فكري ، توجد آليات الهيمنة ثاويه في النسق المعرفي أحيانا دون وعي، و أحيانا بوعي و تصميم. و يشير حلاق الي أن كتاباته هو وطلال أسد تصنف حتى الان من قبل كتاب غربيين ككتابات استشراقية رغم تعاطفهم الشديد مع الإسلام لمجرد أنهم يكتبون عن الإسلام و يعملون في مؤسسات أكاديمية غربية. ويشير حلاق الي ضرورة عدم التعامل مع الاستشراق ككيان واحد و لكن ادراك ان هناك استشراقات كثيرة متعددة بتعدد الكتاب. و لنا أن نتساءل مثلا ما الذي يمكن ان يجمع بين كتابات برنارد لويس و كتابات لويس ماسينيون و كلاهما ينتمي بشكل واسع الى هذه التسمية المطاطة " الاستشراق" علينا ان نكون أكثر تعقيدا إزاء الظاهرة لكي ندرك أن الهيمنة ليست صفة بنيوية لصيقة بالاستشراق . و أنه حتى الاستشراق الأيديولوجي لا يمكن أن يمارس الهيمنة الا كرد فعل لسياسات واقعية من الأنظمة الغربية المختلفة أو رد فعل على أزمات معينة من قبيل 11 سبتمبر. و أنه في الحالتين لا يشكل جهد تآمري موجه بقدر ما هو استجابة للتعطش المعرفي للمواطن الغربي أو استجابة للسياقات الأكاديمية المتعلقة بالرأي العام في الدول الغربية. فقط حينن ننظر الى الاستشراق من خلال هذا المنظور المركب، يمكن ان نتعامل معه بمنطق الحوار الحضاري و ليس بمنطق رد الفعل الذي كان مسؤولا عن الشكل و المضمون الذي ظهر به " الاستغراب " او الاستشراق معكوسا بتعبير صادق جلال العظم. ولكن الانصاف يقتضي قبل الانتقال الى الحديث عن الاستغراب ان نشير الى ان الكثير من المواطنين الغربيين يشعرون بالامتلاء و الثقة بالنفس حين يقرأون أدبيات استشراقية تحط من قدر الإسلام و العرب بشكل او باخر. بل و من الظواهر الغريبة ان هنا جيشا من الصحفيين و الإعلاميين الغربيين لم يتلقى أي تعليم يذكر عن الشرق يتغذى في مادته الإعلامية على الاستشراق الأيديولوجي. لذلك اعتبرت أن وهم امتلاك الهيمنة هو وهم من أوهام الاستشراق خاصة الأيديولوجي المعادي للإسلام و العرب. على الأقل من وجهة نظر كثير من المواطنين الغربيين و الإعلاميين. بل و بعض المستشرقين ممن هم على شاكلة برنارد لويس أو دانيل بايبس.
حين نتناول الاستغراب بالتحليل تكون المهمة أصعب لان الاستغراب ظهر كمحاولة رغائبية ساذجة تحت تأثير و هم امتلاك الهيمنة المعرفية على الأقل بلا مساندة مادية حقيقية سياسيا أو اقتصاديا. أنه أشبه بالاستمناء الفكري الذي يعبر عنه جورج طرابيشي ب " المرض بالغرب". لإنه في واقع الامر، بينما كان المنحنى الفكري للاستشراق في صعود نحو مزيد من العقلانية و الالتزام بالمعايير الاكاديمية و تحت تأثير تداخل و تطور العلوم الاجتماعية و الإنسانية, كان الاستغراب يسير في الاتجاه المعاكس. وإذا أردنا المقارنة فيكفي تأمل الفرق بين كتاب الطهطاوي قبل منتصف القرن التاسع عشر الذي يصف فيه باريس من حيث العيوب و المزايا من جهة، و بين الكتب التي تزعم دراسة الغرب في مكتباتنا العربية في القرن الواحد و العشرون.
عام 1991 أصدر حسن حنفي الكاتب غزير الإنتاج كتاب ضخم قال فيه انه البيان النظري للجبهة الثانية من مشروعه الفكري ثلاثي الجبهات : الموقف من التراث والموقف من الغرب و الموقف من الواقع. و قال حسن حنفي أيضا أنه في هذا الكتاب " مقدمة في علم الاستغراب" يرصد تطور الوعي الغربي من الصعود الى الأفول و أنه يرد الغرب الى حدوده الطبيعية. لا شك أن الدكتور حنفي رحمه الله بذل جهدا جبارا في هذا الكتاب. و لكن في رايي ان الناتج كمان متواضعا اذ غلبت على الكتاب النزعة الوصفية للتواريخ و الأسماء و الفلسفات دون تقديم نقد حقيقي للفكر الغربي اللهم الا في مواضع قليلة من خلال المقارنة بالمصطلحات التراثية و هو جوهر الجهد المبذول في الجبهة الأولى من المشروع .. ربما استغرق اعداد هذا الكتاب سنوات من الجهد الشاق و لكن للأسف أرى ان مردوده المعرفي محدود وأنه لم يقدم نقد معرفي عميق للأسس الحداثية و المادية للثقافة أو للحضارة الغربيتين. يأتي على نفس المنوال جهود المعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي تأسس في فرجينيا عام 1981. و ربما على الأقل حاول منظرو المعهد -محاولة لم تكتمل- التأسيس بمنطق يخلو من رد الفعل لعلوم اجتماعية ذات مرجعية إسلامية و ذلك يلقي ضوءا بشكل غير مباشر على ما يرونه قصور في المشروع الحداثي. ولا يجب ان أغفل هنا محاولات الدكتور المسيري في كتاباته التي نحت نحو نقد العلمانية و الحداثة و التحيز المعرفي. لكن من الانصاف أيضا ذكر أن التيار الإنساني في الفكر الغربي كان الأسبق الى القاء الضوء على هذه الإشكاليات الثلاث و ربما كانت إضافة المسيري أنه طبق هذه الإشكاليات على المجتمع الإسرائيلي في وقت مبكر لم تكن قد ظهرت فيه بعد كتابات أمثال ايلان بابي أو شلومو ساند و غيرهم. و من الجدير بالذكر أن التشكيل الثقافي و الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي هو تشكيل غربي بامتياز. لذلك يمكن اعتبار محاولات المسيري المبكرة نموذجا ناجحا و ربما وحيدا للاستغراب الناجح. لكن عودة لسؤال المقال: هل تشكل هذه الكتابات هيمنة معرفية أو سياسية؟ هل كانت نية المسيري لدى الشروع في هذا الجهد الهيمنة ام المعرفة ام الوعي؟ المشكلة ليست في نية المسيري و لا في غيره من الكتاب. المشكلة هي في البنية الرغائبية القائمة على التمني التي تتقمص شعور الهيمنة لمجرد صدور عدة كتب ناقدة لفلسفة الاجتماع الغربي. و هنا يصبح وهم امتلاك الهيمنة و هما أكاديميا ليس من زاوية اتساق المضمون المعرفي لهذا النقد و صدقه، و لكن من زاوية شعور البعض شعورا زائفا في الكثير من الأحيان باننا تفوقنا على " أعدائنا" بمجرد صدور بضعة ادبيات ناقدة لا تقدم ولا تأخر لأنه لا يدري بها الغالبية العظمى
وهم الصور النمطية
سال المداد سيلا عارما في الحديث عن إشكالية التنميط. والتعميم و هي حقيقة قائمة بدرجات متفاوتة في النسقين الاكاديميين : الاستشراق و الاستغراب. و رغم ان التعميم من المحاذير الأساسية في المجال الاكاديمي الى أن هذا لا يعني عد وقوعه في الكثير من الأحوال. و الوجه المناقض للتعميم والذي قد يؤدي الى كوارث معرفية أخرى هو الإغراق في التفاصيل و الإحصائيات و هي جريمة ترتكب كثيرا في الاستشراق المعاصر الذي ينحو جزء منه منحى إعلامي واضح. و رغم تحذير الكثير من عقلاء الغرب من فنانين و إعلاميين و أكاديميين من مغبة التعميم حول العرب و المسلمين، فان التعميم ما زال يمارس في الاكاديميا الغربية بشكل خفي و ممنهج. و لان حرية النشر واسعة في الغرب نجد كتابات كثيرة يلحق بها وصف الكتابات المتخصصة و هي أبعد ما تكون عن ذلك. من أهم أمثلة الجهود التي ترتدي عباءة أكاديمية في الغرب رغم جنوحها الى التعميم المخل في كثير من الأحيان هي كتابات دانيل بايبسDaniel Pipes الذي يدير منصة الشرق الأوسط The Middle East Forum و غالبا ما تتصدر نشرات هذه المنصة عناوين فيها تعميم مخل ثم تقوم النشرة بالتحديد و التوضيح لكي لا يستطيع أحد الإمساك بسياق التعميم. فالمقالات التي تصدرها النشرة تتصدرها عناوين مثل " المنظمات الإسلامية في أمريكا تمول حماس" ثم نكتشف ان المقال تناول بضعة منظمات معدودة و بدون أدلة كافية على مثل هذا الاتهام. و يتم تقديم بايبس في وسائل الاعلام الامريكية كخبير في دراسات الشرق الأوسط و بروفيسور سابق. غير أن النمطية تتبدى أكثر في النتاج الاكاديمي في أمور العقيدة و الفلسفة فيتم الانحياز الى المعتزلة أو الأشاعرة أو تفسيرات معينة للقرآن الكريم دون غيرها وفق رما يقتضيه السياق. و يقتضي الإنصاف الإشارة الى حركات مراجعة و تصحيح كثيرة في نطاق حقل الاستشراق.
إشكالية التنميط و التعميم حاضرة بقوة في نطاق دراسات الاستغراب. و تشير الدكتورة هبة رؤوف في كتابها " الخيال السياسي للإسلاميين ما قبل الدولة و بعدها " الى ظاهرة التنميط. أشارت الى مثال غير مسبوق على حد علمي و هو أنه حتى في رسائلنا الجامعية التي تتناول جزئيا او كليا ظاهرة سياسية او فكرية غربية فان الباحث يستخدم دائما كلمة "ديني" ليعني به المسيحية الأصولية اليمينية المتعصبة. رغم ان الأفق المعرفي للكلمة يتسع لتنويعات عديدة و متشعبة . ،نفس المثال ينطبق على استخدام مصطلح الصهيونية. فهناك الصهيونية الدينية و الصهيونية السياسية و الصهيونية الاجتماعية و الصهيونية الارثوذوكسية. ولكن كثير من الباحثين يخلط و يعمم بوعي أو غير وعي بين هذه المصطلحات بشكل مخل.
وهم الحداثة
يشير إيلان بابي في كتابه " التاريخ الحديث لفلسطين" الى انه هناك روايتان تاريخيتان من منظور قومي لتاريخ الأرض المتنازع عليها. ما يجمعهما هو الاتفاق على ان تاريخ فلسطين/ إسرائيل يبدأ من دخول الحداثة. و يعرف دخول الحداثة بالإجراءات الاقتصادية و السياسية التي أدخلها العثمانيون بعد انتهاء السيطرة المصرية على فلسطين 1831-1840 في مجال الضرائب و التمثيل السياسي للأعيان. و يقترح بابي في كتابه المذكور رواية ثالثة تحترم الحداثة و لكن لا تعتبرها نقطة البداية و بذلك نستطيع ادراج الفئات الغير مسيسة في المجتمع و هي الأغلبية من مزارعين و بدو و تجار و رجال دين. نفس الملاحظة تنطبق على الاستشراق و الاستغراب مجتمعين. فجل النتاج الغربي الحديث حول الشرق الأوسط يتبنى النمط و المنهج التحديثي و الذي يعتبر بداية التاريخ الحقيقي للشرق الأوسط هو بداية ظهور مفاهيم مثل القومية و المواطنة و السوق العالمي. أي تاريخ سابق على ذلك هو مهم فقط في القاء الضوء على تاريخ ظهور الحداثة . . لذلك حين نفتح اغلب الكتب الغربية عن التاريخ الحديث لمصر نجد ان البداية دائما الحملة الفرنسية. و للأسف تعيد كتاباتنا انتاج مثل هذه الرؤية. و لا يقترح كاتب هذا المقال تجاهل أثر الحداثة كواقع تاريخي و كاستمرارية سياسية. ولكن هناك عوامل و أحداث و تواريخ أخرى مهمة يفرضها مقاربة الموضوع. فمثلا رغم ان بيتر جران في كتابه " الجذور الإسلامية للرأسمالية في مصر 1760-1840" ينحو نحو مناصرة النمط الرأسمالي للإنتاج، الا انه كان متحررا بشكل كافي من أوهام المركزية الحداثية الغربية فاتخذ من عام 1760 تاريخ بداية كتابه لأنه كان يهدف الى ابراز جذور النهضة السياسية (ثورة علي بك الكبير 1768) و العلمية (ارهاصات التجدد العلمي في الازهر) على نمو الوعي الرأسمالي في مصر.
أما على الجانب الأخر -الاستغراب - فأننا نعتنق نموذج التاريخ من المنظور الحداثي بكليته. و ربما للتخصص الدقيق لحسن حنفي فانه تحدث في كتابه"مقدمة في علم الاستغراب" عن العصور الوسطى الغربية باستفاضة. الا إنه في رايي أخفق اخفاقا شديدا في الإمساك باستمرارية او انقطاع الأفكار ما بين العصور الوسطى و عصر النهضة وصولا الى عصر الانوار مما أفقد الكتاب الكثير من القيمة العلمية. مرة أخرى تشير هبة رؤوف ويشير وائل حلاق في كتابيهما " الخيال السياسي للإسلاميين : ما قبل الدولة و ما بعدها " و " الدولة المستحيلة" على التوالي الى ظاهرة الهوس الثقافي بالدولة ككيان قومي حديث بشل فاعلية التفكير المستقل. أكرر أني هنا لا أدعو للتخلص من منجزات الحداثة و على رأسها الدولة القومية لان هذا غير واقعي. و لكن يجب الوعي بحدود المفاهيم الحداثية لان هذا الوعي يمكننا من اكتشاف أدوار جديدة متصلة لعبتها أشكال أخرى من أشكال العمران البشري. حتى أكثر الاسلاميين مناداة بعودة الخلافة لا يملكون لها تصورا الا تحت تأثير مباشر لحضور الدولة القومية الحديثة التي شكلت وعيهم السياسي و المعرفي
بواعث الأوهام والمغالطات
تنقسم البواعث في هذا الصدد الى بواعث عن وعي و بواعث بدون وعي. بالنسبة للاستشراق فان المصالح السياسية للحكومات الغربية المختلفة (دون اللجوء الى نظرية التآمر) و الاستعلاء العنصري لدى بعض المستشرقين و مجاراة الرأي العام تعد عوامل مهمة عن وعي لإنتاج الاستشراق الأيديولوجي الذي تزداد محاولاته يوما عن يوم للتغطية على العداء باستخدام لغة أكاديمية تحقق التوازن بين الضرورات الاكاديمية و الانتشار الجماهيري. أما الاستشراق المعرفي فان التحدي الأول لديه-و الذي ينجح في تحقيقه باضطراد- هو تجاوز النموذج الحداثي دون الغاء او تجاهل مكوناته. وهذا ما اسميه الباعث اللاواعي . لإن الحداثة باعتبار حضورها الطاغي تشتغل على اللاوعي بشكل أساسي
بالنسبة للطرف الأضعف فان القضية قد تكون أبسط. يحرك كثير من مثقفينا دافع نفسي لامتلاك الهيمنة من خلال المعرفة. وبالطبع هناك مجموعه من العوامل الأخرى مثل تلبية احتياجات سوق من القراء متعطش لاسترداد الكرامة المسلوبة عبر التنفيس المعرفي ان جاز القول. و قد لا يختلف الأمر كثيرا عن المشاركة في مظاهرة أو حضور عمل فني ممتلئ بأقذع التنديدات "بالغرب المتآمر" و "الصهيونية العالمية". ألفارق الوحيد للأسف ان المنتج الثقافي الاكاديمي هنا تزينه العلمية و الموضوعية . أرجو قبل الختام أن يتضح من هذا المقال أن المسؤولية الأكبر تقع على المفكرين العرب لتفكيك الأوهام و الاساطير المحيطة بالاستشراق. ليس اعتقادا مني ان الاستشراق فعل علمني خالص منزه عن السياسة و المصالح، ولكن لمحاولة إدراك الحجم الحقيقي و التنوع العميق الذي يوجد في هذا التيار. و لان ذلك سيساعدنا نحن أولا على تفعيل اشتباك حقيقي مع الاطروحات الاستشراقية المختلفة الايدولوجية منها و العلمية.
إذا ا عرفنا هذه الأوهام و درسنا البواعث عليها يمكن أن نجد طريق عبر أكاديميا علمية و معرفية للتفاهم و التعايش و الحوار. ربما أكون حالما أو مرتدا لعصر الاغريق حيث الحاكم هو الفيلسوف. ولكن حتى لو لم نصل الى أكاديميا متحررة من الأوهام من جانب الطرفين، ربما المحاولة في حد ذاتها تستحق الجهد.
………………………..
بقلم / محمد الأنصاري