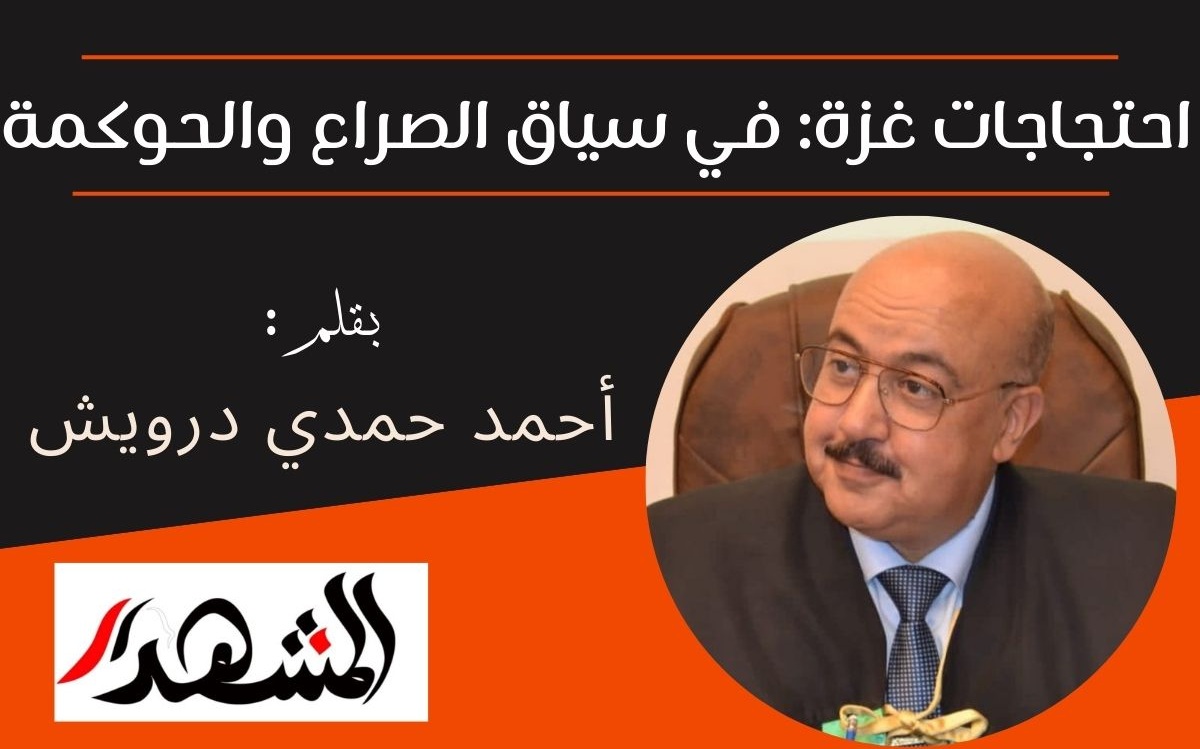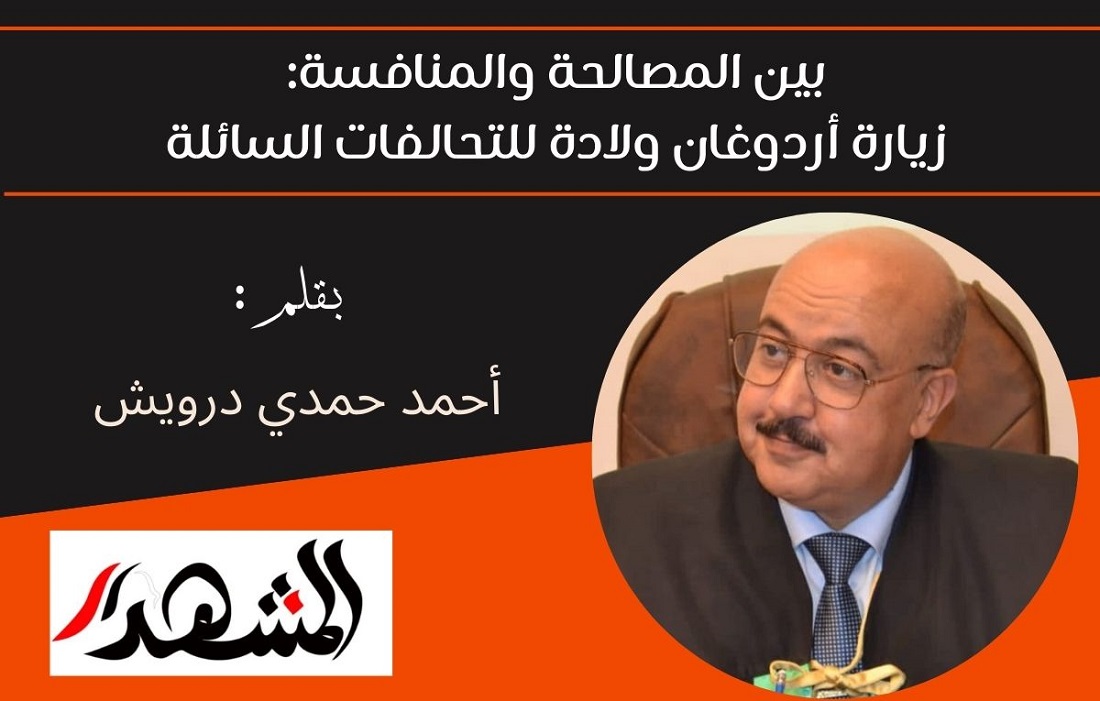تشهد مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة احتجاجاتٍ غير مسبوقة تطالب بإنهاء حكم حركة حماس، في مؤشر على تصاعد السخط الداخلي ضد سياسات الحركة، وخصوصاً في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية التي خلَّفت دماراً غير مسبوق، وتندرج هذه التحركات في إطار تفاعلات معقدة بين العوامل الداخلية والخارجية، في مشهد يعكس تفاعلًا معقدًا بين القانون الدولي، والسياسة الداخلية، والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وتفرض هذه الأحداث قراءةً متعددة الأبعاد، تلامس الإطار القانوني لشرعية الحكم، وواجبات القوى المحتلة، وحقوق المدنيين في ظل النزاعات المسلحة، فضلًا عن تداعيات الانقسام الفلسطيني على الحقوق الوطنية، ويُقدم هذا التحليل رؤيةً قانونية - سياسيةً للأزمة، مع استحضار المرجعيات الدولية والوطنية ذات الصلة ..
١. السياق القانوني للاحتجاجات: بين الحق في التعبير وواقع الحصار
تنص المادة ٢١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (١٩٦٦) على حق الأفراد في التجمع السلمي، وهو حقٌ تُخضعه التشريعات الدولية لضرورات أمن الدولة وحماية الحقوق العامة، ولكن الوضع في غزة يُضفي تعقيداتٍ استثنائية؛ فمنذ سيطرة حماس على القطاع عام ٢٠٠٧، فرضت إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا، مُستندةً إلى مبررات أمنية وفقًا للقانون الدولي الإنساني (مادة ٤٣ من لائحة لاهاي ١٩٠٧)، التي تسمح للقوة المحتلة باتخاذ إجراءات لحماية أمنها، ولكن الحصار الذي أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، يُناقش من حيث تناسبه مع مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني (البروتوكول الإضافي الأول ١٩٧٧)، وهنا تُصبح الاحتجاجات تعبيرًا عن رفض مزدوج: لسياسات حماس الداخلية، ولتداعيات الحصار الذي تُحمِّل فصائله إسرائيل وحركة حماس مسؤوليةً مشتركة عنه..
٢. شرعية الحكم وصراع الولاية: حماس والسلطة الفلسطينية
تُثير الاحتجاجات إشكاليةً دستوريةً حول شرعية حماس في حكم غزة، فمن الناحية القانونية تعتمد شرعية أي سلطة على مصدرين هما الانتخابات والسيطرة الفعلية، حيث فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام ٢٠٠٦، لكن انفرادها بالسلطة بعد اصطدامها مع حركة فتح عام ٢٠٠٧، أفرغ الانتخابات من مضمونها الدستوري، خاصةً بعد حل الرئيس محمود عباس المجلس التشريعي عام ٢٠١٨ (قرارٌ يُطعن في دستوريته وفق القانون الأساسي الفلسطيني)، ومن جهة أخرى تُعتبر السلطة الفلسطينية في رام الله، التي تُديرها حركة فتح، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، لكنها تفتقد السيطرة الفعلية على غزة، مما يضعها في إشكالية قانونية مع مبدأ الوحدة الإقليمية للدولة (المادة ٤ من القانون الأساسي)، وهذا الانقسام يُضعف الموقف التفاوضي الفلسطيني، ويُعقِّد تطبيق اتفاقيات دولية مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تفترض وجود سلطة واحدة ممثلة للشعب ..
٣. التدخل الدولي والإقليمي: التوظيف السياسي للقانون
حيث تُظهر الأزمة الحالية كيف تُوظف الأطراف الإقليمية والدولية القانون الدولي لتحقيق مصالح سياسية، فالدعوات الغربية لإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة تُقدم كحلٍ "قانوني" لإنهاء الانقسام، لكنها تتجاهل انتقاداتٍ قانونيةً موجهةً للسلطة، مثل تعاونها الأمني مع إسرائيل (المادة ٢٥ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرم التعاون في جرائم الحرب)، وفي المقابل تستخدم إسرائيل مبدأ الدفاع عن النفس (المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة) لتبرير عملياتها العسكرية، لكن المحكمة الجنائية الدولية تُحقق في انتهاكات محتملة لاتفاقية جنيف الرابعة (حماية المدنيين)، خاصةً في ضوء التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية..
أما دولٌ مثل مصر وقطر، فتلعب أدوار وساطة تستند إلى اتفاقاتٍ غير ملزمة قانونيًا (مثل اتفاقيات التهدئة ٢٠١٨-٢٠٢٣)، مما يعكس هشاشة الآليات القانونية الإقليمية.
٤. تداعيات الاحتجاجات على القانون الدولي الإنساني
تُثير الاحتجاجات أسئلةً حول التزام حماس بالقانون الدولي الإنساني كسلطة حاكمة، فوفقًا للمادة ٣ المشتركة من اتفاقيات جنيف، تتحمل الجماعات المسلحة غير الحكومية مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولكن تقارير منظمات حقوقية تتهم حماس باستخدام الدرع البشري (نشر مقاتلين في مناطق مدنية)، وهو انتهاك للمادة ٥١ من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧، في المقابل، يُمكن أن تُستخدم الاحتجاجات كدليلٍ في التحقيقات الدولية ضد إسرائيل، لإثبات أن استهداف غزة لا يُبرره "الدافع الأمني" وحده، بل يُخفي سياسةً عقابيةً جماعيةً محظورة بموجب المادة ٣٣ من اتفاقية جنيف الرابعة ..
٥. سيناريوهات مستقبلية:
نحو حلول قانونية ممكنة لتحويل الاحتجاجات إلى فرصةٍ لإنهاء الأزمة، تُطرح عدة خياراتٍ قانونية:
• تفعيل المادة ٢٤ من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تتيح للرئيس حل الحكومة والدعوة لانتخابات، بشرط ضمانات دولية لشمولية القدس والضفة وغزة ..
• التقدم بطلب رسمي إلى مجلس الأمن لتطبيق الفصل السابع من الميثاق، وإجبار إسرائيل على إنهاء الحصار، مستندين إلى رأي محكمة العدل الدولية عام ٢٠٠٤ (الجدار الفاصل) .
• تشكيل محكمة فلسطينية مستقلة للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف، كخطوة نحو مصالحةٍ تستند إلى العدالة الانتقالية .
الخلاصة: القانون كساحة صراعٍ ووسيلة حلّ
تُشكل هذه التحركات نقطة تحوّل محتملة في الديناميكيات الفلسطينية، حيث تتفاعل الضغوط الشعبية مع الحسابات الأمنية والإقليمية، ولكن نجاحها مرهون بتحوِّلها إلى حركة جماهيرية واسعة، وقدرة الفصائل على تجاوز الانقسامات لصالح أولوية إنقاذ غزة من حرب الإبادة المستمرة.
ولا تُعتبر الاحتجاجات في غزة مجرد تعبيرٍ عن السخط الداخلي فقط، بل هي انعكاسٌ لتعطيل النظام القانوني الدولي، الذي فشل في فرض حلٍّ عادلٍ للقضية الفلسطينية، فبقدر ما يُستخدم القانون أداةً للضغط السياسي (كالمحكمة الجنائية الدولية)، تظل فعاليته مرهونةً بإرادة دولية غائبة، وفي هذا السياق قد تكون الاحتجاجات فرصةً لتحريك قضية فلسطين من بوابة القانون، عبر تفعيل آليات المساءلة الدولية، وإعادة الاعتبار لشرعية النظام الفلسطيني الموحد، كمدخلٍ وحيد لإنهاء معاناة المدنيين ..
------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش