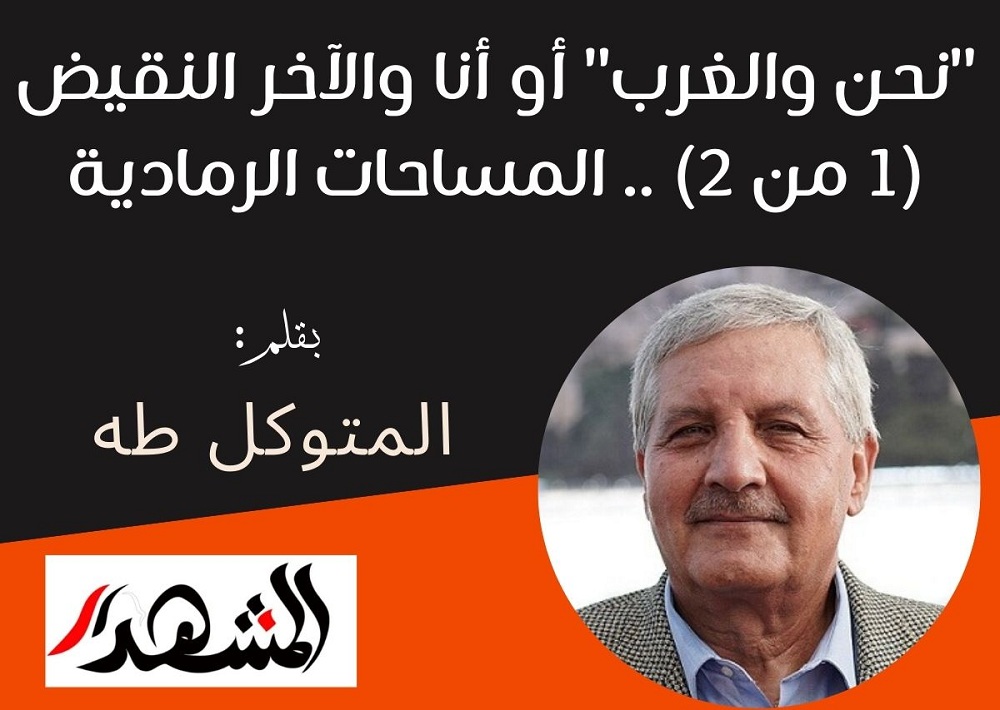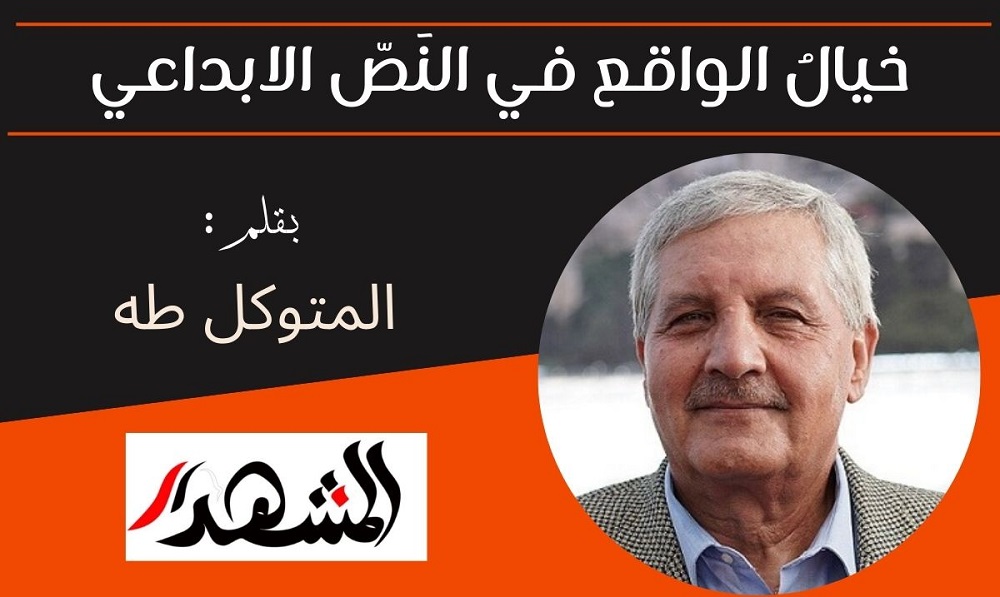***
يختلف معنى "الآخر" في فلسطين عنه في أي مكان آخر، ذلك أن "الآخر" هنا ليس مجرد فكرة، أو مجرد مُنتج صناعي أو ثقافي، بل هو يوجد في مشروع استيطاني إحلالي مرعب، يستعمل ليس، فقط، تكنولوجيته وإنما أيدلوجيته أيضاً، وهو لا يأتي بذلك منفرداً، بل يأتي معززاً برؤية غيبية وسياسية وفيزيائية غريبة ومدعومة من الغرب، رؤية مسبقة وموتورة ولها أهداف وتستعمل وسائل مجازرية.
"الآخر" في فلسطين صاعق وقوي ومسيطر ومُذِلّ وفاشيّ، لا يمكن تجميله أو أنسنته أو التوصل معه إلى نقاط اتفاق، ذلك أنه يهدف إلى سلب الأرض، من جهة، وطرد أصحابها منها، من جهة أخرى، وتسمح له عقائده وأوهامه وقوته بذلك، في الوقت الذي يتم فيه استحسان هذا العمل أو شرعنته من قبل قوى كبرى كشفت فيه عن عطبها البنيوي وعيبها العضوي.
في فلسطين، لا تتم معرفة الآخر من خلال وسائل المعرفة العادية، وإنما من خلال لغة الدم ورائحة التراب. في فلسطين، يدفع الشعب الفلسطيني دمه من أجل أن "يفهم" هذا "الآخر".
أما ما هو خارجها، فنجد أن "الآخر" يتقدم على مستوى الحضور والدبلوماسية والقبول والشرعنة والاندماج في المنطقة والتدخل في شؤونها، ويتحوّل - عملياً - إلى أهم اللاعبين وأقواهم، بل يتحول- فعلياً - إلى بوابة العبور للراغبين في الدعم الغربي والأمريكي بخاصة.
هذا "الآخر" الغريب، المحتل، يشهد عمليات تحول حقيقية في وجوده وأهدافه وكيفية التعامل معه.
أما في الغرب، فإن تلك المنظومات السياسية والثقافية والاجتماعية التي طالبت بخروجه من بلادها، تقدم له اليوم الأسباب الفكرية والعسكرية والسياسية والعقدية والمالية ليمارس الدور ذاته بحقنا.
"الآخر" الصهيوني يتحوّل في الغرب إلى "اليهودي" الجديد المبادر والشجاع الذي من حقّه أن يقيم دولة على أرضٍ ليست له، وأن يطلب من العالم كله أن يعترف بها.
فجأة، وخلال مئة عام تقريباً، يتحول "الآخر" الصهيوني إلى صانع المعجزات ومحقق النبوءات، وتتسابق دول الشرق والغرب على دعمه سياسياً وعسكرياً ومالياً، وقد نستغرب أن الغرب عموماً والولايات المتحدة خاصة تسابقا في تقديم العون المادي لإسرائيل، في السنوات التي تلت إقامتها، وقد نستغرب، أيضاً، كيف أن اليسار العربي لاحظ ذلك ولم يفعل شيئاً.
هذا "الآخر" المنتصر، استطاع أن يغيّر إلى حدٍّ ما من صورته، وأن يعمل على تقديم نفسه بطرق مختلفة، واستطاع من خلال فرض سياسة الأمر الواقع وسياسة القوة وسياسة العصا والجزرة أن يبتزّ مواقف مختلفة من الأطراف العربية المتعددة، وأن يتحول من صورة "المحتل" إلى صورة "الشريك"، ومن دولة "الكيان" إلى الدولة "العبرية"، ومن "العدو" إلى "الصديق".
والمسألة بحد ذاتها تثير الغضب بالقدر ذاته الذي تثير فيه الحيرة والعجب. فهذا "الآخر" لم يغيّر من جلده ولم يغيّر من مصطلحاته ولم يغيّر من أهدافه ولا من أساليبه، فالذي تغيّر هو "نحن". "نحن" هذه تثير الأسئلة أيضاً! فمن هي "نحن" بالضبط؟ هل هناك عدة أنواع من"نحن"هذه؟
هذه "الأنا" العربية الفلسطينية التي تعاملت وتفاعلت مع "آخر" لا يشاطرها الآراء أو الأفكار أو المعتقدات أو الأهداف، "آخر" وضع حدوداً ثقافية وإثنية وعرقية وعقدية لا يمكن القفز فوقها أو تجاهلها أو عدم اعتبارها، "آخر" نافٍ حاذف أعمى ومنتصر، و"أنا" مضطربة ومترددة ومهزومة.
المسألة لم تتوقف عند الشأن الفلسطيني فقط، فعلاقة "الآنا" بـ"الآخر" كانت جدلية تاريخية أيضاً، إذ إننا نعتقد أن أُمّتنا العربية ومن ثم العربية الإسلامية المحددة بحدود ثقافية وإثنية تميزها وتفصلها عن الأمم الأخرى تميزت بردود أفعال مختلفة تجاه "الآخر" حسب فترات الضعف والقوة. ففي فترات القوة كانت ثقافة هذه الأمّة ماصّة بامتياز وإبداع، كما شهدنا في القرن الثاني والثالث والرابع وحتى الخامس الهجري، فيما تميزت هذه الثقافة بامتصاصها الرديء والمقلّد والضعيف في فترات الضعف كما شهدنا ذلك في العصور الحديثة (لنوازن مثلاً بين ما كتبه ابن بطوطة أو أحمد بن فضلان عن "الآخر" وما كتبه الطهطاوي عن "الآخر"، لنوازن بين النصّين من ناحية أسلوب اللغة وطريقة التناول والإحساس بالتفوق والتميز).
الثقافة العربية الإسلامية اعترفت بـ"الآخر" المتعدد، وكانت صارمة في تعاملها مع "الآخر" المعتدي، وكان هذا السقف هو الذي حكم العلاقة معه في القرون السابقة واللاحقة. ومن هنا، كان "الاضطراب" في التعامل مع "الآخر" على إطلاقه؛ إذ كيف نوفق بين الإنجليزي المستعمر والإنجليزي الشاعر والمفكر والباحث؟
ما بين المطلق والنسبي كانت المراوحة وكانت منطقة الرماد، وما بين "المستحيل" و"الممكن" بلغة السياسيين، وقفت الثقافة الفلسطينية بالذات تحفر تحت هذا المعنى.. إذ كيف نوفق بين ما نعتقده عن أنفسنا وعن ثقافتنا، من جهة، وإمكاناتنا، من جهة أخرى؟ كيف نُوفق بين التاريخ والواقع؟
هذا سؤال صعب إذا عرفنا أن لغتنا العربية - وهي المحدد الأساس في اختلافنا عن الآخرين - تعطينا نموذجاً عالياً في الأخلاق والمطلقية - وهو ما اعتبره الجابري عيباً في تمثل ثقافتنا بثقافات الآخرين -.
وبعد اتفاق أوسلو رأينا صورة ملتبسة لِـ "الآخر".إذ انحلّ هذا المفهوم المطلق ليتحول إلى عدد من السياقات المختلفة.. وتفتت "الآخر" – بفعل الهزيمة – إلى عديدين.
وصار المحتل المغتصب يجبرنا على البحث عن إنسانيته، أو نقاط التقاء معه، وإلى جلد ذواتنا، ومحاكمة ثقافتنا، ولعن أجدادنا، وإلى البحث عن أجداد آخرين، والعبث واللا جدوى.
"الآخر" هو "الآخر"، لم يتغير.
أما "الأنا" فهي التي انهارت، إلى حدٍّ ما.. بشكل جارحٍ ومؤلم!
***
الأنا والآخر مولودان معاً، وهذا ما يقرره علماء الاجتماع وعلماء النفس، فالصورة التي نتخيلها عن أنفسنا لا تتم بمعزل عن صورة الآخر لدينا، كما أن صورة الآخر لدينا هي، بمعنى من المعاني، صورة عن ذواتنا.
والذات أو "الأنا"، في تعريفها الأقل تبسيطاً، هي مجموعة من النشاطات المسؤولة عن تعزيز الذات والدفاع عنها، وهو تعريف قدمه كلٌ من العالمين الاجتماعيين جيمس مارك بلدوين وتشارلس كولي اللذين لم يفرقا بين الذات "self" والأنا "ego"، بل استخدما اللفظ بمعنى واحد، ونعتقد أن تعريفهما هذا جاء بسبب طبيعة عملهما الاجتماعي، فركّزا على "النشاطات" وليس على ما "نتصوّره" عن أنفسنا، فالذات أو "الأنا" هي ما نتصوره عن "الأنا" هذه أيضاً، وليس فقط ما يصدر عنها.
وتعريف الذات يتضمن عنصرين مهمين: الأول معرفي والثاني تقييمي، والعنصران كلاهما يتشكلان خلال خبرة الذات مع نفسها وخبرتها مع الآخر، وعلى هذا فـ"الذات نسق تصوّري تطوره الكائنات البشرية أفراداً كانت أم جماعات، وتتبناه وتنسبه إلى نفسها، ويتكون هذا النسق التصوري من مجموعة من الخصائص الفيزيائية والنفسية والاجتماعية، ومن عناصر ثقافية كالقيم والأهداف والقدرات التي يعتقد الأفراد أو تعتقد الجماعة أنها تتسم بها، أما صورة الآخر فهي على هذا الأساس عبارة عن مركب من السمات الاجتماعية والنفسية والفكرية والسلوكية التي ينسبها فرد ما أو جماعة ما إلى الآخرين الذين هم خارجها".
وتجدر الإشارة هنا إلى أن صورة الذات وصورة الآخر قابلتان للتغيير والتبديل والتطوير على رغم ما يبدو عليها من سكونية، كما أن الصورة التي نشكّلها لذواتنا وللآخرين يختلط فيها الواقعي والمثالي غالباً، ويتمازج فيها البعد الداخلي (أي رؤيتنا لحقيقة أنفسنا) مع البعد الخارجي (أي ما نريد إظهاره للآخرين من صفات خاصة بنا)، ومن الممكن، أيضاً، أن تتشكل لدينا صورة انتقائية للآخر نرغب بتثبيتها في أذهاننا ونغيّب صورة أخرى عنه.
وقد شكلت العلاقة بالآخر الأساس الأهم في إنتاج صورة للذات، وتحولت إلى موضوع علمي فضلاً عن تحولها إلى موضوع إبداعي.
أما في حالتنا العربية فقد كان الآخر موجوداً دائماً، محرضاً دائماً، ومتخذاً صوراً متعددة بدأت بألوان رمادية وانتهت إلى ألوان رمادية أيضاً، وقد اتخذت العلاقة مع الآخر أشكالاً مختلفة ومتعددة، حيث لم تكن دائماً له الصورة ذاتها والتصور ذاته، بل ارتبطت صورته بتغير الأوضاع الحضارية والتاريخية لـ"الأنا"، بمعنى أن صورة الآخر والعلاقة معه كانت تتأثر سلباً أو إيجاباً، رفضاً أو قبولاً، تسامحاً أو شدة، بتطور "الأنا" التاريخية والحضارية، قوة أو ضعفاً، نصراً أو هزيمة، ونعتقد أن هذا "قانون" نستطيع به أن نحدد شكل العلاقة مع "الآخر" على المستويات جميعاً.
ويقتضي منا وصف العلاقة مع الآخر، في سياق الثقافة العربية، أن نبدأ بالعصر الجاهلي الذي كان "الآخر" فيه هو الأقوى والأعلم والأحكم، وكانت العلاقة معه تتصف بالتبعية والانبهار، ولكن - في اللحظة التي تم تسجيل أول انتصار عليه - تغيرت تلك العلاقة إلى النديّة.
وعندما جاء الإسلام الكريم وحدد المعاني والتعريفات لـ"أنا" الفردية والجمعية المسلمة و"الآخر" الكافر والذميّ، منح الذات العربية معنى مختلفاً ظل يمتلك التأثير القوي والهائل حتى لحظتنا هذه، إذ تخلّقت "أنا" قوية وعريضة وغنية، تعتقد أنها تحمل مضموناً إنسانياً وعقدياً قادراً على الجدل والمحاورة والإقناع، ومنذ تلك اللحظة صار الإسلام المرجع الأول في تحديد معنى "الأنا" ومعنى "الآخر". ولكن تحديد "الآخر" بالكافر اختفى منذ زمن بعيد، حيث اكتسب هذا المفهوم "ظلالاً بنية" – بتعبير تودوروف – منذ اللحظة التي انفتحت بها الثقافة العربية الإسلامية على "الآخر" العدو، والآخر الداخلي، والآخر الثقافي.
ما واجهته الثقافة العربية الإسلامية بعلاقتها مع هذا "الآخر" تلخّص في الآخر الداخلي أو الآخر القريب، الذي يعمل ضمن فضاء تلك الثقافة، لكنه يعمل من أجل تثبيت صوته الخاص أو رؤيته الخاصة، فكانت المعتزلة وكانت الشيعة وكان الآخرون جميعاً.
جميعهم يتميزون بالأصالة والجهد والبحث والرغبة العميقة في تأسيس هامش ضمن تيار الثقافة العريض. هذا الآخر الداخلي كان أحد العوامل التي جعلت من الثقافة العربية الإسلامية ثقافة تحقق التعددية والرؤى والاجتهادات باعتبارها جهداً دينياً يُثاب عليه، وربما كان ذلك من أهم مزايا هذه الثقافة. وفي المقابل، فإن هذا الآخر الداخلي كان، أيضاً، أحد أهم عوامل ضعف البنية السياسية والحضارية لتلك الثقافة، إذ عمل هذا الآخر الداخلي على تصدع الإطار وتخريبه – وربما تغريبه – في بعض الأحيان، فالآخر الداخلي لم يلعب في بعض الأحيان في مساحات الفكر، إنَّما لعب في ساحات الحرب، أيضاً.
وما كان لهذا "الآخر الداخلي" أن يكون أو أن يوجد لولا ذلك التسامح والقبول بالرأي الآخر في زمن القوة، إذ ما إن مال ميزان القوة هذا إلى هاوية الضعف حتى رأينا كيف تكمم الأفواه وتقطع الرقاب وتسجن العقول.
وفي زمن الضعف – زمن الدويلات والتفتت الاجتماعي والفكري والديني والسياسي – يحتل الآخر مساحات واسعة من الحضور والتعبير، ومن محاولة فرض مقولته السياسية والثقافية، فَتُطَعَّمُ هذه الثقافة بالمختلف والغريب والمستحدث والمبالغ فيه والمسكوت عنه، كالجهر بالألوهية أو ادّعائها، وكالقول بالتناسخ وتحقير جنس العرب، وتبخيس الإسلام، والالتفاف على نصوصه أو قراءتها بطريقة تخدم أغراض "الآخر" البعيدة. وفي زمن الضعف،يكشف "الآخر" الداخلي والعِرقي والديني عن نفسه، ويعرض مقولته المعززة بالسيف والكثرة، وتفقد "الأنا" مقومات الردّ المفحم والمسكت، ويبدو أن "الأنا" الضعيفة تغري بالهجوم عليها، أو تدعو إلى الانشقاق عنها، إن "الآخر" المنشق عنها أو الذي يتخلق أمامها هو مجموع ضعفها أو مساوئها أو جانبها المظلم.
ولكن، على الرغم من كل هذا، تجب الإشارة إلى الذات العربية الإسلامية في أبهى صورها، حيث قامت بتنميط صورة الآخر العرقي والديني أيضاً، فقد تعاملت هذه الذات مع غيرها بطريقة جامدة وثابتة، إذ لم تظهر هذه الذات رغبة في التعرف على غيرها، من منطلق أن الإسلام فيه الكفاية وليس هناك أفضل منه، وأن لا شيء يتعلم من الأمم الأخرى، ونلمس هذا التنميط في ما كتبه الجاحظ عن الأمم الأخرى، وما كتبه، أيضاً، أبو حيان التوحيدي، وفيما كتبه الرحّالة العرب، أيضاً، خصوصاً ابن بطوطة وابن فضلان والإدريسي وابن خلكان وحتى القزويني في عجائبه وغرائبه، إذ إن هؤلاء جميعاً رأوا الصيني صاحب صنعة، والهندي صاحب مخاريق، والإغريقي صاحب حكمة، والسوداني صاحب شهوة..إلخ، فيما رأوا العربي صاحب بيان ووفاء.
أما الذين حاولوا قراءة "الأنا" من خلال النظر إلى "الآخر"، مثل ابن خلدون في مقدمته، وابن جبير في رحلاته (وهو ما فعله رفاعة الطهطاوي في رحلته إلى باريس في العصور الحديثة) فقد واجهوا "الذات" من خلال النظر إلى الجانب المضيء من "الآخر"، الأمر الذي دفعهم إلى الحيرة والتساؤل عما يجري لهذه "الذات" من انحدار وبؤس، وهي حيرة دفعت بعضهم إلى تفضيل "الآخر" على "الآنا" في بعض الحالات – وهو ما فعله ابن جبير صراحة في ما كتب عن مشاهداته في حواضر الفرنجة المحتلين – .
حيرة هؤلاء وتساؤلاتهم نجدها، أيضاً، فيما كتبه فلاسفة المسلمين الذين حاولوا التوفيق بين "الأنا" و"الآخر" على مستوى الاستخلاصات العقلية الكبرى، فما فعله الفارابي والكندي وابن رشد من محاولة للتوفيق بين "النقل" أو الشرع و"العقل" أو الجهد الإنساني في الوصول إلى الحكمة، دفعهم إلى مواجهة ما تقوله "الأنا" وما يقوله "الآخر"، وهو أمر كلّفهم الكثير على المستوى الفكري والشخصي. كانت قراءة هؤلاء لـ"الآخر" الحكيم والمتأمل ترجمة عملية لقراءة "الأنا" أيضاً، كانت محاولة لفحص "الأنا" وقدرتها على الجدل والرد والاستيعاب، ولهذا،عندما قام الغزالي بكتابة "إحياء علوم الدين" اعتبر ذلك الرد المفحم على وجود "الآخر" في ثقافتنا حتى أيامنا هذه في أحوال معينة، وهو عمل يشابه عمل أبي موسى الأشعري قبل ذلك بمئة وخمسين سنة في الرد على المعتزلة الذين حاولوا، أيضاً، جرّ "الآخر" إلى منطقة "الأنا" لمناقشته والرد عليه مستعملين أدواته وأساليبه ومنطقة نفوذه.
وفي مرحلة الضعف يحضر "الآخر" العدوّ بكل ثقله المادي والمعنوي، وعندما يحضر بهذا الشكل، فلا داعي للنقاش والجدل، بل هي الحرب، وعندها تغيب الألوان ويطغى الأبيض والأسود فقط، وقد تكون الحرب هي أوضح فترات تحديد من هو "الآخر" ومن هي "الأنا"، وبهذا يقل الجدل الفكري. أما في حالة السلم، فإن هذا الآخر يتسلل من جديد بأشكال وألوان جديدة، ويعود التساؤل "الأبدي" عن ماهية هذين القطبين (كان المثقفون العرب القدامى يسرعون إلى توضيح انتماءاتهم، إلى أن ظهر أبو العلاء المعري الذي بدأ يتساءل عن ماهيته، وهو ما سنراه يثمر في عصرنا أسئلة صارت معتادة مثل:م َن أنا؟وهو سؤال برع فيه محمود درويش).
وعندما سجلت الثقافة العربية الإسلامية انتصارها على "الآخر" العدوّ في حروب الفرنجة، تكتفي هذه الثقافة بذاتها، تشعر بانتصارها، وأنها كانت من القوة بحيث تستطيع الرد والمواجهة، فدخلت مرحلة التكريس والتكلّس والاجترار والعيش على الأمجاد، فيما كان الآخر يستعد ويفحص ذاته ويراجع حساباته.. كان النصر الذي سجل في القرنين الثاني عشر والثالث عشر مدعاة للتأمل، ولكن ثقافتنا بعد ذلك التاريخ دخلت مرحلة عبادة ذاتها ورفض "الآخر" رفضاً باتاً وقاطعاً، ولهذا ما إن عاد "الآخر" مرة أخرى إلى المنطقة، في مطلع ما عرف بعصور النهضة، حتى انبهرت "الأنا" به انبهاراً عظيماً، عبر عنه الجبرتي في تاريخه تعبيراً بديعاً لا يخلو من طرافة.
عاد "الآخر" منتصراً، قوياً، ومسيطراً وعالماً، عاد يحمل علماً جديداً وطريقة بحث ومنهج بالإضافة إلى حملة السلاح، أيضاً، وهكذا فرض معادلته من طرفيها، فكان من الصعب على المثقف العربي أن يحدد موقفاً نهائياً من هذا "الآخر". فمن جهة، قدم له نتائج عملية وعلمية باهرة لا يمكن تجاهلها، كما قدم له منهجاً للبحث يرى فيه "أناه"، أيضاً.
كان هذا المنهج العلمي – الجديد والقائم على جمع التفاصيل، والتأليف بينها، لإثبات صحة الفرضية أو نفيها، ومن ثم إعادة فحصها من منطلق الشك بها – منهجاً جديداً لرؤية "الأنا" من زاوية أخرى. وهكذا تقع الثقافة العربية الإسلامية في إشكالية جديدة قديمة، فهي تواجه مقولة "الآخر" وتحديد آلته في أقصى حالات الضعف والخور. وبدلاً من أن يتحول "الآخر" إلى مجرد محتلّ عدو، تحول "الآخر" إلى عددٍ من "الآخرين" الذين يمكن التعامل معهم والأخذ منهم والتعاون معهم، وتحوّل هؤلاء "الآخرون" إلى المثال والنموذج والذروة الأخيرة في تطوّر البشرية. واكتشف المثقف العربي الإسلامي أن عليه أن يقفز قفزة حضارية هائلة لم يكن مستعداً لها ولا مهيئاً لتبعاتها، وكان عليه أن يتجاوز عشرات العقود من السنين ليتماشى مع ما وصل إليه "الآخر"، ومن هنا كانت ما تعرف بالصدمات والفجوات والفروق الثقافية، وما عرف بالتيارات الجديدة والمحافظة والمتطرفة في ردودها على هذا الآخر، وكانت هذه "الثورة" في التعامل مع تراث "الأنا" كله، بحيث تم تحليله ونقده والحفر فيه، وتمت إعادة النظر إلى "الأنا" من خلال "الآخر" ومناهج بحثه واستخلاصاته، وصار التعرف على "الأنا" من دون المرور بـ"الآخر" مجرد جهل وعدم معرفة، وصارت "الأنا" موضوعاً بدلاً من أن تكون "ذاتاً"، وكان أن وقع بعضهم في التغريب والغربة ومن ثم الرفض أو البحث عن بنى فكرية أخرى هي نتاج "الآخر"، أيضاً، وصار معتاداً أن يكون المثقف ماركسياً ووجودياً واشتراكياً - وهي كلها من نتاج الآخر أيضاً -.
كان حضور "الآخر" بهذا الشكل العنيف والجديد والصاعق – في مرحلة ضعف عجيبة – من أقسى وأصعب لحظات المواجهة مع "الآخر"، ولم يكن مثل هذا الوضع من قبل أبداً.. ذلك أن هذا "الآخر" لم يأت فقط بمقولته الفكرية بل جاء بمقولته "السيميوطيقية" بلغة تودوروف، أيضاً، إذ تغير شكل المدينة وشكل الأسرة وأنماط السلوك وحتى عادات الأكل، أيضاً.
وما زلنا نشهد ذروة هذا الحضور حتى هذه اللحظة، "فالآخر" اليوم يفرض مقولته "بإرادة دولية"، بمعنى أنه يفرض وصايته الكبرى على مضمون الثقافة العربية الإسلامية وشكلها، من خلال مشاريع ومبادرات يبررها القرار والدبابة والصاروخ والتمويل المشروط، وهو يقوم بتجريم كل من يرغب بالبحث أو النظر في "أناه" بطريقة تختلف عن أسلوب "الآخر" ومنهجه. والآن، يفرض "الآخر" معرفته ولا يكتفي بذلك، بل يفرض منهج معرفته، أيضاً، ولا يكتفي بذلك، أيضاً، بل يضع النتائج باعتبار أن "الآخر" هو مركز الكون، وأن مسار حضارته هو مسار الحضارات جميعاً، وأن نهايات تطوره هي نهايات العالم، وهو بهذا يلغي مسارات الآخرين ونهاياتهم، أيضاً. (يتبع)
----------------------------
بقلم: المتوكل طه *
* كاتب ومبدع فلسطيني