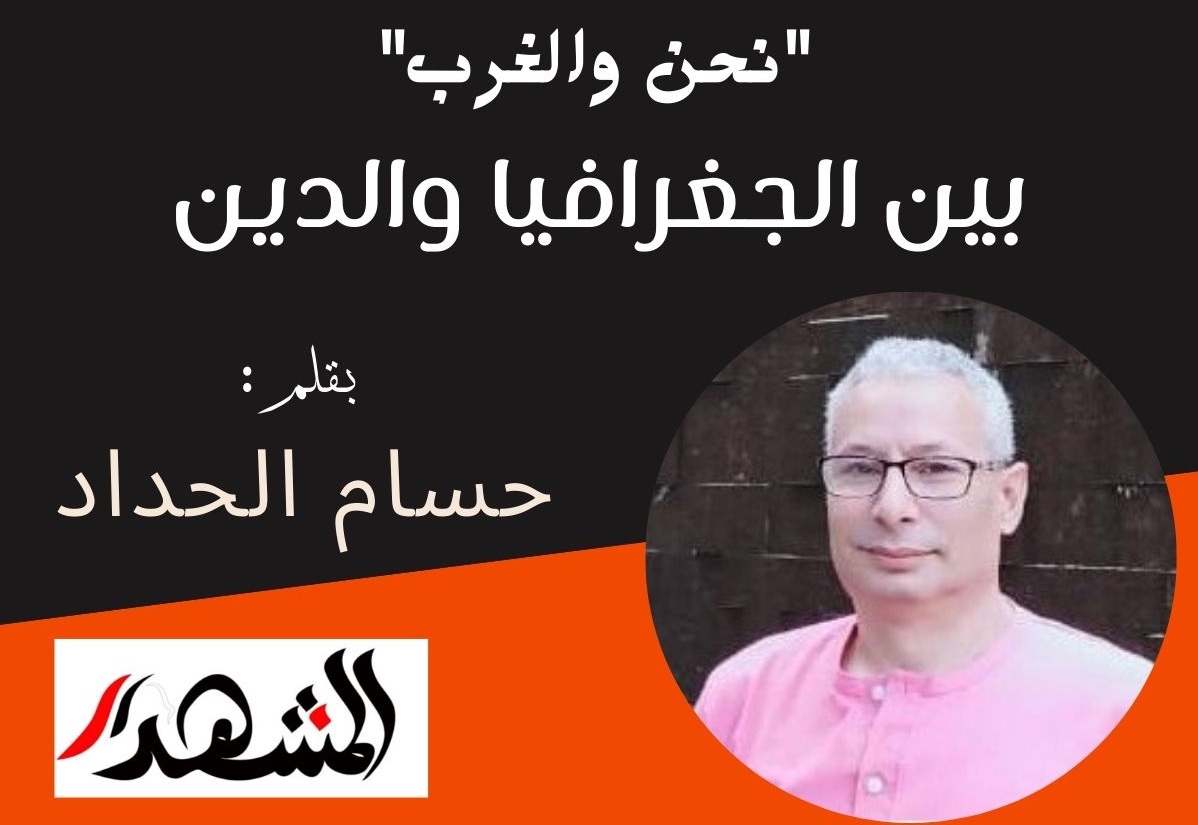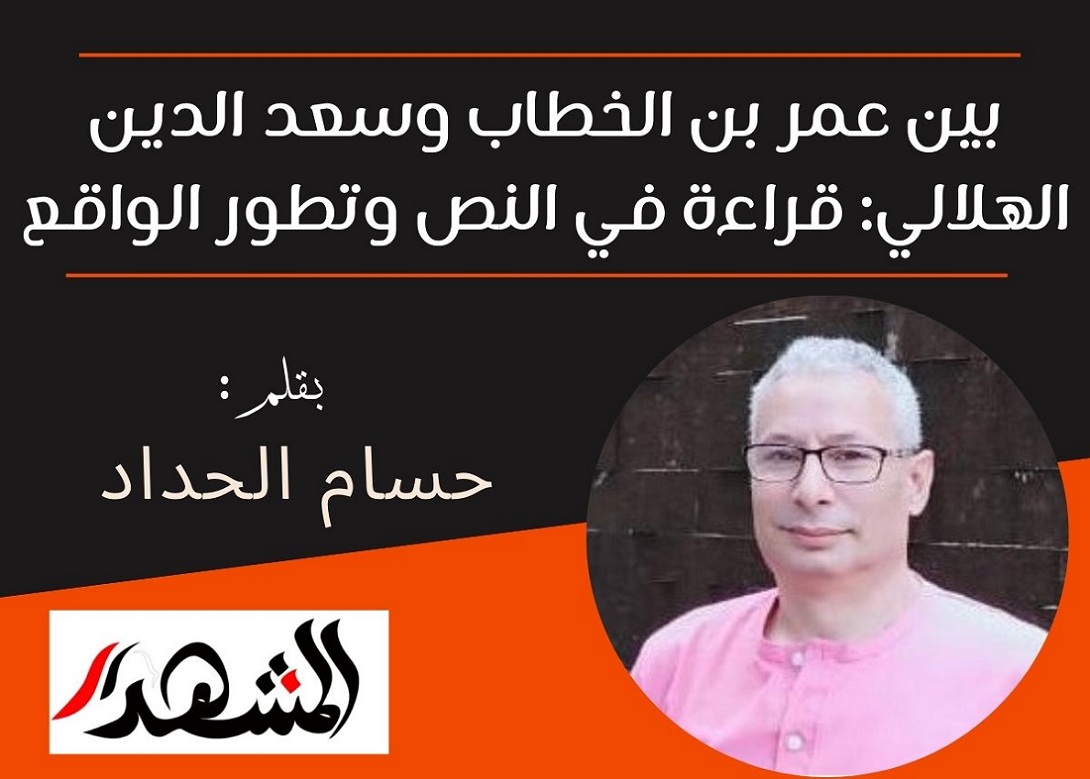بداية لابد من التوجه بالشكر للصديق الدكتور أشرف راضي على دعوتي للمساهمة في هذا الحوار بين الشرق والغرب والذي تتبناه صحيفة المشهد كما اتوجه بالشكر للاستاذ مجدي شندي على هذه المساحة المهمة للحوار البناء والذي نحن حقا بحاجة إليه الآن وكمساهمة أولية في هذا الحوار سوف أناقش واحدا من الكتب المهمة التي تناولت ذات القضية وهو كتاب "عالم بلا إسلام" للباحث والمحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جراهام فولر، حيث يعد محاولة فكرية جريئة للإجابة عن سؤال افتراضي مثير: كيف سيكون شكل العالم لو لم يوجد الإسلام؟ ويقدم فولر في هذا العمل منظورًا مختلفًا عن السرديات التقليدية التي تضع الإسلام في قلب الصراعات العالمية، حيث يجادل بأن هذه الصراعات ليست وليدة الدين، بل نتاج عوامل أعمق تتعلق بالجغرافيا، والتاريخ، والمصالح الاستراتيجية. بهذا الطرح، يسعى الكتاب إلى إعادة النظر في التفسيرات السائدة حول التوتر بين الشرق والغرب، متسائلًا عما إذا كان غياب الإسلام سيؤدي حقًا إلى عالم أكثر سلامًا.
ينطلق الكاتب من فرضية أن التوترات بين العالم الإسلامي والغرب ليست ظاهرة حديثة أو مرتبطة فقط بظهور الإسلام، بل تعود إلى عصور قديمة سبقت الدين الإسلامي نفسه. يشير إلى أن النزاعات بين الإمبراطوريات الشرقية والغربية، مثل المواجهات بين الفرس والإغريق، ثم بين روما وبيزنطة، وأخيرًا بين أوروبا والمجتمعات الشرقية المختلفة، كانت قائمة قبل ظهور الإسلام واستمرت بعده، ما يدل على أن الجغرافيا السياسية والتنافس على النفوذ لعبا دورًا حاسمًا في تشكيل تلك الصراعات. ومن هذا المنظور، يتحدى فولر الفكرة القائلة بأن الإسلام هو العامل الجوهري في هذه المواجهات، معتبرًا أن الدين كان في كثير من الأحيان مجرد غطاء لصراعات أعمق ذات جذور سياسية واقتصادية.
كما يتناول الكتاب العلاقة المتشابكة بين الغرب والعالم الإسلامي، مؤكدًا أن الإسلام لم يكن سوى جزء من المشهد العام للصراعات الحضارية. فعلى سبيل المثال، كان الصراع بين المسيحية الغربية والمسيحية الأرثوذكسية في الشرق، وكذلك التنافس بين الدول الأوروبية نفسها، دليلاً على أن الانقسامات لم تكن دائمًا دينية بحتة. يشير فولر أيضًا إلى أن الاستعمار الحديث، الذي رسم حدود العالم الإسلامي كما نعرفه اليوم، ساهم في تفاقم النزاعات عبر سياسات التقسيم والاستغلال، مما أدى إلى تعميق الفجوة بين الشرق والغرب بغض النظر عن العامل الديني.
هذا الطرح يفتح الباب لنقاش أوسع حول كيفية فهم التوترات الجيوسياسية بعيدًا عن الاختزال الديني، وهو ما يجعل الكتاب مادة خصبة للحوار والنقد. فهل يمكن بالفعل إقصاء العامل الديني تمامًا من معادلة الصراع؟ أم أن الإسلام، بصفته قوة حضارية وثقافية، كان له دور في تشكيل أنماط التفاعل بين الشرق والغرب بطريقة لم تكن لتحدث لولاه؟ هذا ما ستتناوله هذه السلسلة من المقالات في حوار مفتوح حول العلاقة بين الإسلام والغرب، في محاولة لاستكشاف مدى وجاهة أطروحة فولر وإمكانية إعادة تأطير فهمنا لهذه الإشكالية الكبرى.
الإسلام ليس المصدر الرئيسي للصراعات
يرى جراهام فولر أن الصراعات بين الشرق الأوسط والغرب ليست وليدة وجود الإسلام، بل تمتد جذورها إلى ما قبل ظهوره. فالتاريخ مليء بالتوترات بين الحضارات المختلفة، والتي غالبًا ما كانت تنشأ نتيجة المصالح الاقتصادية والتوسع السياسي أكثر من أي اعتبارات دينية. فالإمبراطوريات الكبرى، مثل الفرس والرومان، خاضت حروبًا طويلة من أجل السيطرة على طرق التجارة والموارد، وهو ما شكّل ديناميكيات الصراع بين الشرق والغرب قبل أن يصبح الإسلام عاملًا في المعادلة.
لو لم يظهر الإسلام، يرى فولر أن هذه الصراعات كانت ستستمر ولكن بواجهات مختلفة، سواء كانت دينية أو ثقافية. فبدلًا من المواجهة بين العالم الإسلامي والغرب المسيحي، كان من الممكن أن يتجسد الصراع بين الطوائف المسيحية نفسها، مثل الأرثوذكسية والكاثوليكية، التي كانت بينهما انقسامات عميقة أدت إلى حروب واضطهادات دموية عبر التاريخ. فالصراع هنا لم يكن حول العقيدة بحد ذاتها بقدر ما كان مرتبطًا بالنفوذ السياسي وهيمنة الكنيسة على المجتمعات الأوروبية.
كما أن التوتر بين الشعوب الإيرانية والأوروبية لم يكن ليتوقف، حتى لو غاب الإسلام عن المشهد. فالتاريخ القديم يوضح وجود صدامات طويلة بين الفرس والإغريق، ثم بين الفرس والرومان، في إطار صراع جيوسياسي استمر لقرون. هذه العداوات لم تكن وليدة اختلافات دينية، بل كانت مدفوعة بالرغبة في السيطرة على الأراضي والطرق التجارية الحيوية، وهو ما يعني أن أي أيديولوجية أخرى كانت ستُستخدم كذريعة للصراع، سواء أكانت قومية أو ثقافية.
وبذلك، يخلص فولر إلى أن العوامل الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية هي المحركات الأساسية للصراعات العالمية، وليس الدين بحد ذاته. فالإسلام لم يكن السبب في هذه المواجهات، بل كان جزءًا من سياق تاريخي أوسع، حيث تُوظَّف العقائد والأيديولوجيات في خدمة المصالح السياسية. ولو لم يوجد الإسلام، لكانت البشرية ستجد أيديولوجيات أخرى لتبرير صراعاتها، كما حدث في عصور مختلفة من التاريخ البشري.
الدور الجغرافي والسياسي
يشير جراهام فولر إلى أن الموقع الجغرافي للشرق الأوسط لعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار تاريخه السياسي، حيث جعله نقطة التقاء بين القارات الثلاث: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا. هذا الموقع الاستراتيجي لم يجعله مجرد نقطة عبور، بل مركزًا رئيسيًا للصراعات والنفوذ منذ العصور القديمة، حيث تنافست الإمبراطوريات الكبرى، مثل الفرس والرومان والعثمانيين، على السيطرة عليه. فالأهمية الجغرافية للمنطقة لم تكن مرتبطة بوجود الإسلام، بل كانت قائمة منذ آلاف السنين، مما جعلها دائمًا عرضة للأطماع والتدخلات الخارجية.
بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، فإن الشرق الأوسط يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي بسبب احتوائه على كميات هائلة من احتياطات النفط والغاز، فضلًا عن كونه ملتقى طرق التجارة البحرية والبرية. فمنذ عصر طريق الحرير إلى يومنا هذا، كانت المنطقة محورًا للنقل والتبادل التجاري، وهو ما زاد من أهميتها الاستراتيجية. القوى الكبرى، سواء في الماضي أو الحاضر، سعت إلى ضمان نفوذها في هذه المنطقة للتحكم في مصادر الطاقة وحماية مصالحها الاقتصادية، وهو ما يفسر استمرار التدخلات الدولية والصراعات فيها، بغض النظر عن العامل الديني.
يضرب فولر مثالًا على أن التنافس بين القوى العظمى ليس مرتبطًا بالإسلام، بل هو سمة أساسية في العلاقات الدولية. فالصراع بين الغرب وروسيا، سواء خلال الحرب الباردة أو في العقود الأخيرة، لم يكن دينيًا، بل كان قائمًا على اعتبارات جيوسياسية تتعلق بالنفوذ العسكري والتوسع الاقتصادي. وبالمثل، فإن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين لا ينبع من اختلافات دينية، بل من التنافس على الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تسعى كل قوة للحفاظ على مكانتها في النظام العالمي.
من خلال هذه الأمثلة، يؤكد فولر أن الدين ليس العامل الأساسي في صراعات القوى الكبرى، بل إن المصالح السياسية والاقتصادية هي المحرك الرئيسي. فالشرق الأوسط سيظل منطقة محورية في الاستراتيجيات الدولية ليس بسبب الإسلام، ولكن بسبب موقعه وثرواته. ولو لم يكن الإسلام موجودًا، لكانت هذه القوى ستبحث عن مبررات أخرى لتبرير سياساتها وتدخلاتها، كما يحدث في مناطق أخرى من العالم حيث تسود اعتبارات القوة والمصالح على أي عوامل دينية أو ثقافية.
الإسلام والغرب: من التعاون إلى الصدام
يشير جراهام فولر إلى أن العلاقة بين الإسلام والغرب لم تكن دائمًا قائمة على الصراع، بل شهدت مراحل طويلة من التعاون والتفاعل الثقافي والعلمي. فالتاريخ يكشف عن فترات ازدهرت فيها العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي، حيث لم يكن التنافس هو السمة الوحيدة لهذه العلاقة. في كثير من الأحيان، كان هناك تبادل للمعرفة والتأثيرات الفكرية، ما أسهم في تشكيل الحضارة الأوروبية الحديثة واستفاد منه الطرفان.
يعد عصر الأندلس مثالًا بارزًا على التعايش والتفاعل بين الإسلام والغرب، حيث كانت إسبانيا الإسلامية مركزًا للتقدم العلمي والفكري، ما جذب العلماء والمفكرين الأوروبيين إليها. في مدن مثل قرطبة وطليطلة، ازدهرت الترجمة والتأليف في مجالات الطب والفلك والفلسفة، وانتقلت المعارف العربية إلى أوروبا من خلال الجامعات والمراكز الفكرية. لم يكن الإسلام في هذه الفترة يمثل عائقًا أمام التواصل، بل كان جسرًا لعبور العلوم والفنون بين الحضارات المختلفة.
كما شهدت الحروب الصليبية، رغم كونها صراعًا عسكريًا، نوعًا من التبادل الثقافي بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي. فالحملات الصليبية لم تؤدِّ فقط إلى المواجهات المسلحة، بل أوجدت فرصًا لاطلاع الأوروبيين على أساليب الحياة الشرقية والتقدم العلمي الإسلامي، مما انعكس لاحقًا في النهضة الأوروبية. هذه الأمثلة تؤكد أن العلاقة بين الإسلام والغرب لم تكن دائمًا عدائية، بل تخللتها فترات من التعاون والتأثير المتبادل الذي ساهم في تطور الحضارتين.
الاستعمار والحداثة
يرى جراهام فولر أن الأزمات الحديثة في الشرق الأوسط لم تكن نتيجة الإسلام، بل كانت إلى حد كبير نتاج الحقبة الاستعمارية الأوروبية التي أعادت تشكيل المنطقة وفق مصالحها الخاصة. فالقوى الاستعمارية، مثل بريطانيا وفرنسا، لم تكتفِ بالسيطرة على الموارد والثروات، بل أعادت رسم الخرائط السياسية بشكل تعسفي، ما أدى إلى خلق كيانات سياسية غير مستقرة وحدود مصطنعة لم تراعِ الحقائق التاريخية والاجتماعية للسكان. هذا التدخل ترك إرثًا من الصراعات المستمرة، التي ما زالت المنطقة تعاني منها حتى اليوم.
أحد أبرز نتائج الاستعمار كان فرض سياسات التقسيم الطائفي والإثني كأداة للحكم والسيطرة. فمن خلال استراتيجية "فرّق تسد"، عززت القوى الاستعمارية الانقسامات الداخلية بين الطوائف والمجموعات العرقية، مما أسس لحالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. في العراق وسوريا ولبنان، على سبيل المثال، تم ترسيخ الطائفية كعامل حاكم في تشكيل الهياكل السياسية، وهو ما أدى لاحقًا إلى نزاعات أهلية وحروب مستمرة. لم يكن الدين هو المحرك الأساسي لهذه الصراعات، بل كان الاستعمار هو من استغل البنية المجتمعية لتحقيق مصالحه.
إلى جانب النزاعات السياسية، خلّف الاستعمار أيضًا أنظمة اقتصادية غير متوازنة تعتمد على الهياكل التي أنشأها الأوروبيون لاستنزاف الثروات. فقد تم توجيه الاقتصادات المحلية لخدمة الأسواق الغربية، مما أدى إلى تراجع التنمية المستقلة في دول المنطقة. وحتى بعد انتهاء الاستعمار الرسمي، استمرت الهيمنة الاقتصادية من خلال أنظمة تجارية ومالية أبقت على تبعية الشرق الأوسط للقوى الكبرى. وهكذا، فإن الحداثة التي فرضها الاستعمار لم تكن دائمًا عامل تقدم، بل جاءت على حساب استقرار المنطقة، وهو ما يؤكد أن الإسلام لم يكن العقبة أمام التنمية، بل كانت التدخلات الخارجية السبب الرئيسي في تعثرها.
الإرهاب: مشكلة سياسية أم دينية؟
يشير جراهام فولر إلى أن ظاهرة الإرهاب المنسوبة إلى الإسلام هي في جوهرها مشكلة سياسية أكثر من كونها دينية، حيث يرى أن التدخلات الغربية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحروب والاحتلالات العسكرية ودعم الأنظمة الاستبدادية، كانت السبب الرئيسي في ظهور الجماعات المتطرفة. فبدلًا من النظر إلى الإرهاب كنتاج لعقيدة معينة، ينبغي فهمه في سياق المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض الأفراد والجماعات إلى العنف كوسيلة للرد على القهر والتدخل الأجنبي.
في هذا السياق، يقارن فولر بين حركات المقاومة المسلحة عبر التاريخ، سواء في العالم الإسلامي أو في مناطق أخرى من العالم. فقد شهد التاريخ العديد من الحركات التي لجأت إلى العنف في مواجهة الاحتلال والهيمنة الأجنبية، مثل المقاومة الفيتنامية ضد الاستعمار الفرنسي ثم الأمريكي، أو حركات التحرر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. في جميع هذه الحالات، لم يكن الدين هو المحرك الأساسي، بل كانت القضايا السياسية، مثل الاحتلال والظلم الاقتصادي، هي التي دفعت هذه الحركات إلى تبني أساليب قتالية.
بهذا المنظور، يوضح فولر أن الجماعات التي تلجأ إلى العنف في العالم الإسلامي ليست استثناءً تاريخيًا، بل هي جزء من نمط عالمي أوسع، حيث تستخدم المظلوميات السياسية كسياق لتبرير أفعالها. وبالتالي، فإن معالجة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على الخطاب الديني أو المواجهة العسكرية، بل تتطلب فهمًا أعمق لجذوره السياسية والاجتماعية، والتعامل مع القضايا التي تغذّيه، مثل الاحتلال، والديكتاتورية، والظلم الاقتصادي.
الرسالة الأساسية
يحاول جراهام فولر في كتابه تفكيك الأطروحة الشائعة التي تُحمّل الإسلام مسؤولية الصراعات العالمية، مؤكدًا أن هذه الصراعات ليست ناتجة عن الدين بحد ذاته، بل عن عوامل سياسية وجيوستراتيجية كانت ستظل قائمة حتى في غياب الإسلام. فالتوترات بين الشرق والغرب لم تبدأ مع ظهور الإسلام، بل تعود إلى قرون من الصراع بين الإمبراطوريات والحضارات المختلفة، حيث كانت المصالح الاقتصادية والتوسع السياسي المحرك الأساسي للمواجهات.
ويشير فولر إلى أن العالم لم يكن ليخلو من النزاعات لو لم يوجد الإسلام، بل ربما كانت ستأخذ أشكالًا أخرى، مثل الصراع بين الطوائف المسيحية المختلفة، كما حدث في أوروبا بين الأرثوذكسية والكاثوليكية، أو بين البروتستانت والكاثوليك خلال الحروب الدينية الدموية في العصور الوسطى. فالتاريخ الأوروبي حافل بصراعات دينية داخلية استمرت قرونًا، مما يثبت أن الدين لم يكن العامل الوحيد في نشوب الحروب، بل كان يُستخدم كأداة ضمن صراعات السلطة والنفوذ.
كما يوضح الكاتب أن الصراع بين الشرق والغرب ليس بالضرورة دينيًا، بل يمكن أن ينبع من عوامل ثقافية وعرقية وسياسية. فقد شهد التاريخ مواجهات بين الفرس والإغريق، وبين الرومان والقبائل الجرمانية، دون أن يكون للدين دور حاسم في هذه الحروب. ولو لم يوجد الإسلام، فمن المحتمل أن تُفسَّر النزاعات الحالية في الشرق الأوسط من منظور آخر، سواء كان عرقيًا أو أيديولوجيًا، لأن التنافس على النفوذ والثروات كان وسيظل جزءًا من التفاعلات البشرية.
بهذه الرؤية، يسعى فولر إلى إعادة تأطير النقاش حول العلاقة بين الإسلام والصراعات العالمية، موضحًا أن التركيز على الإسلام كمصدر للمشكلة هو تبسيط مخلٌّ يتجاهل العوامل الأعمق التي تحرك النزاعات. فالتاريخ يثبت أن الصراعات تتجدد وفق معطيات المصالح السياسية والاقتصادية، وليس بناءً على الانتماءات الدينية وحدها، مما يستدعي تحليلًا أكثر شمولية لفهم أسباب التوترات القائمة في العالم اليوم.
الجانب النقدي:
أحد الجوانب النقدية الرئيسية لطرح جراهام فولر هو أنه يقوم على سيناريو افتراضي يصعب إثباته أو دحضه، وهو فكرة غياب الإسلام وتأثيره على مسار التاريخ. فالتاريخ ليس مجرد سلسلة من الأحداث التي يمكن حذف عنصر واحد منها دون أن تتغير النتائج بالكامل، بل هو شبكة معقدة من التفاعلات بين الدين والثقافة والسياسة والاقتصاد. وبالتالي، فإن افتراض أن الصراعات كانت ستأخذ شكلًا آخر في غياب الإسلام قد يكون صحيحًا من حيث المبدأ، لكنه لا يمكن أن يُقدَّم كحقيقة تاريخية مؤكدة، لأن مجرى الأحداث كان سيتغير بشكل جذري، مما يجعل من الصعب التنبؤ بما كان يمكن أن يحدث بالضبط.
إضافة إلى ذلك، قد يقلل فولر من تأثير العامل الديني في الصراعات العالمية، حيث إن الأيديولوجيا الدينية لعبت دورًا محوريًا في تشكيل الهويات السياسية والاجتماعية عبر التاريخ. فحتى لو لم يكن الدين هو السبب المباشر للصراعات، فإنه غالبًا ما يُستخدم كإطار تعبوي يحشد الجماهير ويوجه النزاعات. فقد كانت الحروب الصليبية، وحركات الإصلاح الديني في أوروبا، والصراعات الطائفية في الشرق الأوسط، أمثلة واضحة على كيف يمكن أن يصبح الدين عنصرًا فاعلًا في تأجيج الصراعات، وليس مجرد ستار يخفي المصالح السياسية والاقتصادية.
كما أن تحليل فولر قد يبالغ في التركيز على العوامل الجيوسياسية والاقتصادية على حساب الدين، مما قد يؤدي إلى تبسيط مفرط لبعض الأحداث التاريخية. فالصراعات لا تُختزل فقط في المصالح المادية، بل تتداخل فيها عوامل نفسية وثقافية وأيديولوجية تجعل بعض النزاعات أكثر تعقيدًا. فالتوتر بين الإسلام والغرب، على سبيل المثال، لم يكن دائمًا مجرد صراع على النفوذ، بل تضمن أيضًا أبعادًا فكرية وحضارية عميقة أثرت على رؤية كل طرف للآخر، وهو ما كان يستحق معالجة أكثر تفصيلًا في كتابه.
وأخيرًا، هناك بعض التعميمات في تحليل فولر التي قد تحتاج إلى مزيد من التدقيق، خاصة فيما يتعلق بتفسيره للعلاقات التاريخية بين الإسلام والغرب. فبينما يسلط الضوء على فترات التعاون والتبادل الثقافي، فإنه قد لا يمنح نفس القدر من الاهتمام لفترات التوتر والصدام، مما قد يعطي انطباعًا غير متوازن عن طبيعة العلاقة بين الطرفين. كان من الممكن أن يكون طرحه أكثر إقناعًا لو أنه ناقش هذه الجوانب بتفصيل أعمق، وأوضح كيف تفاعلت العوامل الدينية مع العوامل الأخرى بدلاً من التقليل من دورها في تشكيل التاريخ.
-----------------------
بقلم: حسام الحداد