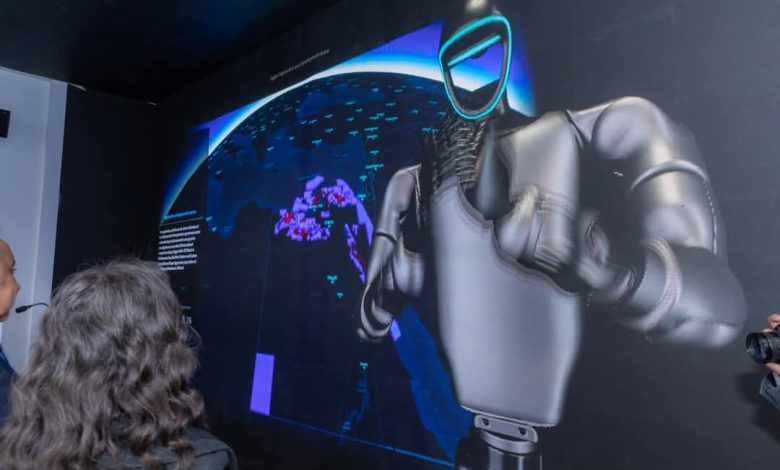“نعيش في فترة يتسم فيها التغيير بالسرعة والشمولية، وتكون فيها التداعيات السياسية للتغيير أكثر ثورية مما يُقدَّر عمومًا" هكذا قال هارولد ومارغريت سبروت في مقالهما “الجغرافيا والسياسة الدولية في عصر التغيير الثوري” في مجلة حل النزاعات الصادرة عام 1960. على الرغم من كتابهما صدر عام 1960، فإن ملاحظة آل سبروت بشأن وتيرة التغيير وتداعياته السياسية (والدولية) تبدو وكأنها مأخوذة مباشرة من عناوين الأخبار اليوم.
يبدو أننا نواجه فترة جديدة من التغيير السريع والاضطراب غير المسبوق في كل عقد، في كل جيل.
عند تقييم المستقبل، لا بد من أخذ التغيير في الاعتبار، ولكن أيضًا الاستمرارية والأنماط، فالتحولات السريعة في التكنولوجيا تخلق فرصًا جديدة وتحديات جديدة، لكنها نادرًا ما تحل بسرعة محل التقنيات الراسخة.
كما أن تغير الأعراف الاجتماعية والتوجهات السياسية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسار الدول (داخليًا وخارجيًا)، لكن التاريخ غالبًا ما يُظهر أن هذه التغييرات تتحرك في دورات وليس في خط مستقيم.
ومع شروعنا مرة أخرى في وضع توقعات للعقد القادم (وهو أمر نقوم به كل خمس سنوات)، لا بد لنا من التمييز بين ما نتوقع أن يسير وفق المسارات الحالية، وما قد تتسارع أو تتباطأ وتيرته من الاتجاهات، وما قد يكون ثوريًا بحق، وكل ذلك مع التفكير فيما هو أبعد من تقلبات اليوم.
هذه ليست مجرد محاولة للتنبؤ بالمستقبل، بل هي محاولة لفهم الديناميكيات الأساسية التي تشكّل النظام العالمي، وتقييم كيفية تفاعلها، وبالتالي تسليط الضوء على المسارات والأنماط المحتملة للمستقبل.
نحن لا نسعى إلى تشكيل المستقبل أو الترويج لنتيجة مفضلة، بل نأمل من خلال هذا التوقع أن نوفر للأفراد والمؤسسات فرصة للنظر إلى الأمام، وتقييم تأثير هذه التغيرات (أو الاستمراريات) وتداعياتها، واغتنام الفرص أو التخطيط لاستراتيجيات التكيف والتخفيف من المخاطر.
يتطلب النظر إلى عقد كامل عبر العالم بأسره (وربما إلى ما هو أبعد) تبسيطًا، ولا نزعم أننا سنكون دقيقين بنسبة 100% أو شاملين تمامًا.
هذه التوقعات لا تتعلق بالتنبؤ بالأحداث، بل نسعى من خلالها إلى تحديد الملامح العامة للديناميكيات الدولية خلال العقد المقبل بطريقة تكون موجزة بما يكفي لاستخدامها، وعامة بما يكفي لتكون ذات قيمة أوسع.
نظرة إلى الوراء، ونظرة إلى الأمام
ركزت توقعاتنا للعقد 2020-2030، التي نحن الآن في منتصفها، على اتجاه عالمي أساسي وهو عودة التعددية القطبية، ونرى أن هذا الاتجاه الأساسي سيظل المسار الأكثر ترجيحًا حتى عام 2035، وهو الأفق الحالي للتوقعات.
لا نرى عودة إلى انقسام عالمي على غرار الحرب الباردة، كما لا نرى لحظة هيمنة أمريكية (أو صينية) تعود من جديد، فالاختلافات داخل العالم الغربي والأولويات المتنافسة في الشرق تمنع هذه السيناريوهات المتطرفة.
وكما أشرنا قبل خمس سنوات: “إنه عقد ستصبح فيه المقاومة لأفكار العولمة المتطرفة أكثر وضوحًا، حيث سيتصادم تأكيد المصالح الوطنية والمحلية مع توجهات الإقليمية والعولمة".
هذا الاتجاه الأساسي لا يزال قائمًا، لكن توقعاتنا للعقد الماضي لم تتنبأ بالتأثير الكامل لأزمة كوفيد-19 على التجارة، ولا بإعادة غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 وتأثيرها على وحدة أوروبا، كما لم تتوقع التغيرات الجذرية في ميزان القوى في الشرق الأوسط التي أطلقتها حرب حماس وإسرائيل أواخر عام 2023.
وعلى الرغم من أن هذه الأحداث لا تغير الاتجاه العالمي الأكبر بشكل جوهري، فإنها تؤدي إلى تحولات كبيرة في الديناميكيات الإقليمية.
كانت توقعاتنا لعام 2020 تركز بشكل أساسي على “العوامل الحاسمة” التي تشكل العالم، أما هذه التوقعات فستأخذ نظرة أكثر شمولية على النظام العالمي ككل والديناميكيات الإقليمية أولًا، ثم تعالج العديد من هذه العوامل المحددة.
الهيكل العالمي الأوسع
ستواصل أنماط النظام التعددي الحديث تطورها خلال العقد المقبل، لكن الملامح الأساسية باتت واضحة بالفعل: لا تمتلك أي قوة كبرى القدرة (ولا الرغبة غالبًا) في تشكيل النظام الدولي بشكل أحادي، فالمصلحة الوطنية هي الدافع الأساسي لسلوك القوى الكبرى، والنزعة الأحادية عادت إلى الواجهة، والاختلافات داخل الكتل القديمة أصبحت ذات أهمية بقدر التنافس بين الكتل القائمة، فيما تستغل القوى المتوسطة هذه الفجوات لتعزيز مصالحها الإقليمية.
سيستمر تآكل الأنظمة متعددة الأطراف التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية والتي تعززت بعد نهاية الحرب الباردة، كما ستتراجع فعالية الأمم المتحدة (على الأقل كأداة لإدارة عدم الاستقرار العالمي)، وستتضاءل أهمية أنظمة مثل منظمة التجارة العالمية، لتحل محلها أدوات وعلاقات ثنائية ومتعددة الأطراف صغيرة النطاق.
تركز الولايات المتحدة بشكل كبير على الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، وتسعى إلى تأكيد مصالحها الأحادية في الخارج، وإن لم يكن ذلك انسحابًا كاملًا من العمل مع الحلفاء والشركاء، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ فيما يتعلق بالأمن التقليدي والتكنولوجي.
أما أوروبا، فتعاني من غياب قيادة مركزية قوية، حيث تواجه فرنسا وألمانيا سنوات من عدم اليقين السياسي الداخلي، في ظل محاولات لتعزيز الاستقلالية الأوروبية وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين، لكنهما لا تزالان عالقتين في تنافس داخلي ومصالح اقتصادية واستراتيجية وأيديولوجية متضاربة.
تباطأ تعافي الصين بعد جائحة كوفيد-19 أكثر من المتوقع، ما دفع بكين للتركيز داخليًا على إدارة التحديات الاجتماعية، سواء في المناطق الريفية وشبه الريفية أو بين فئة الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل في المناطق الساحلية الغنية.
ومن المرجح أن تشهد روسيا تسوية ما لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال السنوات الأولى من فترة التوقعات هذه، ورغم أن ذلك قد يمنح موسكو أراضي إضافية وفرصة لإعادة بعض الروابط الاقتصادية مع الغرب، فإن الاقتصاد الروسي سيظل متأخرًا عن القوى العالمية الكبرى، كما أن تخلفه التكنولوجي وأزمته الديموغرافية قد يكون لهما تأثير أعمق وأسرع مما تواجهه بعض الدول المجاورة.
وسط هذا الفراغ في القيادة العالمية، ستسعى القوى المتوسطة والصغيرة إلى المناورة بين القوى الكبرى، غالبًا من خلال تشكيل كتل إقليمية أصغر أو تكتلات قائمة على المصالح المشتركة لتحقيق مكاسب وتجنب العقوبات من قبل القوى الكبرى.
نتوقع أن تستمر دول مثل تركيا واليابان في توسيع مشاركتها وإدارتها للقضايا الإقليمية، في ظل تراجع التدخل المباشر للقوى الكبرى (أي الولايات المتحدة وأوروبا) وزيادة الاعتماد على الإدارة المحلية.
وتبقى الهند عاملًا غير محسوم، إذ من المرجح أن تحد التحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية من طموحات نيودلهي الإقليمية أو العالمية، ومع ذلك، قد يدفع تصاعد التنافس الأميركي-الصيني الهند إلى تبني خيار الحياد المستمر أو الانحياز إلى الولايات المتحدة وتعزيز تحركاتها الأمنية في المحيط الهندي، بينما تقلل من علاقاتها مع إيران والصين.
باختصار، ستسود سياسات “التعددية المتوازنة” و”التوجهات الخارجية المتعددة” بين الدول التي تحاول التكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية.
بالنسبة للشركات والمنظمات، فإن التوقعات طويلة الأجل بشأن البيئات التنظيمية والعلاقات عبر الحدود ستحتاج إلى استبدالها برؤى قصيرة الأجل، مع الاستعداد لبيئة دولية أكثر سيولة وتغيرًا.
وسيضيف تصاعد القومية الاقتصادية، وقومية المعلومات، والنزعات القومية التقليدية المزيد من العوائق أمام التجارة الدولية، ويختبر الأعراف المتوقعة، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي الذي اعتادت عليه معظم الدول خلال العقود الثلاثة الماضية.
ومع تعمق هذه الاتجاهات، قد نبدأ في رؤية انعكاسات نحو نهاية فترة التوقعات.
ستدفع المخاوف بشأن الصين والإدراك المتزايد بأن القوة الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية تعتمد على الآخرين الولايات المتحدة إلى إعادة توجيه سياستها نحو تعاون اقتصادي وسلاسل إمداد أكبر في أمريكا الشمالية لكن ذلك لن يحدث قبل فترة من الاضطرابات الكبيرة التي ستؤثر على الهياكل والأنماط القائمة.
وستسعى واشنطن أيضًا إلى إحياء التعاون متعدد الأطراف، وتهدئة التوترات مع أوروبا (أو على الأقل داخل الناتو)، وتعزيز العلاقات الأمنية مع القوى البحرية الحديثة الرئيسية الأخرى، لا سيما أستراليا واليابان والمملكة المتحدة، وربما الهند.
وستسهم زيادة استقلالية هذه الدول في مناطقها وتعزيز قدراتها العسكرية، التي تطورت خلال سنوات من الشكوك بشأن مدى موثوقية الولايات المتحدة، في تسهيل هذا التحول.
بحلول نهاية فترة التوقعات، نتوقع أيضًا أن تخرج الصين من مرحلة التركيز الداخلي وتعيد تأكيد مصالحها في محيطها الإقليمي.
دور أمني صيني أكبر
لا تزال الأزمة الديموغرافية الوشيكة للصين خارج نطاق هذا التوقع الممتد لعشر سنوات، لكن بكين ستواجه تحديات مع عدد كبير نسبيًا من الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل أو الذين يعانون من نقص في فرص العمل، والذين لن يظلوا مرتاحين للبقاء خارج سوق العمل أثناء انتظارهم فرصًا يعتبرونها أكثر ملاءمة.
وستتبنى بكين نهجًا أكثر مسؤولية ماليًا ومنطقيًا استراتيجيًا في استثماراتها ومشاريعها في البنية التحتية في الخارج، ومع تصاعد عدم الاستقرار العالمي وتراجع التواجد المادي للغرب في أزمات أوراسيا وأفريقيا الداخلية، نتوقع أن تتخذ الصين دورًا أكثر نشاطًا في القضايا الأمنية في بعض الدول الرئيسية، مما سيكسر في النهاية القيود التي فرضتها على استخدام القوة العسكرية في الخارج.
ومن المرجح أن يبدأ هذا الدور باستخدام قوات الشرطة والشركات العسكرية الخاصة، ولكن من المتوقع أن تصبح عمليات مكافحة الإرهاب التعاونية أكثر شيوعًا، خاصة مع تقليص الولايات المتحدة وأوروبا لعملياتهما العسكرية الخارجية.
على الرغم من أننا لا نتوقع غزوًا صينيًا واسع النطاق لتايوان خلال هذا العقد، إلا إذا حدث تحول كبير في الديناميكيات العسكرية والسياسية الأمريكية في المنطقة أو تغيير جذري في السياسة التايوانية، فإننا نتوقع أن تصعّد الصين من ضغوطها العسكرية حول تايوان.
وقد تتضمن هذه الضغوط مناورات عسكرية موسعة، وفرض حجر تجاري غير رسمي (أو حتى رسمي)، أو عمليات حصار صغيرة، مما سيضيف المزيد من التقلبات إلى طرق التجارة الحيوية، وقد يؤدي ذلك إلى دفع المزيد من القدرات التصنيعية التايوانية الحرجة إلى الخارج، مما قد يقلل من قيمة ما يسمى “الدرع السيليكوني” لتايوان، لكنه أيضًا قد يقلل من أهميتها بالنسبة لأوروبا أو شركاء آخرين.
صدام روسي تركي
أما روسيا، فرغم تعافيها جزئيًا من حربها الطويلة في أوكرانيا، إلا أنها ستواجه صعوبات متزايدة في إعادة تأكيد مصالحها في محيطها الإقليمي.
وستسعى موسكو إلى استعادة نفوذها في منطقة القوقاز، لكنها ستصطدم بتركيا التي تتبنى نهجًا تدخليًا متزايدًا، وبالصين التي ترى أن دول القوقاز تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الاقتصادية والنقلية في أوراسيا.
ومن المحتمل أن تبدأ العلاقات الروسية-الصينية بالتوتر بحلول نهاية فترة التوقعات، حيث ستجد موسكو أن النفوذ الصيني أصبح طاغيًا في آسيا الوسطى، بينما تحاول روسيا موازنة مصالحها الاقتصادية والاجتماعية الأساسية غرب جبال الأورال مع مناطقها في الشرق الأقصى وحتى أراضيها القطبية الشمالية الشرقية.
ستظل مسألة بقاء فلاديمير بوتين في السلطة عاملاً رئيسيًا بالنسبة لروسيا خلال هذا العقد، ووفاته أو عجزه قد يؤديان إلى صراع على السلطة في موسكو، مما قد يتسبب في تآكل السيطرة المركزية، حتى لو كان ذلك مؤقتًا، في المناطق البعيدة من البلاد، وهو أمر قد تسعى الصين وربما حتى اليابان إلى استغلاله لمصلحتهما.
أوروبا نحو اليمين
في أوروبا، سيؤدي التآكل المستمر للإجماع الليبرالي التقليدي وتبلور نزعة محافظة وطنية جديدة في جوهرها، إلى جانب تغير السياق الجيوسياسي، إلى دفع نحو تكامل أوروبي أكبر، وسيأتي هذا التوجه على حساب بعض الجوانب الأكثر تقدمية في التنظيمات والمتطلبات الأوروبية.
إن تحول سياسات الاتحاد الأوروبي نحو اليمين، إلى جانب تفكك العولمة وإضعاف المعايير الدولية والترتيبات التجارية، سيقلل من قدرة أوروبا على تشكيل القوانين والتنظيمات العالمية، مما سيجعلها، مثل غيرها، تركز أكثر على ترتيبات تجارية قصيرة الأمد ومحدودة في الخارج.
وسيظل الناتو العمود الفقري للدفاع الأوروبي، لكن الشكوك المتزايدة حول موثوقية الولايات المتحدة ستدفع أخيرًا نحو إحراز تقدم في تشكيل قوة دفاع أوروبية أكثر استقلالية، تركز في البداية على محيط أوروبا، ولكن من المحتمل أن توسع علاقاتها عبر إفريقيا جنوب الصحراء وتعمّق ارتباطها بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
على المستوى الدولي، ستتمكن مجموعات مثل البريكس من تطوير آليات، ربما تكون أقل كفاءة، لكنها لا تزال فعالة بشكل دوري في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، مما يوفر بعض العزل عن العقوبات الأمريكية (والأوروبية) وأشكال الإكراه الاقتصادي الأخرى، ما يقلل ولكن لا يلغي التأثير النسبي لهذه الأدوات الغربية.
في المقابل، ستشهد مجموعات مثل “الرباعية” و”العيون الخمس” تطورات جديدة لإعادة تشكيل هيكل أمني بحري جديد بقيادة الولايات المتحدة، يظل يركز بشكل كبير على الصين، رغم أن بكين ستكون قد وسعت شراكاتها الأمنية، حتى لو بشكل غير رسمي، عبر أوراسيا القارية وربما في أجزاء من إفريقيا.
انقسام السُنة في الشرق الأوسط
سيكون الشرق الأوسط أقل ارتباطًا بالتنافس الطائفي (السني-الشيعي-اليهودي) وأكثر تأثرًا بالتنافس داخل المعسكر السني، حيث تتنافس تركيا ودول الخليج ومصر على النفوذ من شمال شرق إفريقيا إلى جنوب آسيا.
سيحقق التقدم المتقطع في جذب الاستثمارات في البنية التحتية فرصًا اقتصادية أكبر لشرق إفريقيا، مع احتمال بروز كينيا أو تنزانيا أو أوغندا كمركز ثقل للمنطقة.
في المقابل، ستواجه غرب إفريقيا تحديات أكبر مع استقرار أو انخفاض أسعار النفط وعجز سوق العمل عن استيعاب النمو الديموغرافي المستمر.
وقد توفر حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل مساحة لظهور “خلافة” جديدة معلنة ذاتيًا، مما سيؤدي إلى تدخل عسكري أوروبي بحلول نهاية فترة التوقعات العشرية.
هذه التحديات، إلى جانب الضغوط المناخية، ستسرّع من وتيرة الهجرة، مما سيزيد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على أوروبا، ويدفعها إلى إعادة الانخراط بشكل أكثر فاعلية مع إفريقيا.
صعود منافسي البرازيل في امريكا اللاتينية
في أمريكا الجنوبية، تبدو الأرجنتين في طريقها إلى التعافي الاقتصادي، وهو ما قد يدفعها مجددًا لمنافسة طموحات البرازيل في قيادة المنطقة وتعزيز نفوذها الدولي.
ومن المرجح أن تتبنى الولايات المتحدة نهجًا أكثر انفتاحًا تجاه شمال أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك، سواء كجزء من استراتيجيتها الأمنية الإقليمية الأوسع أو لمواجهة النفوذ الصيني الحقيقي أو المتصوَّر في نصف الكرة الغربي.
وسيساهم التنافس العالمي على الموارد المعدنية في نصف الكرة الغربي في إشعال منافسة غير مباشرة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى أوروبا واليابان، مما قد يزيد من حدة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة.
اليابان قوة توازن الصين
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ستوسع اليابان دورها كأبرز قوة إقليمية موازنة للصين، من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية وتوسيع نطاق تعاونها العسكري والتركيز على جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ.
ورغم مواجهة اليابان لأزمة ديموغرافية نشطة، فمن المرجح أن تحافظ على ما يكفي من الموارد البشرية لتنفيذ استراتيجيتها البحرية والتكنولوجية، مع توسيع مبيعات الأسلحة الإقليمية وبرامج التدريب والتعاون العسكري المباشر.
من جانبها، ستعمل أستراليا، وجزئيًا نيوزيلندا، على تعزيز تفاعلها الإقليمي، مما سيزيد من فعالية اليابان في موازنة النفوذ الصيني.
وستظل أستراليا شريكًا قويًا للولايات المتحدة على غرار اليابان، لكنها ستسعى أيضًا إلى تعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية لضمان مصالحها الاستراتيجية في ظل تقلبات السياسة الأمريكية.
أما الهند، فستواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في التوازن بين المركزية والفيدرالية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز قطاع التصنيع، ومعالجة التحديات الديموغرافية، ومواجهة أزمة المياه المتفاقمة التي تهدد باضطراب القطاع الزراعي وتأثيرها على أعداد كبيرة من العمال الهنود.
باختصار، بحلول نهاية فترة التوقعات العشرية، سنشهد تحولًا نحو مزيد من التوجه الدولي، ولكن في عالم أصبحت فيه القوة موزعة على نطاق أوسع، حيث تسعى الكتل الإقليمية إلى إيجاد حلول محلية، وتركز التكتلات العابرة للحدود على قضايا محددة، بينما تصبح العلاقات التجارية والمعايير العالمية أكثر مرونة وأقل اتساقًا.
إنه عالم يتسم بتنافس شامل بين الدول القومية، يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التقليدية، ومع ذلك، ترفض معظم الدول الاصطفاف الكامل مع قوة أو كتلة كبرى، مفضلة المرونة على اليقين (وهو يقين لم يعد متاحًا في ظل اضطرابات العقد الحالي).
ستصبح مجالات التعاون في تغير المناخ، ونزع السلاح النووي، والأمن السيبراني، والسيادة المعلوماتية، وغيرها من القضايا العالمية، أقل قوة، أو ستتم إدارتها بشكل أساسي عبر تجمعات أصغر بدلاً من إجماع دولي واسع النطاق.
الذكاء الاصطناعي يسود
بحلول عام 2035، ستكون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد أثرت على جميع الصناعات تقريبًا وستصبح مدمجة بشكل وثيق في الحياة اليومية للبشر في معظم الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، على غرار النمو الهائل الذي شهدته الهواتف الذكية قبل عقدين.
ورغم أن الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في مختلف المجالات، سيظل البشر جزءًا أساسيًا من الابتكار والنشاط الاقتصادي، حيث سيظل الذكاء الاصطناعي عرضة للأخطاء ولن يصل إلى مستوى التفوق على الذكاء البشري بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي العام – وهو المرحلة التي تتفوق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري في جميع المجالات – أمرًا شائعًا، ولكن ستتسارع وتيرة تطوير الروبوتات خلال العقد المقبل، وستصبح أكثر قدرة على التنقل بفضل التقدم المستمر في تكنولوجيا البطاريات والذكاء الاصطناعي، مما سيجعل الأنظمة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي منتشرة ومعتمدة على نطاق واسع.
ستكون المنافسة الجيوسياسية على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية البرمجية والعتادية الداعمة له شرسة، لكن من المرجح أن تحافظ الولايات المتحدة على تفوقها بفضل مزيج من الاستثمارات الضخمة، ورأس المال البشري، والطاقة الرخيصة.
وسيمكن التفوق في الذكاء الاصطناعي الولايات المتحدة من جني فوائد اقتصادية وعسكرية وغيرها، مما سيعزز من نجاح الشركات الأمريكية عالميًا في مواجهة نظيراتها الآسيوية والأوروبية، حيث ستطور شركات التكنولوجيا الأمريكية النماذج الأكثر تقدمًا في الذكاء الاصطناعي، بينما ستُبقي الولايات المتحدة القيود المفروضة على تبني هذه التقنيات في حدها الأدنى.
وستكون الصين أيضًا إحدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم تأثرها في البداية بقيود التكنولوجيا الغربية، لكن بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، ستتراجع قدرة الصين على استغلال الذكاء الاصطناعي خارج حدودها، ليس فقط بسبب صعوباتها الاقتصادية الداخلية، ولكن أيضًا نتيجة القيود الصارمة التي ستفرضها حكومتها الاستبدادية المتزايدة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، مما سيحدّ من فعالية التطبيقات الصينية لهذه التكنولوجيا على المستوى الدولي.
وسيجبر الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على تخفيف أو إبطاء نهجه التنظيمي الصارم تجاه الذكاء الاصطناعي، ولن يكون ذلك كافيًا لتمكين المطورين الأوروبيين من مجاراة منافسيهم الأمريكيين أو لجعل الشركات الأوروبية تتبنى الذكاء الاصطناعي بنفس سرعة نظيراتها الأمريكية، مما سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية الاقتصادية والتكنولوجية لأوروبا، وسيفاقم من المشاعر المناهضة لشركات التكنولوجيا الأمريكية داخل القارة.
ورغم أن النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى خلق وظائف أكثر مما سيقضي عليه، إلا أن العقد المقبل سيشهد اضطرابات كبيرة في سوق العمل ضمن بعض المجتمعات، مما سيؤدي إلى تصاعد الشكوك تجاه الذكاء الاصطناعي، وفي كثير من الحالات، إلى اتساع الفجوة بين المستفيدين ماليًا من هذه التقنية وأولئك الذين لا يستفيدون منها.
وستكون ثورة سوق العمل التي يسببها الذكاء الاصطناعي مختلفة عن الاضطرابات السابقة، مثل أتمتة التصنيع في الغرب خلال القرن العشرين، في جانبين أساسيين. أولًا، سيؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي على العمال ذوي الياقات البيضاء المتعلمين، إلى جانب العمال الأقل تعليمًا من ذوي الياقات الزرقاء، وثانيًا، لن يقتصر تأثيره على صناعات أو مناطق جغرافية محددة، بل سيمتد إلى جميع القطاعات، وسيؤدي ذلك إلى تحديات سياسية واجتماعية أكثر تعقيدًا أمام الحكومات أثناء محاولتها مساعدة العمال على التكيف مع ديناميكيات سوق العمل المتغيرة، من خلال برامج إعادة التدريب وشبكات الأمان الاجتماعي.
وسيؤدي الفشل في معالجة هذه التحديات إلى تصاعد المشاعر المناهضة للحكومات والرأسمالية بين العمال الساخطين، بالإضافة إلى تفاقم آفاق التوظيف للخريجين الجدد.
فشل مكافحة التغير المناخي
من المرجح أن تفشل الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي بسبب عدم كفاية الدعم من الحكومات والمجتمعات لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري بشكل جذري، مما سيؤدي إلى تزايد الظواهر الجوية المتطرفة عالميًا بحلول عام 2035.
ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العالمية بشكل متكرر عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يحذر العلماء من أنها تمثل نقطة تحول يصبح بعدها التكيف أكثر صعوبة وتزداد الظواهر الجوية المتطرفة تكرارًا، ولن تكون أي منطقة في العالم بمنأى عن تأثير التغير المناخي.
في الولايات المتحدة، سيؤدي الإجهاد المائي إلى تهديد الإنتاج الزراعي في السهول الكبرى، في حين أن العواصف الاستوائية العنيفة المتزايدة ستشكل خطرًا على سواحل الخليج والأطلسي.
أما شمال أوروبا فسيواجه مشكلة مختلفة تمامًا تتمثل في الفيضانات المتزايدة التي قد تؤثر على النقل والزراعة، وستشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعدًا في الإجهاد المائي وارتفاع درجات الحرارة، في حين ستؤدي الفيضانات المتزايدة في معظم أنحاء الهند إلى عرقلة جهود التنمية.
وستتعرض السواحل الصينية بشكل متزايد للأعاصير المدارية الشديدة والفيضانات، بينما ستواجه المناطق الشمالية من الصين إجهادًا مائيًا وجفافًا متزايدًا.
كما أن ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي سيفتح مزيدًا من الممرات البحرية القطبية، خصوصًا الممرات القريبة من روسيا، مما سيزيد من إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية في القطب الشمالي والمناطق القريبة منه، لكن هذه التغيرات ستفرض أيضًا ضغوطًا على البنية التحتية ووسائل النقل، حيث يؤدي ذوبان الجليد الدائم وانخفاض استقرار التجمّد الشتوي إلى الحاجة لاستثمارات ضخمة في الأصول العسكرية القائمة في القطب الشمالي، خاصة في أمريكا الشمالية.
وستوجه معظم الدول جهودها المالية والسياسية حتى عام 2030، نحو تدابير التخفيف من التغير المناخي المصممة لإيقافه، ولكن بمجرد أن يتضح أن هذه الجهود غير كافية، سيتحول التركيز إلى تدابير التكيف مع التغير المناخي مع تفاقم آثاره.
وسيساعد هذا التحول الدول النامية والدول الأكثر تعرضًا للتغير المناخي في الاستجابة للظواهر الجوية المتطرفة، إلا ان تمويل هذه البرامج سيشكل تحديًا، حيث سيصبح توفير الإغاثة من الكوارث في الدول الغربية والدول المتقدمة بحاجة متزايدة إلى الموارد المالية العامة، في ظل صعوبة تكيف شركات التأمين والآليات الأخرى في القطاع الخاص مع موجات الحرائق والفيضانات والكوارث الطبيعية المدمرة.
وستؤدي هذه الاحتياجات المحلية المتزايدة للتمويل العام إلى تقليص التبرعات الموجهة للعالم النامي، كما من المرجح أن يواجه القطاع الخاص صعوبات في معالجة فجوة تمويل التكيف، إذ على عكس الاستثمارات الخاصة في مشاريع مثل مزارع الرياح، فإن تمويل مشاريع التكيف لا يوفر دائمًا مسارًا واضحًا لعوائد الاستثمار.
كما ان التنافس العالمي، لا سيما قبل عام 2030، سيعرقل جهود التنسيق، حيث ستتبع المزيد من الدول خطى الولايات المتحدة في الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ أو على الأقل تقليل أهدافها لخفض الانبعاثات.
وسيتسبب التغير المناخي في ضغوط كبيرة على إمدادات المياه والغذاء العالمية بحلول عام 2035، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وربما إثارة اضطرابات سياسية وأمنية كبيرة.
وقد أصبح إنتاج المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والقمح والذرة يتركز بشكل متزايد في عدد محدود من المناطق أو الدول، نتيجة لازدياد التجارة الزراعية العالمية وتحسن التكنولوجيا الزراعية، ولكن مع تأثر المناطق الزراعية الرئيسية بتغير المناخ – من إجهاد مائي في الولايات المتحدة، إلى فيضانات في أوروبا والهند وحوض ريو دي لا بلاتا، إلى موجات جفاف في منطقة البحر الأبيض المتوسط – فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستواجه مخاطر نقص الإمدادات بشكل أكثر تكرارًا، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتراجع المحاصيل، مما سيؤثر بشكل خاص على الدول منخفضة الدخل الأكثر ضعفًا.
وسيؤدي تفاقم انعدام الأمن الغذائي إلى زيادة احتمالية اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للحكومات، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى إسقاط الحكومات أو الأنظمة.
تحول في قطاع الطاقة
سيكون التحول في قطاع الطاقة بطيئًا خلال السنوات الخمس المقبلة،، حيث ستؤدي صعود حكومات مشككة في تغير المناخ أو ذات توجهات يمينية في العالم الغربي إلى تحويل الموارد بعيدًا عن مشاريع التحول في الطاقة نحو مشاريع تركز أكثر على النمو الاقتصادي وكذلك مشاريع التكيف مع التغير المناخي.
ولكن ستساهم استثمارات القطاع الخاص والتقدم التكنولوجي في إحداث تحول كبير في المشهد العالمي للطاقة بحلول عام 2035، وسيكون هذا التحول أكثر وضوحًا في توليد الكهرباء، حيث من المتوقع أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية حوالي ثلثي إنتاج الكهرباء العالمي بحلول عام 2035، أي ما يقرب من ضعف مستواها الحالي، وسيكون هذا التحول الأقوى في الدول المتقدمة، لا سيما في أوروبا، حيث ستظل الطموحات المناخية الأقوى عالميًا.
كما أن تزايد الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات، إضافةً إلى الاعتماد على موارد توليد متقطعة مثل الطاقة الشمسية والرياح، سيعزز الطلب على البطاريات ذات النطاق الشبكي والطاقة النووية خلال العقد المقبل.
وسيكون التحول في قطاع النقل أبطأ، حيث إن استبدال أساطيل المركبات يستغرق سنوات، وستظل المنتجات البترولية تشكل حوالي ثلاثة أرباع الطلب العالمي على النقل البري، ومع ذلك، سيؤدي التحول في هذا القطاع إلى تقليص الطلب على النفط بما يتراوح بين 10 و15 مليون برميل يوميًا، رغم أن الاستهلاك العالمي للنفط سيظل مستقرًا إلى حد كبير خلال هذه الفترة بسبب استمرار ارتفاع الطلب على النقل، خاصة في البلدان النامية والأسواق الناشئة.
وسيؤدي التحول في قطاع الطاقة وزيادة الاعتماد على الكهرباء إلى تصاعد المنافسة على المواد الخام الأساسية، ومع احتدام التنافس الجيوسياسي خلال السنوات الخمس المقبلة، ستضع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين مسألة الوصول إلى الموارد في صدارة أجنداتها الدبلوماسية عند التعامل مع الدول الأخرى.
وسيؤدي احتكار الصين لمعالجة وتعدين العديد من المعادن الحيوية إلى استخدامها كأداة ضغط في مواجهة القيود التكنولوجية المتزايدة التي يفرضها الغرب والولايات المتحدة على أشباه الموصلات والتقنيات الأخرى الصينية.
وردًا على ذلك، ستفرض الدول الغربية برامج تحفيزية ومتطلبات جديدة على القطاعين العام والخاص للحد من استخدام الموارد الصينية وتطوير بدائل غير صينية عندما يكون ذلك ممكنًا، بما في ذلك المعادن النادرة والتيتانيوم والتنغستن والصلب والألمنيوم.
كما ستتنافس الصين وأوروبا والولايات المتحدة على ضمان الوصول المادي إلى هذه الموارد—من خلال الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومرافق المعالجة وحقوق التعدين ونقاط الاختناق في النقل—وغالبًا ما ستضغط على دول أخرى، لا سيما الدول غير المنحازة مثل العديد من الدول الأفريقية، لإقصاء المنافسين.
وسيزداد الطلب بشكل كبير أيضًا على النحاس والكوبالت والليثيوم وغيرها من المواد الخام الأساسية للبطاريات والكهربة، إلا أن الاستثمارات في مشاريع التعدين الجديدة والتقنيات الحديثة—مثل استخراج الليثيوم المباشر من المحاليل الملحية أو البطاريات منخفضة النيكل—ستساعد في تجنب حدوث نقص يعيق التحول في قطاع الطاقة.
سيسفر التحول في قطاع الطاقة عن رابحين وخاسرين على المستوى العالمي، فمن المرجح أن تظل الصين رائدة في العديد من التقنيات الخضراء، حيث ستؤثر التحديات التي تواجه القدرة التنافسية الصناعية في أوروبا على قدرتها في مجاراة الصين، فيما ستواجه الولايات المتحدة قيودًا على قيادتها التكنولوجية، على الأقل خلال النصف الأول من العقد المقبل، بسبب معارضة الحكومة الجمهورية لقطاع الطاقة النظيفة ودعمها للوقود الأحفوري.
وحتى إذا أسفرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عن تغيير في الاتجاه، فمن المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة وشركاتها سنوات عدة لتقليص الفجوة مع الشركات الأجنبية التي تركز بشكل أكبر على التحول في الطاقة.
وسيؤدي استقرار الطلب على النفط الخام، وإلى حد ما على الغاز الطبيعي، إلى بقاء أسعار النفط منخفضة بالقيمة الحقيقية خلال النصف الثاني من العقد، وسيؤثر ذلك سلبًا على الدول المنتجة للنفط، خاصة الجزائر وأنغولا والعراق ونيجيريا، مما قد يتسبب في أزمات مالية وعدم استقرار سياسي في بعضها.
منافسة على عسكرة الفضاء
ستتسارع المنافسة على الوصول إلى الفضاء وعسكرته خلال العقد المقبل.
وستظل القوى الفضائية الأربع الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا، في صدارة استكشاف الفضاء واستغلاله.
وستبقى الولايات المتحدة في المقدمة بفارق كبير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تفوقها الحالي في تكنولوجيا الفضاء ووجود قطاع خاص قوي.
وبينما قد يشهد العقد القادم عودة البشر إلى القمر وبدء تقسيم السيطرة الفعلية عليه، فإن التركيز الأساسي للدول والشركات الفضائية سيكون على المدارات حول الأرض.
وستؤدي القيود الأمريكية على التعاون التكنولوجي الفضائي مع الصين إلى تعميق الفصل بين محوري الولايات المتحدة-أوروبا والصين-روسيا، لكن العقد المقبل سيشهد أيضًا تضييق الفجوة بين القوى الفضائية الناشئة، وخاصة الهند واليابان وكوريا الجنوبية، مع القوى الأربع الكبرى.
وستجعل ديمقراطية الوصول إلى الفضاء الدبلوماسية الفضائية أكثر تعقيدًا، حيث يضعف التوازن التاريخي للقوة الفضائية بين روسيا والولايات المتحدة.
وستتسارع عسكرة الفضاء مع دمج كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين الفضاء بشكل أكبر في قواتها العسكرية وعقائدها الأمنية الوطنية.
وبحلول عام 2030، سيكون هناك أسلحة فضائية متموضعة في المدار، بما في ذلك السلاح النووي الفضائي الروسي، وأنظمة هجومية مضادة للأقمار الصناعية تعتمد على الأقمار الصناعية، وربما حتى أنظمة دفاع صاروخي بالليزر في الفضاء.
ومع تزايد نشر الجيوش للأسلحة في الفضاء، متجاوزة الاستخدام التاريخي للفضاء في الاتصالات والتصوير والتطبيقات غير العسكرية، سيصبح التحكم في الفضاء ومنع الوصول إليه، بالإضافة إلى التحكم في نقاط الاختناق الجغرافية للفضاء، أكثر أهمية.
من غير المرجح أن ينشب صراع كبير في الفضاء أو أن يؤدي ازدحام الأقمار الصناعية إلى جعل بعض المدارات غير صالحة للاستخدام، إلا أن الحوادث التي تؤدي إلى تعطيل الأقمار الصناعية بسبب الهجمات الإلكترونية أو المناورات غير الآمنة من قبل المركبات الفضائية ستصبح أكثر شيوعًا.
وستظل عسكرة الفضاء تعمل بشكل أساسي كمضاعف للقوة العسكرية على الأرض بدلاً من أن تصبح ساحة معركة مستقلة.
أما العسكرة الكاملة للفضاء كمنطقة قتال قائمة بذاتها تشمل أيضًا الأجرام السماوية الأخرى، مثل القمر والمريخ، فستُترك لعقود مستقبلية، حيث ستستغرق مشاريع استكشاف القمر والمريخ سنوات طويلة لتتطور بشكل كامل.
وسيشهد العقد المقبل أيضًا تسارعًا في البعد التجاري في الفضاء، فإلى جانب زيادة شركة “سبيس إكس” لمعدل إطلاقها وحجم صواريخها، ستنمو أيضًا شركات الفضاء الخاصة الأخرى.
ولن تؤدي المنافسة المتزايدة في الفضاء إلى خفض تكاليف الإطلاق فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تحفيز الاستثمارات في التكنولوجيا الفضائية التجارية، مما يعزز الابتكار ويمهد الطريق لتطوير الموارد الفضائية والتصنيع في الفضاء، رغم أن الفوائد الفعلية لهذه الاستثمارات في مجال التصنيع وتطوير الموارد لن تتحقق على نطاق واسع قبل عام 2035.
ازدهار القطاع التجاري للفضاء سيخلق تحديات جديدة، حيث سيزيد من اعتماد الاقتصادات الأرضية على الفضاء في مجالات مثل الاتصالات والأبحاث والمعلومات الجيوفضائية وغيرها من التطبيقات، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للفضاء بالنسبة للحكومات، وستزداد الاستثمارات في بناء أنظمة احتياطية وتعزيز المرونة والبحث عن بدائل، بما في ذلك الأنظمة المعتمدة على الطائرات المسيّرة لأداء وظائف مشابهة.