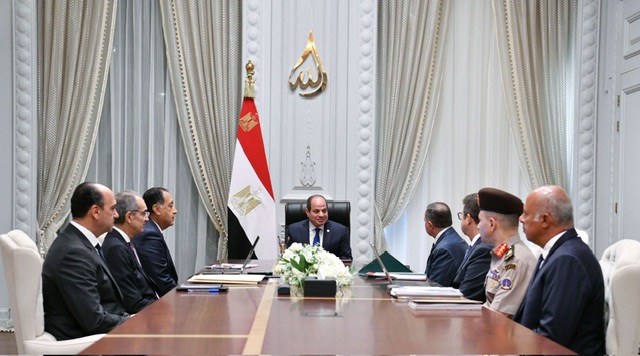كانت فرصة ذهبيَّة منحني إيّاها صالون عرفات أن ألتقيَ تارةً أُخرى بعد أكثرَ من عقدٍ من الزّمانِ بالرّوائيَّةِ والكاتبَةِ القاصَّةِ والأديبةِ ومسؤولة النَّشرِ السّابقةِ في المجلس الأعلى للثَّقافة أمينة زيدان، المشروع الرّوائيّ الكبير الذي لم يكتمل، مع أنّها بدأت نشرَ إِبداعِها منذ ما يقرب من ثلثِ قرنٍ حين نشرت مجموعتها القصصيَّة الأولى:" فوضى" 1994م، وهي دون الثّلاثين، وتحصل على جائزة مسابقة أخبار الأدب، وقت أن كانت اللجان يتصدّرها كبار الأدباء والنّقَّاد في مشهد أدبي يصعب فيه على الشّباب لفت الأنظار وسط جيل السّتينيَّات الذي كان ملء السّمع والبصر، ومازال يعطي عطاءً وافرًا...!
وتتجاوز أمينة هذه الجوائز المحليَّة وتنطلق إلى العالميَّة بمجموعتها الثّانية:" حدث سرًّا" 1995م؛ فقد مثّلت هذه المجموعة تأثيرًا استثنائيًّا داخل مصر وخارجها؛ بوصفها أفضل مجموعة قصصيَّة، شهد لها بذلك النُّقَّاد فمُنحتْ جائزة معرضِ القاهرةِ الدّولي لِلكتاب 1997م، ثم تُرجمتْ إلى اللُّغة الإيطاليَّة، فحصلتْ على الجائزَة الأُولى في مُسابقةِ دوَلِ حَوضِ البحر الأبيضِ المتوسِّط في العامِ نفسهِ؛ بوصفِها أحسن عمل قصصيّ مُترجَم إلى الإيطاليَّة؛ ممَّا بشَّر بميلاد كاتبة نابغةٍ، لفتتِ الأنظار بقوّة داخليًّا وخارجيًّا، وما زالت في عامها الثّلاثين، مع حضورٍ إنسانيّ، ميّزها في المنتديات الأدبيَّة بما امتلكته من صراحةٍ في براءةٍ، وصدقٍ في ثباتٍ؛ فكانت تدلي برايها في الأدباء والنّقّاد بما يخالف المعهود المبتذل؛ فكان خير تتويج لهذه الكاتبة أن تنشر مجموعتها في مكتبة الأسرة بين اختيارات كبار المبدعين الذين اختارتهم لجنة النَّشر في المشروعِ القوميّ عام 2002م.
ومع كلّ هذا النّجاح وجدتْ أمينة أنَّ مشروعها السّرديّ يعوزه الكتابة الرّوائيَّة التي يمكنها أن تبثّ فيها أفكارها الوثّابة كاملةً؛ بحيث يمكنها تعقّب الفكرة، وتعدد مداخلها، وتقليبها من وجهات نظر مختلفة، لاسيّما أنها كانت وقتئذٍ مؤدلجةٍ، تطمح أن تكون الكتابة قادرة على التّغيير، والمقاومة، وتنشيط الوعي؛ فكتبت روايتها الفذة: "هكذا يعبثون"،ونشرتها لها الهيئة المصرية العامة للكتاب في طبعة نفدت في أيام قليلة عام 2003م، واختارتها أيضًا لجان النّشر لمشروع مكتبة الأسرة؛ بوَصفِها من أفضلِ الرّواياتِ التي تمثّل الصّوتَ النّسويَّ في الإبداع السّرديّ...!
وفي قفزة أكبر للأمام تكتب أمينة روايتها التي نالت بها جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكيّة:":"نبيذ أحمر"عام 2007م، وكانت قد نفدت سريعا في طبعتها الأولى عن دار الهلال، وفكّرت في إعادة نشرها في دار نشر خاصَّة؛ فكانت هذه فرصة التقائنا؛ إذ طلبت مني مراجعتها لغويًّا قبل الدّفع بها للطّبعة الثّانية.
كنت أتوقف عند بعض الفقرات لتفكيكها لما يبهرني من قدرتها على تضفير العوالم المتنافرة والبعيدة في جمل متتالية تداعب كلّ حواس القارئ لتجذبه جذبًا إلى عالمها السّرديّ الذي يلمس روحه؛ فلا يبرحها؛ فإذا هو يشعر ويشم ويتذوق ويلمس ويبصر ويسمع في استثارة تتناوبها الكلمات مع الحواس على التتابع المتقن الذي يربطها بموقعها في المخ مباشرة؛ كما يشير علماء البلاغة المعرفية؛ فيمكنك أن تختبر ذلك في هذا المشهد السرديّ: "وحين تفتح الباب تلفنا روائح نادرة تملأ بها ذاكرتنا، قبل أن نعتاد حلاوتها، تصبح جزءًا منها، ونحن نخفي نظراتنا النهمة للأم التي تحوط خصلاتها البنية بدخان سجائرها الكثيف، وهي تلعن قدرها الذي أخذ بأمنها، وسلبها فندقا بناه جدها، أصبح مقرًّا للاتحاد الاشتراكيّ".
من الممكن أن تكون تقنية السّينما حاضرة في وعي أمينة وهي ترسم ملامح المشهد، ولكنّها تتجاوز إتقان التّصوير السّينمائيّ بتصوير داخل الشّخصيَّة والمزج بين وعيها ولا وعيها، واستحضار الأزمنة الثّلاثة في المشهد، دون أن يلهيها ذلك عن تدفّق السّرد، والتّقدّم بالحدثِ للأمام فيما يستفزّ أفق توقع القارئ ليقع في حبالة سردها؛ ليخرج في النّهاية محملا بكلّ ما حملته شخصيّاتها من أزمات وطموحها نحو الخلاص الذي تؤكده السّاردة الحقيقية من خلال كلماتها في حفل منحها الجائزة؛ إذ عقدت مقارنة بين الأديبِ والسياسيّ؛ فوجدت الأوَّل أكثر تأثيرًا لما يمتلكه من حريَّة القول، وامتلاكه القدرة على صياغة هذه الحريّة بعيدًا عن المباشرة والأدلجة والإغراض البراجماتي المضلل أو الراغب في السيطرة والاستحواذ.
كلّ هذه السّمات التي ميّزت أمينة السّاردة والإنسانة دفعتها أن تخوض تجربة الكتابة الجديدة، أو ما سماه الناقد والأديب الفرنسيّ آلان روب جرييه بالرواية الجديدة، التي تواجه غموض العالم، وتسقط مركزية الإنسان؛ بوصفه الشّخصية القادرة على صناعة الأحداث وتحديد أماكنها وأزمانها والبناء الخطِّيّ إلى هدم كلّ هذه المسلمات،؛ لتنفي فكرة الشخصيّة المحوريَّة التي تسيطر على السّرد، كما تهدم محدودية الزمان والمكان؛ لتحلّ القارئ شريكًا للسّارد لاستكمال ملامح الشخصيّات وبواعثها وقدرتها على صناعة الحدث واختيار الزمان والمكان، وإعادة تفكيك هذه العناصر وتركيبها، لتبني نصًّا يشبه الواقع الذي تعيشه من حيث غياب الترابط وسيطرة التفكك وغياب المنطق؛ فنشرت روايتها:"شهوة الصّمت" 2010م عن دار نهضة مصر؛ لتتبارى الكتابات النقديّة حول الرّواية لثرائها من حيث التّجريب الرّوائيّ، واستمرار الكاتبة مع كل هذا التّفكك إلى استمرارها في الدّفاع عن قضايا المرأة من ناحية، والدّفاع عن قيم الحرية والإنسانيّة والعدالة من جهة أُخرى.
هكذا حضرت أمينة زيدان بعد كلّ هذا الغياب لتؤكّد أن طموحها في استكمال مشروعها الرّوائي مازال ملحًّا في رغبته للنّهوض بكتابةٍ جديدةٍ أخرى تصلح للحظة الرّاهنة بما أحدثه العقد الأخير من تغيرات زلزاليَّة في الرؤية والتّوجّه ونوعيّة الكتابة؛ لذا نوّهت إلى مشاريع مغبونة رأتها أكثر أهميَّة من مشاريع تشيع في الوسط الثّقافيّ مع كونها لا تعدو أن تكون ثرثرة، وحكايات مستنسخة يعاد تدويرها، وكان من ضمن من أشارت غليهم في المشاريع التي تستحق الانتباه النّقدي والقرائي مشروع فتحي إمبابي وغيره من الكتَّاب الذي لديهم إمكانات تسمح بتحقيق طموحاتهم ورؤاهم ورغباتهم في وضع بصمة مائزة.
ومع أن إمبابي من الكتاب الفحول الذين أجازوا أمينة حين كتب كلمة التعريف بروايتها:"نبيذ أحمر" في طبعة دار الهلال؛ فإنه قد جاء الدّور لتجيز أمينة مشاريع كثيرة لغيره من الكتّاب الفحول دون أن تسميهم أو نسميهم، وقد اخترنا وصف الفحول تذكيرًا بما فعلته المبدعة العربية القديمة حين أجازت الفحول حين أرتج عليهم القول.
لم تفقد أمينة زيدان براءتها الطفوليَّة ونظراتها البريئة وهي تصدم جمهور الصالون بخلاف المعروف والشّائع المبتذل، وقدرتها على إجازة مشاريع الآخرين بما يذكرنا بإجازات الشّاعرات العربيّات، وقدراتهنّ الخارقة في المماتنة والتمليط في الصالونات الثقافيّة في التراث العربيّ.
* المرأة العربيَّة من المشاركات الصَّالونيَّة إلى مماتنة الرّجال وإجازة الشّعراء الفحول:
قلنا: إنَّ ظاهرة تمثّل الصَّالونات الثَّقافية ثقافة موازية للثقافة الرسمية بل تمثّل الثقافة الحقيقية التي تعبر عن الواقع الثقافي بمزيد من الحرية والخروج عن التقاليد الرسمية التي تلزم رواد الملتقيات والمنتديات والفاعليات.
ومن ثمَّ؛ فقد بدأت هذه الظاهرة منذ فجر الثقافة العربية؛ فتذهب آراء كثير من الدارسين إلى سبق العرب إلى ذلك قبل أن يعرف الأوروبيون هذه الفاعليات في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، ويبدو أن الظاهرة بدأت منذ العصر الجاهلي.
ومن يطالع كتب التراثِ يجد أشكالًا لها في لقاءات الأدباءِ والشُّعراء، ومحاوراتهم، وأسئلتهم النّقديَّة حول أفضل شعراء القبائل، وأشعر الأبيات، وأشعر القصائد، وأسئلة كثيرة حول فحولة الشعراء، والشّعر النّسويّ، ومعايير التفاضلالقبَلِيَّةِ، والبلاغيَّةِ، والجندريَّةِ؛ كمسألة تفوق الخنساء على غيرها من الشعراء ، أو تفضيل غيرها على كثير من الشعراء الآخرين، ومباريات ليلى الأخيليَّة مع الشّعراء للتّفوّق عليهم وانتزاع الفحولة منهم.
وقد حفلت كتب التراث بكثير من أخبار المماتنة بين الشعراء والشَّاعرات؛ إذ كانت الشَّاعرة ابنة أو زوجة أو أمة تجيز الشاعر في مجلسه متى أُرتج عليه، ولم يفلح في إكمال بيته؛ كما نجد فيما حكته لنا كتب التراث عن إجازة ابنة لبيد بن ربيعة العامريّ إيَّاه، له وكذا ابنة زهير بن أبي سلمى، في حضور جمع من الشعراء وشُداة الأدب.
* الخطاب النّسويّ وكسر النُّموذج الأبويّ الذّكوريّ:
ومن الرّوايات التي تشي باتساعِ دائرةِ هذا الخطابِ روايةٌ عن الأصمعيّ يروي فيها عن الشَّاعرِ الجاهليِّ المعروف المُحيّا الهَمدانيّ، الذيرزقَه الله ثلاثَ بناتٍ اتَّصفنَ بالكمال والعقل والأدب، يُدعينَ ظمياءَ، وريَّا، وَوَسْنَى على التَّرتيب، وقد جلس بينهنّ في روضة ربيعيَّة، فرأى سربَ ظِباء؛ فقال:
فَكَأنَّهُنَّ وَقَدْ ترجَّلتِ الضُّحَى ودَعٌ تكبَّدُ صَحْصَحَانًا أَفيَحَا
ثمَّ قال: أجيزي يا ظَمياءُ فأجازتْه على الفَور:
أَكَذَاكَ أَوْ كَحَجَا غَدِيرٍ مُفْعَمٍ رِيحَتْ جَوَانبُهُ فَرَاحَ مُسَيَّحَا
ثمَّ طلبَ إجازة ريّا فأجازتْ؛ حتّى وصل إلى وَسْنَى، وطلب منها الإجازةَ؛ فأكملتِ الصُّورة كأنَّهما يصدران من بديهةٍ وقريحةٍ واحدة:
لَا بَلْ نُوَاصِلُ مِنْ وِشَاحِ خَرِيدَةٍ خَانَتْ مَعَاقِدُ نَظْمِهِ المُتَوَشّحَا
فشهد لهنَّ جميعًا بالإحسانِ والإجادة، حتّى تعجّب الأصمعيُّ وتساءَلَ مُتمنيًّا بعد افتتانه بجمالِ الصُّورة: لو كانت للمُحيّا بنتٌ رابعةٌ، ماذا تقول؟!
وظلّت هذه الرّوح الأبويّة في رعاية خطاب الإجازة النِّسويِّ وما إليه وتشجيعه ، والاعتراف بشاعريّتها التي تفوق شاعريّته في اطِّراد إلى ما بعد القرن الخامس الهِجريِّ، وانتقلت من القصيدة إلى الموشَّح.
ويمكنُ أن نوافقَ مَن يرى أنَّ المبدعة العربيَّة ما زالتْ تحتاجُ إلى صوتٍ ذُكُوريٍّ يُجيزها، ويَرى أن المُقدمات التي يَكتبها كبار النُّقَّادِ والشُّعراءِ، مع ما فيها من مجاملةٍ، هي شهاداتُ ميلاد للشَّاعرات المعاصرات؛ وعليه تكون شهادةُ الشاعر الأب هنا بمثابة المُقدِّمة التي تكتب للشاعرة شهادة ميلاد جديدة، وربَّما لم تخلُ من هذه الـمُجاملة لتعلنَ للنَّاس ميلادَ شاعرةٍ في مجتمعٍ تحاول أن تجد فيه المرأة المثقفة موضعًا بين الذُّكور في المنتدياتِ والصالونات.
ومن أجمل ما نقله لنا ابن دريد في أماليه من قصص تجمع بين الهوى والإبداع ما نجده في صالون مثقفة أموية كانت تعقده في المدينة، وقد كان من روَّاده فتًى أُمويًّا ظريفًا طريراً من أحفاد عثمان بن عفان، وقع في حبّ قينة لبعض وجهاء قريش، بادلته حبًّا صامتًا بحبٍّ؛ فهي تحبُّه ولا يعلم بحبّها، ويحبها ولاتعلم بحبّهِ، فأرد يوم المجلس أن يختبر حبَّها؛ فلمّا أخذت موضعها من المجلس، واحتجرت بمزهرها، سألها العاشق تغنين:
أُحبُّكُم حبًّا بكُلِّ جَوارحِي فهلْ لكُم علمٌ بما لكُم عِنْدِي
وتجزونَ بالودِّ المضَاعَفِ مِثْلَهُ فإنَّ الكَريمَ مَنْ جَزى الوُدَّ بالوُدِّ
قالتْ نعمْ، وأحسن منْهُ، وغنَّتْ:
للّذِي وَدَّنَا المودَّةبالضِّعْــــــــــــفِ، وفَضْلُ البادِي بهِ لا يُجازَى
لَو بَدَا بنَا لَكُم ملَأَ الأَرْ ضَ وأقطَار شَامِها والحِجَازَا
فعجبَ القومُ من سرعتهِ مع شغلِ قلبهِ، ومن ذهنِها وحُسن جوابها فازدادَ بها كلفًا،
وصرَّح عَمَّا في قلبِهِ فقالَ:
أَنْتِ عُذْر الْفَتى إِذا هَتكَ السِّتْــــــــــرَ، وَإِن كَانَ يُوسُفَ المَعْصُومَا
مَن يَقُمْ فِي هَوَاكِ يَقْصُر عَنِ اللّومِ وإمَّـــــــا زَالَ كَانَ مَلُــــــــــــــــــــــــــومَا
وبلغَ عمر بن عبد العزيز وهو على المدينةِ خبرُها، فاشتراها بعشرِ حدائقَ، ووهبها لهُ، ومايصلحها، فمكثتْ عندهُ حَولًا، ثمَّ ماتَتْ فرثَاها، فقالَ:
قَدْ تمنيتُ جنَّةَ الْخلد بالجهْــ ـــدِ؛ فأُدخلْتُها بِلَا اسْتِئْهَالِ
ثُمَّ أخرجتُ إِذْ تطعمت بالنِّعْــــــــمَةِ مِنْهَا والمَوْتُ أَحْمَدُ حَالِيَ
وكرَّر هذا الشِّعر مرارًا وقضى، فدفنا معًا، فقال أشعبُ: هذان شَهيدَا الهوى انحرُوا على قبره سبعينَ نحرةً كما كبَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزةَ سبعينَ تكبيرةً.
قال: وبلغ أبا حازم فقال: لو محبٌّ في اللهِ يبلغ في الحبِّ هذا المبلغَ فهو وليٌّ.
---------------------
بقلم: د. محمد سيد علي عبدالعال (د. محمد عمر)
* أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية الآداب للدّراسات العليا بآداب العريش