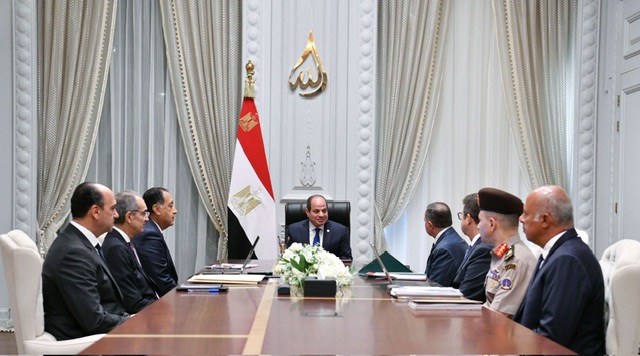- حملت موروثي الفكري والثقافي في حقائب ذاكرتي
الأديبة السورية سمر محمد الكلاس عركتها التجارب، وقد استفادت من الرحلة والإقامة في بلدان عديدة في مشوارها الإبداعي..
في دمشق استقبلت أول نسمات حياتها لأسرة عريقة، وتعلمت في مدراسها، وتخرجت في كلية العلوم ثم أكملت دراساتها العليا حتى حصلت على درجة الماجستير في التشريح النباتي، ثم عملت في سلك التدريس الجامعي في جامعة الفاتح كمعيدة في علم الأحياء الدقيقة، ثم غزاها حب الأدب منذ فجر حياتها، وقد كان للنشأة في بيئة الشام الخلابة أثرها في رهافة حسها، ثم مطالعة كل أنماط الأدب، وقد صقلت تجربتها بعوامل أخرى منها الرحلة حيث تنقلت مع والدها الخبير في الأمم المتحدة، في كثير من البلدان واستفادت من ثقافات هذه الأمم، ثم عادت إلى سوريا، ثم استقرت في أم الدنيا مصر وحصلت على الجنسية المصرية، وأصدرت فيها أعمالها القصصية. وقد أردنا أن نقترب أكثر من عالمها الأدبي فكان هذا الحوار التالي:
* كيف كان للنشأة أثرها في حياتك الإبداعية بعد ذلك؟
- ولدت في مدينة دمشق عاصمة الشام في حي الكلاسة، لأسرة عربية سورية، وأحمل الجنسية المصرية، ولهذا أنا امرأة تحمل وجه وطنين. التفاصيل الصغيرة لكل ركن من أركان البيت وكل مشهد من المشاهد، وروائح توابل الحي خزنتها عيني الثاقبة في الذاكرة، وزخارف جدرن منزل جدتي.. نافورة بيتنا وسقاطة باب المنزل.. فسحته السماوية، وشمس تتوسطها شجرة النارنج، بيت صديقي العصفور، تفاصيل كثيرة تبدو على وجه الدقة صغيرة؛ لكنّها جعلتني أُدركُ أنّ للشمس علاقة بقلمي. وأنّ لأناشيد عصفوري الصباحية بصمة في نثري. زخارف المنزل أحد أسباب الإلهام في أدبي. وأصوات المنزل مصدر واسع للخيال. وأما الشمس منبع النور. انعكاس الضوء على الروح. لهذا أوّل ما بَدَأتُ بالكتابة حَاولتُ أن أجعلها نافذة للشمس الساطعة ليكون للحروف صدى النور في القلوب المتعبة. كنت أحصي كلّ ما ينزل من السّماء أو كلّ ما يخرج مِن الأرض.
ولدت رحالّة بسبب عمل والدي كخبير مع الأمم المتحدة ودرست في الدول المغاربية حيث الابتدائية في المغرب، وأتممت مراحل دراستي الأكاديمية في مدينة الجزائر العاصمة، وحصلت على الماجستير في قسنطينة في الجزائر.

* متى بدأت رحلتك مع الإبداع ومن قدوتك في هذا المجال؟
- وردة مِن زخارف منزل جدتي رسمتها على جدار المنزل هي نقطة انطلاق رحلتي الأدبية. ولأنّ الرسم فن. والكتابة والقراءة ثقافة. وشتان بين العلم والفن ذاك الوقت. أعطتني أمّي دفتراً وقلماً. وصارت تُحصي عدد أوراقه وتُراقب صفحاته. لهذا صرت أكتب الصور كلمات، وصارت الكلمات جملاً، وامتلأت أوراق كرّاستي بكلّ التفاصيل المخزونة في الذاكرة
* ماذا أثمرت هذه الرحلة من أعمال إبداعية؟
- كان أول نتاج لي رواية بعنوان "وينكسر الطريق" وصدرت عن الهيئة السورية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة في سورية، وبعد سنتين صدرت الرواية الثانية بعنوان "جنوب الكهف بقليل"، وأنا بصدد الانتهاء من كتابة الرواية الثالثة.
ورواية "جنوب الكهف بقليل"، التي طبعتها في دار المُفكّر العربي في القاهرة. انبثقت فكرتها مِن انفجار ميناء بيروت الكبير، وبدأت بتسجيل الاحتمالات، وتحليل ظهور المعابد والمقابر المفاجئة التي تزامنت مع الانفجار. حتى رأيتني أكتب رواية امتداد صهيونيّ لتنفيذ مآربه وتحقيق هدفه. روايتي فيها الكثير مِن الاحتمالات المشوّقة والمُثيرة. وحين ظهر طوفان الأقصى كان لا بدّ مِن نهاية تتوافق مع وقائع الرواية.
* وماذا عن أنشطتك الأدبية الأخرى؟
- كنت من مؤسسي مجموعة كلمات الأدبية صدر لدينا ديوان شعري لبعض الأعضاء وأيضا كنا نمارس نشاطنا الأدبي بشكل دوري في المؤسسات الثقافية وكان لنا مهرجان سنوي ومسابقات أمير كلمات سنوية. ولي بعض الخواطر وبعض النصوص النثرية، وكتب مقالات أدبية وقراءات نقدية طبعت في مجلة "العربي" في سورية، وجريدة "الاتحاد" الأسبوعية في سورية، وكنت صاحبة صالون ثقافي أقمته في المنزل للأدباء لمناقشة أعمالنا الأدبية.
* عاشت سمر الكلاس متنقلة بين الدول كيف أثر هذا في منجزك الادبي؟
- حملت موروثي الفكري والثقافي، في حقائب ذاكرتي. وسرت في درب الرحيل الدائم والمستمر عبر العالم العربي والغربي، وهذا ما جعلني أحمل في حقائبي الزمان والمكان، وبعض الشخصيات التي دخلت القلب وتآلفتْ مع الروح، حتى أنّي زرعتها في عالمي، ووظفْتها في روايتيّ.
*في حب مصر حدثينا عن هذه التجربة؟
- دخلت بحر الاسكندرية على متن مركب سياحي يتجوّل في رحلته عبر مدن تطلّ على البحر الأبيض المتوسط بعمر لا يتجاوز السادسة. وكنت الطفلة الذاهلة الذكية اللّماحة. محبة لأساطيرها. أدركت أني عائدة إليها لأني شربت من ماء النيل. وبالفعل شاءت الظروف عودتيK ولأن الانتماء فطرة ربانية وهبني الله إيّاها. فأنا أنتمي لكلّ بلد أعطاني وأغدق علي علماً، وثقافة ومعرفة. حتى أنّي تمازجتُ حباّ مع حضارة وثقافة جميع الأوطان التي عشتُ فيها، وأعطتني كلّ ما لديها. فما بالك بمن منحني جنسيته، وكان لي روحا ترفرف في سماء النيل تشدّني إلى جنيني الذي فقدته. مصر التي في خاطري. لهذا أنا امرأة تحملُ وجه وطنين.

* حدثينا عن رحلاتك وذكرياتك في الدول التي قمت بزيارتها وأقمت بها؟
- الطائرة، أوّل مّن فتح أبواب الخيال ليتسع فضاءه. فكانت أحلامي اللعب على سجادة السماء البيضاء. كنت أجد متعة التنقل بين البلاد في القفز على الغيمات. وراح الخيال يغزل قصصاّ وحكايات عديدة. حتى أنّي سمعت والدي يقول: "ستصبح ابنتي في يوم مِن الأيام كاتبة". كان عمل والدي خبيرا مع الأمم المتحدة العالم يفرض علينا التنقل والترحال بين البلاد. وكنّا نتجوّل في مُدن تطلّ على البحر الأبيض المتوسط بسيارته عبر جبال الألب. التي وهبتني خيالاً مرعباً، لأني كنت أعتبر الجبال وحشا يخشاه والدي لأنه يطالبنا بالصمت حين يعبرها. والضباب كثيف يحجب الرؤية.
رغم انّي لا أعي معنى كلمة وحش. وفي المغرب تعرّفت على البحر ورأيت الشمس تلك الكرة البرتقالية التي تتوسط سماء منزل جدتي في دمشق. وأنا الذاهلة المندهشة التي كانت تتوق لشرائها. فرحت بها وصارت صديقتي، حتى أنّي لا زلت أتوق حضور شروقها وغروبها. أستيقظ قبل الشروق لأوقظ صغارها وتبدأ لعبة الألوان.
وأمّا عن المجتمع المغربي كانت أول كلمات سمعتها بلهجة مغاربية حين عثرت على صدفة كبيرة، اختطفها مني طفل صغير وبدأ يغني لها (غولالة غولالة خرجيلي قريناتك ولا أذبحلك وليداتك). وتعني أيها الحلزون أخرج قرونك حتى لا أذبح صغارك. وبالفعل خرج الحلزون وكنت الخائفة الثابتة تراقب هذا الوحش الجديد. وحين رأيت الطفل يخرجها من بيتها ليأكلها صرت أخاف من الطفل آكل الوحش الذي خفته.
وكنا نقضي إجازة الصيف في إسبانيا مروراً بمدينة سبتة لنعبرّ مضيق جبل طارق. كل هذه الأماكن أضافتْ إلى ثقافتي، وسلوكي نكهة مميزة وجديدة. جمعتها ووضعتها في حقائب الذاكرة التي لا أحبها أن تمتليء.
انتهى عمل والدي في المغرب وتوجهنا للجزائر. بكيت كثيرا ألعابي وأصدقائي وصدفتي الجميلة. جدار غرفة نومنا الذي كان مسرحاً للظلال. حيث كان والدي يهيئ الضوء ليرسم بكفيّه طيوراً ناطقة بلسانه قصصاً حياتية قبل النوم. وأمّا غرفة الجلوس فكان يفتتح بها ندوات ومسابقات ثقافية أدبية. حيث كان يشتري لنا قصصا باللغة العربية، يناقشها بعد القراءة. كما أنّه يجري مسابقات شعرية بيننا ويكافئ الفائز منّا.

رحلنا وتركنا خلفنا كلّ هذا العالم لننتقل إلى عالم جديد لا أعرفه. الفقد والخوف مِن مجتمع جديد ولهجة لا أعرفها. هي جلّ معاناتنا في الرحيل. لكنّ السعادة في أنْ تتعرّف على أصدقاء جدد ولهجة جديدة وثقافة أخرى ممتعة. ففي الجزائر تعرفت على قبائل مختلفة منها الأمازيغ، والشّاوة وعرفت طباعهم وعاداتهم. جبال الأوراس الخلابة الساحرة. في الجزائر العاصمة، من محطة باب الزوار إلى جامعته. كانت انطلاقة الطلاب. إنّك إن رأيتهم لحسبتها ساعة الحشر لكثرة العدد. كلّ شيء فيها جميل شعبها، مدنها، وبخاصة طريق الجزائر إلى بيجايا وجيجل، إنّه يفوق جمالا من طريق باريس إلى موناكو. شعب طيبُ لا ينافق. هناك درست المراحل الجامعية العلمية، وتخرّجت مِنها حاملةً شهادة الليسانس ومن ثمّ تابعت دراستي في جامعة قسنطينة مدينة العلم، إنك إن سافرت إليها في الطائرة سترى جامعتها على هيئة كتاب مفتوح وقلم يتوسطه. تمضي الأيام ما بين الدراسة ورحلاتنا، إلى أن تخرجت وصرت من حملة شهادة الماجستير. عدت إلى سورية مسقط رأسي وعملت في سلك التدريس، إلى أن جاءني عمل في جامعة الفاتح كمعيدة في معمل الأحياء الدقيقة. وصرت أمارس فنون التصبير، أجفف الزهر والفراش وبعض الزواحف من أجل صناعة لوحات صنعتها بيدي. وكنت لا أنفك عن كتابة خواطري، وعن الحبّ النقيّ الصادق الذي أشتهيه. عملت في سلك التدريس مدة إحدى عشرة سنة. كتبت فيها قصصاً عن تآلف البكتريا الحمراء مع الزرقاء وتارة. ثمّ شاءت الأقدار أن أتركها متوجهة إلى مصر، هناك صنعت حياة أخرى. طيلة عشر سنوات كنت أتنقل ما بين القاهرة والإسكندرية. أحببتها. شعرت أن عودتي كان تلبية لنداء طفولتي. فلقد شربت حينها من ماء النيل. ثمّ غادرتها مُكرهة وعدت إلى دمشق أراعي والدتي بعد وفاة والدي. العزلة والوحدة والفقد، والحرب دوافع صدور روايتي الأولى وينكسر الطريق التي طبعتها هيئة الكتاب التابعة لوزارة الثقافة السورية. فيها كتبت عن الهمً الذي طال الشارع العربي. كما أنّي كتبت برمزية اغتصاب جزائرية وانتقامها مّن الغاصبين. للتعبير عن حرب تحرير الجزائر مِن الاستعمار الفرنسي التي طالت مدتها مئة وثلاثين سنة، ولم يحررها إلا شعبها.
---------------------
حوار: أبو الحسن الجمال
* كاتب ومؤرخ مصري