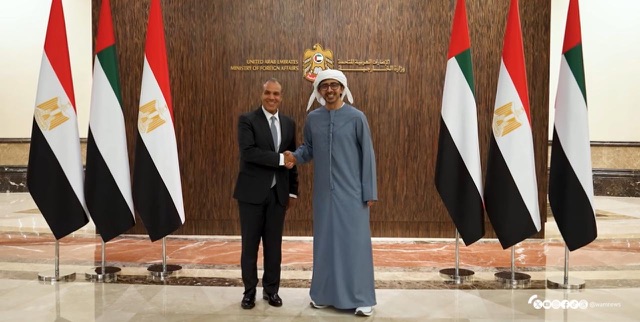سلم وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الجمعة الماضي، جائزة طه حسين الدولية، والتي يمنحها اتحاد كتاب مصر، للباحث والمؤرخ الأمريكي بيتر جران، والدكتورة يمنىالخولي أستاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث، والرئيس الأسبق لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. في حفل شهده مسرح الهناجر للفنون.
ويعد المؤرخ الأمريكي"بيتر جران" ــ أستاذ التاريخ المصري بجامعة تمبل الأمريكية ــ واحدا من رواد مدرسة جديدة للمؤرخين٬ واشتهر بكتابه المهم "الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر 1760-1840 " والذي أحدث ضجة عند صدوره في منتصف الثمانينيات وترجمه المؤرخ الكبير دكتور رؤوف عباس، ومن كتبه "صعود أهل النفوذ.. رؤية جديدة لتاريخ العالم الحديث"، وتناول موضوع "اللوبيات" الأجنبية داخل الإدارة الأمريكية٬ وقال إن هناك نفوذ أجنبي على السياسات الأمريكية يمثله اللوبي٬ علي العكس من رؤية الكثير من المؤرخين الأكاديميين. فالموجود علي الأرض فعليا٬ "لوبيات" أجنبية ضالعة في اللعبة السياسية الأمريكية. ويمثل"صعود أهل النفوذ" محاولة جديدة لتعبير جديد في قاموس النظريات، وهو مصطلح يعبر عن أربعة أشياء مختلفة في كلمة واحدة٬ وهي الطبقة الحاكمة، الشعوب، السماسرة الدوليين المتمثلين في الشركات العابرة للجنسيات٬ وقد أسماهم الــ "new man"والذين ينسجون علاقات دولية بين مكان ومكان آخر، لمصالحهم الشخصية الخاصة، وكل هؤلاء يعملون بتعاون مشترك في نمو السوق الدولي والهيمنة عليه. كما يذهب بيتر جران في كتابه “الاستشراق هيمنة مستمرة”، إلى أن: استخدام الاستبداد الشرقي في تفسير التاريخ المصري مستمر، لأنه يلعب دورا أساسيا في الرواية المرتبطة بالهوية الأمريكية.

وهذا نص كلمة بيتر جران لدى منحه جائزة طه حسين:
التيار العقلاني من الشيخ حسن العطار إلى طه حسين
البداية الواضحة اليوم هي بكلمة شكر لدكتور علاء عبد الهادي ولنقابة اتحاد الكتاب لاختياري كأحد الفائزين هذا العام بجائزة طه حسين، ولإعطائي فرصة لإعادة تأمل شخصية حسن العطار الذي أعجبت به لفترة طويلة، مما أتاح لي التفكير في احتمال وجود صلة فكرية بين حسن العطار وشخصية عظيمة، كطه حسين.
بدأت أفكر في وجود مثل هذه الصلة، لأنها تنتج عن الانخراط الفكري في ظروف تاريخية متماثلة، تميزت بالصعوبة، ووجود تحول اجتماعي، كما أنها تنطوي على أزمة ثقافية أيضًا. ولهذا، كان كل من الرجلين لديه الأسباب لطرح أسئلة جوهرية دفعت إليها تلك الأحوال المتأزمة. وكلاهما عانى من صعوبة التكيف مع العقلانية العادية عندما انتهت الأزمة.
ولتأمل هذه الأمور، دعوني أبدأ بنظرة موجزة للتيار العقلاني في مصر الحديثة، وكيف تمكن كل من حسن العطار وطه حسين من التكيف مع هذا التيار كوسيلة لبيان الصلة بين الرجلين، ولاستكشاف ما يمكن أن نصل إليه من هذه الفكرة.
بدأ التيار العقلاني المعاصر بظهور التنوير في القرن الثامن عشر، واستمر حتى الحاضر. وهو في مجمله تاريخ الكُتاب في الأزمنة العادية بقبول منطق النموذج المهيمن. هذا النموذج أتاح لهم المشاركة في تطوير المعرفة لخدمة المجتمع. ومن النماذج المعروفة رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك، وكلاهما لم يكن فقط من الكُتاب، ولكن أيضًا من بناة الدولة الحديثة "المتمدنة" في عصر الخديوي إسماعيل.
واجه التيار العقلاني معارضة من الرومانتيكيين الذين تشككوا في قدرة العقل البشري، وأيضًا من موظفي الحكم الاستعماري، الذين قبلوا هذا التيار ولكن في الشكل الفاسد الذي نطلق عليه حاليًّا المعرفة الاستعمارية، والتي كانت عنصرية ومبنية على المركزية الأوروبية.
لكن، كما يشير الدليل المقدم هنا، ثمة تيار آخر للعقلانية، يظهر بشكل أوضح في عصور الانتقال، تيار يطرح أسئلة جوهرية، أسئلة ضرورية ولكنها ليست بالضرورة باعثة على السرور. وهذا هو الموضوع الذي بين أيدينا.
في مصر الحديثة، ظهر هذا النوع الآخر من العقلانية مرتين حتى الآن. المرة الأولى كانت في أواخر القرن الثامن عشر، وخاصة في شخص الشيخ حسن العطار، والمرة الثانية كانت في الفترة بين الكساد العظيم في سنوات العقد 1930، وثورة 1952، وتمثلت في شخص طه حسين. والحال هو أنه في أزمنة التحول، نجد دائمًا أزمة ثقافية. وأثناء الأزمات الثقافية، أحيانا تتعاطف بعض عناصر الطبقات المهيمنة مع المصاعب التي يواجهها المجتمع في حالة التحول، فتتيح الاستماع إلى أصوات من خارج الخطاب اليومي السائد. وأحيانًا، نتيجة لذلك، تثار أسئلة جوهرية، ليس لمجرد أن الطبقة الوسطى، على سبيل المثال، كانت متورطة، ولكن بسبب الأزمة البنيوية التي أشرت إليها.
وهكذا، على سبيل المثال، في الحالة الأولى، عصر التنوير المصري، كان النظام الميركانتيلي المصري- العثماني ينهار أمام الضغوط التجارية الأجنبية. وقررت عناصر من النخبة إنشاء صالونات ثقافية أتاحت ظهور أفراد عاديين يتمتعون بموهبة متميزة، مثل الشيخ حسن العطار.
عندما انتهت تلك المرحلة، أعادت البلاد إصلاح نفسها من جديد مع ظهور محمد علي. تغير التيار العقلاني نفسه، حيث أصبح أكثر ترتيبًا، وأكثر بيروقراطية، وأكثر نظامًا، كما سوف نبين.
ومع ذلك، أصبح هذا التيار العقلاني أيضًا أكثر إشكالية. منذ عصر محمد علي، بدأ في الأزهر وفي الكنيسة القبطية تيار رومانتيكي قوي للغاية يتحدى الاتجاه العقلاني، الذي كان قريبًا إلى حد ما من الحكومة. والحق أن رد الفعل الرومانتيكي هذا كان قويًّا لدرجة أن هيمنته لم تمتد فقط على تلك الفترة، ولكنها امتدت أيضًا على ثقافة القرن التاسع عشر بالكامل، وليس فقط الثقافة المصرية في القرن التاسع عشر، ولكن على ثقافة العديد من البلدان الأخرى أيضًا، فكانوا ينتقدون التقاليد العقلانية في الكتابات الدينية أو الشعر بالإشارة إلى ما كان يحدث في حياة الناس العاديين، والإشارة، على سبيل المثال إلى التشرذم كما فعل الشيخ إبراهيم الباجوري في رسالة التوحيد، أو إلى المعاناة كما فعل الأسقف أبرام بإطعام الفقراء في أسيوط. ولم تكن كل انتقاداتهم في الواقع في غير محلها. عادة، كان المصلحون في التيار العقلاني السائد يميلون إلى النظر إلى خدمة المجتمع في مجالات العلم والتقدم والتطور، وليس إلى التعاطف مع المعاناة في الحياة اليومية.
في المثال الثاني، المستمد من الفترة بين سنوات العقد 1930 حتى 1952، كان هناك ما اسماه المؤرخ الشهير د. عاصم الدسوقي مشكلة اجتماعية، أي مشكلة ما كان يمكن حلها بدون تغيير سياسي يتيح إصلاح نظام الأراضي. كانت هناك أعداد كبيرة من الفقراء بحاجة إلى الطعام والخدمات، لكن السياسيين والمفكرين في ذلك العصر الليبرالي لم يستطيعوا حل مشكلاتهم. كان حل تلك المشكلات، وأكرر مرة أخرى، يتطلب تحولاً واسع النطاق.
في هذا السياق، ظهر نوع جديد من التيار العقلاني مرة أخرى، تيار يطرح أسئلة جوهرية. وقد أنتج نوعًا جديدًا من الفن مع الفنانين السرياليين فؤاد كامل، ورمسيس يونان، ونوعًا جديدًا من الفكر النسوي مع إنجي أفلاطون ولطيفة الزيات، وأدى لظهور نوال السعداوي، كما ظهر نوع جديد من السياسة النخبوية مع محمد مندور والتوجهات السياسية الجديدة للنقابات العمالية والطلبة. وبالإضافة إلى ذلك النوع الجديد من التعليقات الاجتماعية لطه حسين، مثلما رأينا في كتابه الذي حُظر في ذلك الوقت، المعذبون في الأرض.
بعد 1952، ومع إعادة تنظيم الدولة تحت حكم عبد الناصر، عادة الصيغة المهيمنة من العقلانية إلى الظهور مرة أخرى. عندما حدث ذلك كان طه حسين رغم شهرته يعاني من صعوباته الخاصة. وعندما رحل، لم يظهر بديل، مما يذكرنا بشخصية حسن العطار تحت حكم محمد علي وما حدث عندما مات.
ودعونا الآن نلقي نظرة مقربة على حسن العطار وطه حسين لنرى ماذا كانت النقاط التأسيسية التي ميزت الفكر العقلاني لكل منهما، وهو أمر بالغ الأهمية هنا لأن موضوع الصلة بينهما يظهر في هذه النقطة، وهذا حيث تظهر فكرة وجود نوعين من التقاليد العقلانية.

كان حسن العطار يعتقد أن الإصلاح اللغوي ينبغي أن يركز على استخدام اللغة في التواصل باعتباره الوظيفة الأهم للغة. وعلى العكس، كانت العقلانية في العصور العادية نادرًا ما تربط التقدم اللغوي بتبسيط اللغة العربية المكتوبة أو تعديلها لتتناسب مع احتياجات الحكومة والمجتمع، كما فعل العطار في كتاب الإنشاء ونقده للكتاب النحوي الشهير لخالد الأزهري "الأزهرية" (مُوصِل الطلاب إلى قواعد الإعراب)، وهو كتاب وضع من أجل شعراء البلاط، وكان مشهورًا دائمًا لكنه محدود المنفعة لمن يكتبون لصحيفة الوقائع المصرية. السؤال الأساسي هنا بالنسبة للعطار – وأكرر هنا – هو: هل التقدم في اللغة يتعلق أكثر بالاتصال الوظيفي، أم فقط لمجرد حفظها؟
ويتعلق بهذا ما يلي: كيف يتميز ويبرز الأفراد بمثل هذه الأفكار؟ هنا نحن بحاجة للعودة إلى موضوع الأزمة. في الأزمنة العادية، من يحمل مثل هذه الأفكار لن يجد وظيفة أبدًا. أما القليلون الذين استطاعوا أن يفلتوا، فهم أولئك الذين وجدوا رعاة يدعمونهم، وينبغي أيضًا أن نشير على أنه في معظم الأوقات، لن يقوم شخص برعاية مثل أولئك النقاد. فهذا خطير للغاية. أما زمن الأزمة، فهو مختلف.
كما نعلم، دخل حسن العطار الحياة الفكرية القاهرية كشخص من خارجها، مثلما حدث مع طه حسين، الأول مغربي فقير، والآخر صعيدي فقير، كلاهما يحمل أفكارًا ذات طبيعة إشكالية. كان السؤال التأسيسي لطه حسين هو هل ينتمي الأدب العربي للتحليل العقلاني أم للتراث. وهاجمه الأزهر لإثارته لهذا السؤال، كما سبق أن هاجم حسن العطار. لكن من حسن حظ طه حسين، مثل العطار أيضًا، أن وجد راعيًا يدعمه. وبينما لقي العطار دعم عبد الرحمن سامي بك؛ وجد طه حسين دعمًا من أحمد لطفي السيد، ومن ثم استطاع أن يعمل عن قرب مع أحمد نبيل الهلالي باشا، والذي كان شخصية تؤيد التيار العقلاني، وإن كان من طبقة ملاك الأراضي، وكان يؤيد الفكرة الراديكالية للتعليم العام للجميع. وأنا أربط هذا بالسياق التاريخي.
ما استخلصه من ذلك بشكل عام، هو أنه في التاريخ الحديث كان هناك نوعان مختلفان من التيار العقلاني، أحدهما تيار مهيمن لكل يوم، والآخر ثانوي، وهذا الأخير هو الذي أدركناه في أوقات الأزمات. ولهذا لا ينبغي أن ندهش عندما نجد تفسيرات أفكار العطار وطه حسين تميل لأن تكون من صنع الصيغة اليومية من التيار العقلاني، تفسيرات تهمّش العطار لتتجنب الاعتراف بالدور التحديثي الذي لعبه شخص لم يسافر إلى فرنسا ليصبح عصريًّا، ورغم ذلك فهو ربما كان أكثر أهمية ممن ذهبوا إلى فرنسا. من الواضح أن محمد علي لم يكن قادرًا على أن يضع برنامجًا إصلاحيًّا بدون التبرير العربي-الإسلامي، لأن الذي قدمه هو حسن العطار. وفي حالة طه حسين، كان الأمر مماثلا تمامًا. فقد تعرض للتهميش من جانب التيار العقلاني المهيمن الذي وضع ثقله في هجومه على تأكيد الأزهر على الحفظ، ولم يهتم كثيرًا بالسؤال الذي أثاره إن كان تاريخ الأدب كان جزءًا من العلم أم التراث، وكذلك تجاهل تقريبًا تمامًا اهتمامه بالمشكلة الاجتماعية. وفي المحصلة، فإن هؤلاء المهيمنين على التيار العقلاني صنعوا من الشخصيتين ما أرادوه، في إحدى الحالتين صنعوا أيقونة، ليجعلوه ملائمًا، وفي الحالة الأخرى رجلاً تقليديًّا، ليجعلوه ملائمًا لرواية النهضة التي بدأت رسميًّا بعد وفاته. ومن الواضح أن التيار العقلاني من أحد النوعين ليس هو التيار العقلاني للنوع الآخر، لكن من الواضح أننا بحاجة للاهتمام بالاثنين.