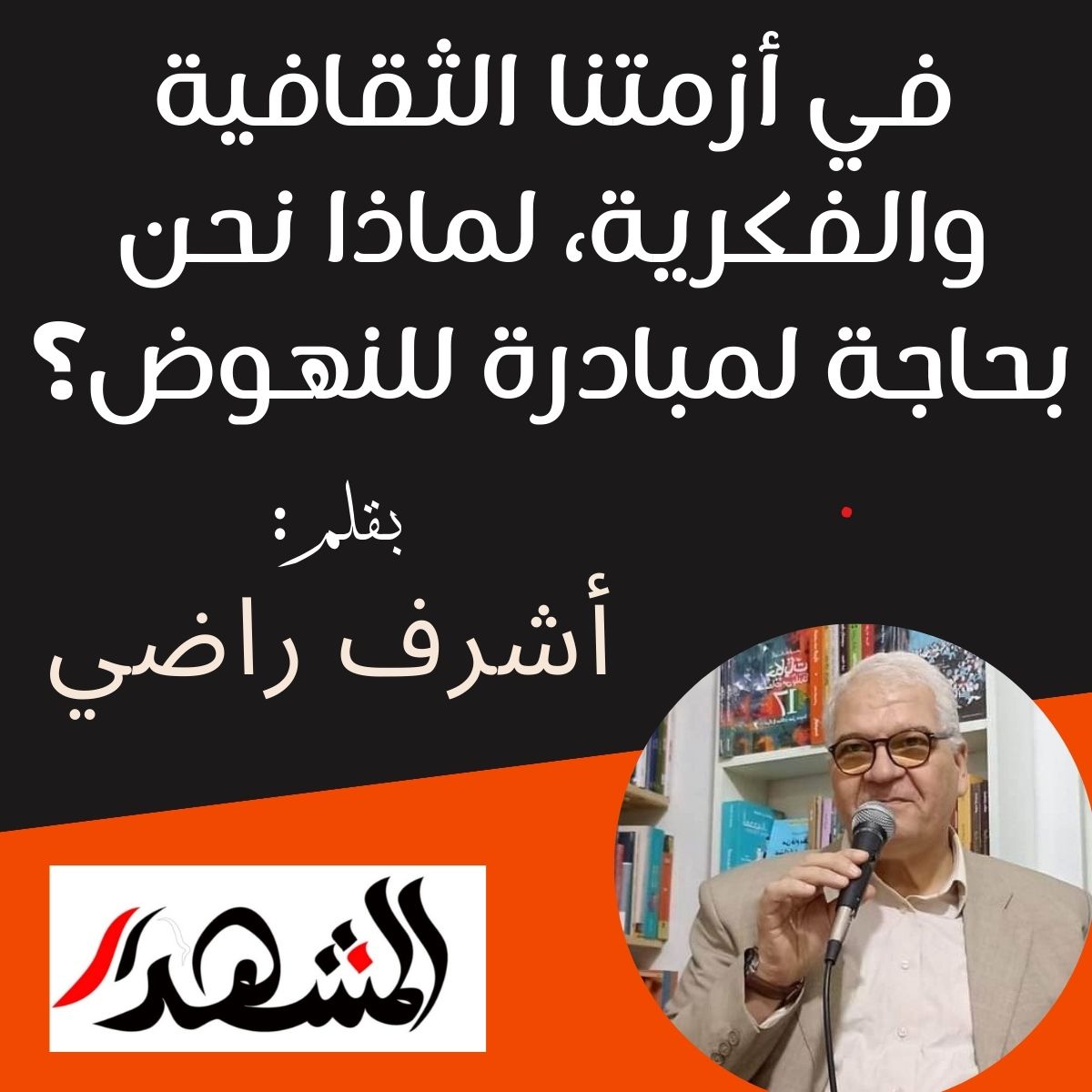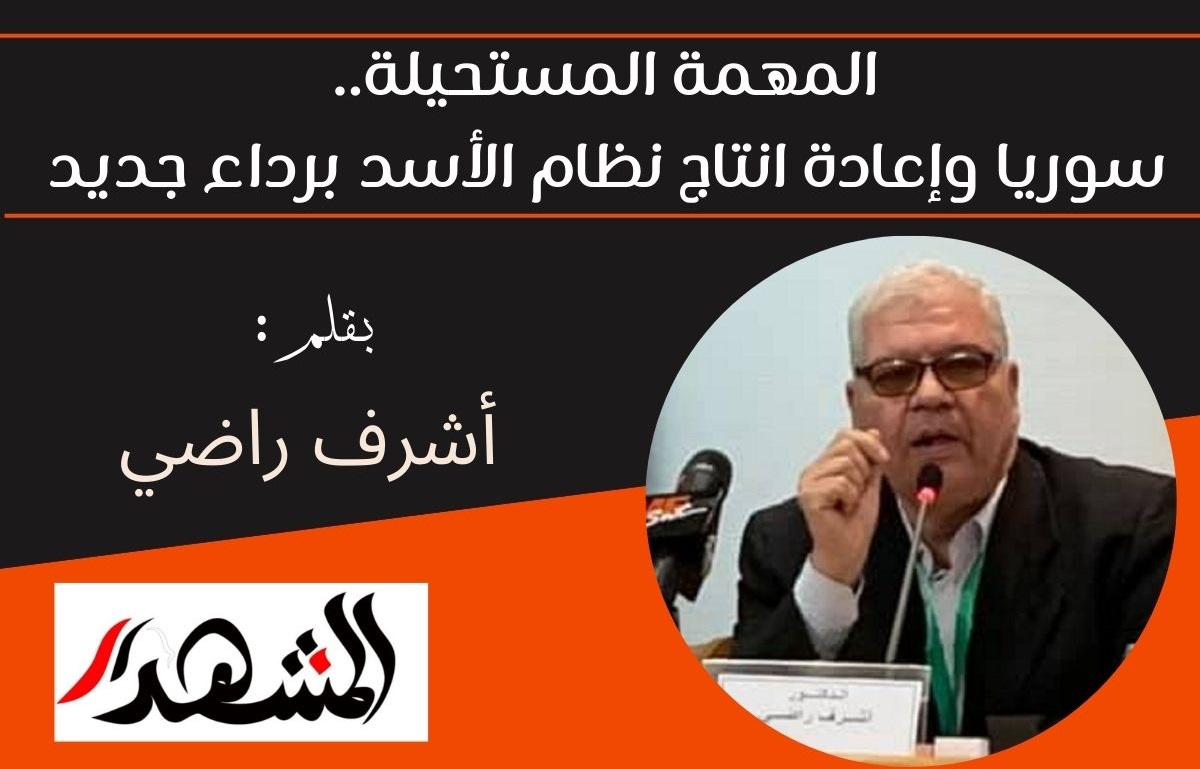في المقال السابق، تطرقت لمسألة غياب النقاش العام والحر حول قضية تراجع "قوة مصر الناعمة"، والحاجة إلى مبادرة للنهوض بهذه القوى التي تزخر بها مصر، لكن المسألتين – التراجع ومبادرة النهوض – لم يأخذا حقهما من النقاش الذي لم يتسع له المقال السابق ولن يتسع له أيضاً المقال الحالي وسيتطلب مقالات أخرى. وأرى أن نقاشاً حول تراجع قوة مصر الناعمة وحاجتها الملحة إلى مبادرة من أجل النهوض بتلك القوى مستحيل بدون تحليل طبيعة الأزمة الثقافية والفكرية التي تعانيها مصر منذ عقود، وهو الأمر الذي يلاحظه كثير من المثقفين المنشغلين بهذه القضية والمراقبين والدارسين المهتمين. وتم تناول هذه الأزمة عبر سلسلة من النقاشات العامة تحت عناوين مثل "التجريف الثقافي" أو "التصحر الثقافي" وغيرهما. والحقيقة أن ما يجري الاعتداء عليه بالسرقة والنهب أو بالتشويه والتدمير، هو إرث مصر الحضاري والثقافي القديم والحديث، في حين أن هناك جانباً آخر للأزمة يتصل بعودة مصر، مرة أخرى، إلى حالة من حالات الانقطاع عن هذا الميراث، بعد فترة من الانفتاح والتواصل والتي كانت سمة رئيسية لمشروع الدولة الحديثة في مصر. كيف حدث هذا الانقطاع والتراجع؟ وما السبيل لوصل ما انقطع ووضع شروط لنهوض يؤسس على استعداد فطري للإبداع الفني والثقافي لدى الأغلبية الساحقة من المصريين الذين يجري تهميشهم، وبقسوة؟
التهميش وإهدار القوى
أشرت في مقالي السابق أن قوى مصر الناعمة مهدرة، وأي دعوة لمبادرة من أجل النهوض لا بد وأن تتطرق لمسألة الهدر أو الإهدار هذه، وأن معالجتها يبدأ بالوقوف على أسبابها المباشرة والرئيسية أو الثانوية، لكن دعنا نركز على ما هو مباشر ورئيسي، أما الثانوي فسيجري حله في سياق علاج السبب الرئيسي الذي أراه منحصراً في مسألة تعبر عن نظرة النخب الحاكمة للثروة البشرية، ذلك أن أي حديث عن القوى الناعمة ينصرف بالأساس إلى مفهومي "رأس المال البشري" و"رأس المال الرمزي". في هذا المقال سنتعامل مع المفهوم الأول، "رأس المال البشري". نقطة الانطلاق لأي مشروع جاد للنهوض هي النظر إلى البشر كثروة ورصيد، لا النظر إليهم كعبء، كما نرى في الخطاب المصدر من النخبة الحاكمة في مصر بمختلف مستوياتها، في قمة هرم السلطة وفي قاعدته، وفي لغة الخطاب التي تسعى لتبرير فشل السياسات العامة بمسألة الزيادة السكانية.
لا شك في أن إدارة السكان أو الجغرافية البشرية من الأمور الرئيسية في السياسة العامة لأي حكومة، وأن الأزمة السكانية لها وجهان، ففي كثير من دول الشمال الغنية بمواردها تتركز الشكوى على نقص السكان، ويتم التعامل مع هذه الأزمة بسياسات لفتح باب الهجرة أمام البشر من مجتمعات الوفرة السكانية التي تعاني في الوقت ذاته من شح الموارد نتيجة لضعف الإنتاجية وهدر كثير من القدرات والموارد بسبب الفساد وسوء التنظيم وسوء الإدارة. وعلى الجانب الآخر، تشكو النخب الحاكمة في بلدان الجنوب الفقيرة، من الزيادة السكانية، التي غالبا ما يتم الدفع بها كسبب رئيسي لحالة الفقر والتخلف التي تعاني منه هذه المجتمعات، ومن المؤسف حقاً أن مثل هذا المبرر يحول دون حل المشكلة لأنه لا يعالج الأسباب الجذرية لها. وفي تقديري، أن السبب الرئيسي يتعلق بالانحياز الطبقي للنخب الحاكمة الذي يرتب الأولويات السياسية لهذا المجتمع أو ذاك. وأحد النتائج الأساسية لهذا الانحياز هو ظاهرة التهميش التي تعاني منها هذه المجتمعات المحكومة بنخب واقعة في أسر النظرة الطبقية للبشر، والتي تميل إلى النظر للمكانة من منظور الموقع الطبقي الموروث، وتسعى إلى تأبيده. ووصلتني رسالة من صديقي نمساوي من أصل سوري تعليقاً على مقالي السابق يستعرض فيها تجربة حزب الشعب النمساوي، وحزب الشعب الأوروبي، التي تركز على تعزيز وضع الطبقات الوسطى وتقويتها، كفلسفة للتنظيم الاقتصادي للمجتمع، وهي تجربة تستحق الدراسة والتأمل، لكن الأمر اللافت للنظر هو أن النخب الحاكمة في مجتمعاتنا تعمل في اتجاه مضاد تماماً. فقد تأثرت هذه النخب بالاتجاهات المحافظة الجديدة في الفكر الاقتصادي والتنموي الأمريكي وبمدرسة شيكاغو وعميدها ميلتون فريدمان، وهي المدرسة التي تتعرض لانتقادات شديدة من الاتجاهات الليبرالية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة.
النتيجة الرئيسية التي ترتبت على هذا التحول في النهج، هي التهميش المتزايد الذي يعاني منه مجتمعنا نتيجة لسياسات عامة أدت إلى تعميق الانقسامات الطبقية وتنمية الفقر. لقد كانت فضيحة "صفر المونديال" في عام 2004، لحظة كاشفة، بالنسبة لي، إلى ما انتهى إليه الحال نتيجة للتراجع في قوة مصر الناعمة والخشنة، على حد سواء. وكتبت في ذلك الوقت معلقاٌ على هذه الحادثة مقالاُ نشرته صحيفة الوطن، منبهاً إلى خطورة الموقف الذي حددته في التهميش الذي تعاني منه مصر خارجياً، الذي جسدته حقيقة أن الملف المصري لتنظيم بطولة كأس العالم 2010، لم يحصل ولو على صوت واحد عند عرضه على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذكرت أن هذا التهميش الخارجي ليس سوى مظهر أو عرض لتهميش اجتماعي وسياسي تعاني منه مصر داخلياً. وقتها ركزت التحقيقات ورد الفعل على مبلغ 43 مليون جنيه مصر، منها 32 مليون جنيه أموال عامة و11 مليون جنيه أموال خاصة قدمها الرعاة، وركزت ردود الفعل اللاحقة على السبب الذي أورده الاتحاد الدولي لرفض الملف المصري والمتمثل في عدم صلاحية الطرق والخدمات والإدارة المصرية لتنظيم مثل هذا الحدث.انصرفت جهود الدولة اللاحقة إلى الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وخدمات ولم تهتم كثيراً بجوهر المشكلة والمستهدف من أي جهد تنموي وهو "الإنسان"، ولم تلتفت إلى أن الثقافة والاهتمام بها وترقيتها يجب أن تكون المحور والموجه للسياسات العامة للدولة ولجهودها التنموية.
الخوف من الثقافة
كل ما فعله وزير الدعاية السياسية في ألمانيا النازية، جوزيف جوبلز، حين قال "كلما سمعت كلمة مثقف (أو ثقافة) تحسست مسدسي"، شيئا سوى أنه أماط اللثام عن حقيقة موقف الحكم الاستبدادي من الفكر والثقافة والمثقفين. لقد تناول المفكر المغربي الراحل، محمد عابد الجابري، هذه المسألة في كتابه "المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد"، الصادر في عام 1995، وتعرض الكاتب المصري الكبير فتحي غانم لها في كتاب آخر صدر في العام ذاته، في سلسلة كتاب اليوم التي تصدرها مؤسسة دار أخبار اليوم، بعنوان "معركة بين الدولة والمثقفين: كيف سيطرت المخابرات والمباحث على عقول المصريين". ويستعرض هذان الكتابان وغيرهما من عشرات الكتب التي تعرضت لأزمة العقل والفكر والثقافة في البلدان العربية، المحن التي يتعرض لها المثقفون في مختلف البلدان العربية على أيدي نظم حاكمة تعادي العقل والفكر والمثقفين، صناع الفكر. والأخطر هو الموقف الذي يتخذه كثير من الفقهاء المسلمين المنتمين لمدرسة الوحي، منذ عصر الفقيه الكبير أبو حامد الغزالي، صاحب كتاب إحياء علوم الدين، من العقل وأدواته لاسيما المنطق والفلسفة.
بالتأكيد، المعارضة هنا ليست للثقافة كمعطي أو منتج اجتماعي يتشكل نتيجة لتفاعل الأفراد في المجتمع فيما بينهم وتفاعلهم مع البيئة من حولهم، والتي تشكل وسطاً يحكم طريقة التفكير السائدة في المجتمع أو لدى طائفة من طوائفه. وإنما الموقف هنا إنما ينصرف إلى الموقف من طبقة المثقفين في المجتمع (الانتلجينسيا)، وهو موقف مرده أن الفكر الذي تقدمه هذه الطبقة أو الفئة يقدم معياراً للتقويم أو الحكم على السلوك والقرارات التي تتخذها السلطة، وينصرف أيضاً إلى الثقافة باعتبارها فعلا يستهدف التغيير، تغيير السلوك وأساليب التفكير وما هو سلبي من عادات وتقاليد، أو تقديم رسائل تتصادم مع المصالح الراسخة والمستقرة ومع المستفيدين منها. وبالتأكيد أن السيطرة على شعب غير مثقف وغير متعلم أسهل بكثير من السيطرة على المتعلمين وتوجيههم. إن التعليم يزيد من تكلفة السيطرة وممارسة السلطة. وفي هذا السياق يمكن فهم موقف النخبة الحاكمة من مسألة الفكر والثقافة، وحرصها على تهميشهما، وهو موقف يتسم بقصر نظر شديد وينطلق من مصالح ضيقة ويعمق من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها المجتمع.
وهكذا، لم تحظ قضية التراجع الثقافي والفكري، أو أزمة الثقافة والفكر في مصر، بأي اهتمام يذكر، من قبل متخذي القرار، رغم إدراك بعض دوائر صنع القرار لضرورة وأهمية الثقافة، وهو ما يتضح من وثيقة أعدها وزير الثقافة السابق، عماد أبو غازي، التي عرضها بالتفصيل، الكاتب والمفكر نبيل عبد الفتاح في كتابه "الحرية والحقيقة"، أو فيما يكشفه ما جاء في الجزء المخصص للثقافة في وثيقة "استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030"، والتي اعتبرت الثقافة أحد المقومات الأساسية للبعد الاجتماعي في التنمية المستدامة. ولا شك في أن المحور الثقافي كان شاغلاً رئيسيا لأعضاء لجنة الخمسين الذين وضعوا بنود دستور مصر في عام 2014، إذ تضمن هذا الدستور، ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية، فصلاً كاملاً عن المقومات الثقافية للمجتمع هو الفصل الثالث من الباب الثاني المخصص للمقومات الاجتماعية والذي تغطيه المواد من 47 إلى 50. ورغم هذه الجهود، إلا أن هناك مشكلة فيما يخص السياسات الثقافية للدولة، لخصتها دراسة تناولت هذه السياسات بالتحليل، والتي لخصت أسباب الأزمة من خلال دراسة أربعة تصورات للسياسات الثقافية، قدمها أربعة من وزراء الثقافة في مصر خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2020، في استمرار الخلاف بين دور الدولة والفاعلين الآخرين في الشأن الثقافي، ومحتويات السياسة الثقافية، وعدم استقرار السياسات الثقافية بتغير وزراء الثقافة، وشح الموارد المالية وضعف كفاءة العنصر البشري.
سيكون من الصعب في حدود هذا المقال تناول هذه المشكلات، لكننا سنركز على الجانب المحوري في هذه الأزمة والمتمثل في غياب رؤية أو عدم وجود استراتيجية ثقافية للدولة المصرية في سياق التفكير في "الجمهورية الجديدة"، الأمر الذي يشير، وللأسف الشديد، إلى استمرار موقف الطبقة السياسية المصرية من الثقافة. ولا يقتصر هذا الأمر على الحكومة أو النخبة الحاكمة أو القيادة السياسية للدولة فقط، وإنما هذا الغياب ملحوظ، وبشكل لا يمكن لأحد أن ينكره، على مستوى الأحزاب السياسية. فلا يوجد ما يشير إلى اهتمام الأحزاب السياسية في نشاطها العام بالأزمة الثقافية والفكرية التي تعاني منها مصر، إلا باستثناءات قليلة وفي حدود انشغالها بقضايا أكبر مثل مسألة الهوية وما تفرضه من صراع سياسي وفكري، وباستثناء بعض التجارب المحدودة التي لم تستمر كثيرا ولم تحدث فارقاً يذكر في إعطاء الملف الثقافي وصناعة الفكر المكانة التي يستحقها. الأمر قد يتطلب طرحاً مماثلا لما تناوله الصحفي البارز، محمد سلماوي، في مقاله المنشور في جريدة الأهرام بتاريخ 23 مايو 2023، والذي طالب فيه بضرورة "وضع إستراتيجية ثقافية جديدة"لا تقف عند حدود مشروعات وزارة الثقافة، وإنما تطمح لأن تصبح "إستراتيجية عامة للجمهورية الجديدة"، ودعا إلى تعاون وزارات الثقافة والتعليم والشباب والأوقاف والهيئة المسؤولة عن الإعلام والمؤسسات الثقافية للمجتمع المدني، لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
ما يلفت النظر في طرح الأستاذ سلماوي نقطتان: الأولى هو إدراك لأهمية القوى الناعمة لمصر، فمصر دولة ثقافة أقامت مجدها على مر التاريخ بقوتها الناعمة من فكر ومعمار وفنون وآداب، وليس بجيوشها الغازية أو ثرواتها الطبيعية، والنقطة الثانية، هي أن بناء الإنسان الجديد هو الهدف الأساسي لهذه الاستراتيجية،وأن بناء الإنسان لا يتوقف عند إصلاح حال المؤسسات الثقافية أوانعاش أوضاع المسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية، وإنما يركز على التعليم ودور المدرسة المهم والمؤثر في تنشئة جيل يواكب التطورات المتسارعة التي يشهده العالم، بما يتفق مع الهدف الذي حددته "رؤية 2030"، والتي استهدفت أن تكون في المجتمع المصري، بحلول عام 2030، منظومة قيم ثقافية إيجابية تحترم التنوع والاختلاف وتمكن المواطن من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وإكسابه القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة، والتي ترى في هذه العناصر في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليمياً وعالمياً.ولا شك أن تحقيق هذه الرؤية يستلزم خطة للنهوض لا تقتصر على أنشطة وزارة الثقافة، وإنما تتضمن أيضا خطة لإصلاح التعليم والمدارس، وإعادة النظر في المناهج الدراسية البالية التي تعتمد التلقين وحشو أدمغة التلاميذ بها ، ولا تغفل عن الدور المحوري للإعلام في تشكيل وعى وأفكار المواطنين، ولا دور الوزرات والهيئات ذات الصلة.
النهوض والحفاظ على المقومات
إن هذه الاستراتيجية لا تهتم فقط بالحفاظ على المقومات الثقافية للشعب المصري والدفاع عنها، فهذه نقطة أكدها الدستور الذي ألزم الدولة في "المادة 47" بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وأكد في "المادة 48" أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز..."وفي نص "المادة 49" الذي ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها واعتبر أن الاعتداء على الآثار والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. كذلك أولت "المادة 50" من الدستور اهتماما كبيراً بتراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله -المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية- باعتباره ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، ولم تغفل هذه المادة عن الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته، وجرم الاعتداء على أي منها. ويتضح من النص في هذه المادة إدراك المشرع لأن مكونات التعددية الثقافية في مصر، ثروة قومية على الدولة أن تولى اهتماما خاصا بالحفاظ عليها.
إلا أن المسألة لا تقتصر فقط على الحفاظ على التراث الثقافي والفكري لمصر، وإنما يجب أن تنصرف أيضا إلى النهوض بهذا التراث وتنميته وإدراك أنه أحد المقومات الرئيسية لقوة مصر، دولة وشعباً. ولا شك أن ملف التعليم هو المدخل الرئيسي لهذه الصناعة الثقيلة التي تعد من أهم الصناعات لأي أمة وهي بناء الإنسان القادر على التفاعل الإيجابي والبناء من أجل التنمية والتقدم. ومن الأمور اللافتة هنا أن التفكير في مسألة الثقافة لم يعد مقتصراً على النخبة في المجتمع بل أصبح التفكير ينصرف إلى ما يعرف بالحرف والصناعات الإبداعية والتراثية في المجتمعات. ومن شأن تغيير النظرة إلى الثقافة ليشمل هذا البعد أن يغير من طريقة تعامل مع الثقافة والذي يجعل جزءاً محورياً في السياسات العامة. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها كثير من الهيئات الرسمية وغير الرسمية من أجل رفع الوعي بأهمية وقيمة الصناعات الثقافية والحرف الإبداعية في مصر، وعلى الرغم من عشرات الدراسات والتقارير والمؤتمرات التي بحثت هذا الموضوع، إلا أن هذه الجهود لم تثمر في حفز الدولة على وضع استراتيجية للنهوض بمثل هذه الصناعات، وهو موقف لا يمكن فهمه بمعزل عن الموقف من الثقافة والمثقفين وفقر الفكر الاقتصادي الذي ينظر إلى الفائدة المباشرة والعاجلة ولا يميل للاستثمار طويل الأجل في مشروعات ثقافية، لعجز عن رؤية المردود من هذه الصناعات.
تكفي هنا الإشارة إلى ما تبذله دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي من المؤكد أنها بحكم التاريخ والجغرافيا، لا تمتلك تراثا مثل التراث الإبداعي المصري، لكن نخبتها الحاكمة أدركت أن هذا التراث ثروة فعمدت إلى تطويره وتنميته من خلال وضع خطة استراتيجية مدتها عشر سنوات صاغتها في وثيقة "استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية 2021- 2031"، والتي أعدتها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، وحددت لها أهدافاً تتمثل في:- تعزيز مكانة الدولة على خريطة الإبداع الثقافي العالمي وفي مؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال؛ وتحويل الدولة إلى وجهة جاذبة للمبدعين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم؛ وجذب المواهب والمبدعين لتأسيس وتطوير مشاريعهم المبتكرة في الدولة؛ ومضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع الثقافي والإبداعي؛ وتوفير وظائف جديدة في هذا القطاع؛ ورفع متوسط دخل العاملين فيه؛ ورفع متوسط إنفاق الأسر على السلع والخدمات الثقافية والإبداعية؛ وزيادة حجم صادرات المنتجات والخدمات الثقافية والإبداعية. ولتحقيق هذه الأهداف، حددت الاستراتيجية 40 مبادرة، توزع على ثلاثة محاور رئيسة هي: محور الموهوبين والمبدعين، ومحور المهنيين وبيئة الأعمال، وممكنات بيئة الأعمال، وعملت على توحيد الجهود المبذولة على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية ومؤسسات النفع العام، بهدف تعزيز مساهمة هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، ومكانة الإمارات كوجهة عالمية تستقطب الخبرات والمواهب الإبداعية، وتمكنها من إنتاج محتوى إبداعي في بيئة داعمة ومتميزة، تضمن الاستدامة والكفاءة والجودة.
إن نظرة إلى هذه الاستراتيجية تشير إلى أمرين: الأول، هو إدراك أن مثل هذا القطاع يتطلب رؤية شاملة ومستقبلية، والثاني أن كثيرا من بنود هذه الاستراتيجية استفاد من تجارب وخبرات مجتمعات أخرى، والأهم أنه استفاد من التوصيات الواردة في عشرات الدراسات التي كتبها باحثون وأكاديميون مصريون، وضعت حكوماتنا المتعاقبة دراساتهم وما تضمنته من توصيات على الرف، وماذا ينتظر من أناس لا يقدرون قيمة الثقافة والمعرفة. إن مبادرة النهوض لا بد وأن تبدأ بتغيير نظرة المؤسسات المسؤولة عن اتخاذ القرار للثقافة والمثقفين وأن تطلق العنان للجهود المجتمعية وحرية التفكير في هذه القضايا، لا أن تكون أدوات معاونة في نزيف قدرات المصريين وهدرها. إن الواجب يحتم الصراحة في طرح هذا الموضوع للنقاش العام والإلحاح من أجل تغيير النظرة لمسألة الثقافة والتغيير، وحل المشكلات يبدأ دائما بالاعتراف بها ومواجهتها بدلاً من دفن رؤوسنا في الرمال كالنعام. إن هذه القضية لم تعد مجرد حديث للمثقفين وإنما باتت موضوعاً يستحق أن نخوض من أجله المعارك، فهي قضية أن نكون أو لا نكون في الصراع من أجل المستقبل في هذه المنطقة وفي العالم الأوسع.
----------------------------
بقلم: أشرف راضي