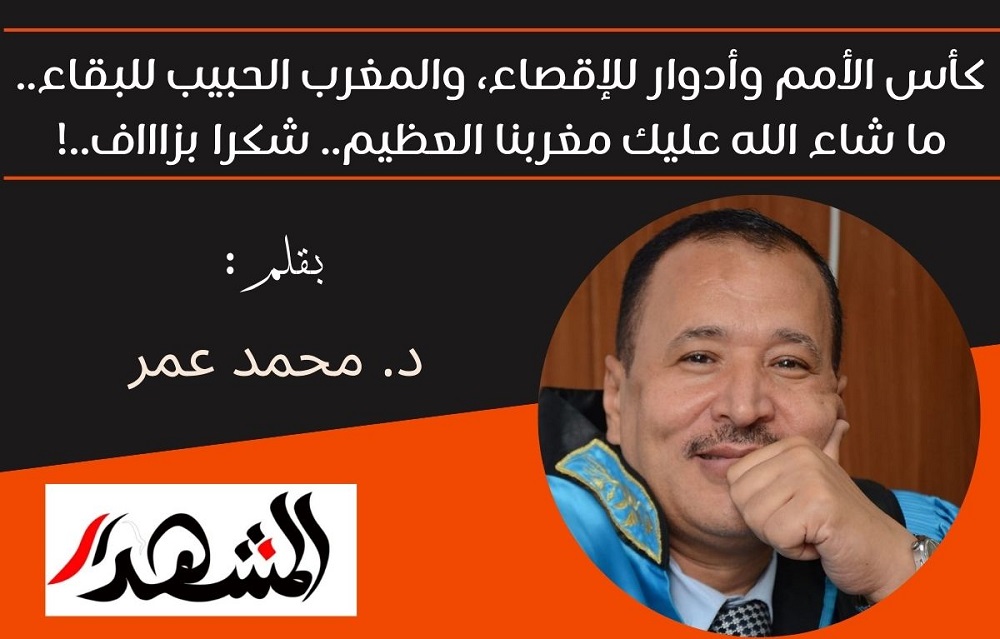لعلَّنا من خلال تجاربنا النَّقديَّةِ المتّصلةِ بتذوُّقِ الفنونِ نؤمنُ الآن بما آمنَ به هوراسُ " كما يكون الرَّسم يكون الشّعر"، ولقد نعتَ النّاقد الإغريقي لوكيان شاعِرُهُم الأعظمُ هوميروسُ بالرَّسّام المجيدً؛ فالشّعراءُ حقيقةً هم أعظم الرَّسَّامين؛ فالشِّعر صورٌ ناطقةٌ، والرُّسومُ قصائدُ معبرةٌ؛ لذا كانت القصيدة لوحةً مرسومةً بلا حدودٍ، والرّسمُ قصيدةٌ بلاصوتٍ؛ فالفنَّانِ فنٌّ واحدٌ له وجهانِ.
ولقد مرّت البشرية عبر تاريخها بقصائد رسمها رسّامون، والعكس، ولعلّنا نذكرُ قصيدة الشاعر الفرنسي مالارميه "عصر إله الغاب" التي رسمها الفنّان مانيه، ولحنها ديبوس، ونقلها نينسكي إلى رقصة باليه شهيرة؛ هكذا يكون التّنافذ بين الفنون؛ لأنّ ثمة تنافذًا بين الحواسّ والعواطف والانفعالات والأفكار، يعتملُ داخلَ النّفسِ الإنسانيّةِ لحظةَ تلقي العمل الفنّيّ.
ونقش الحنّاء قصيدة للشاعر خالد جعبور توازيها صورةٌ مرسومة لنقش حنّاء على كفّ حسناء، أترك لك صاحب الذوق الرّهيف تكوين أفق شعوريّ وفكريّ تُجاهَ اللوحتين المتوازيتين بمفهوم جيرار جينت والمتطابقتين من خلال واقع تذوقي مسبق نتفق ونختلف حوله بعد تأملهما:
الزَّهرُ في كفّها حُسْناً لها يُضْفي ** مَا أَجْمَلَ الزَّهْرَ مَرسُومًا عَلَى الكَفِّ .
قد زيّن الكَفَّ أزْهارًا وَجمّلَها ** حتَّى غَدَا الزَّهرُ مِنها طَيّبَ العَرفِ .
بهِ تغنّتْ منَ الأطيارِ شَادِيةٌ ** فذابَ مِن شَدوها الإحساسُ في حَرفِي.
فيضٌ مِنَ الحُسنِ يَجري حولَ مِعصَمِها ** وفي مَدى الرُّوح يَجري حُسنُها خَلْفي .
كأنَّه السِّحرُ يَجري في دَمي ولهُ ** قلبي غَدَا تَبَعًا بالرَّغمِ عنْ أنفِي.
أُخفِي بِنفسِي هُيَامًا حِينَ أرْمقُهُ ** وإذَا نظَرتُ لهُ أُبدي الّذِي أُخفِي.
يا ربَّة الحُسنِ إنّ الحُسنَ أضعفني** فلترحمِي ما تريهِ اليومَ مِنْ ضَعْفِي.
يَحلُّ بِي سُقم ٌمِمَّا أَرَاهُ فَمَا ** لِي دُونهُ مِن دَوَاءٍ أَبتَغِي يَشْفِي .
مَهْما وَصَفتُ لهذَا الحُسْنِ يُعجِزُنِي ** لأنَّهُ فوقَ ما قدْ قُلتُ مِنْ وَصْفِ .
لا الشِّعرُ لا النَّثرُ يُوفي ما أرَى أَبدًا ** مَهمَا أَقُلْ عَن جَمالِ الكفّ لا يَكْفِي .
هذه قصيدة صورة يا صاحبي أو صورة قصيدة، قل ما يحلو لذوقك؛ فالأمر لا يمكن حسمهُ حول أيّهما أسبق، هذه الصورة المرسومة لنقش حناء على كف فاتنة حسناء، أم القصيدة المصوِّرة لصورة هذا النّقش وصداه في النّفوسِ من ناحية ونفس الشّاعر المتيَّم الذي اتّخذ من صورة العصفور الواقف على الغصن إلى جوار الزّهر في النقش معادلًا موضوعيًّا عنه.
إن كنت ممن تزكو عنده حاسّة البصر فستستهويك الخطوط البديعة الملونة المرسومة بدقة متناهية بظلالها المترامية ، وقد أودعت فيها الشّاعرة والفنانة التشكيلية الموهوبة أفراح مؤذنة أحاسيسها وتركتها قصيدة تنطق بكل آيات الفتنة والجمال وتثير داخلك من المشاعر ما ينظم من صداها قصائد حبّ استحضرتها كف تلك الفاتنة التي تستحضر تجربتك أنت وفاتنتك وفتنتك أنت، وستخرج في النّهاية صورة مطابقة لتجربتك أنت.
وإن كنت ممن أسرهم الحرف العربي بإيقاع جرسه وتنغيمات مقاطعه، وعبقريات تراكيبه، وتنوع أساليبه، فستستدرجك قصيدة خالد جعبور إلى عالمها الخاص وقدرتها الفذة على رسم صورة موازية بالكلمات لما يثيره نقش الحنّاء في كف حسناء من ولَهِ وعشقٍ وتدلُّهٍ واستتار وفضح، وتماهٍ بين تناغم الطبيعةِ في رموزها وعالم المحبين في تآلفه؛ لتظل تذهب وتجئ بين الرسم والقصيد لتؤطر المطلق وتطلق المقيد في سماوات الشعر المفتوحة الآفاق لتعدد زوايا النّظر.
إذًا؛ فنحن أمام قصيدة تترجم رسمًا، أو رسمٍ يترجمُ قصيدةً، و يوقفنا اختلاف أدواتهما الفنيّةِ في البناء والتَّشكيل أم إشكاليَّة الصُّورة الواحدة ذات الوجهينِ بما تمتلكانِ من قدراتٍ متفاوتة في الاتّساق والتّأثير والتّلقّي؛ فكلتاهما تعتمد على حاسَّة المتلقّي وإحساسه ودربته في فنّي الرسم والشّعر، وثقافته الشّخصيّة، وعواطفه الخاصّة، ومخزون تجاربهِ الوجدانيّة في الماضي والحاضر وما يستشرفه من مستقبل أيضًا؛ لأنها منطقةٌ شائكةٌ بين الواقعِ المصوَّر، والخيال الخلَّاقِ.
وأعترف لك صاحبي أنَّني ممَّن يسترقون السّمع إلى سِحر الحرفِ، وروحي أروحُ لإشعاعات الكلماتِ وامتداداتها وشحناتها الوجدانية وذاكرتها عبر ثقافتي الدَّرس والحِسّ، من روح الخطوط المتشابكة والمنحنية بدلال وحنان معا في تآلفٍ وتعانق وتعشق وتحلُّق، في وسط الرسم لتسبح بك سريعًا نحو آفاق مترامية مفتوحة على كل احتمالات البهجة والخوف في الوقت نفسه؛ فالعصفور على عود هشّ تصله بالغصن نتوء واهن؛ فإن حلّق ترك الزّهر حبيبه، وإن استدار له وقع؛ فاختار القرب مع البعد وإخفاء العين العاشقة عن الزّهر وإن كانت عينه فاضحة أمره.
هذه المفارقة بين الهشاشة والالتئام في الرَّسمِ نلحظها في المقارنة بين المركز والأطراف فخطوط المركزِ قريبة مكثفة متعاضدة تسعى للاستدارة لتحقيق الوحدة والاتساق، وخطوط الأطراف بعيدة مشعثة تتوزّع بين التفرّق التام في معظمها، ووهم الاقتراب المحتمل في أقلها؛ ففي اللحظة التي تشعر بأنها تجمعك وتدنيك من لبّها وفلبها وتطمئنك لاتّساقها واستوائها تفرقك خطوطها؛ فتشعّث روحك، وتشظي قلبك، وتبعثرك؛ فتظل في بين منزلتينِ: الرّكون والاحتماء والاكتمال والامتلاك والبهجة، والتّشتُّت والحرمان والحسرة؛ فثمة محبٌّ ضعيفٌ على غصنٍ واهٍ/عصفور، ومحبوب ينعم وسط الغصن المتماسك/ الزّهر، وقد تجلّت عبقرية الرّسم في توزيعات ريش العصفور مجسدة أزهارًا محتملةً مجسدة سيطرة الزّهرة على قلبِ العصفور الوامق.
لعلّي اقتربتُ قليلًا أو ابتعدتُ عن شعريّة الصورة التي تستحقُّ مزيدًا من الصّبر والتّأملِ للوقوف على شعريّة خطوطها الملهمة التي توزّعت فيها مناطق الظل والفراغ، أو النور والعتمة لتتركك في عالمٍ من السّحر الملهم للعواطف المشبعة بالجمال دون أن توافيك لغة التّعبير عن صدى إحساساتك تجاه ذاك النّقشُ النّاطق، أو الشّعر الصّامت.
ولكن دعني أقترب بك كثيرًا من قصيدة خالد جعبور الذي يمثّل صدًى قريبًا أقرب للتّطابق مع الرّسم، وكأنهما صِنوانِ، ولعلّي أبتعدُ بك قليلًا حين أحتملُ أن يكونا ضربًا من تلاقي المشاعر وتشابهها دونما اتفاقٍ؛ فمشاعر المحبين تتشابه حين تمر بتجارب متقاربة؛ فالقصيدة والصورة تدوران في فلك ربة من ربات الجمال والحسن اللائي يحيّرن ذا اللّبّ، كأنْ لا لبّ لهُ، ويسبين قلبًا أدمن التّحليق، وكلا المعنيين يستدعي صورة العصفور طائش اللّب، خفيف العقل، عاشق التّحليق، رقيق القلب، قصير العمر، بل دعني أمارس معك لعبة التأويل قربًا وبعدًا فنعيد معًا قراءة القصيدة لنعرف إلى أي حدّ نقتربُ أو نبتعدُ؛ فالمطابقةُ في الفنّ محض وهمٍ.
يمثّل مطلع القصيدة صورة من الاتساق والانسجام في سطحه اللَّفظيّ، وكذا في عمقه المعنويّ:
الزَّهرُ في كفّها حُسْناً لها يُضْفي ** مَا أَجْمَلَ الزَّهْرَ مَرسُومًا عَلَى الكَفِّ .
تأتي عتبة المطلع، بعد عتبة العنوانِ متآزرتين في رسم صورة لنقش الحناء بما تستدعيه عتبة العنوان تلميحًا وتكثيفًا وعتبة المطلعِ كشقًا وفضحًا وتوضيحًا، وكلمة البدء عتبةٌ مهمة يمكنا البناء عليها داخل عتبة المطلع؛ فكلمة" الزّهر" تأتي جمعًا من جموع الكثرة معرفةً بال العهديّة بقرينة الصَّورةِ المصاحبة السَّابقة على القصيدةِ؛ فالمرادُ تلك الأزهار التي نقشت بالحناء على كفّ الحسناءِ. والزَّهر هو طلع الشَّجرِ والنَّباتِ في الرَّبيع خاصَّةً؛ وهو ما يستدعي مع حاسة البصرِ حواسَّ اللَّمسِ والشَّمِّ والسَّمعِ؛ فالزَّهرُ يُقطَّرُ فينتجُ ما يصلحُ للنَّقشِ والرَّسمِ ممزوجًا بغيرهِ من الحنَّاءِ؛ فامتلكت الكلمة إشعاعاتٍ عدَّة من حواسّ مختلفة.
وجاءت(ال) عهديَّةً أيضًا في (الزَّهرِ) لزهرٍ مرسومٍ مُشَاهدٍ، و(كفّ) معرفة بإضافة ضمير الغيبة(ها) إليها، وإن كانت الغائبة في خيالهِ وبوحي الصورة المرسومة حاضرةٌ؛ فهي حاضرةٌ غائبةٌ، أو غابة حاضرةٌ بقلقِ العشَّاقِ وتقلُّب أحوالهم يين البوح والسَّترِ، ويأتي خبرُ الزّهرِ شبه جملة(في كفّها) للاستغراق الكامل للجمال فيها .
ويمضي فيرسم صورته بالكلمات؛ فيقدِّم المفعول (حُسنًا) على عاملهِ (يُضفي) نقشًا بالكلماتِ على كفّ الورقةِ يشبه نقشَ الرّسم على الكفّ؛ فيزيد العامل والمعمول تأثيرًا على قوة تأثيرهما بما يحملانهِ من اتساع لدوائر الحسنِ وفيضانها.
ونلحظُ أنَّ(الزَّهر) كلمة مركزيّة في معنى البيت ارتبطت كلّ الكلمات بها، وزادتها الامتداداتُ الصّوتيّة المنبعثة من حروف اللِّين فيما تعلّقَ بها امتدادًا وجدانيًّا أكمل معناها وأتمّه وعمّقهُ دَلاليًّا؛ فاستدعى لذَّةَ العاشقِ في عشقه، بتآلف حروفهِ توازيًا مع تآلفِ البتلات والسَّبلاتِ في الزّهرة في دوائر عادلها الشّاعرُ بالفيضِ الحسنِ الذي يصنع دوائرهُ على اتّساع المدى.
ينتقل عجزُ البيتِ إلى إنشائيَّة التّعجُّبِ من خبريَّة البناء والدَّلالةِ في صدرهِ لاستدعاء صورة الكفّ المنقوشِ زهرًا وحُسنًا وفتنةً وتثبيتها؛ فيأتي التّعجّب فيطلقُ النّفسَ في تصوّر ذاك الجمال، ويختم البيتَ بردّ صدرهِ على عجزهِ مذكّرًا بالكفّ ومردّدًا إيّاهُ ليفاجئنا أنّ الزّهر الذي شغل مركز الدّلالة إنّما يُضمرُ وراءهُ فتنةً معادلةً بالكفِّ؛ فكلاهما في مقام الجمال سواءُ، ويأتي تصريعُ البيتِ ليعضّدَ هذا التّعادلَ والتّكافؤَ بينهما(الزّهر-الكَفّ).
وهكذا يستدرجنا الشّاعرُ من صورةٍ مركزيَّة إلى تفاصيلها الدّاخليَّة:
قدْ زيّن الكَفَّ أزْهارًا وَجمّلَها ** حتَّى غَدَا الزَّهرُ مِنها طَيّبَ العَرفِ .
-----------------------------------
بقلم: د. محمد سيد علي عبدالعال
(أستاذ الأدب العربي ووكيل كلية الآداب بالعريش- مصر)