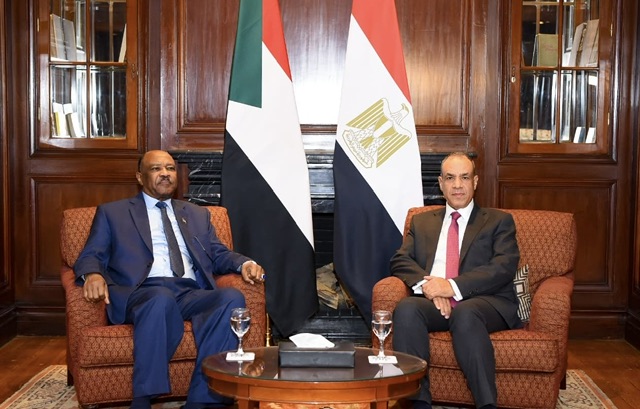الانقسام والتشتت الوطنى - وهو ماعرضنا ملامحه في الحلقة الماضية - كان مقصودا لتأجيج المناخ والفرز الطائفى الذى كان فى صالح تيار وتنظيمات بعينها وكانت رسالة غير مباشرة لصاحب القرار حينها، ومع العين الحمرا هذه والتى تمثلت فى استغلال الأحداث الطائفية، كانت هناك اجتماعات مستمرة بين المجلس العسكرى وكل القوى السياسية الموجودة على الساحة لوضع خريطة طريق تصل إلى تحقيق الاستقرار، بعيدا عن تلك الفوضى المسماة بالخلاقة والتى كانت رسائلها تتوالى من الخارج (أمريكا وغيرها) تحت مسمى الاختيار الديمقراطى للثورة.
المجلس العسكرى أعلن أنه لايطمع فى الحكم ولكنه سيسلم الحكم للقوى التى سوف يختارها الشعب، وهذا هو بيت القصيد. من هي هذه القوى التى يمكن أن يختارها الشعب؟
ظهر الانقسام والتناقض المغلف بشعارات الثورة والحفاظ عليها بين القوى الدينية والقوى المدنية، ولكن ماهو الواقع على الأرض حينها؟ القوى المدنية تمثلت فى مجموعة أحزاب كانت فاقدة الجماهيرية ولاعلاقة لها بالشارع ولذا لم تكن حاصلة على الشرعية الجماهيرية. الجمعية الوطنية للتغيير وهى تجميع لقوى اسمية ولشخصيات عامة لاتملك اى تواجد حقيقى فى الشارع غير التواجد الإعلامى ورفع الشعارات الثورية اعتمادا على أن ذلك سيجعل الجماهير تحمل هؤلاء على الاعناق وتسلمهم السلطة الثورية!.
هناك شارع منقسم على ذاته طائفيا بعد غزوة الصناديق التى احدثت فرزا صب وراكم فى صالح التيار الديني، والأهم أن جماعة الإخوان كانت قد أجلت الخلافات بين التيار الدينى وظهرت تلك التيارات والتنظيمات وكأنها تيار واحد ذا رؤية واحدة (والأدهى أنهم ظهروا وكأنهم القوى الثورية).
كانت جماعة الإخوان قد امتلكت الخريطة الاجتماعية عن طريق المساعدات المقدمة للأسر والتلاميذ، وفرص العمل فى مشروعاتهم الاقتصادية والخدمة الطبية عن طريق المستوصفات والجمعيات الأهلية، خريطة تتحول إلى مناطق نفوذ انتخابية، إضافة لظهورها بعد أن ركبت الموجة الثورية يوم ٢٨ يناير حيث كانت قد أعلنت عن عدم مشاركتها فى مظاهرات ٢٥ يناير بل إنه فى اجتماع قبل ٢٥ حضره عصام العريان أعلن أن الجماعة لن تشارك، ليس هذا فحسب، بل رفض التوقيع على بيان يرفض التوريث!!.
ولأن الجماعة تجيد التلون حسب المصلحة والحاجة، فبالرغم من تزوير انتخابات مجلس شعب ٢٠١٠ كانت الجماعة تنسق كعادتها مع نظام مبارك فى تلك الانتخابات، بدليل إعلان محمد مرسي – الذي كان المسئول عن ملف الانتخابات - أن الجماعة نسقت مع الحزب الوطنى وتركت له دوائر زكريا عزمى وفتحى سرور وبطرس غالى ..الخ.
وفي ظل هذا الواقع السياسى الذى سيطر عليه المناخ الدينى لصالح السياسى، فى مواجهة الآخر الدينى والسياسي، مع امتلاك الشارع تحت ادعاء الحفاظ على الإسلام والمطالبة بتطبيق الشريعة. ورغم وضوح المشهد، كان غريبا أن تعلن ما تسمى بالقوى السياسية المدنية أن جماعة الإخوان هي التى حمت الميدان في موقعة الجمل، وهناك تصريحات لمصطفى بكرى وغيره تتباهى بدور الإخوان فى الميدان بل فى الثورة!! ناهيك عن زيارة رموز السياسيين ومنهم اليسار وبعض الناصريين لمقر الإخوان الجديد فى المقطم، إضافة إلى تحويل حفل الإفطار السنوى للجماعة إلى حفل قومى جمع كل الأطياف السياسية حينها حيث كان هناك وزراء على رأسهم وزير الداخلية منصور العيسوي، فما بالك بتحالف هذه القوى مع الإخوان ضمانا لعدد من المقاعد فى مجلس الشعب !!!
كان المجلس العسكرى أمام أحد اختيارين أما مساندة التيار المدنى بصورة أو بأخرى للوصول إلى الحكم، أو تسليم الإخوان الحكم عن طريق الانتخابات وبالمظهر الديمقراطى الذى كان شعار المرحلة ومطلب القوى الخارجية، خاصة الأمريكية والتى أعلنت دون مواربة مساندتها لجماعة الإخوان على اعتبار أنها جماعة تمتلك الشارع وتمتلك الرؤية الدينية والسياسية التى تؤهلها للحكم فى ظل مد دينى يحكم الشارع والمنطقة بكاملها.
هل كانت هذه الأسباب والواقع المعاش هما المدخل والمبرر لوصول الإخوان للسلطة؟ وهل كان شعار الإخوان (مشاركة لامغالبة) هو شعار تكتيكى بهدف الاستيلاء على السلطة؟ وهل كان المجلس العسكرى يدرك أن تنحية الجماعة تعنى حربا أهلية؟ وهل كانت هناك رؤية للمجلس العسكرى بأن وصول الإخوان للحكم تعنى نهايتهم قبل أن يبدأوا؟ خاصة أن هناك تصريح للواء عمر سليمان (أن وصول الإخوان للحكم يعنى كشفهم ونهايتهم).
وكأن الجماعة هى الثورة!
كانت شرارة الفوضى فى الشارع قد أطلقت بأحداث ٢٨ يناير ٢٠١١، ولغياب التنظيم الثورى الحقيقى الذى يمتلك برنامجا ليشكل السلطة الثورية التى تلتف حولها الجماهير حتى تحقق الثورة أهدافها على أرض الواقع، كانت النتائج الطبيعية هى تصاعد المناخ والفرز الطائفى بين التيار الاسلامى الذى تقوده جماعةالإخوان ومعها التيار السلفي بكل تصنيفاته إضافة إلى الجماعة الإسلامية (التى كانت قد أعلنت مراجعاتها نبذ العنف!!) وبين الشباب القبطى الذى خرج من بين جدران الكنيسة إلى الشارع رافعا الصليب أيضا.
أجج هذا المناخ الأحداث الطائفية التى قام بها فى غالب الأمر التيار السلفي الذى أسفر عن وجهه السياسى والنفعى بعد ٢٥ يناير بعدما كان يعلن أنه لاعلاقة له بالسياسة من قريب أو من بعيد، الذى كان يظهر فى هذه الأحداث تحت ادعاء الحل والتهدئة هم رموز التيار السلفي! فى الوقت الذى تصاعدت فيه الوقفات من السلفيين ضد البابا شنودة وأمام الكاتدرائية رافعين شعارات مسيئة للبابا وللكنيسة وللمسيحيين بحجة المطالبة بعودة من أسلموا واحتجزتهم الكنيسة.
وعلى الوجه الآخر كان التيار الإسلامى قد حول الأمر إلى صراع حياتى بين تيار يدعى التمسك والحفاظ على الاسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية، وبين تيار يطلقون عليه التيار العلماني الذى يضم القوى الثورية ومعهم الأقباط ، بزعم أن هذا التيار العلماني ضد الإسلام والمسلمين وضد تطبيق الشريعة. كان من الطبيعى أن ينحاز الشارع المسلم - وليس الإسلامي - إلى هذه الشعارات ويتبنى تلك الادعاءات التى لاعلاقة لها بالإسلام ولا بالشريعة.
ظهر هذا منذ الاستفتاء الذى تم فى ١٩ مارس ٢٠١١ على التعديلات الدستورية التى كانت تضم تعديل ٨ مواد من دستور ٧1 والتى أصبحت ٦٢ مادة فيما بعد!!. فى ذلك المناخ وعلى ضوء هذه الظروف وكعادة الإخوان أخذت الجماعة تستأسد فى مطالبها التى اخذت فى طرحها رويدا رويدا أثناء الاجتماعات التى كان يعقدها المجلس العسكرى مع كل القوى السياسية، وبالطبع كان هذا الاستئساد على خلفية تعاطف الشارع مع الجماعة بسبب تأجيج العاطفة الدينية لدى الشارع المسلم، حتى أننا وجدنا أن حزب الجماعة المسمى حزب الحرية والعدالة قد أصبح بديلا سريعا للحزب الوطنى ليس لأنه سيكون حزب السلطة البديل، بل لأنه الحزب الاسلامى الذى يحمى الإسلام والمسلمين من الهجمة الداخلية والخارجية على الإسلام والذى يريد تطبيق شريعة الله!! ناهيك عن تكاثر ظهور اللحى مما جعل أحد قادة السلفيين يتباهى بهذا ويطالب أن يكون الجميع هكذا، تعميقا للتدين الشكلي الذي يعتمدون عليه فى تمرير أهدافهم وتحقيق مصالحهم.
واتذكر هنا واقعة حاول فيها مجلس الوزراء العمل على تهدئة ذلك المناخ الطائفى، فقد دعا الدكتور على الغتيت وكان كبير مستشارى مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع بين بعض الرموز الإسلامية والمسيحية لمناقشة إنشاء مجلس قومى للوحدة الوطنية يصدر به قرار من المجلس العسكري، كان دكتور على الغتيت قد دعانى إلى حضور هذا الاجتماع فى مقر مجلس رئاسة الوزراء، وناقشنا لائحة مقترحة لهذا المجلس. كانت بعض مواد هذه اللائحة المقترحة تقول إن يشكل المجلس من عشرين مسلما ومثلهم من المسيحيين على أن يوافق شيخ الأزهر والبابا على هذه الترشيحات!!
هنا اعترضت أولا على تحديد هذه النسبة من الطرفين بما يعنى من وجهة نظري انها تعميق وتكريس للطائفية، والأهم أني اعترضت على موافقة شيخ الأزهر والبابا على هذه الترشيحات حيث أن كلا منهما وعلى ضوء الواقع المعاش سيجعل هذه الترشيحات لاتخلو من أعضاء متأثرين ومنحازين لكلا المؤسستين.
والأهم أني قلت.. هل سيوافق البابا شنودة على ترشيحى لعضوية هذا المجلس؟! حينذاك وجدت أغلب الحاضرين من المسيحيين يعترض على كلامي ويؤكد أن لاترشيحات بعيدا عن قداسة البابا (هكذا قالوا)، والأغرب أنه بعد حضورى هذه الجلسة التي تم الإعلان عنها فى وسائل الإعلام، وجدت هناك حملة شعواء ممن سموا أنفسهم (شباب ماسبيرو) رافضين حضورى ومشاركتى. (وإن كان هؤلاء يرفضون حضور من هو مسيحى فكيف كانوا سيقبلون غير المسيحي).
فى هذا المناخ وعلى ضوء تلك المعطيات أخذت جماعة الاخوان فى احتواء من تستطيع احتواءهم كل على طريقته وحسب احتياجه، فكانت هناك بعض الائتلافات الانتخابية بين الجماعة وبين بعض الأحزاب السياسية فى انتخابات مجلس الشعب، ضمانا للحصول على عدد من المقاعد فى المجلس لإدراك تلك الاحزاب سيطرة الجماعة على الشارع.
وفى الوقت الذى كانت فيه القوى السياسية والثورية تواصل التظاهر والاحتجاج بميدان التحرير، كانت جماعة الإخوان تسيطر على الشارع الانتخابى باسم الدين وبالمساعدات المادية، حتى حصلت الجماعة على أغلبية مقاعد مجلس الشعب. وتحول شعار الإخوان إلى (شرعية البرلمان لا شرعية الميدان!) وفى المجلس حول نواب التيار الاسلامى المجلس إلى أداة ترهيب للحكومة التى كان يرأسها د. كمال الجنزورى وبشكل مباشر، فى الوقت الذى كانت هذه الممارسات تمثل رسائل غير مباشرة للمجلس العسكرى والشارع المصرى بشكل عام.
كان وصول التيار الاسلامى إلى أغلبية البرلمان البداية الحقيقية للسيطرة على مجمل المشهد، حتى أصبح الجميع أما تابع بصورة أو أخرى أو معارض فى مناخ لاوجود طبيعى وسياسى فيه للمعارضة.
بدأت حينها المواجهات بين التيار وبين المعارضين تأخذ اشكال عنيفة لاتنبئ بأى خير، وبالرغم من ذلك وبمنتهى النفعية البراجماتية كانت الجماعة تعلن أثناء ترشيحات الرئاسة أنها لاتريد المغالبة بل المشاركة في محاولة منها للحفاظ على الشكل الثورى الذى استغلته الجماعة كعادتها.
هل كانت عادة جماعة الإخوان وديدنها الاستغلال؟ فى هذا الإطار علينا أن نعرج قليلا الى تاريخ هذه الجماعة حتى نتأكد من هذا، فالجماعة منذ نشأتها عام ١٩٢٨ وهى جماعة براجماتية نفعية لاترى غير مصلحتها فى المقام الأول، وتحاول تحقيق هذه المصلحة بكل السبل والطرق والأساليب المشروعة وغير المشروعة، لم تقدم نفسها منذ البداية كحزب سياسى ولكن قدمت نفسها بمسارات متعددة تتوافق مع الظرف السياسى الموضوعى فى كل مرحلة، ولكن الذى لم تستطع إنكاره وعلى لسان مرشدها الاول أنها جماعة سياسية ودينية واجتماعية وصوفية...الخ .
منذ تاسيسها وهى تغازل السلطة، أي سلطة، فبعد ثورة ١٩١٩ وإعلان تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ – وقبل إنشاء الجماعة بسنوات قلائل - كان هناك توجه للملك فؤاد يرغب في تتويجه خليفة للمسلمين بعد إسقاط الخلافة العثمانية، حتى يتم تأكيد مكانته السياسية من خلال هذا التوجه الاسلامى تأكيدا لسلطته الدينية والوطنية فى مواجهة خصومه السياسيين فى الداخل فضلا عما يحققه له ذلك من زعامة العالم الاسلامى. لكن هذه الفكرة واجهت صعوبة كبيرة فى عهد فؤاد، إلا أنها وجدت رواجا كبيرا فى عهد الملك فاروق وذلك من خلال علاقته بالأزهر كمؤسسة دينية يستخدمها فى مواجهة الخصوم.
هذا الأمر – ضمن أسباب أخرى - أحدث صراعا علنيا بين الملك وبين حزب الوفد مما سهل للإخوان استغلال الظرف ومساندة الملك فاروق ضد الوفد، وأصبح المناخ ملائما لجماعة الاخوان كى تظهر على الساحة المصرية. فشهدت المرحلة الأولى من العلاقة بين الإخوان وفاروق توافقا، بين مسيرة الإخوان الفكرية وتوجهات القصر الإسلامية، وأدى دعم القصر وتأييده لهم إلى نشر دعوتهم وهيأ لها أسباب القوة، إلا أن نبذهم الحرية والديمقراطية باعتبارها أنماطا غربية جعلها في عداء مع الاحزاب السياسية.
أصبحت الجماعة سندا لفاروق والقصر فى لحظات الخلاف بين القصر وحزب الوفد، ولم تكن هذه العلاقة تهدف لغير مصلحتهم فى المقام الأول، فمع تزايد قوة الإخوان بعد حرب فلسطين اضطربت العلاقة مع القصر، وأصبحوا مصدر تهديد له وكان الصراع الذى حسمه القصر لصالحه بعد قرار حل الجماعة ووقف نشاطها.
علاقة الجماعة بثورة يوليو
كانت الجماعة خلال الاربعينات قد بذلت جهودا موفقة لاختراق الجيش والشرطة، وصارت لها علاقات تنظيمية وشبه تنظيمية بعدد من الضباط الذين قادوا الثورة، وكان هؤلاء يتعاطفون مع الإخوان بحكم أنهم يدعون إلى إقامة الدولة الاسلامية، فضلا عن أن الضباط وتنظيمهم نشط هو الآخر من جانبه لاحتواء الضباط الإخوان، والتغلغل على نطاق واسع فى صفوف الجيش.
شارك الإخوان بعد إسقاط فاروق مع مجلس قيادة الثورة فى عمليات الحشد الجماهيرى كرسالة الإنجليز وللمناهضين للثورة، ساندوا الثورة والثورة ساندتهم حتى أن قرار حل الأحزاب السياسية لم يشمل جمعية الإخوان، كما قام سيد قطب بدور أساسي فى المساندة خاصة فى أيام الثورة الأولى، حتى أنه كان شبه بمستشار لمجلس قيادة الثورة ولكن طموح الجماعة الخيالى للوصول للسلطة جعلهم يريدون أن يكونوا أوصياء على القرار، فكانت النقطة التى انتهت بمحاولة اغتيال عبد الناصر فى الاسكندرية عام ١٩٥4.
كعادتها وبعد أن أفرج عبد الناصر عن قيادات الجماعة بعد وساطة عربية كانت محاولة انقلاب عام ١٩٦٥، ومن الجدير بالذكر وتأكيدا لمبدأ النفعية الذى تمارسه الجماعة طوال الوقت نقول: هل اعترضت الجماعة على حل الأحزاب بعد قيام الثورة؟ هل اعترضت الجماعة على إعدام خميس والبقرى فى الوقت الذى لم يوافق فيه عبد الناصر على الإعدام، بل كان القرار بتوقيع محمد نجيب؟ هنا لازلنا نرى الجماعة تأخذ موقفا ليس عدائيا فقط، بل موقف انتقام من عبد الناصر تحت زعم التعذيب وخلافه وهو ما تم كشفه على لسان قياداتهم فى الشهادة التى أدلى بها المهندس أبو العلا ماضى والذى كشف قيامهم بتأليف أكاذيب حول التعذيب منشورة فى كتب بأسماء لاعلاقة لها بهذه الكتب (كتاب زينب الغزالى إلذي ألفه يوسف ندا!!).
علاقتهم بالسادات
( أنا اللى غلطان كنت خليتهم مكانهم ) من خطاب السادات فى ٥ سبتمبر ١٩٨١.
(فتح لهم السادات أبواب الحياة من جديد وخانوا العهد وقتلوه)، فى صيف ١٩٧١ وفى استراحة الرئاسة بجناكليس فى الاسكندرية وبترتيب من الملك فيصل ملك السعودية، قرر السادات الإفراج عن عديد من المعتقلين والمسجونين من الجماعة ومن التيارات الإسلامية وسمح لهم بالحركة والنشاط خصوصا فى الجامعات، وتم إعادة اصدار بعض مجلاتهم ومطبوعاتهم وإعادتهم إلى وظائفهم. وقد ألزمهم السادات حينها بالعودة للحياة على أنهم دعاة وليسوا مشاركين بالحياة السياسية فتعهدوا بذلك على أن يكونوا فى مواجهة الناصريين واليسار خاصة فى الجامعات.
ولكن سرعان ما عادت الصراعات بين السادات والإخوان تلك الصراعات التى انتهت بتورط أفراد من الإسلاميين فى اغتيال السادات فى ٦ اكتوبر ١٩٨١، أما عن علاقتهم مع خلفه، فقد كان مبارك يريد ما يسمى بالاستقرار الذى يضمن له السلطة والبقاء فيها، فكان التوافق الذى فتح لهم المجال السياسى بشكل غير مسبوق فى تاريخ الجماعة فقد استولوا على النقابات ووصلوا إلى البرلمان (فى الوقت الذى لم يحقق فيه حسن البنا حلمه فى الوصول للبرلمان).وكان التوافق بين الجماعة وبين نظام مبارك شبه علني بل كان المرشد قد أعلن أن الجماعة لا تمانع من توريث جمال مبارك الحكم .
كما أن الجماعة وبالتوافق مع الامن كانت قد أعلنت عدم مشاركتها فى مظاهرات ٢٥ يناير، بل وأثناء المظاهرات لم تنقطع الاجتماعات بين الجماعة وبين النظام، ولكن حين تلوح لها الفرصة فهى على أتم الاستعداد، وهذا ماشاهدناه حتى تم لهم الوصول إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الشورى وكذلك مجلس الوزراء. فماذا كان بعد وصول المرشد لحكم مصر؟
---------------------------
بقلم: جمال أسعد عبدالملاك *
* سياسي وبرلماني سابق