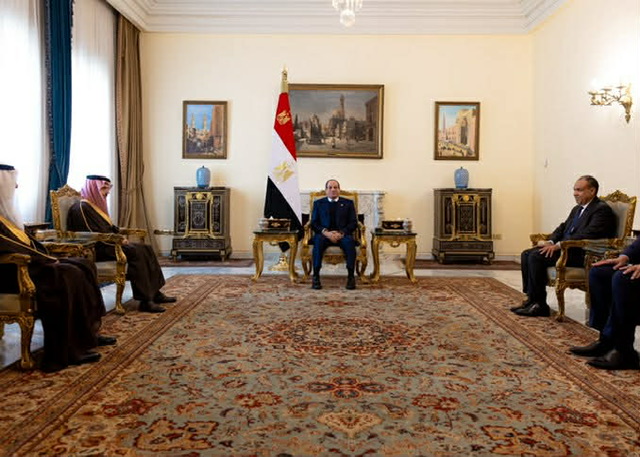ربط نجيب محفوظ بين النكسة والمطر كاستعارة دلالية على توالي الكروب وانهمار الهزائم، وذلك في مجموعته القصصية «تحت المظلة» أول أعماله المنشورة بعد النكسة، وظهر في أول روايته بعدها «الحب تحت المطر». تتجلى هذه العلاقة في قول أحد أبطال الرواية: «أيام الكروب تتابع كالممطر… الاحتلال، الاستقلال، 1956، اليمن، الاحتلال» (بيروت: دار القلم، ط1، 1977م، ص 73).، في إحالة مباشرة إلى تاريخ مثقل بالانتكاسات المتعاقبة.
نشرت الرواية كاملة لأول مرة عام 1973، ثم تحولت إلى فيلم سينمائي عام 1975، غير أنها تعرضت لتدخلات رقابية واسعة، حتى قال محفوظ إن لها ثلاث نسخ مختلفة، وهو ما وثقه محمد شعير في مقاله «الحب تحت المطر: ماذا فعلت رقابة النكسة برواية نجيب محفوظ»، مقارنًا بين المخطوط الأصلي وبين ما نشر كاشفًا عن أثر المناخ السياسي في تشكيل النص وحجبه ورفض صحفية الأهرام لنشره منجمًا كما كانت تفعل مع أعماله السابقة قبل الدفع بها إلى المطبعة.
توثق الرواية حالة العبث والإحباط التي أعقبت الصدمة العنيفة التي مر بها الشعب المصري بعد نكسة يونيو، هزيمة أفضت إلى تفكك منظومة القيم وانتشار مظاهر التحلل الاجتماعي، ظهرت داخل الرواية في العلاقات المفتوحة بين الشبان، الميل إلى الشرب واللهو، صعود السينما الرديئة. وهو ما يتكرر تاريخيًا في المجتمعات التي تتعرض لصدمات كبرى في أزمنة الحروب، فقد شهدت مصر عقب الحرب العالمية الأولى انتشار الفودفيلات الخليعة، ولا سيما تلك التي أخرجها عزيز عيد، وتكرر المشهد ذاته أثناء الحرب العالمية الثانية، وبلغ ذروته بعد نكسة يونيو في نوعية الأفلام والمسرحيات التي قدمت آنذاك. وهو يفسره حسن حمودة المحامي والشخصية الجوهرية حين يقول: «كلما اشتد البلاء حق للإنسان أن يتفانى في البحث عن السعادة» (ص 77). رابطًا ما بين التحلل الاجتماعي والانغماس في اللذة في الوقت الذي تعاني في الجماعة من أخطار داهمة.
فعلى المستوى النفسي الجمعي، تحدث الصدمة العنيفة مثل نكسة يونيو انكسارًا في صورة الذات الجماعية، ينهار الإحساس بالكفاءة والقوة، ويحل محله شعور بالعجز والمهانة. ما يولد حالة من القلق الوجودي وفقدان المعنى هو ما تعبر عنه إحدى بطلات الرواية «إننا نحيا بلا هدف» (ص41)، فيلجأ الأفراد إلى آليات دفاع نفسية بديلة، في مقدمتها الهروب والإنكار، عبر الانغماس في اللذة الفورية واللهو والشرب والعلاقات العابرة للهروب من الواقع المقبض.
كما أن الهزائم الكبرى تنتج حالة من التطبيع مع العبث، وهو ما ظهر في جملة من قصص ومسرحيات محفوظ العبثية بعد النكسة، فإغراق الرواية في الجانب المتعلق بالجنس لم يكن كما رأى البعض أن محفوظ جارى فيها الأفلام الاستهلاكية في هذه الحقبة، فالأمر أكبر من ذلك وفي حقيقته رصد لعرض نفسي للهزيمة، الجنس يظهر فيها الجنس كألية للتعويض والهروب من الإحساس بالعجز والانكسار.
تحمل الرواية مجموعة من الثنائيات المهمة منها ثنائية الحارة والمدينة. حارة يجلس على مقهى فيها المصور حسني حجازي، تشهد تحولات عنيفة عصفت بقيمها وتاريخها، فيها عشماوي الذي يعمل ماسح أحذية بلغ من العمر عتيا بعدما كان فتوة المنطقة يتحسر على الزمن القديم، تستنجد به امرأة عجوز لينتقم لها من الصهاينة الذين أصابوا حفيدها على الجبهة.
وفي المقابل تظهر المدينة، خاصة في شارع «شريف» بوسط البلد الذي تدار فيها علاقات مشبوهة، وهو ما يتنافى مع اسم الشارع نفسه، اختلافات قيمية كبيرة بين العالمين وبين زمنين في وقت مفصلي في تاريخ الوطن.
تظهر المدينة بزحامها وغياب الثوابت الاجتماعية، وضياع البوصلة كما في المشهد السابع «اكتظت ناصية الأمريكيين فلا موضع لقدم، تلاصق الشبان تحت الأضواء وانحصر المارة بين الأجسام الحارة الفتية وقل الكلام أو انعدم، وحملقت الأعين وتحركت بعض السيقان بالرقص الخفيف. وثار سالك بحريمه في عباب الزحام غضبًا لكرامته الشخصية فيما بدا وصاح اخجلوا من أنفسكم واذهبوا إلى الجبهة إن كنتم رجالًا» (ص28) يتردد في حوارات الشباب أسئلة وجودية حول وجود الله، الجنس، النكسة، الرغبة في الهجرة، الجنون، تقصي الضحك وألا يسمحوا لشيء أن يفسد عليهم حياتهم أي الإغراق في الذاتية بعيدًا عن العالم الخارجي المحبط والمقبض، حالة من العدمية تسيطر على الشباب والجنون كما يقول الكهل حسني حجازي «إن الجنون هو الطابع المميز لهذه الأعوام» (ص86).
تناقش الرواية الفرق بين جيلين، جيل ما قبل يوليو وما بعدها، يظهر ذلك في الحوار بين الأب زاهران وابنه وابنته علي ومنى، جيل جديد «لا يرى الوطن أرضًا وحدودًا ولكنه وطن الفكر والروح» ويفكر دائمًا في الهجرة. فيقارن الأب ذلك بموقفه المختلف على الوطنية «تألم الأب الذي ينسب إلى جيل 1919 جيل الوطنية المصرية الخالصة، واستمع إلى ابنه بانزعاج فخيل إليه أنه يطالع ظاهرة غريبة تستعصي على الإدراك والتفسير» (ص41).
وفي سياق مواز، تكشف الرواية عن تحولات اجتماعية عميقة تراجعت فيها القيم الأخلاقية التقليدية، ولم تعد تشكل مرجعية حاكمة للسلوك. فشخصياتها النسائية منى، عليات، سنية، فتنة، سمراء، نساء متعلمات تعليمًا جامعيًا، متحررات جنسيًا، وجدت بعضهن أنفسهن مدفوعات إلى علاقات عاطفية تحت ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مثل سنية وعليات، بينما أقدمت أخريات على ذلك بدافع الحب ذاته. وتؤمن هذه الشخصيات بالمساواة وترفض التقاليد التي تحاكم المرأة أخلاقيًا بمعايير مزدوجة، ولا تطبق الحكم ذاته على الرجل.
سنية: هي تقاليد بلادنا
فهزت منى رأسها بعناد وقالت: إني أرفض ذلك كله
فقالت سنية: إنهم معقدون ويحتاجون إلى ترويض طويل (ص38).
وهو ما يظهر في رد فعل سنية على رأي أخيها في الجبهة حول المرأة:
* ليس الرجل كالمرأة
فضربت الأرض بقدمها غيظًا ولكنها لم تنبس (ص16)
في إشارة دالة إلى احتدام الصراع بين الوعي الجديد والبنى الذهنية التقليدية.
ترصد الرواية تحولات ثقافية جذرية هزت المجتمع، أحدث حالة من الصراع بين عالمين مختلفين من القيم، عالم المدينة وعالم الحارة الذي يمثله قول عشماوي: «ماذا جرى للدنيا، نسوان عرايا في شوارع، ومساجين موظفون، ويهود غزاة» (ص 136). يعبر عن وعي مأزوم ينتمي إلى زمن آفل، يعجز عن استيعاب التحولات القيمية والاجتماعية التي فرضها الواقع الجديد. عشماوي «الفتوة» الذي جار عليه الزمن، وانتهي به المطاف ماسحًا للأحذية، في مصير يتقاطع مع بطل قصة نجيب محفوظ «فتوة العطوف». ففي القصة، يخرج الفتوة من السجن وقد تجاوزه الزمن، ولم يعد لعنفه ومفاهيمه مكان في عالم تغيرت قواعده، فيُجبر على العمل ماسحًا للأحذية في إشارة انهيار منظومة اجتماعية كاملة كانت تقوم على القوة الفردية والهيمنة الشعبية. يتباكى عليها ويرى في عودتها حلًا لكل المشاكل التي تعاني منها مصر.
في الرواية لم تكن الحارة بمنأى عن زحف المدينة وتحولاتها القيمية، تسللت مظاهر الحداثة إلى فضائها المغلق، محدثة شرخًا عميقًا في منظومتها الأخلاقية التقليدية. كما هو الحال في شخصية عليات، ابنة عبده عامل المقهى، التي تنخرط في علاقات عاطفية مفتوحة، في سلوك يتناقض جذريًا مع قيم الحارة التي كانت تحاصر المرأة داخل حدود صارمة، وترفض خروجها من المنزل. تلك القيم التي يحملها أخيها إبراهيم الذي يعجب بصديقتها سنية ويسألها عن أخلاقها كشرط من شروط الارتباط بها.
ويقود هذا التصادم الحاد بين القيم القديمة والواقع الجديد الذي خلقته يوليو ونكسة يونيو إلى انفجار مأساوي، حين يُقدم عبده على قتل «سمراء» لأنها أخبرته بعلاقات ابنته خارج إطار الزواج، ثم يلوذ بالصمت رافضًا الإفصاح عن الدوافع الحقيقية للجريمة.
تقيم الرواية مقابلة حادة بين واقع الجبهة بما يحمله من موت وفقد وخراب، وبين واقعٍ مدني متحلل من القيم. تتساقط أرواح الجنود وتتحول مدن القناة، وعلى رأسها بورسعيد، إلى مدن أشباح ويعود المجندون قتلى أو بعاهات دائمة مثل إبراهيم ابن عبدة الذي فقد بصره على الجبهة.
وفي المقابل، ترسم الرواية صورة لمدينة أخرى غارقة في اللهو والانفصال الأخلاقي، يجسّدها حسني المصوّر الذي يعيش حياة مترفة قائمة على المتعة والاستهلاك، ويتعامل مع الحرب مادة للتصوير. ولا يختلف الوضع كثيرًا في عالم السينما المنفصلة عن الواقع التي يذهب ممثلوها إلى الجبهة تحت لافتة الدعم المعنوي، ويقدمون الحرب بشكل تجاري هزلي على الشاشة، بينما حياتهم غارقة في اللهو في تباين واضح بين الشعارات والواقع. وتكتمل إباحية المدينة بشخصية سمراء التي تجعل من بيتها ماخورًا للنخبة، وإشباع رغباتها الجنسية الشاذة.
تقدّم الرواية، من خلال شخصية حسن حمودة، نقدًا لاذعًا لثورة يوليو، كاشفة عن أثرها العميق في تفكيك طبقة اجتماعية كانت فاعلة في الحياة الوطنية. موقف سياسي قدمه نجيب محفوظ في أكثر من عمل لفئة أسعدتها نكسة يونيو نكاية في النظام الذي سلب أموالهم. فحسن حمودة إقطاعي فقد ثروة ضخمة تقدر بنحو ألف فدان «في ثانية واحدة» ما تسبب في وفاة أبيه بأزمة قلبية، وألحق بأسرة شاركت في الحياة الوطنية منذ الثورة العرابية وصمة اجتماعية وتشويهًا لسمعتها.
جعلته يملك تعربفًا خاصة للمجتمع من منظور فردي فيراه «الأرض التي يسعد فيها الإنسان ويُكرم».
ومن هذا المنظور، يجد في هزيمة يونيو (النكسة) نوعًا من الانتقام الرمزي من السلطة التي أذلت أسرته واستحلّت ممتلكاتها. ويتجلى هذا الموقف بوضوح في مخطوط الرواية، حيث يقول: «ولو أنهم انتصروا في حرب يونية لهرستنا الأقدام الغليظة إلى الأبد. فالهزيمة رغم شرها لا تخلو من بركة للمغلوبين على أمرهم!» (الاقتباس نقلًا عن مقال شعير).
غير أنّ هذا المقطع جرى تخفيف حدّته أثناء نشر الرواية، ليصبح: «لو أنهم انتصروا في حرب يونية فماذا كان يفعل أمثالنا، فالهزيمة رغم شرها لا تخلو من بركة للمغلوبين على أمرهم» (ص 76)،
وعلى المستوى السياسي، يرفض حسن حمودة التقارب مع الاتحاد السوفيتي، ويعبر صراحة عن ميله إلى النموذج الديمقراطي الأمريكي، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع الخطاب القومي الاشتراكي. ويظهر الصدام في حوار دال، حين يُتهم ضمنيًا بأن هواه «مع جيش إسرائيل ضد جيش مصر»، فيتساءل مستنكرًا، لا يخلو من شعور بالاستياء: «أهذا هو توصيفك لموقفي؟»
وحين يجاب بأن «المسألة مسألة موقف وطني قبل كل شيء»، يرد ساخرًا كاشفًا عن اختزال الوطنية في خيار أيديولوجي واحد: «أي موقف وطني! إما الديمقراطية أو الاشتراكية، أمريكا أو روسيا، وإذا كان من حقكم أن تحبوا روسيا فلم لا يكون من حقنا أن نحب أمريكا» (ص 101).
ومن هذا المنظور، تطرح الرواية ما لا يقل عن ثلاثة تصورات مختلفة لمفهوم الوطن، تتوزع وفق الانتماء الجيلي والاجتماعي للشخصيات. فالتصور الأول يمثّله الشباب الذين فقدوا الثقة في الوطن، فلم يعودوا يرونه مجالًا لتحقيق الذات أو الكرامة، وهو ما يدفعهم إلى تفضيل الهجرة أو الانفصال عنه نفسيًا ووجدانيًا. أما التصوّر الثاني فيرتبط بـ جيل ثورة 1919، الذي أحب الوطن بالمعنى التقليدي، وطن التضحية والفداء، والاستعداد لبذل النفس في سبيل الاستقلال والكرامة الوطنية، دون اشتراط مقابل فردي مباشر. يتمثل التصور الثالث في الإقطاعيين الذين ينظرون إلى الوطن من زاوية الجرح الطبقي، يحملون ضغائن عميقة تجاه ما صنعته ثورة يوليو بهم، بعد أن جردتهم من الثروة والمكانة، فارتبط الوطن لديهم بالإقصاء والظلم.
فيظهر في الرواية تفكك مفهوم الموطن من قيمة جامعة إلى متنازع عليها وفقًا للموقع الاجتماعي والتجربة التاريخية لكل شخصية.
------------------------------------
بقلم: د. عبدالكريم الحجراوي