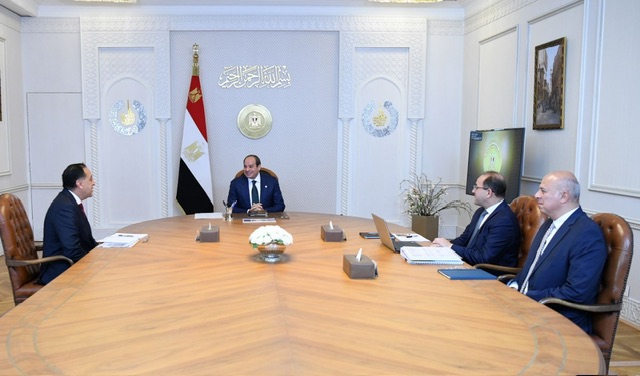في الرابع من ديسمبر 2025، وفي خطوة مصيرية كُتبت بلغة جافة وعلى بُردة بيروقراطية، لم تُعلن الإدارة الأمريكية مجرد تحديث روتيني لوثيقة رسمية، لقد أقدمت على نحوٍ غير مسبوق، على تفكيك الإطار الفلسفي ذاته، الذي حكم علاقاتها مع العالم طوال ثمانية عقود متتالية، عبر ثلاثٍ وثلاثين صفحة، هي خلاصة استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، لم تقدم مجرد خريطة طريق جديدة؛ بل قدّمت نهاية لعالم بأسره وبداية لعالمٍ آخر أكثر تقطُّباً وأقل يقيناً.
إنها في جوهرها وثيقة تنازل طوعي عن العرش، تنازل عن عرش القيادة العالمية الذي تبوأته واشنطن منذ أن خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى وحيدة، مُؤسِّسةً لنظامٍ دولي ربط أمنها وسيادتها بأمن وسيادة الآخرين، فالوثيقة تعلن بلا مواربة، انتهاء صلاحية ذلك العقد الاجتماعي العالمي، فلم يعد "الشرطي العالمي" مهتماً بدورياته في الأحياء البعيدة، وهو لا يكتفي بالانسحاب إلى ثكناته، بل يُعلن بشكل قاطع أن حديقة منزله الخلفية - النصف الغربي للكرة الأرضية - قد أصبحت حداً أحمراً مطلقاً، لا يُسمح فيه بأي منافسة أو حتى حضور لقوى أخرى.
هذا التحول الجذري - من راعٍ عالمي إلى سيد إقليمي - ليس قراراً تكتيكياً عابراً، إنه تحول هُوي في مفهوم القوة والسيادة، فالقوة وفق هذه الرؤية الجديدة، لم تعد تُقاس بالقدرة على تشكيل النظام العالمي وتوجيه مساره، بل بالقدرة على الانكفاء عنه وحماية المصالح الحيوية المباشرة بكل ما يتطلبه من أنانية صلبة، وهذا الانكفاء المتعمد لا يترك العالم كما هو؛ بل يخلق فراغاً وجودياً في قمة الهرم الدولي، وهو فراغٌ لن يبقى شاغراً طويلاً، إذ تتدافع القوى العظمى الصاعدة والقوى الإقليمية الطامحة لملئه، مُطلقةً سباقاً محموماً على النفوذ وإعادة تعريف مناطق السيطرة، من أوروبا الحليفة والمصدومة، مروراً بمحيطها الهندي - الهادئ حيث تتصاعد المنافسة مع الصين، وصولاً إلى الشرق الأوسط الذي يُترك ليُصارع شياطينه بيديه، ويبدأ العالم رحلة غير مضمونة العواقب في ظل غياب القائد التقليدي الذي قرر فجأة أن يلعب دور المُشاهد لا الفاعل.
فلم تكتفِ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار وثيقة "استراتيجية الأمن القومي"، بل أعلنت رسمياً نهاية حقبة تاريخية بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية، في تحول تقليد إداري بيروقراطي إلى زلزال جيوبوليتيكي يهز أركان النظام العالمي، الوثيقة التي وصفت بأنها أحدث وأوضح تعبير عن رؤية ترامب، تُمثل تحولاً جذرياً في الفلسفة الكامنة خلف السياسة الخارجية الأمريكية، هي إعلان تاريخي عن نهاية عصر بأكمله، استراتيجية الأمن القومي الجديدة ليست تحديثاً لسياسة خارجية، بل هي نقطة قطع نهائية مع فلسفة القيادة الليبرالية التي حكمت واشنطن منذ انتصارها في الحرب العالمية الثانية.
بإصدار هذه الوثيقة، لم تكتفِ إدارة الرئيس دونالد ترامب بوضع خريطة طريق لمستقبلها، بل قامت بنبش وإعادة دفن جثة الماضي، إنها ترفض بشكل قاطع الرؤية التي رسمتها النخب الأمريكية بعد الحرب الباردة، معتبرة إياها حقبة من "الغطرسة" و"الأخطاء الاستراتيجية" المكلِفة، بدءاً من الحروب في الشرق الأوسط ووصولاً إلى الاعتماد الاقتصادي على الصين، وبدلاً من ذلك تُعلن الوثيقة ولادة نموذج جديد: عودة الدولة القومية بشراستها كالفينيق الذي ينهض من رمز النظام المتعدد الأطراف.
ويتردد صدى هذا التحول في كل سطر من السطور التي تحمل بصمة ترامب الشخصية الواضحة، والتي لا تقدم الولايات المتحدة ككيان مؤسسي مجرد، بل كتجسيد مباشر لرؤية ترامب وصفقاته، والأكثر إثارة أنها تعلن رسمياً عن "ملحق ترامب لمبدأ مونرو"، معلنة أن النصف الغربي من الكرة الأرضية هو حديقة منزلية أمريكية خالصة، يحظر على أي قوة خارجية - أوروبية أو صينية أو روسية - الاقتراب منها، إنها إعلان بالسيادة الإقليمية المطلقة كبديل للهيمنة العالمية المنتشرة.
وتترك هذه القطيعة التاريخية العالم في حالة من الارتباك الاستراتيجي، ففي أوروبا تتعالى أصوات الصدمة بعد أن وجهت الوثيقة انتقادات حادة غير مسبوقة لحلفاء الناتو التقليديين، وتحدثت بلغة عن "محو حضاري" قد تواجهه القارة، بل وتعهدت بتنمية المقاومة لسياساتها من الداخل، بينما في الشرق الأوسط، يُقرأ التراجع الواضح في الأولوية الأمريكية كإشارة لبدء سباق محموم لإعادة رسم الخرائط وتحديد النفوذ في فراغ استراتيجي جديد، والعالم بكل حلفائه وخصومه، يقف على عتبة حقبة "السيادة المتصارعة"، ويتساءل عن قواعد اللعبة الجديدة في عصر "أمريكا أولاً" المتكامل.
إن ما تقدمه هذه الوثيقة يتجاوز بكثير حدود المراجعة التكتيكية أو التعديل الظاهري على سياسة قائمة، إنها في جوهرها نصل قطعٍ حادّ يشق شريان الرؤية الكبرى التي نَظَّرت لها واشنطن وحوَّلتها إلى نظام عالمي طوال القرن العشرين وأوائل الحادي والعشرين، فهي تعلن تفكيكاً متعمداً للإطار الذي قام عليه ذلك النظام: فكرة أن أمن أمريكا واستقرارها مرهونان بأمن واستقرار حلفائها، وأن ثمة قيماً ومصالح مشتركة تتطلب قيادةً عالمية نشطة. وبخطابٍ واضح يخلو من أي مواربة دبلوماسية، ترفض الوثيقة ما تصفه بالمبدأ المشؤوم للهيمنة على العالم، وتطرح بديلاً فلسفياً قائماً على صراع السيادات المتعصبة، وفي هذه الرؤية الجديدة للعالم، لا وجود لنظام عام أو رابطة إنسانية جامعة؛ بل هناك فوضى من الدول القومية، كل منها قلعة منعزلة تتصارع مع جاراتها في سوق دولية لا ترحم، حيث المصلحة المباشرة هي الإله الوحيد المُتَّبَع، إنها عودة مدوّية إلى "حقبة ما قبل وستفاليا" من العلاقات الدولية، ولكن بأسلحة القرن الحادي والعشرين.
لكن في قلب هذا الرفض الرنان للهيمنة العالمية، تكمن مفارقة صارخة تفضح جوهر الاستراتيجية الحقيقي، فبينما تنسحب أمريكا من دور الشرطي العالمي، فإنها لا تتخلى عن مفهوم الهيمنة ذاته، بل تحصرها وتكثِّفها جغرافياً، فمن خلال إعلانها ما سمّته تحديثاً لمبدأ مونرو التاريخي، وتوسيعه بملحق ترامب الجديد، تُعلن واشنطن بصراحة أن النصف الغربي من الكرة الأرضية هو متنزهها الخلفي الحصري، وإنها ترسم حدوداً إمبراطورية جديدة، حيث يُعتبر أي حضور اقتصادي أو أمني لقوى منافسة مثل الصين أو روسيا في أمريكا اللاتينية أو الكاريبي اعتداءً على الأمن القومي الأمريكي المباشر، وهكذا نرى التناقض العجيب: رفض عام للهيمنة، يقابله إعلان خاص عن هيمنة إقليمية مطلقة، إنها ليست نهاية الإمبراطورية، بل تحوُّلها من شمولية عالمية إلى انكفاء إقليمي عدواني.
هذا التحول الجذري في البوصلة الاستراتيجية لا يُترجم إلى عزلة كاملة، بل إلى انكفاء انتقائي عدائي، يُعيد إحياء مبدأ جيوبوليتيكي من القرن التاسع عشر ويضعه في صلب القرن الحادي والعشرين، فمركز ثقل العالم، من منظور واشنطن الجديد، يتقلص ليصبح فناءها الخلفي المباشر، وتعلن الاستراتيجية صراحة أن الساحة الأولى والأخيرة هي أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، في تحول يقلب الطاولة على عقود من التركيز على المحيطين الهادئ والأطلسي كساحتي مواجهة مع القوى العظمى، ولكن هذه ليست دعوة للتعاون الإقليمي، بل إعلان ملكية: فهي تُحدِّث ما يعرف "بمبدأ مونرو 2.0"، وتعلن أن النصف الغربي من الكرة الأرضية هو حدٌ أحمر إمبراطوري، وسيُقابل أي نشاط صيني أو روسي أو حتى أوروبي هناك ليس كمنافسة، بل كعمل استفزازي يتطلب رداً حاسماً.
ولكن إذا كان الجوار يُحاط بهذا السياج الحديدي، فما مصير الحلفاء القدامى وراء البحار؟ هنا تكمن الصدمة الثانية، فبدلاً من لغة التضامن التقليدية، توجه الوثيقة لأوروبا - العمود الفقري التاريخي للحلف الأطلسي - مطرقة ثقافية وسياسية غير مسبوقة، إنها لا تنتقد سياساتها فحسب، بل تطعن في صميم هويتها الحضارية وتتحدث عن "محو" يتهددها، وتعد صراحة "بتنمية المقاومة الداخلية" ضد مشروعها السياسي، إنها لغة تُستخدم عادة ضد الخصوم، لا ضد الشركاء، وكأن الاستراتيجية تقطع آخر خيوط الانتماء لنادي القيم الغربية المشتركة، وكان الرد الأوروبي، ممثلاً بألمانيا سريعاً وجارحاً في رفضه هذه الوصاية: "لا نحتاج إلى نصائح من الخارج".. إنه مؤشر واضح على أن العقد الأطلسي يدخل عصراً من القطيعة الاستراتيجية والثقافية، حيث تُستبدل المظلة الأمنية بعلاقة معاملات باردة، ويُستبدل الحلفاء بعملاء مدفوعين مسبقاً، وفق المنطق الجديد الذي لا يعترف إلا بالمنفعة البراغماتية المباشرة.
يتجلى هذا التحول الفلسفي في قواعد عملية صارمة تعيد تعريف كيف تُدار العلاقات الدولية من واشنطن، فلم يعد التحالف قيمة قائمة على المصير المشترك أو الدفاع عن نظام عالمي، بل تحول إلى عقد خدمة خاضع للمساءلة، وتعلن الاستراتيجية بلا مواربة أن الضمان الأمني الأمريكي لم يعد "مظلة مفتوحة" تُظلل الجميع، بل أصبح سلعة في سوق تنافسية، تسري عليها معادلة تجارية قاسية: "القيمة مقابل القيمة"، فالدولة التي تدفع أكثر من جيبها الوطني وتضع المزيد من جنودها على خط النار، هي وحدها التي تحظى بموثوقية الالتزام الأمريكي، ويظهر هذا جلياً في المطلب الأمريكي المعلن لحلفاء الناتو برفع إنفاقهم الدفاعي إلى نسب خيالية، وهو ما يشبه تقديم فاتورة متأخرة عن عقود من الحماية، ويحول الحلف من مؤسسة سياسية إلى تحالف تجاري مسلح.
وهذا المنطق المعاملاتي لا يقتصر على الشق العسكري، بل يمتد ليشكل الفلسفة الكاملة للانخراط الخارجي، تحت مسمى ملتبس هو "الواقعية المرنة"، وفي هذه الرؤية، يتم التخلي نهائياً عن أي ادعاء بأجندة قيمية أو رغبة في تشكيل العالم على صورة أمريكية، فالديمقراطية وحقوق الإنسان والتحول الاجتماعي تختفي من المعجم، لتحل محلها نفعية باردة صرفة، والهدف الوحيد هو المصالح المادية المباشرة: الصفقات التجارية، والعقود الاقتصادية، والتعاون الأمني الظرفي الذي يحقق منفعة لحظية، إنها دبلوماسية دون رسالة، تتعامل مع العالم كسوق كبيرة، حيث يُقاس نجاح السياسة الخارجية بأرقام الميزان التجاري وليس بمدى انتشار الأفكار أو تحقيق الاستقرار، وهكذا تتحول واشنطن من زعيم عالمي إلى تاجر سلع إستراتيجية فاحش الثراء، يُمسك بورقة الحساب في يد، والقوة العسكرية في اليد الأخرى، مستعداً للتعامل مع أي نظام، ديمقراطياً كان أو استبدادياً، ما دام السعر مُرضياً.
وفي أكثر المواضع خطورة في الوثيقة، تعلن الاستراتيجية أن "هدف أمريكا التاريخي للتركيز على الشرق الأوسط سيتراجع"، والسبب المعلن هو تحول الولايات المتحدة إلى دولة مصدرة للطاقة، مما يعني تراجع الاعتماد الاستراتيجي على نفط الخليج، وتُصور الوثيقة المنطقة بأنها "مكان للشراكة والصداقة والاستثمار"، وليس مصدر تهديد دائم، وهذا التصريح الذي يُشبه إعلانًا تجاريًا، ويَعِدُ بمرحلة من "الشراكة والصداقة والاستثمار" في الشرق الأوسط، يطفو فوق سطح بحر هائج من الدماء والأنقاض، إنه لا يعكس فحسب تغيرًا في الأولويات، بل يكشف عن انفصال خطير عن الواقع؛ فالسردية الأمريكية الجديدة تتجاهل عمدًا أن المنطقة التي تُعلن تراجع أهميتها الإستراتيجية عنها، هي نفسها التي تَشْهَد بعضاً من أعنف الصراعات وأكثرها تعقيداً على وجه الأرض، في وقت صدور الوثيقة نفسها.
والتناقض بين الخطاب الأمريكي المتفائل ووقائع الأرض المُفجعة يصطدم بالواقع في نقاط عدة، تُظهر أن المنطقة بعيدة كل البعد عن أي "استقرار" مُفترض، فيشكل الموقف الأمريكي الجديد من الخليج لغزاً استراتيجياً محفوفاً بالمخاطر، حيث تعلن واشنطن تراجع أولويتها عن المنطقة بينما تؤكد في نفس الوقت على حماية "مصالح حيوية" فيها، كحرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا التناقض لا يخلق فراغاً فحسب، بل يصوغ علاقة جديدة غريبة الأطوار: فالحليف التاريخي يتحول إلى طرف ثالث متحفظ، حاضرٌ جسدياً لحماية خطوط إمداده، لكنه غائب سياسياً عن ضمان أمن حلفائه القدامى، إنها صيغة تقتلع جذور الثقة التي بُنيت على مدى عقود، وتستبدلها بحسابات باردة وقصيرة الأمد.
وفي هذا المناخ، تُجبر دول الخليج على إجراء مراجعة وجودية لسياساتها الأمنية، فتحوّل العلاقة من تحالف إستراتيجي إلى معاملة تجارية خاضعة لمعادلة "المنفعة مقابل المنفعة" يعني أن الدرع الأمريكي لم يعد مطلقاً ولا غير مشروط، إنه أصبح سلعة قابلة للتفاوض، قد تُسحب إذا قلّ العطاء أو تغيرت موازين المصالح في واشنطن، وهذه الحقيقة المرّة تدفع العواصم الخليجية نحو خيارات كانت تُعتبر حتى الأمس القريب خطوطاً حمراء استراتيجية: التسارع في تنويع التحالفات عبر التقارب الأعمق مع القوى المنافسة لواشنطن، لا كخيار تفضيل، بل كدروب ضرورة للبقاء في عالم تتهاوى فيه الضمانات التقليدية، وهكذا بينما تتحدث الوثيقة عن الشراكة، تزرع سياساتها بذور قلق دائم قد يحوِّل الخليج من منطقة حليفة مستقرة إلى سوق مفتوحة للتنافس الجيوبوليتيكي الأكثر ضراوة.
وكذلك في قلب التناقض الأقصى بين سردية واشنطن الوردية والواقع الحديدي للمنطقة، تطل جبهة لبنان الجنوبية - إسرائيل كأكثر النقاط سخونة على وجه الأرض، حيث يتحول خط الهدنة الهشة إلى ساحة اختبار خطيرة لفرض الأمر الواقع في ظل غياب الضامن التقليدي، فتشير تقارير استخباراتية إلى أن حزب الله، رغم وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، يعمل بشكل شبه كامل تحت الأرض لإعادة بناء ترسانته العسكرية، وهذا يشمل تهريب الصواريخ مستفيداً من الدعم الإيراني، مع إنتاج أسلحة محلياً، وإعادة تنظيم صفوفه وهيكله القيادي لتعويض القادة الذين تمت تصفيتهم، في شبكة معقدة من الأنفاق المحصنة شمال نهر الليطاني، مما يجعله جيشاً شبه نظامي يصعب استئصاله، فالمشهد ليس فوضى عشوائية، بل لعبة استراتيجية محكمة الخطورة بديناميكية تصعيد مقصودة وحسابات باردة.
بينما يُدرك الجيش الإسرائيلي هذه التحركات ويعتبرها تهديداً وجودياً، وقد بلغت الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار نحو 4500 عملية، فيما يوصف بأنه حملة مستمرة لتعطيل عمليات إعادة التسليح، وتقدر مصادر إسرائيلية أن حزب الله يمتلك حالياً ما بين 15 إلى 20 ألف صاروخ، ويعمل على تطوير برنامجه للطائرات المسيرة، والمنطق الإسرائيلي هنا هو البحث عن "الذريعة الذهبية"، حيث تشير تقارير إلى أن العمليات الإسرائيلية المستفزة داخل العمق اللبناني تهدف إلى جر حزب الله لرد فعل محسوب، يمنح إسرائيل المبرر لإطلاق حرب واسعة النطاق، وهذا ليس تصعيداً تكتيكياً فحسب، بل محاولة إعادة ترميم الردع الإسرائيلي الذي اهتز، وربما تحقيق الحلم الإسرائيلي الطويل الأمد بتجريد الحزب من سلاحه قسراً. بينما منطق حزب الله هو المناورة على حافة الهاوية، حيث يبدو أن حزب الله مدركاً أن حرباً شاملة لا تخدم مصالحه في الظرف الراهن، وتشير التقارير إلى أنه يتصرف كفاعل عقلاني لبناني يضع أولوية لمنع حرب مدمرة على لبنان، ما لم تفرض إسرائيل ذلك، واستراتيجيته تركز على زيادة التكلفة على إسرائيل دون عبور عتبة الحرب الشاملة، وهذا التوازن المرعب هو ما يبقي المنطقة "فوق برميل بارود"، حيث يناور كل طرف على الحافة.
ولعل أخطر ما في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ليس ما تصرح به، بل الفراغ المُتعمَّد الذي تتركه بين السطور، فهي ترفض رسمياً "الحروب الإضافية"، وفي ذات النَفَس تضع أمن إسرائيل على رأس أولوياتها وتعلن تراجع اهتمامها المباشر بالمنطقة مفضِّلة منطق "الاحتواء" على "الاستئصال"، وهذا التناقض المحفوف بالمخاطر لا يُعد سياسة، بل هو مجازفة كبرى، تُحوِّل جبهة لبنان الجنوبية إلى ساحة لاختبار أقصى حدود الردع في عصر السيادة المتصارعة.
هذا الغموض الاستراتيجي يُرسل إشارات مزدوجة، يُفسرها كل طرف وفق هواجسه ومصالحه؛ فلإسرائيل قد يكون هذا الصمت الأمريكي المريب بمثابة إذن ضمني لاتخاذ زمام المبادرة العسكرية إذا ما اعتبرت أن تهديد حزب الله الوجودي قد تجاوز كل الحدود، وإنها رسالة تقول: "احموا أنفسكم بأنفسكم، ونحن سنقف إلى جواركم – لكن من بعيد"، وفي ظل غياب الضامن القوي، قد تدفع ثقافة الردع الإسرائيلية، القائمة على الرد الساحق، نحو استباقية عدوانية كخيار وحيد متبقٍ، بينما لحزب الله وإيران، قد يُقرأ التراجع الأمريكي كتراخٍ استراتيجي وترخيص لاستغلال الفراغ، وفرصة لتعزيز المكاسب والتسلح دون خشية من تدخل أمريكي حاسم يُعيد حساباته، وهو ما يُفاقم من شعور إسرائيل بالمحاصرة، في حلقة مفرغة من التصعيد.
وهكذا يتحول الفراغ الأمريكي من حالة سياسية إلى عامل تفجير فعلي، ففي ساحة حيث يشحذ جميع اللاعبين أسلحتهم، ويختبرون يومياً حدود بعضهم البعض عبر الاختراقات المتعمدة، يُصبح غياب الحَكَم الواضح أو الردع المعلوم الشرارة التي تنتظر حادثاً واحداً، والجميع يعلنون أنهم لا يريدون حرباً شاملة، لكن الجميع يستعدون لها وكأنها قدر محتوم، فالاستراتيجية الأمريكية، بغموضها المقصود، لا تُهدئ هذا البرميل الواقع على حدود لبنان وإسرائيل، بل تضع تحته وقود الريبة والشك، جاعلةً اندلاع حرب إقليمية لا يرغب فيها أحد ظاهرياً، احتمالاً يلوح في الأفق أقوى من أي وقت مضى.
كما تتجلى الخطورة المشتعلة في الفجوة السحيقة بين الخطاب الاستراتيجي والواقع الميداني، في اشتعال أطراف الشرق الأوسط بنيران صراعات لن تهدأ، أشبه بجمرٍ تحت الرماد، ففي اليمن وسوريا، لا تُدار الحسابات بلغة الدبلوماسية، بل بلغة القوة والصراع على النفوذ، فيتناقض الوعد الاستراتيجي بالاستقرار مع واقع التصعيد العسكري الفعلي في اليمن، فمع تولي إدارة ترامب، دخلت الحملة العسكرية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مرحلة أكثر حدة؛ حملة عسكرية موسعة، بأكثر من ألف ضربة جوية على أهداف في اليمن منذ منتصف مارس 2025 فقط، ووصفت وسائل إعلام أخرى القصف في أبريل 2025 بأنه "الأعنف" منذ استئناف الهجمات، كما هدفت هذه الضربات، التي تستخدم طائرات متقدمة مثل قاذفات B-2 الشبح، إلى إضعاف قدرات الحوثيين العسكرية ومنشآتهم تحت الأرض التي تُستخدم في هجماتهم على الملاحة الدولية، وأدت هذه الهجمات إلى تعطيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وأسفرت عن خسائر بشرية، حيث أعلن الحوثيون عن سقوط مدنيين بين القتلى، كما تُظهر التقارير استمرار التنسيق بين الحوثيين وحركة "الشباب" الصومالية، مما يوسع نطاق التهديد.
وتعكس الحالة في سوريا التناقض ذاته، حيث يخفي الهدوء النسبي توتراً قابلاً للاشتعال، فلا تزال البلاد ساحة لصراعات محلية وعابرة للحدود، وتواجه الحكومة الانتقالية تحديات جسيمة في فرض الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية، وفي ظل غياب سلطة مركزية قوية، تتحول سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين فاعلين محليين وإقليميين متعددين، وعلى عكس اليمن، لا تظهر إستراتيجية 2025 رؤية واضحة أو التزاماً عميقاً بإعادة إعمار سوريا، مما يترك مصيرها رهناً لتوازنات القوى الإقليمية الهشة.
ففي الوثيقة، ثمة تناقض جوهري لا يقل خطورة عن مضامينها: فبينما تُعلن انسحاباً تاريخياً من دور الحكم العالمي، تفرض منطقاً جديداً للصراع هو "السيادة المتصارعة"، وهذا المنطق لا يعني السلام، بل هو إعلانٌ بأن الساحة الدولية أصبحت "غابة مفتوحة"، حيث تتنافس الدول والقوى بضراوة على النفوذ في غياب أي سلطة عليا أو قواعد متفق عليها، والشرق الأوسط، بتركيبته الهشة وتداخلاته المعقدة، هو الضحية الأولى لهذا المختبر الجيوبوليتيكي الجديد.
وهنا تتجلى المفارقة الكبرى: فسياسة الانكفاء الانتقائي لا تعني انعزالاً تاماً، بل انخراطاً عسكرياً انتقائياً حاداً، يُدار كعمليات جراحية سريعة لحماية مصالح ضيقة (كدحر تهديد الملاحة في اليمن)، بينما تُترك الأزمات البنيوية (كالمأزق السوري) لتعفن وتتفجر، لأن حلها يتطلب استثماراً سياسياً طويلاً تنأى عنه الاستراتيجية الجديدة، والنتيجة هي فراغ استراتيجي هائل، لا تعني واشنطن بملئه، ولكنها تفتح الباب على مصراعيه لتدافع القوى الإقليمية (إيران وتركيا ودول الخليج) والدولية (روسيا والصين) لرسم خرائط النفوذ بقوة الأمر الواقع، إنه تحول من نظام حاولت واشنطن قيادته - وإن كان بعيوب فادحة - إلى فوضى مُدججة بالسلاح، حيث تكون المنافسة صفرية والاستقرار هو الضحية الأولى.
وبالتالي فإن استراتيجية 2025 ليست مجرد وثيقة سياسية عابرة؛ إنها نهاية لعهد كامل وبداية لآخر أكثر قتامة، إنها تخرس الجرس الذي دقّ إيذاناً بقيادة أمريكية للنظام العالمي بعد عام 1945، ولكنها بدلاً من أن تعلن ميلاد نظام جديد أكثر إنصافاً، تترك العالم على حافة حقبة من الفوضى الخلاقة الأكثر عنفاً، وفي هذه الحقبة لن يكون الشرق الأوسط مجرد متفرج، بل ساحة المعركة الرئيسية حيث تُختبر قواعد اللعبة الجديدة - أو انعدامها - على جثث الأبرياء وخراب الدول.
الخاتمة: عالم السيادة المتصارعة
استناداً إلى تحليل وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية (نوفمبر 2025) والتداعيات العملية المتوقعة لها، يمكن صياغة النتائج الرئيسية على النحو التالي:
1. تحول جذري في المفهوم الاستراتيجي الأمريكي: حيث تُمثِّل الاستراتيجية تحولاً فلسفياً عميقاً من نموذج "القائد العالمي" و"مُوَفِّر السلع العامة الدولية" من أمن واستقرار، الذي ساد منذ 1945، إلى نموذج "الدولة القومية السيادية ذات الأولوية القصوى"، والتي تتبني عالماً قائماً على "السيادة المتصارعة"، حيث تتنافس الدول القومية بضراوة على المصالح المباشرة، وهذا النموذج الجديد لا يرفض "المبدأ المشؤوم للهيمنة على العالم" فحسب، بل يعيد تعريف الانخراط الدولي على أساس معادلة نفعية صرفة تقوم على "أمريكا أولاً" وتُحوِّل التحالفات إلى معاملات قائمة على "المنفعة مقابل المنفعة".
2- تعزيز الهيمنة الإقليمية كبديل للانتشار العالمي: حيث يكشف التحليل التناقض الجوهري بين رفض الهيمنة العالمية وإعلان هيمنة إقليمية مطلقة، من خلال إعلان تحديث "مبدأ مونرو" وتطبيقه بملحق ترامب، فتُعلن الولايات المتحدة أن النصف الغربي للكرة الأرضية منطقة نفوذ أمريكي حصرياً، وتهديداً أمريكياً للأمن القومي لأي دولة في حال تدخل أي قوة منافسة مثل الصين أو روسيا فيها، وهذه السياسة تجسد مفهوم "الانكفاء الانتقائي العدائي".
3 - تفكيك مقصود للعلاقات التقليدية مع الحلفاء: حيث تصل لغة الوثيقة غير المسبوقة في انتقاد الحلفاء التاريخيين، خاصة في أوروبا، إلى حد الحديث عن "المحو الحضاري" للقارة ووعد بتنمية المقاومة لسياساتها من الداخل، وهذا النهج لا يضعف حلف شمال الأطلسي (الناتو) مؤسسياً فحسب، بل يحول العلاقة الثنائية من إطار استراتيجي قائم على الثقة والقيم المشتركة إلى علاقة تعاقدية قصيرة الأمد، وهو ما ظهر جلياً في الرد الألماني الحازم الذي رفض "النصائح من الخارج".
4 - من المتوقع وجود فراغ استراتيجي وتصعيد للمنافسات؛ حيث يؤكد التحليل أن إعلان تراجع الاهتمام التاريخي بالمنطقة يخلق فراغاً استراتيجياً سيحاول عدد من الفاعلين ملئه، ويشمل هؤلاء الفاعلين:
- القوى الإقليمية المتنافسة: مثل إيران وتركيا والسعودية والإمارات ومصر.
- القوى الدولية المنافسة: روسيا والصين، اللتان ستجدان مجالاً أوسع للتأثير.
- جهات فاعلة من غير الدول: مثل الميليشيات والجماعات المسلحة.
5 - مع توقع أزمات في علاقات التحالف التقليدية: حيث ستُجبر دول الخليج التقليدية على إجراء مراجعة وجودية لتحالفاتها الأمنية، تحوّل العلاقة من تحالف إستراتيجي إلى معاملة تجارية مشروطة سيدفع هذه الدول إلى تنويع تحالفاتها بوتيرة أسرع، والتقارب مع قوى منافسة لواشنطن كخيار للضرورة وليس التفضيل، والاستثمار في سياسات دفاعية وطنية أكثر استقلالية وتكلفة.
6 - توقع ارتفاع مخاطر التصعيد في النقاط الساخنة: حيث يُظهر تحليل ديناميكيات الصراع في كل من اليمن وسوريا ولبنان أن سياسة "الاحتواء" و"إدارة الأزمات من بُعد" ستزيد من هشاشة الوضع، والوضع في الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية يُعد نموذجاً تحذيرياً:
- يقود الغموض المتعمد في الالتزام الأمريكي وغياب الضامن الواضح إلى تآكل مستمر للردع.
- قد تُفسر إسرائيل هذا التراجع على أنه ضوء أخضر ضمني لحسم التهديدات التي تراها وجودية (كالتي يمثلها حزب الله) بطريقتها الذاتية.
- في المقابل، قد تفسر إيران وحلفاؤها نفس الرسالة على أنها ترخيص لاستغلال الفراغ وتعزيز مكاسبهم.
7 - توقع صراع مستمر على السلطة والهوية في دول ما بعد الصراع كما تُظهر حالة سوريا، فإن غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية في الدول الهشة سيُبقيها ساحات مفتوحة للتنافس الإقليمي والدولي، مع استمرار العنف الطائفي والصراع على الموارد كسمة دائمة، مما يُعيق أي استقرار حقيقي.
الخلاصة الجيوبوليتيكية: حقبة جديدة من "الفوضى المُنظمة"
لا تعلن استراتيجية 2025 انسحاب أمريكا من العالم، بل انسحابها من فكرة النظام العالمي التعاوني، إنها تُؤسس حقبة جديدة من "السيادة المتصارعة"، حيث تُدار العلاقات الدولية بلغة القوة الصرفة والمنفعة المباشرة، في غياب أي قيادة مهيمنة أو أطر تعاونية مستقرة، والشرق الأوسط، بتركيبته المعقدة وسجله الحافل بالصراعات، سيكون الساحة الرئيسية التي ستُختبر فيها عواقب هذه الفلسفة الجديدة، والخطورة القصوى تكمن في أن واشنطن، التي تصر على بقاء مصالح حيوية لها في المنطقة، تختار التعامل معها عن بُعد، معرضةً المنطقة لعاصفة من الفوضى الإستراتيجية والتصعيد المحفوف بالمخاطر، التي ساهمت هي نفسها في صنع رياحها..
----------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش