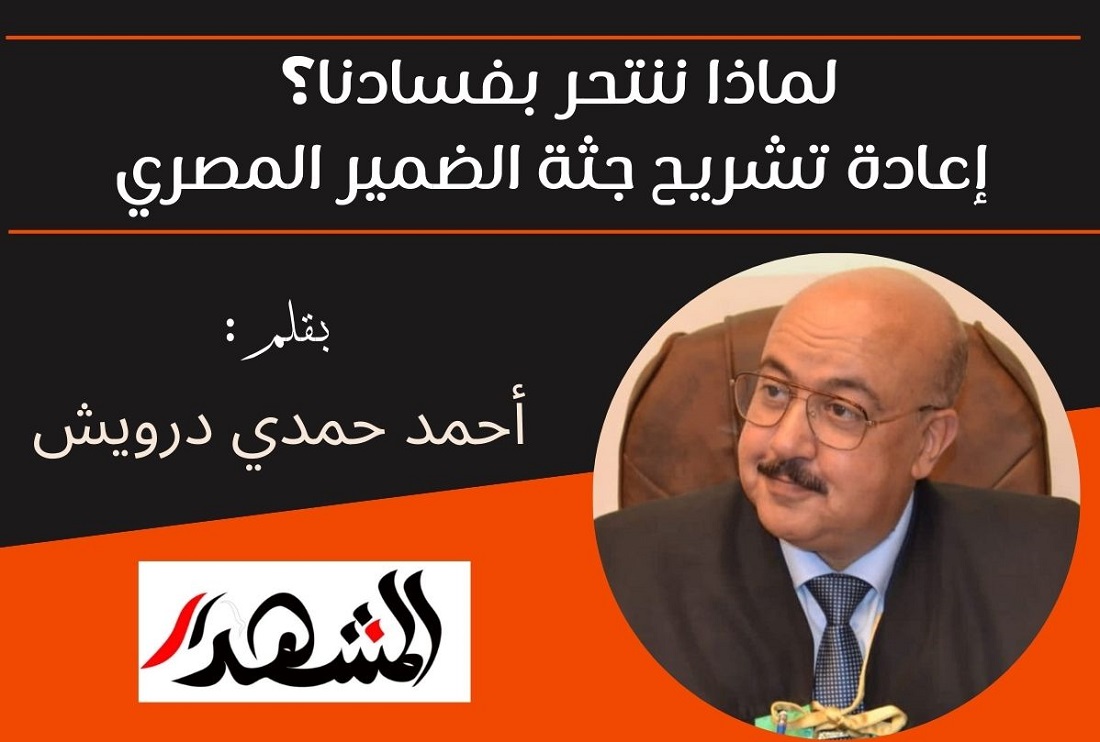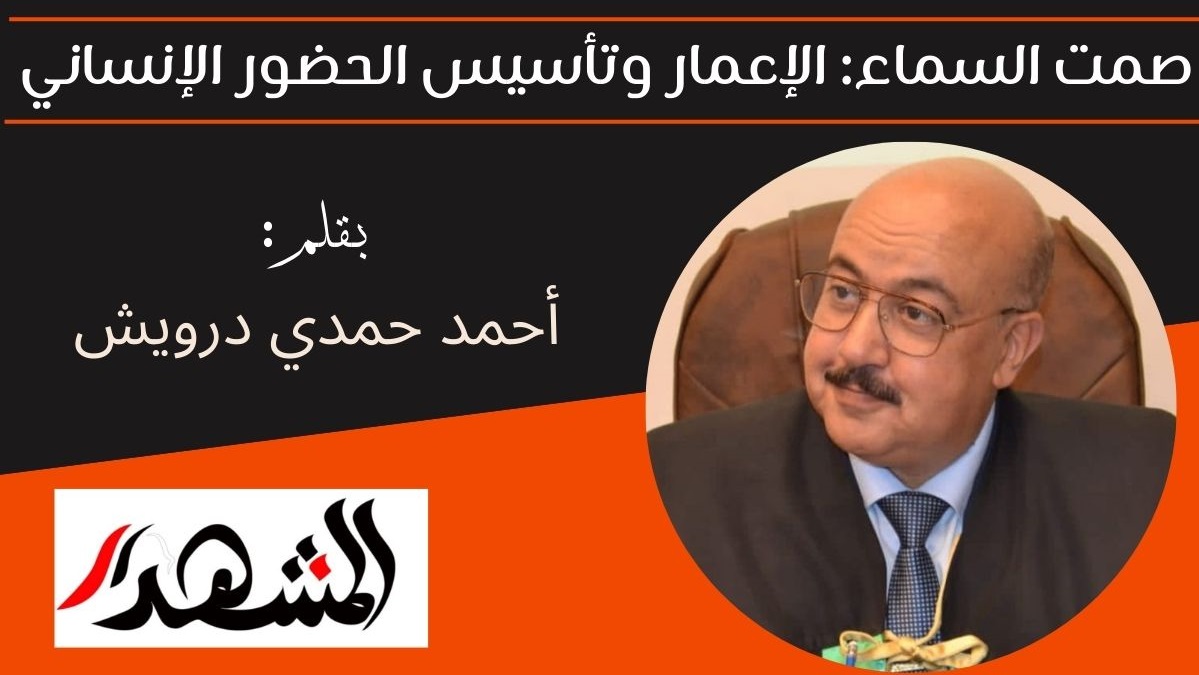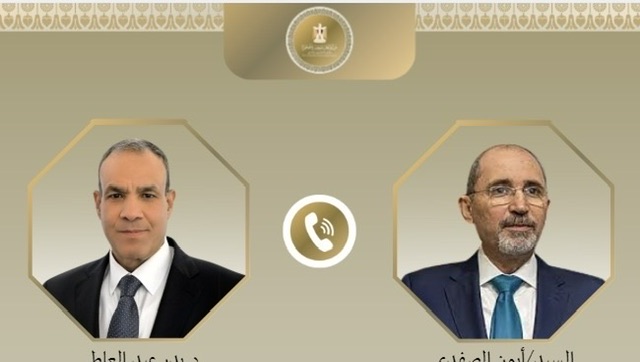الفساد السياسي لا ينهك الدولة، بل يشوه روحها، ويحولها من حاضنةٍ لأحلام شعبها إلى كائنٍ مفترسٍ ينهش جسد الأمة تحت سقف القانون، فيصبح القمع شرعيةً، والنهش حقاً، والخيانةُ نظاماً.. فعندما تفسد الدولة لا تموت ولا تعجز، بل تتحول إلى كيانات طفيلية فَعّالة في نهب مواطنيها تحت غطاء الشرعية، حيث القوانين لا تُلغى، بل تُشوه لتصبح أدوات قمع، والأجهزة لا تُفكك، بل تُوظف لخدمة النخبة، فالفساد السياسي لا يعني الفوضى، بل نظامًا موازيًا منظمًا للإثراء على حساب الوطن.. إنه تحول جوهري في الوظيفة؛ من "دولة الخدمة" إلى "دولة الافتراس"، حيث يصبح المنصب استثمارًا، والقرار سلعة، والمواطن مجرد ضريبة حية تُدفع من حريته وكرامته لتمويل نظام لم يعد يخدم سوى نفسه.
فعندما خطط محمد علي باشا لـمذبحة القلعة في الأول من مارس 1811، لم يكن يتصور أن هذا الحدث الدامي من الإبادة سيصبح نموذجاً يُتبنى في الخيال الجمعي كحل سحري ومرعب للفساد، فبينما كان المماليك يرتدون أفخر الثياب ويحملون أجمل السيوف، كان الرصاص ينتظرهم في ممرات قلعة صلاح الدين الأيوبي، ليضع نهايةً دموية لحوالي 500 مملوك، وليبدأ بإبادتهم فصل جديد من تاريخ مصر.
ففي ذلك اليوم المشؤوم، دعا محمد علي باشا كبار قادة المماليك إلى حفل باذخ في القلعة، بمناسبة تولي ابنه أحمد طوسون قيادة الجيش المتجه إلى الحجاز لمحاربة الحركة الوهابية، وبعد انتهاء الحفل، انضم المماليك إلى موكب الجيش الخارج، وما إن دخلوا ممر باب العزب الضيق حتى أغلق الباب، وانهال عليهم الرصاص من كل اتجاه، ولم تكن المذبحة مجرد فعل عفوي، بل كانت عملية مدروسة بدقة، إذ اختير الطريق الوعر والممر الضيق لحجب الرؤية عن المماليك وتقليل فرص هروبهم، وتكشف الروايات التاريخية أن محمد علي كان متجهماً طوال اليوم، وأنه طلب الماء بشدة عندما سمع طلقة البداية، وكأنه كان يدرك أن التاريخ سيتذكره بهذا المشهد الدموي رغم كل ما سيقوم به من إصلاحات لاحقاً .
ويطرح حدث مذبحة المماليك التاريخي إشكالية فلسفية عميقة حول العلاقة بين الغاية والوسيلة، فهل تبرر الغاية النبيلة (التخلص من الفساد) استخدام أي وسيلة كانت حتى لو كانت دموية وغير أخلاقية؟ فمن المنظور البراغماتي؛ يرى أنصار هذا التوجه أن مذبحة القلعة كانت ضرورة تاريخية لتحقيق الاستقرار وتمهيد الطريق لمشروع النهضة الحديثة، فالمماليك - كما تصورهم بعض الروايات التاريخية - كانوا "يشكلون دولة داخل الدولة" ويعيقون أي محاولة للإصلاح، ومن المنظور الأخلاقي؛ يرفض هذا المنظور مبدئياً استخدام الوسائل غير الأخلاقية بغض النظر عن النتائج، فكما يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي: "ولكن مهما بلغت سيئاتهم فإن القضاء عليهم بوسيلة الغدر أمر تأباه الإنسانية".
وإذا قفزنا بالزمن إلى مصر المعاصرة، نجد أن الفساد قد تغيرت أشكاله، لكنه بقي متجذراً في النسيج الاجتماعي، فبينما كان فساد المماليك مباشراً وعنيفاً، تحول الفساد اليوم إلى نظام شبكي معقد له جذور من زبائنية ودولة عميقة ورأسمالية المحاسيب. ويتساءل المؤرخ والمستعرب الياباني "نوبواكي نوتوهارا" الذي عاش أربعين عاماً بين العرب، في كتابه "رحلة البحث عن الأشياء المفقودة" أو "العرب: وجهة نظر يابانية" - سنة النشر 2003 - ملخصاً انطباعاته الصادقة ودهشته من هذا المزيج الغريب بين الإيمان العميق والفساد العميق عند العرب، فالعربي يرفع شعار الدين عند كل حديث، لكنه يدهس القيم عند أول اختبار، ويصلي ويلعن الظلم، ثم يمارسه عند أول فرصة، فالدين عند العرب أهم ما يتم تعلمه ولكنه لم يمنع الفساد وتدني قيم الاحترام، فكيف لهذه الشعوب التي تمجد الدين ليل نهار وتدعوا إلى الفَلَاح خمس مرات في اليوم أن تفسد بهذه الجرأة؟!..
وحتى سجناء الرأي والسياسة في البلاد العربية الذين ضحوا من أجل الشعوب، لا تجد شعوبهم غضاضة من التضحية بأولئك الشجعان، في صورة فجة من صور انعدام المسئولية، فيمجدون زعاماتهم ويقدسونهم كأنهم آلهة وهم يتنازعون العروش باسم الوطن، بينما يبقى الشعب العربي يتناحر بفساد على الفتات باسم الشرف، حتى المثقف العربي صار يمدح القمع وهو يقرأ عن الحرية، والخلاصة الصادمة لنوتوهارا أن الحكومات العربية لا تعامل شعوبها بجدية، بل تسخر منهم، وأبشع ما تقترفه تلك الأنظمة بشعوبها أنها تقتل فيهم الطيبة.
والفساد في مصر قد شهد تحولاً نوعياً عبر المراحل التاريخية الحديثة، حيث انتقل من كونه ممارسات فردية محدودة على المستوى الشخصي في عهد جمال عبد الناصر مرتبطة بسلطات بيروقراطية في إطار الاقتصاد الموجه، إلى مؤسسة منظمة (فساد مؤسسي) في عهد أنور السادات مع تحول الاقتصاد إلى سياسة الانفتاح وبروز الرأسمالية الطفيلية، ورأسمالية المحاسيب، ليبلغ ذروته كممارسة مجتمعية مُمَأسسة في عهد الرئيس مبارك، حيث تحول إلى ظاهرة ثقافية مهيمنة وقيمة اجتماعية مُتطَبَّعة، يمارسها ويتبناها أغلب أفراد المجتمع كآلية وسنة مجتمعية للتعامل مع مؤسسات الدولة البيروقراطية.
مأسسة الفساد
بينما المرحلة الراهنة من تاريخ مصر، تحول فيها الفساد إلى ظاهرة هيكلية ومؤسسية تكرست من خلال تشريعات وقوانين أضفت الطابع الرسمي على غياب الشفافية، بدلاً من أن تكون مجرد سنة مجتمعية كما في العهود السابقة، ورغم الخطاب الرسمي الداعي لمكافحته، تشير البيانات الدولية والتقارير التحليلية إلى أن الفساد قد ارتفع إلى مستويات قياسية، حيث تحول إلى أداة لإدارة الدولة نفسها.
وتوضح مؤشرات الفساد في مصر خلال السنوات الأخيرة، استناداً إلى بيانات منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)، أن الترتيب العالمي المصري لمؤشر مدركات الفساد من أصل 180 دولة عام 2010 كان الترتيب رقم 98، بينما في عام 2024 احتلت مصر المرتبة رقم 130 وهذا هو أسوأ مستوى سجلته مصر، فلم يعد الفساد في مصر مجرد ممارسات فردية، بل أصبح مُدعماً بقوانين وهياكل تجعله جزءاً لا يتجزأ من نظام الحكم. فصدرت قوانين وتشريعات تقنن غياب الشفافية مثل "تحصين العقود الحكومية" الذي يجعل التعاقدات الحكومية محصنة من الطعن القضائي، مما يحمي أي عقود مشبوهة من المراجعة، بما فيها المتعلقة ببيع الأصول والخصخصة، كما سمح قانون المناقصات والمزايدات بالإسناد المباشر لمعظم الأعمال الحكومية، متجاوزاً الطرح العلني مما يهدر المال العام ويضعف الرقابة، وفي الوقت نفسه تم إنشاء صناديق وحسابات خاصة خارج الميزانية - مثل صندوق "تحيا مصر" - تدار خارج نطاق المالية العامة المعتادة وبمعزل عن الرقابة البرلمانية أو الشعبية، مما يجعل تتبع الأموال العامة مهمة شبه مستحيلة، كما أن سيطرة الجهات والأجهزة السيادية على الصفقات الكبرى (كشراء القمح والمنتجات البترولية) بعيداً عن أعين الجهات الرقابية بمليارات الدولارات، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الفساد دون محاسبة.
ورغم إطلاق "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" عام 2014 وتأسيس "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" عام 2017، إلا أن الواقع يشهد بفشل ذريع، لتعطيل آليات الرقابة من عمل اللجان الوطنية لمكافحة الفساد، مع استبعاد المجتمع المدني والرقابة الشعبية من عضوية تلك اللجان، مما يحرم النظام من أدوات رقابية فعالة، كما أنه رغم المطالبة لسنوات فلم يتم إصدار قانون فعال لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، مما يعرض كل من يحاول كشف الفساد للاضطهاد والفصل من العمل، علاوة على أن الفساد يكمن داخل أجهزة مكافحة الفساد نفسها، فتشير بعض التقارير إلى تورط أجهزة الدولة في ممارسات المحسوبية مما تشكل "هيئة عائلية مغلقة" تقف كعقبة هيكلية أمام تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تقويض فعالية الآليات الرقابية وإضعاف ثقة المجتمع في مؤسساته.
الملخص والنتيجة
يمكن القول إن الفساد في الغضون الحالية من عمر الوطن قد تجاوز مرحلة "الظاهرة المجتمعية" إلى مرحلة "الدولة الموازية"، تماماً كما كان المماليك يشكلون "دولة داخل الدولة وموازية لها" حيث أصبح الفساد أداة حكم ووسيلة لإثراء النخبة الحاكمة تحت غطاء قانوني، إلا أن الفارق الوحيد بين المماليك القدامى والمماليك الجدد، هو أن القدامى لم يكونوا على وفاق مع الوالي..
ولقد تحولت "حرب الفساد" المعلنة إلى مجرد خطاب، بينما باتت الممارسات الفعلية تكرس نظاماً اقتصادياً وسياسياً قائماً على الامتيازات والثراء غير المشروع، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفساد وفقاً للمقاييس الدولية، ويبدو الاقتراح القائل بأن "حرب الفساد لا تحتاج سوى إبادة كمذبحة القلعة" كأنه حلم يراود الكثيرين من الذين سئموا استشراء الفساد، فهل نحتاج فعلاً إلى مذبحة؟
ربما تكون الإجابة الأكثر عمقاً على فكرة 'المذبحة' كحل للفساد، هي أن جذور الفساد الحقيقية لا تكمن في الأفراد فحسب، بل في الأنظمة والهياكل الاجتماعية التي تنتجه وتعيد إنتاجه، فالمذبحة - بحسب منطق التاريخ - قد تقضي على الأفراد، لكنها عاجزة عن اقتلاع البنى الهيكلية التي أنتجتهم في الأساس، فلقد حاول محمد علي أن يحل مشكلة الفساد بإزالة رموزه، لكنه لم يستطع بناء نظام منيع ضد الفساد، واليوم بعد أكثر من مئتي عام على مذبحة القلعة، مازلنا نناقش نفس الإشكالية، ربما لأن الفساد مرض حضاري لا يمكن علاجه بقطعة جراحة دموية، بل يحتاج إلى مشروع نهضوي متكامل يغير الثقافة والأنظمة والقيم، ويعيد تشكيل وتعريف الذات بعيداً عن الازدواجية والرياء والخداع والنفاق.
كما أن الفلسفة والتاريخ يقدمان تحذيرات مهمة؛ فالفساد كائن متعدد الرؤوس، وقطع رأسه لا يعني القضاء عليه، بل سينمو مرة أخرى بشكل آخر، فبعد إبادة المماليك، ظهرت أشكال جديدة من الفساد أكثر تعقيداً وتشابكاً، كما تشير الدراسات إلى أن لكل حقبة تاريخية للفساد دورة حياة تبدأ بالبناء ثم التوهج ثم الانهيار، وترتبط سرعة هذا الانهيار بشدة حالات الفساد وتواترها، ويقدم لنا التاريخ درساً بأن الحلول السريعة والعنيفة غالباً ما تنتج مشاكل أعمق، فمحمد علي نفسه، بعد أن تخلص من المماليك، انقلب على حلفائه من قادة الحركة الشعبية الذين نصبوه والياً، فقتل بعضهم ونفى البعض الآخر.
ويقدم لنا العلم نماذج بديلة للإصلاح قابلة للتطبيق التدريجي حتى في أكثر الأنظمة مقاومة للتغيير، حيث تعتمد على خلق وقائع جديدة من خلال تمكين المجتمع وخلق تحالفات إصلاحية ذكية تستفيد من التناقضات بدون النظام الحاكم نفسه، وتتدرج في التمكين كالآتي:
نموذج الإصلاح التدريجي: يقوم على معالجة الفساد عبر مؤسسات قوية وقوانين رادعة ذات حوكمة رقابية مستقلة، مع التركيز على التربية والتعليم كمداخل أساسية لتغيير الثقافة المجتمعية، كخطوة هامة لتفعيل رقابتها عبر منصات رقمية تتيح التبليغ المجهول مع حماية المبلغين، وإرساء عقود أداء للمسؤولين مع مؤشرات قياس أداء مرتبطة بمكافحة الفساد.
نموذج الضغط الاقتصادي الخارجي: بربط التمويل الدولي بشروط النزاهة، مع إنشاء هيئات رقابية مستقلة للإشراف، وأيضاً تفعيل الشفافية المالية الإلزامية للصفقات الحكومية الكبرى بنظام النفاذ العام للمعلومات، كما يتم تطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة لمكافحة الرشوة في التجارة الدولية.
نموذج التحول الديمقراطي التشاركي: بإقرار اللامركزية الإدارية الفعلية مع نقل السلطات المالية للمحافظات، تحت رقابة المجالس المحلية، وتفعيل موازنات تشاركية يقررها المواطنون مباشرة في المشاريع المحلية، وإنشاء مجالس رقابيةمستقلة تمثل المجتمع المدني والأكاديميين.
نموذج التغيير الثقافي الطويل الأمد: بإدماج التربية المدنية في المناهج التعليمية والتركيز على قيم النزاهة، وتفعيل الحملات الإعلامية المستندة لدراسات سلوكية تغير القبول المجتمعي للفساد، كما يتم إنشاء مراصد وطنية مستقلة لرصد الفساد ونشر تقارير دورية.
نموذج التحالف الدولي الإقليمي: بالانضمام لاتفاقيات دولية ملزمة لمكافحة الفساد مع آليات تقييم الأقران، وكذلك إنشاء محاكم إقليمية متخصصة في قضايا الفساد العابرة للحدود، وتفعيل التعاون القضائي الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة.
نموذج التمكين التكنولوجي: بتطبيق أنظمة البلوك تشين (Blockchain) في التعاقدات الحكومية والمناقصات، وإنشاء منصات الذكاء الاصطناعي لرصد الشبهات المالية والإنفاق الحكومي، وتفعيل الحكومة الإلكترونية الشاملة لتقليل الاحتكاك البشري.
نموذج المقاومة السلمية: بتبني أساليب الضغط السلمي والمقاطعة والاحتجاج القانوني لتغيير النظام الفاسد.
نموذج التحول الديمقراطي: بالتركيز على بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تضمن الشفافية والمحاسبة وتداول السلطة.
ومن مذبحة القلعة إلى معركة الوعي، وبينما نغلق هذا التحليل، ندرك أن معركة الفساد ليست معركة ضد أشخاص، بل هي معركة ضد أنظمة استوطنت الوعي والواقع معاً، فلقد تحول الفساد من شوكة في جسد الدولة إلى نظام عصبي يتحكم في أدائها، ومن عدو تقليدي إلى طفيلي متجذر في الخلايا العميقة للمجتمع.والتاريخ يخبرنا أن المذابح تنتج دماءً ولكنها لا تنتج وعياً، وأن القضاء على الأسماء لا يقتلع الجذور، فكما أن القلعة شهدت مذبحة الجسد قبل قرون، فإن معركتنا اليوم هي مذبحة الوهم - وهم الحلول السريعة، وهم البطل المنقذ، وهم أن النظام يمكن إصلاحه من داخله.
والحل يكمن في تلك المساحة الهادئة بين اليأس والأمل، حيث نرفض أن نكون ضحية أو جلَّاداً، إنها المعركة التي تبدأ من إصلاح علاقتنا مع السلطة، مع المال، مع الضمير، ومشروع النهضة الحقيقي يبدأ عندما نتحول من شعب ينتظر المنقذ إلى أمة تبني نظامها المناعي الخاص. فالفساد لا يخاف من الرصاص، بل يخاف من المعرفة، ولا ينهار بالقوة، بل يذوي عندما تتوقف القلوب عن تقبله والعقول عن تبريره، وقد تكون أعظم انتصاراتنا ليست في تغيير النظام الفاسد، بل في رفضنا أن نكون أدوات في آليته، فعندما يموت الضمير، يولد الفساد.. ولكن عندما يستيقظ الضمير، تبدأ المعجزة.
-------------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش