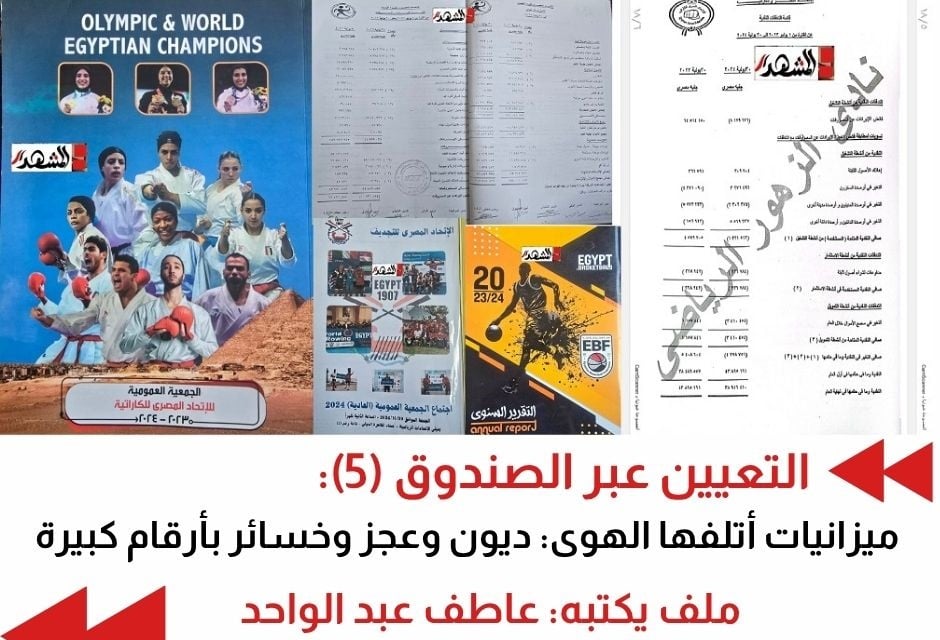في السنوات الأخيرة، برز اسم رجال حبيب العادلي يطفو على السطح من جديد، كأن عقارب الساعة تعود إلى ما قبل يناير، داخل أروقة الأمن الوطني، اللهجة واحدة، والأساليب معروفة، و كأن فوق المكاتب صور الرجل الذي صنع المدرسة: "الوزير الحديدي"، و بعضهم يتباهى علنًا بأنهم "أبناء المدرسة القديمة"، وكأنها شارة فخر أكثر من كونها تهمة، فحينما يرددها بعض الضباط في وجه طرف أضعف ثقافيًا أو عدديًا، فالمقصود منها إخضاع وليس طمأنة في عالم "الإخضاع النفسي" .
وعلي الرغم من تغير الاسم من جهاز أمن الدولة إلى الأمن الوطني بعد الثورة، إلا أن كثيرين داخل المؤسسات الحقوقية والسياسية يرون أن العقلية لم تتغير، و يعاد نفس منهج السيطرة بالترهيب، ونفس نظرة الاشتباه الدائم في المجتمع المدني، وكل من يرفع صوته خارج "النغمة العامة"، هذه المدرسة الأمنية لم تعتنَ يومًا بحرية التعبير بصفتها حقًا مدنيًا بقدر ما تعاملت معها كقضية "أمنية" تتطلب ضبطاً ومراقبة واستباقاً، لتحول المجال العام إلى مساحة مراقبة ذاتية لا تختلف كثيرًا عن الأنظمة الشمولية.
و كانت واحدة من أكثر القضايا حساسية في عهد جهاز أمن الدولة، علاقة الدولة بالأقباط.
و مازال هناك وحدة "ملف النشاط القبطي"، مسؤولة عن متابعة الأديرة والكنائس والخدام، ليس بدافع أمني بحت، بل كرؤية سياسية ومنع أي "تسييس" للمطالب الدينية أو الحقوقية، التي تهدم مشروع المواطنة بالعقول المروَّضة، و ليست الحرة، عبر إعادة تشكيل الوعي بالإذعان يعيد المجتمع إلى نقطة الصفر، مهما تقدمت البنية التحتية أو تغيرت الوجوه.
و بحسب شهادات حقوقيين ومسؤولين سابقين، كانت بعض القرارات الكنسية الكبرى و أدق التفاصيل تخضع لمراجعة أمنية دقيقة عبر "الخوف المُستبطن" و الترغيب بالمصلحة الفردية.
و عاش الأقباط في عهد مبارك ما يمكن أن نسميته بالحماية المشروطة، تقدم الدولة الحمايه ظاهريًا من التطرف، لكنها في المقابل تحاصرهم داخل جدران الرقابة، وكانت التعليمات غير المعلنة واضحة:"لا صوت يعلو فوق صوت الأمن، حتى داخل الكنيسة."
في كواليس تلك الحقبة، ترددت حكايات لم تخرج للإعلام أبدًا، عن رهبان و رجال دين استُدعوا شفويًا للاستجواب حول منشورات كنسية تتحدث عن المساواة، دون محضر و إجبارهم على التوقيع بالتزام “تهدئة الشباب" ومنع الشكوى و أيضا عن ضباط كانوا يتفاخرون بقدرتهم على "ضبط الملف الطائفي" كما يضبطون خلية إرهابية، و كانت المقولة الشهيرة داخل الجهاز، "الطائفية تُدار، لا تُحل"، ضمن ما كان يُعرف وقتها بـ"ضبط النشاط الكنسي العام"، و في أحداث الاحتقان الطائفي قبل 2011، كان يُنقل للكهنة جملة شهيرة "لو رُفع محضر رسمي، الأزمة حتكبر، خلّوها عندكم.”، و كانت النتيجة هي غلق ملفات الإعتداءات على الأقباط محليًا وإجبارهم على قبول “جلسات عرفية” وعدم وصول القضايا للنيابة وهي استراتيجية “الصمت الغامض”، ومنع بناء وإصلاح كنائس بقرارات شفهية حتى لو كانت الأوراق سليمة، وتعطيلها بسلطه مطلقة وطلب تقليل مساحة الكنيسة أو ارتفاعها، ورأينا ذلك كتطبيق عملي مؤخرا في كنيسة "ميت عفيف" بالمنوفية واتهم أسقف الإبراشية رسميا ضابطا محددا داخل الفرع بتعطيله قبل الشتاء، وكانت الرساله للناشطين الفاضحين لهذه السياسات “اهدأوا قليلا، الإعلام خط أحمر.”، وأثبت تحميل الضحية المسؤولية وتدوير الأزمة داخليًا فساده، حينما يمنع أي مسار قانوني مستقل وتحويل جهاز عظيم إلى “حَكَم”و ليس “جهة تنفيذ قانون”.
و لم تكن عودة سياسات حبيب العادلي إلى مواقع القرار الأمني مجرد أراء فردية، بل عقلية و ميكانزمات كاملة اعتادت النظر إلى المواطن من خلف زجاج المراقبة، والتعامل مع الرأي والاختلاف باعتبارهما تهديدًا لا حقًا، والأخطر هو التفاخر بتلك المدرسة، وكأنها وسام يُعلق على الصدر، لا صفحة مؤلمة من تاريخ جهاز أمني تجاوز صلاحياته وانتهت بكارثة علي النظام، وكانت فصلا من الانتهاكات والمداهمات والتصنت والاعتداء على الحريات وكانت “عصرًا ذهبيًا” ينبغي استعادته لا طيّه في صفحات التاريخ.
و اليوم، ومع عودة نهج المدرسة القديمة، بدأت تظهر مؤشرات مقلقة، عن حملات استدعاء متزايدة لبعض الناشطين المسيحيين تحت عناوين “تحقيقات استيضاحية” ومراقبة غير معلنة للسيطرة علي الخطاب العام بل الأراء الحرة، ثم تدوين وقائع قد تُستغل لاحقًا، خاصة بعد اقرار القانون الجنائي الجديد، فهناك محاضر وقضايا تُعدّ بصياغات عامة وفضفاضة مثل "نشر معلومات كاذبة" أو "إساءة استخدام وسائل التواصل" تتيح للجهات الأمنية توجيه تهم جاهزة لأي صوت معارض، واستعادة لهجة الاشتباه في أي نشاط ديني أو مدني خارج السيطرة المؤسسية، كل ذلك يعيد للأذهان مرحلة "القبضة الصامتة" التي سبقت ثورة يناير، حين كان الأمن يرى نفسه وصيًا على المجتمع لا حارسًا له، وهذا مؤشر خطير، لأن الضربة هنا ليس ضد معارض عابر، بل ضد داعم حاول توصيف وتحليل مشكلة.
و الحقيقة أن العودة إلى "سياسات زمن العادلي" ليست مجرد إستدعاء لرأي قد يكون شخصيا، بل استدعاء لمنهج يرى المواطن ملفًا، ويرى التنوع تهديدًا، وإذا استمر هذا النهج، فإن الأقليات وخاصة الأقباط سيكونون أول من يشعر بثقل الظل الأمني، وأول من يدفع ثمن عودة الماضي.
لكن التاريخ علّمنا أن القبضة مهما اشتدت، تضعف حين تصطدم بالوعي، والذاكرة الوطنية لا تنسى من كانوا السبب في خوفها وصمتها، و تتسبب في اخطاء استراتيجية قاتلة.
إن العودة غير المعلنة لنهج حبيب العادلي داخل وزارة الداخلية ليست مجرد تدوير لإعادة للانضباط الأمني، أو توريث سياسات، بل هي عودة لفكر كامل يرى في الكلمة جريمة، وفي النقد تهديدًا، وفي المواطن "ملفًا مفتوحًا" يجب مراقبته إلى الأبد، ليكون أول ضحايا التحكم العقلي هم الهامشيون. هذه المدرسة التي تربّى فيها أغلب رجال أمن الدولة في التسعينات والألفية، لم تفرق بين معارض سياسي، أو صحفي، أو كاتب رأي، و كل تعبير كان يُقرأ بمنظار أمني، وكل كلمة تُصنف كاحتمال للتحريض، فيتحول الي مُحاصر بالرمز، وبالهيبة.
اما اليوم، ومع تزايد نفوذ من يتبنون النهج القديم، بدأت تظهر بوادر خطيرة، مثل استدعاءات واستجوابات لصحفيين وناشطين بتهم فضفاضة مثل "بث منشورات اثارة" ومحاضر معدّة مسبقًا يمكن أن تلبَّس لأي صوت مختلف، بمجرد توقيع من ضابط الأمن الوطني أو الفحص الفني، و مراقبة رقمية مكثفة، يجعل الأقليات تكتب "بيد مرتعشة" أو تخرس تمامًا، رغم الذين ما زالوا يدفعون ثمن التمييز الاجتماعي في قرى الصعيد والمدن الصغيرة، هم أول من يشعر بظل هذه العودة الثقيلة، مع النهج القائم على التحكم في الصوت لا الإصغاء له، وعلى “إدارة الملف الطائفي” لا ضمان المساواة الدستورية، و نتساءل هل نحن بصدد تجريم كل من يصور الاعتداءات وانتهاكات الغوغائين علي أقباط القرية بدواع أمنية؟!، أم اختزال وهيكلة الملف ليصبح مدارا بالكامل من الخارج أي أقباط المهجر وليس الداخل؟!
و يوثق أحد المراقبين الأمنيين السابقين شهادته، بأن بعض هؤلاء الضباط "يرون أن إعادة السيطرة على الرأي العام تبدأ من إعادة إنتاج الخوف"، وأن “العصر الذهبي للأمن” في نظرهم حين يعتاد المواطن على أن رأيه قد يُحسب جريمة، فتنكمش قدرته على التفكير الحرّ، وتتهيأ الأرضية لغسيل أدمغة سياسي يخلق شعبًا يخشى حتى الأسئلة.
فكلما ارتفع صوت الأجهزة على صوت القانون، عادت الدولة تكرر التاريخ نفسه: صناعة وعي خاضع، يقبل القيود باعتبارها ‘ضرورة أمنية’. وهنا تحديدًا تبدأ عملية إعادة تدوير الماضي داخل الحاضر.”
فاستثمار أحكام عامة في قوانين الإعلام والأمن القومي لترسيخ إجراء أمني تحت ستار الشرعية، يعد كارثة تحمل ظلما ثقيلا. أما عن رجوع منهج المدرسة القديمة يعيد السؤال الأخطر: هل الدولة تُدار بالقانون أم بالتقارير الأمنية؟ و عندما يتسع نفوذ الفكر الذي يرى في المواطن احتمال خطر دائم، فهذا معناه أن حرية الرأي في مصر تتراجع لمنطقة مظلمة جدًا، بل منطقة تدفع فيها الشخصيات العامة ثمنا “لمنشور” أو “تغريدة” عابرة، بل خطة متكاملة لخلق طابور جديد من سجناء الرأي الذين يعبرون عن اضطهاد أو يشكون من انتهاكات، واستدعاء لروح نظام كامل يحيا على الخوف والتكميم والولاء الأعمى. تلك المدرسة لا تعرف إلا لغة الحوار الشكلي ولا تؤمن بالاختلاف، بل تعمل بالعقيدة القديمة التي تؤكد “اضبط كل صوت قبل أن يعلو.”
فكيف نعيد عقارب الزمن، وقد أصبح التنكيل في زمن الإنترنت والميديا المفتوحة، والذاكرة الجمعية لا تموت، وهذه الأدوات ليست محايدة، بل تصبّ مباشرة في صالح المتشددين داخل الجهاز والدائرة الحاكمة، لأنهم يستفيدون من بيئة الخوف والولاء طويلاً، بيئة تُقلّل من قوة الأصوات الوسطية وتُشرعن سردية أن "الاستقرار" يمرّ عبر تكميم الأصوات، بل يستفيد المتشددون داخليًا من عودة الوجوه القديمة. حين يتحول النقد إلى تهمة، والمنشور على الفيسبوك إلى بلاغ بتهمة ازدراء أو إثارة فتنة، فهذا يعني أن الأقباط والمثقفين والتنويريين جميعًا يدخلون دائرة الاشتباه بالرغم من معرفة نواياهم مسبقا، خاصة أن بعضهم يُنظر إليه باعتباره “قريبًا من الكنيسة” أو “ناشطًا في الشأن القبطي”، وتُغلق الأبواب أمام وصول أصواتهم للرئيس أو جهه محايدة، ويُختزل صوت المجتمع القبطي في بضعة وجوه مُنتقاة أمنياً، بينما الباقون يعيشون تحت الخوف من “كلمة يُساء تأويلها”.
و خلال شرعنة الخطاب الأمني، فإن تواجد هذه السياسات يُعيد الاعتبار للرؤية القائلة إن أي تغيير سياسي أو إجتماعي يجب أن يكون تحت إشراف أمني، وهذا يمنح المتشددين منصة لتوسيع رقعة صلاحياتهم. وإضعاف الوسطاء والمعتدلين، عندما تُخنق مساحة التعبير.. تقلّ قدرة الشخصيات العامة والمجتمع المدني المستقل على الوساطة، وهذا يترك المجال مفتوحًا للقرار الأمني الصارم، الذي يفضّل فرض الطاعة على الحوار، وبتطويع النخب الموالية ووجود شخصيات عامة وحقوقيين محسوبين على النظام يمنح المتشددين غطاءً سياسيًا واجتماعيًا، ويمكن استخدام تصريحات هؤلاء لتبرير إجراءات قاسية باسم "الحكمة" أو "الواقعية"، ما يقلل من الاحتجاجات الداخلية ضد التشدّد، و كذلك استغلال الأزمات لتوسيع الصلاحيات، وكل أزمة أمنية أو إجتماعية تصبح ذريعة لتشديد القواعد، والمتشدّدون يصبّون في هذا السرد لتبرير مزيد من التدخّلات.
عندما يشعر المواطن القبطي أنه بلا حماية قانونية، وأن أي مشكلة قد تُحل عبر “جلسة عرفية” لا عبر المحكمة، فهو يُدفع تلقائيًا إلى الصمت والتنازل، بينما يستقوي المتطرف المحلي بشعور الإفلات من العقاب.
هذه السياسة القائمة على “الاحتواء الأمني” بدل تطبيق العدالة بإدخال الداخلية كطرف، خلقت بيئة خصبة للترويع والتنكيل، مع تكرار الأحداث يتأكد أن العدالة تراجعت، وأن غطرسة السلطة الميدانية تغلبت على دولة القانون، فكم من بيت قبطي أُحرق، وكم من فتاة أُهينت، وكم من أسرة طُردت من قريتها ثم أُجبرت على “الصلح” أمام الكاميرات، بينما الجناة يسيرون في الشوارع بلا عقاب يتفاخرون ويكيدون شركاء الوطن، هذه الوقائع لا تُنشر كلها، لكنها تُعرف في القرى والبيوت والكنائس، وتُروى كقصص تُخيف أكثر مما تُواسي.
فالمحصلة النهائية، ليست مجرد خطابات متشددة أو سجلات استدعاء؛ هي بيئة عامة تجعل المواطن يفكّر مرتين قبل أن يعبر عن رأيه، وتحوّل الأقليات خاصة المسيحيين إلى أهداف سهلة للمناورات الإدارية والأمنية وأداه لتفريغ الأحتقان. في بيئة كهذه، تتحول الحقوق إلى تنازلات مؤقتة تُمنح وفق أطر أمنية، لا على مبادئ دستورية وضمانات قانونية. فإن عودة "المدرسة القديمة" بأساليبهم تمثل اختبارًا لمدى قدرة الدولة على اختيار الحماية القانونية بدلًا من الحماية الأمنية. إذا ما استمرّ الميل إلى إدارة المجتمع بلغة المراقبة والاعتبارات الأمنية الضيقة، فإن من يكسبون على المدى القصير هم المتشددون والموالون لصيغة الحكم القاصرة، وهؤلاء سيُكلفون البلاد ثمناً باهظًا على مستوى الحريات الاجتماعية والسياسية والثقة العامة.
ولا يمكن تجاهل أن صفحة وزارة الداخلية على “فيسبوك” باتت تمارس، عمليًا أحد أكثر أشكال “الهندسة الذهنية” مباشرة، عبر حجب أي رأي معارض أو حتى متحفظ على البيانات الرسمية. فمجرد طرح سؤال مشروع، أو إبداء وجهة نظر قانونية، قد ينتهي بحظر صاحب الحساب بالكامل، في سلوك أقرب إلى “تنميط الوعي” منه إلى إدارة تواصل حكومي، هذا المنهج يخلق فقاعة خطابية لا يسمع فيها المسؤولون إلا أنفسهم، ويحرم الدولة من التغذية الراجعة الحقيقية، وإغلاق القنوات الطبيعية للتعبير والاعتراض، وهنا مكمن الخطورة: حين تتحول صفحات رسمية من منصات للتواصل إلى أدوات لتضييق الرأي، تُفتح الباب أمام سياسات أكثر قسوة خارج العالم الافتراضي.
وفي مشهد أخر يعكس ازدواجيةً صارخة في معايير التعامل الأمني، أقدمت الداخلية على القبض علي أحد المحرّضين على الاحتجاج في نقادة وقوص، فيما يخص ردود الفعل علي الانتخابات البرلمانية، رغم أن التجمعات هناك لم تشهد أي اعتداء على ممتلكات عامة أو خاصة، في حين اختارت الوزارة أن تتعامل بمنطق "الاحتواء المدار" مع أحداث المنيا التي اتسمت بالفوضى و الغوغائية، وهذا التناقض لا يعود إلى اختلاف في الخطأ أو حجم الخطر بقدر ما يكشف المنهج الأمني المعتمد في إدارة اللحظة، نري تشديدا وقمعا سريعا في أي تحرك منظم يمكن أن يُقرأ كبُعد سياسي، مقابل تغافل محسوب عن حالات الانفلات العشوائي التي ترى فيها الأجهزة "غضبا مقننا" دون عواقب، وبين هذا وذاك تغيب العدالة وتتراجع دولة القانون، لتحل محلّها سياسة انتقائية تُحدّدها حساسية المنطقة ومزاج الشارع لا نصوص الدستور، ولا معايير المساواة، ولا حتى الحد الأدنى من المنطق.
“عودة القبضة الحديدية”، تمثل خطورة لا تقع على المعارضين فقط، بل تمتدّ إلى داعمي النظام أنفسهم، كثير من الشخصيات العامة، ومن الحقوقييين الموالين للدولة، والمثقفين الذين وقفوا بوضوح إلى جانب مشروع 30 يونيو ودعموا الرئيس في أصعب مراحل المواجهة مع الإرهاب، يواجهون اليوم الخطر ذاته: أن يتحوّل رأي، أو نقد داخلي، أو ملاحظة إصلاحية إلى “قضية أمنية”، فيتحوّل تلقائيًا إلى خصم صامت أخطر من معارض واضح.
هذا النهج يضع الحلفاء في موقع المستهدف، ويحوّل المقرّبين من الدولة إلى فئة تحت إختبار ضاغط أو يعيد إنتاج صمت يشل المجال العام، ويمنع وصول الحقائق والإنذارات المبكرة للدولة نفسها، فالأسلوب القائم على “التحدي، وإظهار السطوة” قد يمنح بعض الضباط شعورًا بالقوة، لكنه يخلق على الجانب الآخر مناخًا يُضعف النظام من الداخل، لأن الداعم الذي يلاحَق بتهمة “نشر الفتنة” رغم أن توصيف الفتنة معروف، لن يستطيع حماية صورة الدولة خارجيًا، والحليف الذي يشعر بأنه مُهدَّد يصبح أقل ولاءً وأكثر حذرًا وانسحابًا. هكذا يقضم الثقة بين الدولة ورجالها، ويُربك أداء النظام، ويجعل من المساحة المؤيدة نفسها منطقة مشتعلة بالتوتر، بدلًا من أن تكون عمقًا داعمًا لمشروع الدولة الوطنية الحديثة.
إن رؤية أمن الدولة كانت تحتسب “الغضب القبطي” أخطر من “الغضب الايدلوجي”، لأنه يُترجم فورًا لضغط دولي يؤثر على العلاقات الدولية و يهدد صورة الدولة، ويظل الكابوس الأعظم هو فقدان السيطرة الكنيسة، فكانت القاعدة الذهبية “لا قضية طائفية تدخل محكمة إلا للضرورة القصوى”، وكأنها أزمة وطنية أو إحراج حكومي، هذه الأساليب العقيمة منتهية الصلاحيه وصار من الطبيعي خلق جهه محايدة للتحقيق والفصل.
ورغم التحديات التي مرّت بها الدولة خلال الولاية الأولى والثانية للرئيس السيسي، فإن وزارة الداخلية استطاعت في فترات واسعة أن تبني جسور تعاون متين مع الأقليات، سواء في تأمين الكنائس، أو حماية الفعاليات الدينية، أو في إدارة الفتن المحلية التي كانت - لأول مرة منذ عقود - تُحسم بمنطق الدولة وليس بمنطق الغلبة. هذا التعاون لم يكن منحة من طرف، بل كان تلاقي مصالح وطنية، لذلك يحتاج الأمن مجتمعًا متماسكًا، لكن الخطر الآن هو انزلاق الخطاب من مساحة الشراكة إلى مساحة نبرة التحدي والتهديد بالسجن، وهي لهجة لا تخدم الدولة ولا المجتمع أو رموزه، المجتمع الذين يمثل صمام الأمان السياسي، بل تُنتج احتقانًا يُستغل سياسيًا ودينيًا ويهدد مكتسبات سنوات.
نحن في لحظة تحتاج فيها مصر إلى نقطة تلاقي جديدة بين الداخلية والمواطنين الأقباط، تقوم على احترام القانون، والمساواة، والمصلحة الوطنية العليا لا على التنكيل أو فرض السطوة، لأنه في النهاية، لن تنجح الداخلية بدون تعاون المواطنين، كما أن المواطنين لن يكونوا آمنين بدون قوة الدولة، و التاريخ مليء بالتجارب، أما المسار الذي يبدأ بتهديد فرد بسبب منشور، فقد ينتهي في الغالب بخصم من رصيد الدولة نفسها، وخلق هوّة كان من المفترض أن تُردم لا أن تتسع، و انفجارًا مؤجلًا، وينفجر حين لا ينفع الندم، فهو لا يهدّد أعداء النظام، بل قلب النظام ذاته.
----------------------------
بقلم: جورجيت شرقاوي