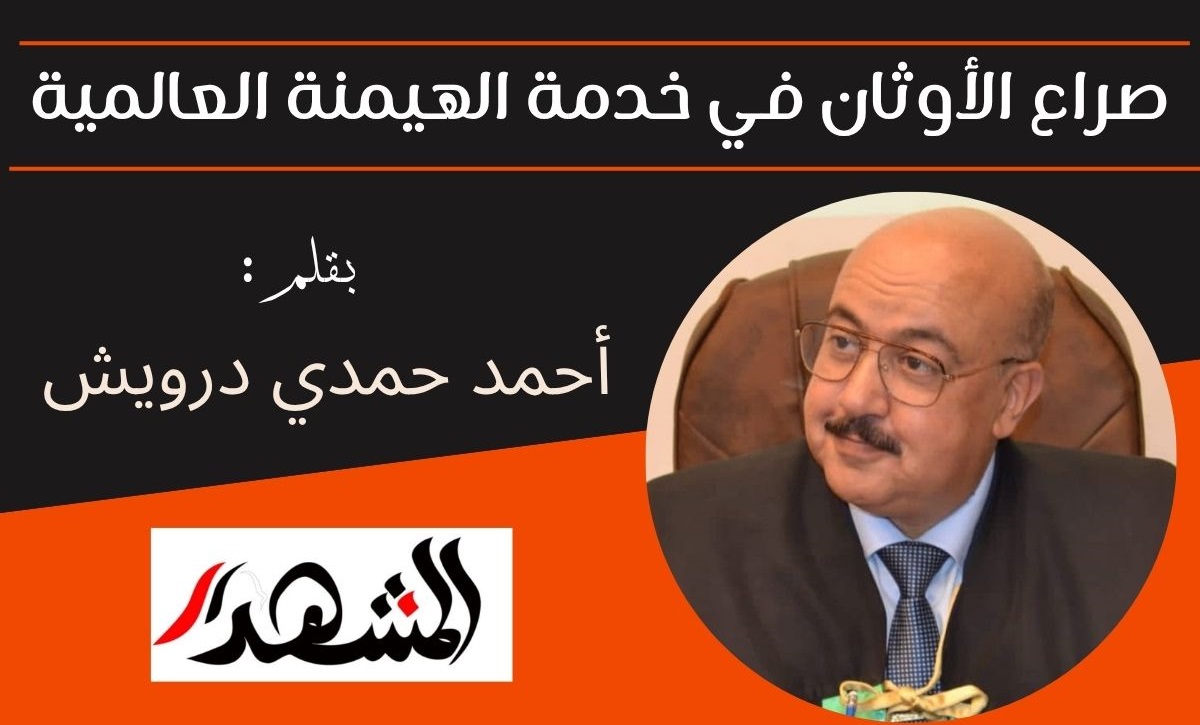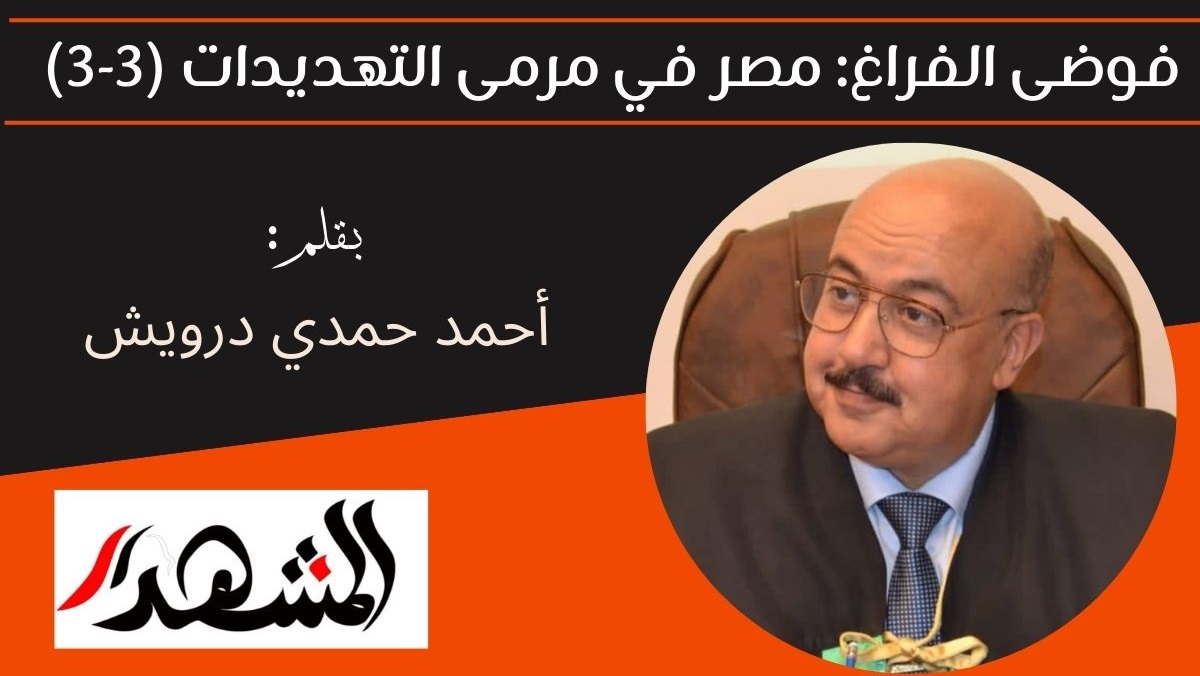"متصارعون على الحكم، ما بين متصارع باسم الدين وآخر باسم الوطن، ولا فرق بينهما في عدم الإيمان بالله أو بالوطن"، هذه الكلمات تختصر مأساة الصراع السياسي في عالمنا الشرق أوسطي المعاصر، حيث يتحول كل من الدين والوطنية إلى أوثان سياسية تُعبَد من دون الله، وتُستَخدم كأدوات لتبرير الهيمنة والاستبداد، وفي هذه المعمعة، يصبح المعارض لسباق الدين "كافراً"، والمعارض لسباق الوطن "خائناً"، بينما يبقى كلا النظامين خاضعين خانعين راكعين مستسلمين للقوى العظمى ومنفذين لمتطلبات العجز والتبعية.
وتتكرر المأساة دائما في فضاءاتنا السياسية، بكلا الفريقين، كما لو أننا أفلسنا من تقديم الرجال، ففريق يتنكر بزي الوصاية الدينية، وفريق يترصد خلف شعارات الوطن البراقة، وكلا الادعاءين قناعان لوجه واحد من العجز والتبعية، فالدين هنا يتحول إلى طقوس سياسية جوفاء، والوطنية تتحول إلى خطاب هوياتي منغلق، وكلاهما يمارس نفس اللعبة: اختزال الحقائق المعقدة في شعارات جوفاء، وتحويل الفضاء العام إلى ساحة للتصفيق الإجباري.
وفي هذه الدائرة المفرغة، يصبح الاختلاف جريمة مزدوجة: فمن يشكك في أدعياء الدين يُرمى بالزندقة والخروج عن الجماعة، ومن يتساءل عن أدعياء الوطنية يُتهم بتقويض أسس المجتمع وتمزيق النسيج الوطني، لكن المفارقة المُرة أن كلا الفريقين يتشاركان في العبادة الحقيقية نفسها: عبادة السلطة بكل ما تحمله من امتيازات وموارد، بينما تتحول الشعارات المرفوعة إلى مجرد غطاء لممارسة الهيمنة وإعادة إنتاج التبعية.
والأخطر أن هذه الأوثان الأيديولوجية، رغم ضجيجها وخطابها الاستقطابي، تبقى في النهاية أدوات طيعة في يد القوى الكبرى، تتبارى في تنفيذ أجنداتها، وتتسابق على إرضاء سادتها الجدد، وتقدم الولاء المطلق على أنه خيار استراتيجي، والتبعية على أنها ضرورة واقعية، وهكذا تتحول السياسة من فضاء للتحرر والبناء إلى سوق للمزايدات الفارغة، حيث يتبارى الجميع في بيع الأوهام وشراء الشرعيات الزائفة.
وبالنظر في عمليات الاستلاب الديني، حيث تشريح آليات التوظيف السياسي للخطاب المقدس، يعتمد المتصارع باسم الدين على آلية التقديس التي تحول آراءه السياسية إلى مسلمات دينية، وأفعاله إلى فرائض إلهية - كما تشير كثير من التحليلات - فإن بعض الجماعات الإسلامية "لا يتقنون إلا جريمة واحدة" هي "حشد العامة والرعاع، وتهييج السفلة الدهماء، فهذا سلاحهم القذر، ومنتهى وزرهم الآثم"، وتتحول هذه الآلية إلى وسيلة لهدم الآخرين وطمس هوية الآدميين من خلال "إشاعات كاذبة، وأباطيل مزينة".
ويتأسس المشروع السياسي للمتصارع باسم الدين على عملية استلاب منهجية للمقدس، حيث يجري تحويل المجال الديني من فضاء للقيم الروحية والأخلاقية إلى أداة للهيمنة السياسية، تعمل هذه الآلية عبر تسييل الرمز الديني وتحويله إلى عملة سياسية قابلة للتداول، فيتحول الخطاب الديني من كونه وسيلة للتقرب إلى الله إلى أداة للاقتراب من السلطة، وتعتمد هذه المنظومة على استراتيجيات متعددة المستويات، أبرزها التأويل الانتهازي للنصوص الدينية، حيث يتم انتقاء النصوص وتفسيرها بشكل انتقائي يخدم الأجندة السياسية، مع تغييب السياق التاريخي والروح الكلية للشريعة، كما تعتمد على تديين السياسي وتسييس الديني في حركة دائبة تخلط الأوراق وتلبس الحق بالباطل.
وفي إطار هذه الآلية، يتم توظيف العواطف الجمعية عبر خطاب إثاري يحرك المشاعر دون العقول، مستغلاً التعلق الفطري بالمقدس لدى العامة، وهنا تتحول الساحة السياسية إلى ما يشبه الساحة الدعوية، حيث يصبح السياسي واعظاً، والجمهور مأموراً بالطاعة دون نقاش. أما الآلية الأكثر خطورة فهي صناعة العدو المشترك الذي يتم تقديمه في صورة "الخارج عن الدين" أو "المنافق" أو "العميل"، مما يخلق حالة من القلق الوجودي تبرر تعليق الحريات وتجاوز الحقوق تحت شعار "الضرورات تبيح المحظورات"، وهكذا يتحول الخطاب الديني من كونه رسالة تحرر روحي وإصلاح أخلاقي إلى أداة قمع وتجهيل، حيث تُقدَّم الأجوبة الجاهزة على الأسئلة المصيرية، وتُجمَد العقول أمام حقائق يُمنع مساءلتها، ويُختزل الدين في طقوس سياسية تكرس الاستبداد وتُقدِّسه..
وبتشريح آليات تحويل الوطن إلى أداة هيمنة، فيعمل المتصارع باسم الوطن على تأليه الوطن وتحويله إلى صنم جديد، حيث تصبح الوطنية "وثن العصر"، وهذا الخطاب يعمل على تفتيت الأمة وتجزئتها من خلال "جعل الوطنية وثن العصر، ومن ثمة تفرقة الأمة"، ويتم توظيف آليات مثل "مباريات كرة القدم بالتعصب لفرقة ما" لخلق ولاءات مصطنعة تخدم النظام الحاكم.
ويصنع المتصارع باسم الوطن من مفهوم الوطنية صنماً حديثاً، لا يقل خطورة عن الأصنام القديمة، حيث يتحول الوطن من فضاء للعيش المشترك إلى أداة لإقصاء المختلف وتبرير الهيمنة، وتبدأ هذه العملية بتحويل الوطن من قيمة إنسانية جامعة إلى أيديولوجيا مغلقة، تختزل مفهوم الوطن في النظام الحاكم، وتجعل من انتقاد السلطة خيانة للوطن نفسه.
وتعتمد هذه الآلية على تقديس الرموز الوطنية، فهي تجسيد للهوية والقيم المشتركة، حيث يتحول العلم والنشيد والتاريخ والشعارات إلى مقدسات غير قابلة للمساءلة، ويُحتكر تمثيل الوطن من قبل فئة سياسية معينة وأي انتقاد لها هو مساس بمقدسات الوطن، بينما يفرغ مضمون الوطن من أي دلالة إنسانية حقيقية، وهكذا تتحول الوطنية من ممارسة حية إلى طقوس جوفاء تكرس الخضوع وتقدس الامتثال.
وتعمل هذه المنظومة على تجزئة الهوية الجامعة عبر خلق ولاءات مصطنعة تتصارع في الساحة الاجتماعية، فتصبح الولاءات الرياضية والمناطقية والطائفية بدائل مزيفة عن المشاركة السياسية الحقيقية، كما يتم توظيف آليات التضخيم الإعلامي للخلافات الفرعية وتضئيل القضايا المصيرية، فيتحول النقاش العام من جدال حول العدالة والتوزيع العادل للثروة إلى سجالات هامشية تستهلك الطاقة المجتمعية دون طائل.
وتصل الذروة في عملية تسليع الوطن، حيث يتحول من مفهوم مجرد إلى سلعة يتم تسويقها عبر خطاب عاطفي يستهدف استثمار المشاعر الجمعية لصالح النخبة الحاكمة، وهكذا تتحول الوطنية من فضيلة أخلاقية إلى أداة قمع رمزي، تنتج مواطناً مستهلكاً لمنتجات الخطاب الرسمي، بدلاً من مواطن فاعل يشارك في صنع القرار، وهذه الآلية التضليلية تخلق ما يمكن تسميته "الوطن-السلعة" الذي يُباع ويُشترى في سوق الخطابات السياسية، بينما يتحول المواطنون من أصحاب حق في الوطن إلى مجرد جمهور متفرج على مسرحية السلطة.
وتشترك الأنساق الخطابية لكل من المتصارعين (باسم الدين وباسم الوطن) في اعتمادها على بنية مهيمنة واحدة، تتبدى في جملة من الآليات المتقاطعة التي تعمل في تناغم عضوي لضمان استمرارية النفوذ والسيطرة بأربع آليات تشكل نظاماً دائرياً مغلقاً؛ أولها، هندسة الوجود عبر عداء مصطنع، حيث تعمل كل منظومة على استنبات عدو وجودي يهدد الكيان من الداخل مثل المفكرين المستقلين، والأصوات الناقدة، ومن الخارج مثل القوى الدولية، وادعاءات المؤامرات الخارجية، ليتم تحويل الصراع السياسي من مجابهة أفكار إلى مواجهة وجودية تبرر استخدام كافة الوسائل.
وثانيا، احتكار حقل الشرعية عبر آليات الاستبعاد، فتسعى كل منظومة إلى تأبيد احتكارها لتمثيل الحقيقة المطلقة، سواء عبر ادعاء الانفراد بتفسير الدين أو احتكار تعريف الوطنية، مما يسمح بإقصاء أي صوت مخالف تحت ذريعة الخروج عن "الثوابت" أو "المقدسات"، وثالثاً، اقتصاد العواطف وإدارة الغرائز، فتتحول المنصات الإعلامية إلى مختبرات لتوجيه المشاعر الجمعية، حيث يتم استبدال الحجج العقلانية برموز عاطفية ومخاوف غريزية، في عملية تحويل الجمهور من فاعل نقدي إلى كتلة انفعالية سهلة التوجيه.
رابعاً وأخيراً، تأطير الاختلاف ضمن تصنيفات قاتلة، حيث يتم توظيف آلة تصنيفية ثنائية حادة (مؤمن/كافر، موالي/خائن) لتحييد أي معارضة، حيث يتحول النقاش من حوار حول السياسات إلى محاكمة للنيات والولاءات، في عملية إبادة رمزية للمختلف، وهذه الآليات الأربع تشكل نظاماً دائرياً مغلقاً، بمعنى أنها تغذي كل منها الآخر، مكونة ما يشبه "الحلقة المفرغة للهيمنة" التي تنتج طواعية سياسية مزيفة، وتقضي على أي إمكانية لحوار مجتمعي حقيقي..
ورغم التباين الظاهري في الشعارات والخطابات، تظهر البنى الوظيفية للنظامين متشابهة إلى حد مذهل، وكأن الاختلاف في الأغطية الأيديولوجية لا يمس الجوهر الآلي المشترك، فتحت قشرة الخطاب الديني والوطني، تعمل آليات متطابقة في الهيكل والوظيفة، مما يكشف أن الهدف النهائي ليس خدمة الدين أو الوطن، بل تكريس الهيمنة وإعادة إنتاج السلطة.
فيؤسس النظام الثيوقراطي (الحكم الديني) هيمنته على استلاب المقدس الديني وتحويله إلى رأس مال رمزي تُدار به الشؤون الدنيوية، فتتحول المؤسسة الدينية من حارسة للقيم إلى هيكل سلطوي ينتج الاستبداد في ثوب القداسة، حيث يُختزل الخطاب الديني في خدمة الأغراض السياسية، ويُوظف التراث الفقهي كأداة لترسيخ الامتيازات.
وتعتمد هذه المنظومة على احتكار الوساطة بين المطلق والنسبي، فتصبح المؤسسة الدينية هي الممثل الحصري للإرادة الإلهية، والوسيط الوحيد بين البشر والسماء، وهذا الاحتكار ينتج نظاماً أبوكاليبسياً (عالِم ببواطن الأمور) يقدس النصوص ويحرم القراءات التاريخية، ويحول الدين من مجال للتدبر والتفكر إلى نصوص مغلقة تقبل قراءة واحدة فقط. وتعمل الآلية عبر إنتاج خطاب تكفيري يختزل الأمة في جماعة واحدة، ويُخرج المختلف مذهبياً أو فكرياً من دائرة الإسلام، وهذا الخطاب يخلق استقطاباً وجودياً يحول السياسة من "إدارة للاختلاف" إلى معركة بين "الإيمان والكفر"، حيث تُلغى المساحات الرمادية ويُقام عالم من الثنائيات الحادة.
كما تنتج هذه المنظومة أخلاقيات الخضوع التي تحول العباد من كائنات مفكرة إلى قطيع طائع، حيث يُمنع الاجتهاد ويُحجر على العقول، وتُقدم الأجوبة الجاهزة على الأسئلة المصيرية، وهكذا يتحول الدين من رسالة تحرر إلى أداة قمع، ومن مشروع إنساني إلى سجن أيديولوجي مغلق.. بينما آليات الهيمنة في نظام "الوطنية الكاذبة" (Pseudo-Nationalism)؛ فتبني سلطتها على توطين الاستبداد عبر تحويل مفهوم الوطن من فضاء للعيش المشترك إلى أيديولوجيا مغلقة تخدم النخبة الحاكمة، فتُختزل فكرة الوطن في النظام القائم، ويُختطف الحس الوطني ليكون مجرد أداة طيعة في يد السلطة، فيما يشبه عملية اختطاف رمزي للجماعة السياسية بأكملها.
وتعتمد هذه الآلية على تأميم الاختلاف عبر تسويق نموذج موحد للهوية، يُلغى فيه التنوع الثقافي والديني لصالح خطاب قومي متصلب، ويتحول الوطن هنا من حاضن للتنوع إلى آلة طحن تسوى فيها الفروقات تحت شعار الوحدة الوطنية، فيما يشبه عملية قتل رمزي للهويات الفرعية التي تشكل نسيج المجتمع الأصيل. وتعمل المنظومة عبر تسييد النخبة وتحويلها إلى طبقة متروبولية (طبقة حضرية مركزية) تحتكر تمثيل الوطن وتوزيع صكوك الوطنية، ويتحول الفساد هنا من مجرد انحراف أخلاقي إلى آلية حكم تضمن توزيع الثروة والامتيازات داخل الدائرة الضيقة الموالية، فيما يشبه نظام الريع السياسي المُؤسَس.
والأخطر أن هذه المنظومة تنتج مواطناً مستهلكاً للخطاب الوطني بدلاً من مواطن فاعل في صنعه، وتتحول الوطنية من ممارسة نقدية إلى طقوس استهلاكية تتبارى فيها الأصوات في مزايدات خطابية فارغة، بينما تظهر المواطنة الحقيقية كعدو يجب تهميشه، وهذه الآليات الثلاث - توطين الاستبداد، تأميم الاختلاف، وتسييد النخبة - تشكل معاً دائرة مغلقة تنتج نظاماً سياسياً يقوم على احتكار الوطن بدلاً من خدمته، ويحول المواطن من شريك في الوطن إلى مجرد رهين في سجن وطني كبير..
ووراء تناقض الشعارات والخطابات، تكشف البنى العميقة لكل من النظامين عن توافق بنيوي وتماثل جوهري في البنى والممارسات، يشي بأن الاختلافات السطحية ليست سوى أقنعة تخفي حقيقة وظيفية واحدة، ففي العمق، يعمل كلا النظامين كآلتين متطابقتين في إنتاج الهيمنة وإعادة إنتاج التبعية، وهذا التوافق يتمثل في الآتي:
الأول: آلة طحن التعددية، فتعمل كل منظومة على تسويق نموذج أحادي للوجود، يرفض أي شكل من أشكال التعددية السياسية أو الثقافية، فتحت شعار "الوحدة الوطنية" أو "الجماعة الإسلامية"، يتم تسطيح الاختلافات وتنميط المجتمع في قالب واحد، فيما يشبه عملية إبادة رمزية للتنوع الإنساني، ويتحول الفضاء العام من ساحة للحوار إلى مسرح للعرض الأيديولوجي الأحادي.
الثاني: اقتصاد التقديس الرمزي، فتمتلك كل منظومة آليات متشابهة لتحويل النظام الحاكم إلى كيان متعالٍ، فبين "الحاكمية الإلهية" و"المصلحة الوطنية العليا"، تُنتج آليات متطابقة لـتأليه السلطة وتحويلها من كائن تاريخي قابل للنقد إلى مقدس معصوم، وهذا التقديس لا يختلف سواء كان باسم الدين أو الوطن، فكلاهما ينتج طاعة عمياء ويحول السياسة من مجال للصراع الصحي إلى دائرة للتبجيل القسري.
الثالث: هندسة التبعية الخلاقة، حيث تكشف الممارسات الفعلية عن تناغم مذهل في علاقة كل نظام بالقوى الدولية، فوراء الخطابات الوطنية أو الدينية المتشددة، تعمل كل منظومة كوسيط فعال في تنفيذ متطلبات الهيمنة العالمية، وهذه التبعية المُؤسَسَة لا تعني الخضوع المباشر، بل التحول إلى شريك في إدارة التبعية، حيث تُستخدم الخطابات المحلية لتسهيل تنفيذ الأجندات الدولية.
وهذا التشابه البنيوي ليس صدفة، بل هو نتاج حتمي لمنطق السلطة نفسه عندما تتحول من أداة لخدمة المجتمع إلى غاية في ذاتها، فالاستبداد مهما اختلفت أقمشته، ينتج أنماطاً متشابهة من الممارسات والهياكل، كاشفاً أن جوهر الهيمنة واحد وإن تعددت تبريراته..
ومن المنظور الجيوبوليتيكي، حيث تشريح آليات الاستخدام في النظام العالمي، فوجهة نظر القوى العظمى، تتمثل في أن كلا النظامين أدوات هيمنة يمكن توظيفها لخدمة المصالح الدولية، فكما يشير تحليل واقع حقوق الإنسان في ظل النظام العالمي الجديد (ما بين الإسلام وإعلان حقوق الإنسان - جامعة أم القرى - د. عبد الحفيظ محبوب)، فإن "ملف حقوق الإنسان" يستخدم كسلاح ضغط ضد دول معينة، وتعمل القوى العظمى على استغلال كلا النظامين لتحقيق مصالحها، سواء كان ذلك تحت شعار "محاربة الإرهاب" مع الأنظمة الدينية، أو "تعزيز الديمقراطية" مع الأنظمة الوطنية.
ومن زاوية الرؤية الجيوستراتيجية للقوى الكبرى، يقدم النظامان - الديني والوطني - نفسيهما كوجهين لعملة واحدة في معادلة الهيمنة العالمية، فكلا المنظومتين هما أدوات فعالة قابلة للتوجيه والتوظيف ضمن الاستراتيجيات الدولية، حيث تتحول الخلافات الأيديولوجية بينهما إلى مجرد فروق تكتيكية في إدارة النفوذ.
وتعتمد القوى العظمى في تعاملها مع كلا النظامين على استراتيجية التوأمة الوظيفية، حيث يتم توظيف التناقض الظاهري بين الخطابين لخدمة مصالح مترابطة، فالنظام الديني يصبح مفيداً في حروب "إدارة الفوضى" وخلق بؤر التوتر الإقليمي، بينما يلعب النظام الوطني دوراً في سياسات "الاحتواء الناعم" وضمان استقرار الأسواق وموارد الطاقة.
وتتجلى براعة الآلية في كيفية تحويل المتناقضات المحلية إلى تكاملات دولية، فالصراع بين الخطاب الديني والوطني، رغم سخونته المحلية، يتحول على المسرح الدولي إلى عنصر داعم لاستمرارية الهيمنة، والنظام الديني ينتج "العدو الإرهابي" الذي يبرر التدخلات، والوطني ينتج "الحليف المعتدل" الذي يضفي شرعية على هذه التدخلات.
والأكثر إثارة أن كلا النظامين يشاركان في إعادة إنتاج ثقافة التبعية عبر آليات داخلية، فبينما يشتغل النظام الديني على إنتاج "العدو الخارجي" لتبرير إخفاقاته الداخلية، يعمل النظام الوطني على تسويق "نظرية المؤامرة" لتعطيل المحاسبة الذاتية، وكلاهما يخدم في النهاية إبقاء المنطقة في حالة من الاستقرار القلق الذي يضمن تدفق الثروات نحو المراكز الرأسمالية.
وهذه الرؤية التكاملية من قبل القوى الكبرى تكشف أن التعامل مع النظامين ليس انحيازاً لأحدهما ضد الآخر، بل هو إدارة لصراع محكوم تدرك فيه أن كلا الطرفين يشكلان معاً نظاماً واحداُ للتبعية المتبادلة، حيث يغذي كل منهما وجود الآخر ويبرر استمراريته في دائرة مفرغة من الصراع المدبر. ويكمن التمايز من منظور القوى العظمى بين النظامين في آليات التوظيف، حيث يتضح من تشريح الاستراتيجيات الدولية تجاه النموذجين، أن وراء الوحدة الوظيفية للنظامين في خدمة الهيمنة الدولية، تبرز تمايزات تكتيكية عميقة في تعامل القوى الكبرى مع كل منهما، تعكس مرونة الآلة الإمبريالية في تكييف أدواتها مع مختلف السياقات مثل:
سياق الاستثمار التفاضلي في رأسمال الشرعية؛ حيث تتعامل المنظومة الدولية مع الخطاب الوطني باعتباره عملة شرعية سائلة يسهل تداولها في الأسواق السياسية العالمية، بينما تتعامل مع الخطاب الديني كـعملة مشبوهة تحتاج إلى "غسيل سياسي" قبل تداولها، وهذا التفاوت ليس ناتجاً عن جوهر الخطابين، بل عن قدرة الخطاب الوطني على الاندماج في السرديات الليبرالية السائدة، بينما يظل الخطاب الديني عنصراً طارئاً في الحفلة الليبرالية.
وكذلك سياق الابتزاز الانتقائي عبر أدوات الضغط؛ حيث تتقن القوى الكبرى فن الضغط التفاضلي (ازدواجية المعايير)، فتُدير ملف حقوق الإنسان كسلاح أخلاقي موجّه في المقام الأول نحو الأنظمة الدينية، بينما تحوِّل الملف الاقتصادي إلى أداة عقابية ضد الأنظمة الوطنية، وهذه الآلية تعكس ازدواجية مقصودة في المعايير، حيث تتحول المبادئ الإنسانية إلى بضاعة سياسية تُستخدم انتقائياً، فتغُض الطرف عن انتهاكات الحليف الوطني تحت ذريعة "الاستقرار"، بينما تُضخّم هفوات الخصم الديني تحت شعار "الحقوق".
وفي سياق الدمج والإقصاء في حظيرة العولمة؛ حيث تعمل العولمة هنا كـمنخُل سياسي يفرز الأنظمة وفقاً لقابليتها للاندماج في الاقتصاد العالمي، فتُدمج الأنظمة الوطنية في شبكات التبعية المربحة، بينما تُهمش الأنظمة الدينية أو تُحتوى في أدوار ثانوية، وهذه الآلية تنتج تقسيم عمل جيوبوليتيكي يكرس تبعية النموذج الوطني في المجال الاقتصادي، ويحصر النموذج الديني في أدوار أمنية واستخباراتية.
وهذه التمايزات لا تنفي الوحدة الجوهرية بين النظامين، بل تكشف عن براعة النظام العالمي في إدارة التنوع الاستبدادي، حيث يصبح الاختلاف بين النموذجين مجرد تخصص في تقسيم العمل الإمبريالي، يشبه فريق عمل واحد يتقن كل فرد فيه أداء دور مختلف، بينما تبقى الغاية النهائية واحدة: إعادة تجميع وإنتاج الهيمنة.
ولكي نبدأ في إيجاد الحل يلزمنا فك الاشتباك بين الدين والوطن، من خلال كسر الثنائية الزائفة بينهما، والبحث عن صيغة تكاملية بدلاً من صيغة صراعية، فلماذا الإصرار على وضع التمسك بالدين وبقاء الوطن في موضع التضاد؟ كأننا نشير إلى حتمية فقدان الوطن حال التمسك بالدين!! وهذا يتطلب إعادة تعريف العلاقة بين الدين والوطن على أساس مفاهيمي أعمق من خلال أن "الأرض لله والسموات وما فيهن والأرض وما عليها وما فيها لله، فكيف يقدم المملوك على المالك؟"
وتتمثل المعضلة الجوهرية في إشكالية الصراع بين الخطابين في اختطاف كل منهما لحقل دلالي يبدو متناقضاً، بينما هو في العمق متكامل، فالثنائية الزائفة التي تقدم الدين والوطن كخصمين في معادلة صفرية تستدعي تفكيكاً ابستمولوجياً يجرد كلاً المفهومين من حمولته الإقصائية. إن عملية الفك هذه تبدأ بإعادة تعريف العلاقة بين المقدس والأرضي، بين الانتماء الروحي والهوية الأرضية، فالدين - في جوهره - ليس منافساً للوطن على الولاء، بل هو مصدر إشعاع قيمي يضفي على مفهوم الوطن بعداً أخلاقياً وأفقاً تعبدياً، والوطن ليس بديلاً عن الدين، بل هو فضاء مادي لممارسة القيم الدينية في أرض الواقع.
وهنا تكمن المفارقة العميقة؛ فبدلاً من أن يكون الدين والوطن شريكين في بناء الإنسان، تحولا في الخطاب السياسي إلى خصمين متعارضين، وكأن الإيمان يتناقض مع الانتماء، أو كما لو أن حب الوطن يناقض حب الله، وهذا التشويه المقصود يخدم في النهاية استمرارية أنظمة الهيمنة التي تزدهر في مناخات الانقسام.
والحل الجذري يكمن في انتشال المفهومين من ساحة الصراع الأيديولوجي وإعادتهما إلى حقيقتهما الوجودية، فالدين يظل المنظومة القيمية الشاملة، والوطن يبقى الإطار الجغرافي والتاريخي لممارسة هذه القيم، والعلاقة بينهما هي علاقة الكلي بالجزئي، وعلاقة المطلق بالنسبي، حيث يقدم الدين المبادئ الكلية، ويوفر الوطن السياق التطبيقي، وهذه الرؤية التكاملية تنتج مواطناً متصالحاً مع هويته المركبة، قادراً على حمل قيمه الدينية دون تناقض مع انتمائه الوطني، والعكس صحيح، وهي تخلق مساحة للعيش المشترك تتيح للمقدس أن يظل مقدساً، وللأرضي أن يبقى أرضياً، دون أن يطغى أحدهما على الآخر أو يلغيه.
وتتجاوز ضرورة صياغة مشروع حضاري بديل مجرد الرد المقابل للنموذج الغربي، إلى تأسيس رؤية وجودية متكاملة تستعيد فيها الأمة دورها الحضاري من خلال استنطاق تراثها الروحي والفكري، وهذا المشروع لا يهدف إلى محاكاة النموذج الغربي أو مناهضته، بل إلى إنتاج كينونة حضارية مستقلة تنبع من الخصوصية الثقافية والروحية للأمة. ويعتمد هذا التأسيس على تفعيل العقل النقدي ضمن الإطار القيمي الإسلامي، حيث يصبح الاجتهاد ليس مجرد استنباط فقهي، بل منهج حياة يشمل جميع المجالات، فالإسلام هنا ليس مجرد شعائر تعبدية، بل نظام قيمي شامل يقدم رؤية متكاملة للإنسان والمجتمع والكون.
ويكمن التحدي الحقيقي في تحرير الموروث الديني من القراءات الأحادية والمصادرة السياسية، وإعادة اكتشاف الإسلام كـمنظومة قيم ديناميكية قادرة على استيعاب متغيرات العصر دون التفريط في ثوابتها، وهذا يتطلب قطيعة ابستمولوجية مع خطاب التقديس الانتقائي الذي حوَّل الدين إلى أيديولوجيا مغلقة. والمنهجية الأمثل تقوم على التركيب الخلاق بين الأصالة والمعاصرة، حيث لا يكون التمسك بالتراث انغلاقاً على الماضي، ولا تكون المعاصرة انسلاخاً عن الهوية، وهذا التركيب ينتج توازناً وجودياً يجمع بين روح الدين وضرورات العصر، بين الثوابت القيمية والمتغيرات الزمنية.
والأبعاد العملية لهذا المشروع في متناول التعليم والإعلام والثقافة، بإعادة بناء الإنسان كغاية قبل الوسيلة، وتأسيس عقد اجتماعي يجمع بين العدالة والحرية، وصياغة نموذج تنموي متوازن يجمع بين الروحي والمادي، وبناء خطاب ثقافي يجدد اللغة والمفاهيم دون قطيعة مع الجوهر، هذا المشروع ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة وجودية مُلحة للأمة التي تبحث عن موقعها تحت الشمس، بعيداً عن استلاب التبعية أو انغلاق الهوية، إنه محاولة لاستعادة الدور الحضاري من خلال الاستفادة من الماضي لبناء المستقبل، دون أن نكون أسرى لأي منهما..
وتمثل الأنسنة كمنهج تحرري وأفق للتعايش الآمن، نقلة نوعية من حقل الصراع الأيديولوجي إلى فضاء التفكير النقدي الحر، حيث تتحول من مجرد مفهوم فلسفي إلى منهجية تفكيكية تعيد قراءة التراث والخطابات السياسية بعيداً عن قدسية النصوص أو حصانة الأيديولوجيات، وهذا المنهج لا يهدف إلى إلغاء الدين أو الوطن، بل إلى تفكيك آليات استغلالهما سياسياً على الأسس التالية:
• تفكيك المركزيات المتعالية: يعمل على تجاوز كل أشكال التمركز حول الذات، سواء أكانت دينية أم وطنية، وكشف كيف تتحول هذه المركزيات إلى أدوات لإنتاج التطرف والاستبعاد، فهو يرفض احتكار الحقيقة سواء باسم السماء أو باسم الأرض.
• النسبية الفكرية المنتجة: لا تعني النسبية هنا الانحلال القيمي، بل اعتبارية المعرفة وإدراك أن كل قراءة للدين أو الوطن هي محكومة بسياقها التاريخي والاجتماعي، وهذا الإدراك يفتح الباب لتعددية القراءات والتعايش بينها.
• تشريح خطابات الهيمنة: يقدم أدوات لـتفكيك الخطاب المهيمن سواء كان دينياً أو وطنياً، من خلال تحليل شبكة المصالح والعلاقات والقوى التي تنتجه وتدعمه وتعيد إنتاجه.
وتعتمد الأنسنة على قراءة تاريخية نقدية تكشف كيف تم اختطاف المفاهيم الدينية والوطنية وتحويلها إلى أدوات هيمنة، كما تقوم على إعادة الاعتبار للبعد الإنساني المشترك الذي يتجاوز الانتماءات الضيقة، مع تفعيل العقل النقدي كأداة لمساءلة كل الخطابات دون استثناء، كما تتجلى الأنسنة أيضاً في إنتاج خطاب وسطي يرفض التناقض المصطنع بين الديني والوطني، ويؤسس لـمواطنة متصالحة مع هوياتها المتعددة، كما تظهر في خلق فضاء عمومي تداولي يتسع للاختلاف ويحترم التعدد.
وهذا المنهج لا يمثل حلماً طوباوياً، بل هو ضرورة منهجية للخروج من الصراعات المستعصية التي تنتجها الخطابات المغلقة، إنه يشكل أرضية مشتركة للتفكير في مستقبل تتعايش فيه الهويات دون صراع، وتتقاطع فيه الانتماءات دون تناقض..
الخاتمة:
في المحصلة النهائية، نحو فضاء وجودي متجاوز للثنائيات المستحيلة، يمثل الصراع بين أدعياء الدين وأدعياء الوطن مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الصراعات الوهمية التي تنتجها آلة الهيمنة العالمية، فهذا الصراع ليس تعبيراً عن تناقض حقيقي بين المقدس والدنيوي، بل هو إفراز لأزمة مشروع تحرري حقيقي قادر على استيعاب كلا البعدين في رؤية متكاملة.
والحقيقة الجوهرية التي تغيب عن طرفي الصراع هي أن الدين - في جوهره - ليس منافساً للوطن، والوطن - في أصله - ليس نِداً للدين، كلاهما مكون أساسي في الهوية الإنسانية، وكلاهما يخدم الآخر عندما يُفهم في سياقه الصحيح، فالدين يظل المصدر القيمي الذي يمنح الحياة معناها، والوطن يبقى الإطار الحاضن لممارسة هذه القيم.
والمخرج الحقيقي لا يكمن في انتصار أحد الطرفين على الآخر، بل في تفكيك آلية الصراع بينهما، وهذا يتطلب نقلة نوعية من ثقافة القبيلة الأيديولوجية إلى فضاء المواطنة المتصالحة، حيث يتسع المجال العام للاختلاف، وتتعايش الهويات المتعددة دون صراع.
والرؤية البديلة تقوم على إنسانوية متصالحة تجمع بين روح الدين وضرورات العصر، بين انتماء الوطن وكونية القيم، إنها رؤية ترفض أن تكون أسيرة الثنائيات الزائفة، وتؤمن بأن المستقبل لا يبنى باختيار بين الدين والوطن، بل بتجاوز التناقض المصطنع بينهما.
وهكذا، فإن الخلاص من الاستبداد المزدوج لا يتحقق بانتصار خطاب على آخر، بل بانهيار نظام الثنائيات نفسه، وبروز وعي جديد قادر على استيعاب التعقيد دون اختزاله، واحتضان التنوع دون خوف منه، وهذا الوعي هو المدخل الحقيقي لمشروع حضاري يليق بالإنسان، مشروع يجمع ولا يفرق، يحرر ولا يستعبد، يبني ولا يهدم..
----------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش