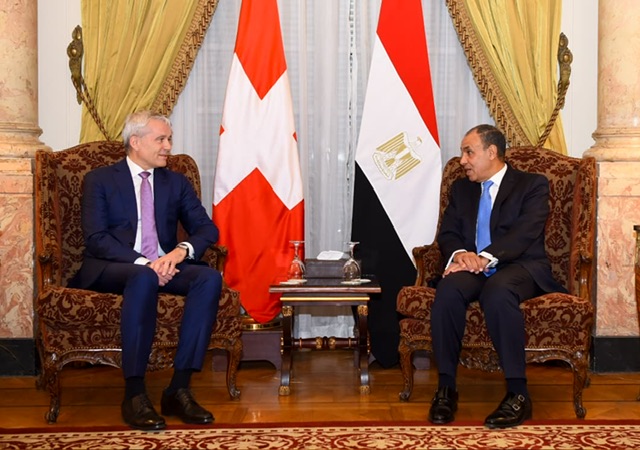من يعمل بين الناس ويحتك بالشارع الحقيقي يدرك أن ما يسمى بـ“الاستحقاق الانتخابي” لم يعد مجرد حدث سياسي عابر، بل تحول إلى اختبار حقيقي لميزان العدالة الاجتماعية ومدى حضور الطبقات المنتجة داخل الدولة. وعندما يتغير هذا الميزان، وتصبح الكفة منحازة بشكل فجّ لمن يملك المال والقدرة على النفوذ، يصبح الحديث عن انتخابات بلا مضمون، وعن ديمقراطية بلا صوت شعبي حقيقي، مهما حاولت الشعارات أن توهمنا بغير ذلك.
لقد صارت ظاهرة المال السياسي واقعًا لا يمكن التخفيف من حدته. ولم يعد المواطن يتوقف متسائلًا: من أين يأتي هذا الإنفاق الكبير؟ ولا كيف تحولت بعض الحملات الانتخابية إلى ما يشبه الشركات المتحركة؟ أصبح الناس يعرفون جيدًا أن اللعبة السياسية لم تعد لعبة البرامج، بل لعبة ميزانيات وظهور إعلامي مدفوع، وشبكات مصالح تتحرك وتتحكم وتفرض حضورها دون أدنى علاقة بقدرات المرشح أو كفاءته.
المشهد أصبح واضحًا: المال هو الذي يحدد حجم المرشح في الشارع، ومساحة وجوده في الدائرة، وقدرته على الوصول للناس، وسطوة صوته في الإعلام، بل وحتى فرصه في الظهور باعتباره "الأقوى". وهكذا يُنتزع الحضور الطبيعي من العامل والفلاح والموظف البسيط وأصحاب الخبرة الحقيقية، ويُمنح لمن كان الأوفر قدرة على الصرف، لا الأكثر قدرة على الخدمة.
ولا يمكن أن نتحدث بصدق عن الانتخابات دون أن نقول إن العامل والفلاح قد تحوّلا إلى “ديكور انتخابي” في كثير من الأحيان. فمن المفترض أن يكون هؤلاء هم قلب البرلمان، لكنهم للأسف أصبحوا خارج المشهد الفعلي، وإن وُضع لهم مقعد هنا أو هناك فهو لا يشكل حضورًا مؤثرًا ولا يعكس وزنهم الحقيقي في الشارع أو في الإنتاج أو في الاقتصاد الوطني. لقد سقطت قيمة الوجود النيابي للطبقات المنتجة تحت وطأة التدخلات المالية، وغاب الصوت الذي يحمل الهمّ الشعبي ويعرف قيمة الجنيه وقيمة العرق.
ولنكن صريحين: العامل الذي يعمل 12 ساعة يوميًا تحت ظروف إنتاج ضاغطة، والفلاح الذي يخوض معركة يومية مع الغلاء والبذور والأسمدة والمياه، لا يستطيعان الدخول في منافسة انتخابية مع أشخاص يمتلكون ميزانيات كافية لإغراق الدائرة بلافتات، ولتنظيم مؤتمرات يومية، ولشراء مساحات كاملة من المشهد الاجتماعي. هكذا تُسحق الكفاءات الحقيقية تحت طبقات من النفوذ والمال.
إن أخطر ما يصنعه المال السياسي ليس شراء الأصوات فقط – وهذه ممارسة يعرف الشارع كله أنها موجودة بأشكال متعددة – بل أخطر ما فيه أنه يخلق “خيالًا سياسيًا” يُقنع الناس بأن الفائز هو الأقوى والأكثر قبولًا. وفي الحقيقة، كثير ممن يفوزون لا يفوزون بقوة فكرهم أو بعمق برامجهم، بل لأنهم استطاعوا بناء شبكة مصالح تغطي على غياب الدور الحقيقي. وهكذا يتشكل وهم سياسي يعيد إنتاج نفسه، ويُقصي كل صوت مختلف أو مستقل أو منحاز للطبقات البسيطة.
في ظل هذا الواقع، أصبحت الانتخابات بالنسبة للعامل والفلاح مجرد مناسبة يسمعون فيها وعودًا كبيرة قبل الاقتراع، ثم يختفون أصحاب الوعود بعد إعلان النتائج. إن ما يؤلم حقًا هو أن صوت الطبقة العاملة أصبح صوتًا ضعيفًا داخل البرلمان، بينما في الحقيقة هو الصوت الذي يحمل همّ الإنتاج، والعمالة، والأجور، والصحة المهنية، والتأمينات، وتشغيل المصانع المتعثرة، وحماية الصناعات الوطنية. غياب هذا الصوت هو غياب للضمير التشريعي للدولة.
وفي الوقت نفسه، لا أحد يستطيع تجاهل ما يشعر به المواطن اليوم من فقدان الثقة. حين يرى المرشح الذي لا يسمع به أحد طوال سنوات يظهر فجأة موسم الانتخابات محاطًا بأطنان من الدعاية، وحين يشعر بأن المعركة محسومة بالقدرة على الصرف لا بالإرادة الشعبية، فإنه يفقد الإحساس بأن صوته مهم. وهنا تكمن الأزمة الأخطر: أزمة الإيمان بالتمثيل ذاته. لا توجد دولة قوية حين يشعر المواطن أن صندوق الانتخابات لا يعكس إرادته بل يعكس قدرات آخرين.
ورغم كل هذا السوء، فإن الحقيقة التي يعرفها كل من مارس العمل العام بضمير هي أن المجتمع لا يستقر ولا يبنى من أعلى، بل يبنى من أسفل… من المصنع، من الورشة، من الأرض، من العزبة والنجع والحي الشعبي. إن استبعاد صوت هؤلاء من البرلمان ليس فقط ظلمًا لهم، بل هو خلل في بنية الدولة ذاتها، لأن البرلمان الذي لا يمثل أوسع فئات شعبه يتحول إلى مؤسسة صوت واحد، ومصالح واحدة، واتجاه واحد، ووجهة واحدة.
إن إعادة العمال والفلاحين إلى مقاعدهم ليست منّة من أحد، بل هي تصحيح لمسار اختلّ طويلًا. يجب أن تُفتح الساحة للجميع بلا تمييز مالي، وأن يُعاد الاعتبار للخبرة الاجتماعية، وللتجربة النقابية، وللتاريخ الحقيقي على الأرض. فالعمال والنقابيون هم الأكثر قدرة على فهم قوانين العمل، والأجور، وحماية الصناعات، والفلاحون هم الأكثر قدرة على فهم سياسات الزراعة والري والدعم والأسعار. غيابهم عن البرلمان فراغ لا يملؤه مال ولا نفوذ مهما اتسع.
أما الحل الحقيقي فيبدأ حين ندرك أن الانتخابات ليست مجرد صراع على مقعد، بل صراع على شكل الدولة. الدولة التي يحكمها من يخدمها، لا من يشتري حق الحضور فيها. الدولة التي تعطي فرصة متساوية للجميع، لا التي تترك الساحة لمن يستطيع أن يعلو بالمال على حساب من تعلو قيمتهم بالخبرة والعرق.
وفي النهاية، سيظل المال قادرًا على تحريك المشهد، لكنه لن يستطيع شراء التاريخ. ولن يستطيع أن يُسكت صوت العامل والفلاح مهما طال غيابهم عن المنابر. لأن الوطن بكل وضوح لم يُبنَ بالمال السياسي، بل بعرق من يعملون… ومن يزرعون… ومن يقفون في طوابير الإنتاج كل صباح.
وسيبقى صوتنا عاليًا، مهما حاولت القوى المالية أن تضغط عليه:
صوت العدالة… صوت المشاركة… صوت التمثيل الحقيقي… صوت من صنعوا هذا الوطن بأيديهم لا بحساباتهم.
---------------------------------
بقلم: محمد عبدالمجيد هندي