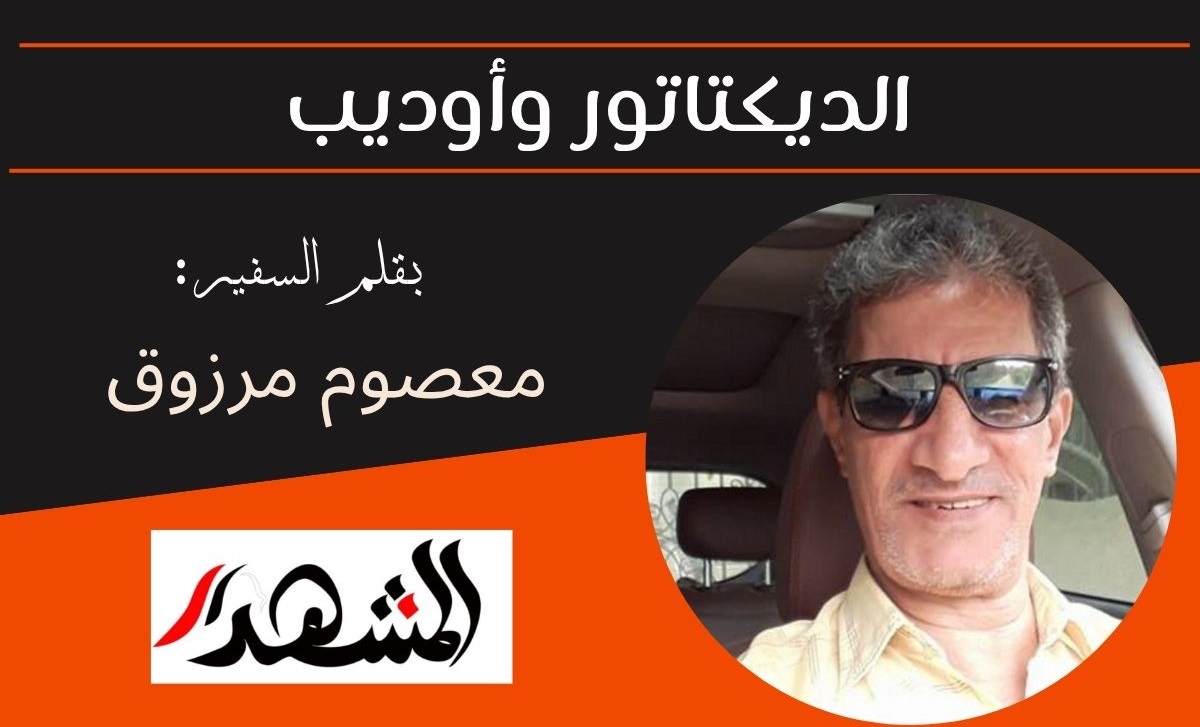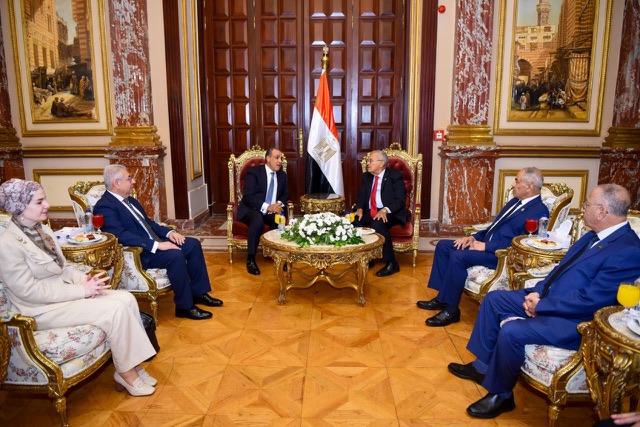إن إمعان النظر في دورات التاريخ والأحداث ، يؤكد أنه منذ أن تثاءب التاريخ الإنساني ، وبدأ يتلمس الطرق في مجاهل الأرض المقفرة ، تواكبت فكرة القدر في الفكر الإنساني مع فكرة الإرادة الحرة ، في ثنائية تتصادم وتطرد ، وتلاصقت القضيتان عبر دروب التاريخ وفي مواقع الجغرافيا المتصلة المنفصلة ، حتي أصبحت الفكرتان – بحق – متلازمتين يسيران معاً ، وكأنهما أصل وظل لا يفترقان .
وقد عبر الأدب عن هذه الثنائية في نصوص عديدة ، اشتهرت وذاعت وخُلدت علي مر التاريخ ، وكان التماثل فيما بينها وبين الواقع بأحداثه وصوره مثيراً للتأمل والدهشة .
من ذلك مثلاً ، مسرحية "أوديب ملكاً" التي كتبها سوفوكليس ( Sophocles ) الذي ولد في أثينا عام ٤٩٦ قبل الميلاد ، وتوفي عام ٤٠٦ قبل الميلاد ، ويعد من أشهر كتّاب المآساة الإغريقية ، ومعه كذلك كل من "أسخيلوس" و "يوربيديس" ، لكنه كان الأدق والأحكم في البناء الدرامي ، وقد اعتبر أرسطو "أوديب ملكاً": "من أكمل المآسي التي كتبت في التاريخ البشري"، من حيث إحكام الحبكة، والتطور الدرامي ولحظة الكشف (إدراك البطل أنه قتل أباه وتزوج أمه) ، وما يقدمه النص من "تطهر" من خلال فكرة الخوف والشفقة والتعاطف بين جمهور المشاهدين ، وهي نفس العناصر التي قام عليها بناء الدراما الغربية بشكل عام .
أننا لو تأملنا إلي مسرحية "أوديب ملكاً " لسوفوكليس ، سوف نجد أنها بشكل ما تقف عند أصل هذا الصراع، لا بوصفها حكاية عن الملوك والآلهة فقط بل كمرآة لحقيقة الوجود الإنساني ذاته، فقصة أوديب الذي حاول الهروب من نبوءته ليجد نفسه يسير إليها بقدميه، ليست محصورة في طيبة القديمة؛ بل يتردد صداها في كل عصرٍ يصطدم فيه طموح الإنسان بإرادة المصير ، ولعل أكثر صورها كارثية تتجلى في شخصية أي ديكتاتور .
أن القدر في عالم أوديب، هو المهندس الخفي للأحداث، قبل أن يولد أوديب، تنبأت عرّافة دلفي بأنه سيقتل أباه ويتزوج أمه ، لم تكن النبوءة لغزاً يُحلّ، بل حقيقة لا مفر منها، وفي سعيه إلى الهرب منها، كان أوديب ينسج خيوطاً يحققها ذكاؤه وكبرياؤه وإصراره الأخلاقي - وهي صفاته النبيلة - التي كانت هي نفسها الأدوات التي ساقته إلى الهلاك.
لقد رأى سوفوكليس أن الإنسان محكوم بنظام كوني لا يستطيع أن يتجاوزه، وأن حتى أفعاله الحرة إنما تخدم ما كتب له منذ البدء بحيث تصبح المأساة ليست في غياب الحرية، بل في أن الحرية نفسها تصبح أداة في يد القدر.
المسرحية تعكس المآساة الإنسانية من خلال تصوير الخطيئة والقدر وهما يتحركان بشكل متواز عبر الأحداث ، وفي عصر النهضة تأثر شكسبير بالبناء الدرامي لأوديب في مسرحيتيه ( هاملت – الملك لير ) ، وكذلك مالرو في مسرحيته ( يهودي مالطا )، من حيث تصوير الصراع بين القدر والإنفعالات الداخلية للبطل ، وفي زمن الأدب الواقعي والرمزي ( القرن ١٩ و ٢٠ ) ، سوف نجد كتّاباً مثل توماس هاردي ونيتشه ، يستخدمون فكرة "العمي" و "الرؤية الرمزية" بشكلها الأوديبي .
مسرحية "أوديب ملكاً " إذن ، تجسد السؤال الأبدي: "هل نتحكم في مصيرنا ، أم أن المصير يتحكم بنا" ، أو المباحث الفلسفية المتعددة حول " الإرادية واللا إرادية " ، وقضية "التسيير والتخيير" بصبغتها الفقهية .
فقد سقط "أوديب" رغم ذكائه وشجاعته ضحية لمحاولته الهروب من مصيره، حيث أدت محاولاته نفسها إلي التورط في المصير المحتوم ، وهو موضوع عبرت عنه بشكل عام الفلسفة اليونانية والرومانية، ثم الفلسفة الوجودية في القرن العشرين ( سارتر و كامو ) ، بل واستخدمت في علم النفس التحليلي.
أن القدر في عالم أوديب، هو المهندس الخفي للأحداث، فقبل أن يولد أوديب تنبأت عرّافة دلفي بأنه سيقتل أباه ويتزوج أمه. لم تكن النبوءة لغزاً يُحلّ، بل حقيقة لا مفر منها وفي سعيه إلى الهرب منها كان أوديب ينسج خيوطاً تحققها، وهكذا فإن ذكاءه وكبرياءه وإصراره الأخلاقي — وهي صفاته النبيلة — كانت هي نفس الخصال التي كانت الأدوات التي ساقته إلى الهلاك.
لقد رأى سوفوكليس أن الإنسان محكوم بنظام كوني لا يستطيع أن يتجاوزه، وأنه حتى أفعاله الحرة إنما تخدم ما كُتب له منذ البدء بحيث تصبح المأساة ليست في غياب الحرية، بل في أن الحرية نفسها تصبح أداة في يد القدر.
فلقد كان "أوديب" يري بعينيه، لكنه كان " أعمي " عن الحقيقة ( أو يتعامي عنها ) ، بينما كان الكاهن "تيريسياس" ضريراً لكنه كان يري ببصيرته ، وأصبح هذا التناقض رمزاً فلسفياً للوعي ، فعرفت البشرية أنواعاً مختلفة من السياسيين الذين "يرون كل شيء" لكنهم "لا يفهمون شيئاً"، في حين قد يري المواطنون ببصيرتهم كل الحقائٍق، لكنهم بلا سلطة تحقق رؤاهم .
لقد كان أوديب ملكاً قوياً يرغب حقاً في إنقاذ شعبه، ولديه ثقة في ذكائه وقدراته، لكنه كان يرفض الإنصات لنصيحة، ويغضب من النقد، ويعتقد أنه قادر علي تحدي الحقائق أياً ما كانت، فانتهي الأمر أن قاد مدينته إلي الكارثة.
وفي التاريخ، تكررت مآسي أوديب في وجوه أخرى فقد كان هتلر علي سبيل المثال يؤمن بأنه رسول "العناية الإلهية "، وأن له مهمة "تاريخية" لإستعادة مجد ألمانيا وتطهيرها وبناء الرايخ الألفي، ظنّ أن الإرادة وحدها قادرة على إعادة تشكيل العالم لكنه مثل أوديب، خلط بين الإرادة والحكمة، وبين الإيمان بالذات والبصيرة، كان أعمى أمام الحقيقة التي صنعها بيده من خلال القوى التي حاول إخضاعها - الاقتصاد، الحرب، العنصرية، آلة الدولة - فانقلبت عليه وابتلعته، وكما أن أوديب في سعيه لتطهير "طيبة" جلب عليها اللعنة، فإن هتلر، في بحثه عن الخلاص والمجد أغرق أوروبا في الدمار وحطم ألمانيا نفسها .
ولم يكن "هتلر" هو المثل الوحيد، فقد شهدت العصور الأخرى أمثلة مشابهة: نابليون الذي ظنّ أن أوروبا ستنحني لعبقريته فانتهى منفياً، وروبسبير الذي حوّل الثورة إلى رعب، بل وحتى حكّام العصر الحديث الذين يثقون في الخوارزميات أكثر من ضمير الإنسان، كلهم تصرفوا بحرية، ولكنهم بدوا مدفوعين بأقدار أكبر منهم - مثل أقدار من الضرورة التاريخية أو الجنون الجماعي – مغلفة بشعبية حقيقية أو مصنوعة، وفي نهايتها يتلاشى الحد بين الحرية والمصير حتى يصبح السقوط حتمياً .
والديكتاتور لا يبتعد نفسياً عن هذا البطل الأسطوري، فهو قد يبدأ زعيماً محبوباً، لكنه ينتهي طاغية جباراً، يري بعينيه كل شيء، ولكنه لا يكاد يبصر شيئاً من الحقائق ، وبالتالي تسقط سلطته التي ترعرعت في إنكار الحقائق ، فلم يكن الوباء الذي ضرب " طيبة " في المسرحية صدفة أو مجرد عقاب من الآلهة ، وإنما هي نتيجة "خطيئة" لم يعترف بها الملك .
وفي الأدب السياسي يجد ذلك أكثر من تعبير معاصر، حيث يؤدي فساد القيادة إلي خراب الدول، ويتطور الخطأ الخاص إلي أن يصبح كارثة عامة، والأمثلة تستعصي علي الحصر .
من الناحية الفلسفية، يمثل كلٌّ من أوديب وهتلر التوتر الأبدي بين الحتمية والمسؤولية الأخلاقية مع الفارق في أن عالم أوديب تحكمه إرادة الآلهة ، أما عالم هتلر فيخضع لحتميات دنيوية مثل العرق والإيديولوجيا والتاريخ، ولكن نجد في كليهما "وهم "الحرية، ولكنها حرية محكومة بالعمي الداخلي كان الإغريق يسمّون ذلك الغرور "الهيوبريس" أي تحدي حدود الإنسان، أما علم النفس الحديث فيسميه الوهم أو الافتتان الإيديولوجي ، وفي كلتا الحالتين النمط واحد: الإنسان يحاول وفقاً لمعطيات الواقع أن يكون إلهاً فيتحول ذلك إلي آداة في هلاكه.
وربما لا يوجد نص أدبي آخر أثر في علم النفس مثلما أثرت مسرحية "أوديب ملكاً" ، فقد استخدمها "فرويد " في التحليل النفسي فيما أُطلق عليه "عقدة أوديب" ، كما صارت بشكل عام رمزاً لصراع الإنسان مع ذاته وجهله بحقيقته الداخلية، والأمور التي نواريها عامدين عن أنفسنا ، فنراها ولا نراها ، بل صارت رمزاً للذنب الذي يلاحقنا رغم إمعاننا في الإنكار .
ومع ذلك، يترك سوفوكليس خيطاً من الخلاص، فعندما فقأ أوديب عينيه، بدأ يرى حقاً ، فالمعرفة - رغم قسوتها- منحته وضوحاً أخلاقياً، فتقبل مسؤوليته عن أفعال كُتبت له قبل أن يُولد، و هنا يكمن جوهر البصيرة الإغريقية: " قد يتحكم القدر في الظروف، لكن طريقة مواجهتنا للقدر هي ما تصنع إنسانيتنا" ولهذا، يقف أوديب في لحظة وعيه أكثر نبلاً من هتلر في لحظة إنكاره؛ الأول نال كرامة المأساة، والآخر سقط في هوّة العدم غير مأسوف عليه .
ربما هذه هي الرسالة التي يرسلها سوفوكليس عبر القرون "أن التاريخ لا يعيد نفسه لأن القدر ثابت بل لأن الإنسان يرفض الاعتراف بحدود إرادته، و في كل عصر نعيد كتابة "أوديب ملكاً" بأبطال جدد مرة باسم الأيديولوجيا، ومرةً باسم العلم، ومرةً باسم التكنولوجيا ،وفي كل مرة تنتهي المسرحية بالطريقة ذاتها: بالعمى، والاكتشاف، والخراب.
المأساة إذن ليست في وجود القدر، بل في أننا نظنه حرية مطلقة لتفسيراتنا لذواتنا وقدراتنا، وإصرارنا علي الإنكار ، وذلك بالنسبة لكل ديكتاتور " عقدة أوديب " بتفسير أشمل .
-----------------------------
بقلم: معصوم مرزوق
* مساعد وزير الخارجية الأسبق