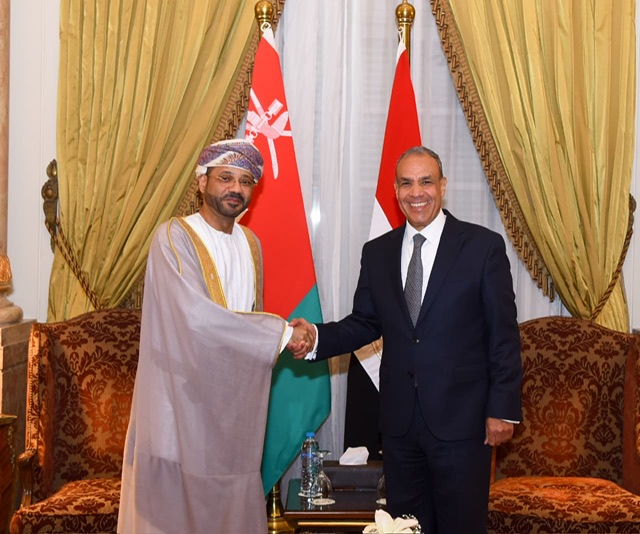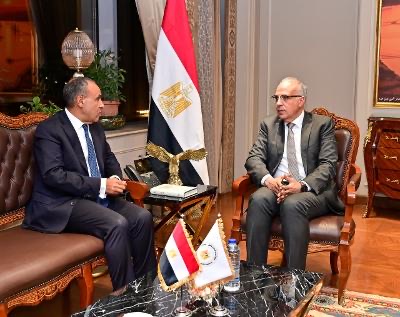احتفال جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية على مدار دوراتها السابقة حتى دورتها التاسعة عشرة،بم يكن مجرد احتفال رمزي بمنجزات أسماء مبدعين ومفكرين وباحثين من العالم العربي، بل كان لحظة اعتراف بتاريخ طويل من الإصرار على الكتابة، وعلى حمل الذاكرة العربية فوق أكتاف اللغة. في مقدمة الكتيّب المخصّص للفائزين لهذه الدورة التاسعة عشرة، نقرأ جملة تكشف روح هذا التكريم (كتبوا حكايتهم بأنفسهم… رسموا صورتهم بريشتهم، دون ضوابط أو تجميل، وأعطوا للتاريخ حقيقة لا تُدحض). هذا النص وحده يشبه تصريحًا بأن شهادات الفائزين (الشاعر العراقي حميد سعيد جائزة الشعر، الروائية العراقية إنعام كجه جي جائزة القصة والرواية والمسرحية، الناقد المغربي حميد لحمداني جائزة الدراسات الأدبية والنقد المؤرخ، والمفكر التونسي عبد الجليل التميمي جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية) ليست مجرد سِيَر؛ بل هي مكاشفات، كتبت بصدق، كما لو أنّ كل واحد منهم تعلّم أن ينحت حياته كلمة كلمة.
وتضيف الأمانة العامة للمؤسسة في مقدمتها للكتاب أن هؤلاء الفائزين ساروا بخطى ثابتة دون تردّد "كلماتهم تدل عليهم، خطاهم الثابتة المتزنة، مثابرتهم، كلها ساهمت في نجاحهم، لتصبح لبنة في جدار الثقافة العربية، جدار يحمينا ويحمي هويتنا". هذا المدخل يهيِّئ القارئ لقراءة أربع رحلات مختلفة، ولكنها تتقاطع في مكان واحد: الإيمان بالكتابة كقدر.
يبدأ السرد مع الشاعر العراقي حميد سعيد. لا يبدأ حديثه بوصف الجوائز أو الإنجازات، بل يبدأ بتعريف شديد البساطة والعمق في آن واحد، وكأنه يريد أن يقول إن الشعر لا يقوم إلا على التواضع أمام العالم. يقول "لو سألنا حميد سعيد سؤالًا افتراضيًا بسيطًا: من أنت؟ لكان جوابه: كلمة واحدة، عميقة في لفظها، عميقة في دلالاتها: أنا مواطن".
يفتح هذا التعريف الباب إلى سيرته، إلى ميلاده في مدينة الحلة، في منطقة مجاورة للنهر وقريبة من مدينة بابل، "وُلدت في محلة الوردية، جارة النهر، قريبة من مدينة بابل التاريخية، في السابع والعشرين من أيار عام 1941، في بيت جدي الذي لم يكن بعيدًا عن شط الحلة، وهو فرع من نهر الفرات". النهر هنا ليس خلفية جغرافية، بل بذرة الشعر الأولى. الذين يعرفون شعر حميد سعيد، ويعرفون اشتغاله على اللغة والصورة، سيلاحظون أن النهر ظل يرافقه كمعادل للذاكرة. هذه البداية الساحرة، الواقعية والرمزية معًا، تفسر فيما بعد العلاقة بين القصيدة والانتماء، بين الشعر والهوية.
ومع تحولات المكان، انتقلت القصيدة أيضًا. حين غادر العراق في بداية الألفية الثالثة، استقر في عمّان، لكنه لم يستقر شعريًا. بقيت القصيدة تتنقل معه. فمنذ عام 2003 يقيم حميد سعيد في العاصمة عمّان، حيث يواصل عمله الثقافي والأدبي، وقد صدرت له خلال فترة إقامته عدد من المجموعات الشعرية والأدبية، مثل "من وردة الكتاب إلى غابة الرماد"، "مشهد مختلف"، "من أوراق الموريسكي"، "أولئك أصحابي"، «ما تأخر من القول»، بالإضافة إلى الأعمال الأدبية والنقدية مثل "تطفل على السرد"، و"عن الشعر ومآلاته".
حين يكتب حميد عن الشعر، يبدو واضحًا أنه لا يتعامل معه كحرفة، بل كمساحة للحقائق الداخلية. كأنه يعلن أن الشعر ليس زخرفة لغوية، بل مسؤولية. لذلك لا غرابة أن يختتم شهادته، وهو يتحدث عن جوهر الكتابة، بنبرة تشبه العهد "أحاول أن أكون شاعرًا يقدم عطايا القصيدة… لا عطايا الكلام".
ينتقل الكتاب إلى تجربة إنعام كجه جي، الروائية العراقية التي تجمع بين الرواية والصحافة والتوثيق. عنوان فصلها ليس سيرة ذاتية عادية، بل إعلان داخلي "شغف بالحكايات". وفي أول شهادة لها تقول "جاء في أسباب منحي جائزة العويس أن كتابتي تميزت بالقدرة على مزج الجانب التوثيقي والأدبي. وهذا ما دفعني إلى الولع بالقصص الحقيقية في كتاباتي". .
تحكي كجه جي أن بدايتها الأولى في الكتابة لم تكن رواية، بل كانت تتبع أثر امرأة رسامة "كان كتابي الأول سيرة روائية لرسامة بريطانية عاشت في بغداد، أواسط القرن الماضي، وأخذت على عاتقها أن ترسم البيوت التراثية العتيقة وسط المدينة قبل هدمها وشق الطرق والجادات الحديثة. هكذا كتبت سيرة لورنا هيلز، زوجة الفنان الرائد جواد سليم"
لكن الفصل الأكثر تأثيرًا في شهادتها، هو الذي تحدّثت فيه عن الرحيل. تقول في مقطع موجع يختصر السنوات والتحولات: "يوم سافرت إلى فرنسا لإكمال الدراسة العليا لم تكن إنعام كجه جي تتوقع أنها ستمضي في البلد الغريب عمرًا يفوق سنوات عمرها في الوطن". وبهذه الجملة تفتح بابًا كبيرًا لأسئلة الاغتراب، وأسئلة اللغة والهوية، وتعود لتتساءل بصراحة قاسية عن علاقتها بالكتابة "هل كنت أمينة في تسجيل تفاصيل الحياة في بغداد أو الموصل أو الديوانية… أم ارتكبت خيانة لغتي؟". ثم تكمل الجملة نفسها لكنها تذهب أبعد "وجدت واقعًا يزدري الخيال، فكنت ألوي شراعي أحيانًا كي أحول بينه وبين الانسياق طويلًا وراء ريح عبثية تهب علينا وتبلبل رشدنا". .
في شهادة كجه جي ليس هناك تجميل. هناك مواجهة مباشرة مع الذاكرة، مع الكتابة، مع الوطن حين يتحول إلى مادة للحنين لا للفعل. إنها لا تكتب روايات هروب، بل روايات مواجهة. هي تكتب لتشهد، وتكتب لكي لا تموت التفاصيل.
بعد الشعر والرواية، يأخذ الكتيب اتجاهًا آخر تمامًا مع حميد لحمداني، الناقد المغربي الذي يتعامل مع الأدب كعلم. عنوان شهادته واضح" تطواف في النقد والفكر".
النقد عند لحمداني ليس انطباعًا، بل ممارسة معرفية تعتمد الأدوات والمنهج. هذا واضح أيضًا من كتبه، ومنها "مهارات تحليل البنيات السردية" الصادر سنة 2018، حين يكتب عن النقد، فهو يتحدث من موقع الباحث الذي لا يكتفي بقراءة النص، بل يحلله ويعيد تركيبه ويبحث عن طبقاته الداخلية.
في شهادته يظهر وعيه بأن النقد ليس جسرًا إلى النص فقط، بل جسرًا إلى المجتمع والثقافة والفكر. عمله لا يقدّم قراءة في النصوص فقط، بل يفتح أسئلة حول وجود النص ذاته، وحول العلاقة بين الإبداع وبنية الوعي.
مع د.عبد الجليل التميمي، المفكر والمؤرخ التونسي، حكاية مختلفة تمامًا. إنه انتقال من الأدب إلى التاريخ، ومن الحكاية إلى الوثيقة. يروي رحلته التي بدأت عام 1965، يقول: (لقد بدأت مسيرتي البحثية سنة 1965، أي منذ ستين عامًا، بالتاريخ العثماني خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر، ثم توسعت إلى البلاد المغاربية خلال العهد العثماني" . ثم يروي لحظة التحول الكبرى في حياته العلمية، حين انتقل من البحث في الوثائق العثمانية إلى تأسيس مجال جديد تمامًا في الدراسات العربية "وفي مطلع الثمانينيات أضفت إلى ذلك الاهتمام الدراسات الموريسكية الأندلسية التي تُعنى بمن بقي بإسبانيا من العرب المسلمين بعد سقوط غرناطة"..
لم يكتف التميمي بالدراسات النظرية، بل أسس مؤتمرًا دوليًا جعل من هذا المجال مدرسة علمية ذات أثر. يقول "أعمال المؤتمر الخامس عشر للدراسات العثمانية حول أدب الرحلات والمصادر الأرشيفية للإيالات العربية خلال العهد العثماني". ويذكر الصفحات أن المؤتمرات تناولت موضوعات دقيقة مثل أوضاع الموريسكيين الاقتصادية والاجتماعية والدينية، والمرأة الموريسكية وتحوّلات المجتمع.
الأهم من ذلك، أن التميمي لم يشتغل بالتاريخ فقط، بل اشتغل بالأرشفة نفسها، وهي الخطوة التي تصنع التاريخ. يشير "تمكنا خلال مسيرتنا العلمية أن نساهم في إدارة مؤسسة تهتم بالأرشيف والتوثيق والمعلومات… وأسسنا المجلة العربية للأرشيف والتوثيق والمعلومات، إيمانًا منا بالعلاقة المتينة بين التوثيق والأرشيف وعلم التاريخ" . إنه لا يكتب التاريخ، بل يضمن أن يبقى محفوظًا.
رحلة التميمي العلمية تتوجها أوسمة عديدة، تذكر منها صفحات الكتيب: (الوسام القومي التونسي لعلم التاريخ سنة 1984، والوسام الثقافي الفرنسي… ومنح جائزة الأمير كلوس بهولندا".
وهكذا بين شاعر بدأ حياته على ضفاف الفرات، وروائية حملت بغداد تاريخها وحضارتها وعوالمها وتقلباتها في حقيبة لغة ورؤى، وناقد يسير برؤى مبدعة داخل النصوص، ومؤرخ يحفظ الذاكرة قبل أن تضيع، تبدو هذه الدورة من جائزة العويس كأنها فسيفساء للثقافة العربية في أكثر صورها صدقًا وإنسانية.
وبقي الاشارة إلى ما كتبته الأمانة العامة للجائزة ، وهي جملة تصلح أن تكون خاتمة لتجليات هؤلاء جميعًا "لهذا نحتفي بهم، وننظر بفخر إلى أعمالهم، ولسان حالنا يقول: أمتنا كانت تنجب دائمًا أبناءً نجباء مثلكم".. لقد كتبوا حكايتهم بأقلامهم، وكتبوا تاريخنا في الوقت نفسه.