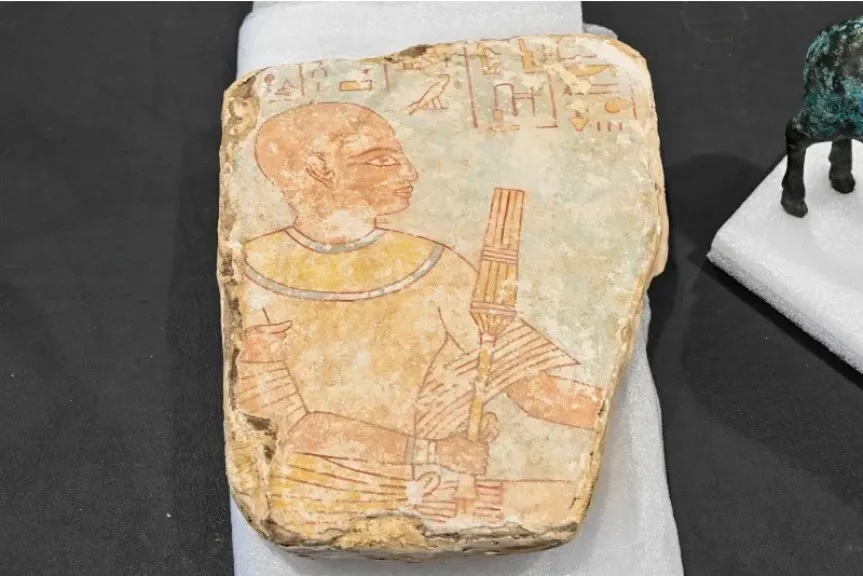تتهاوى المرايا في القاعة المصرية، فما تعكسه من صور لم يعد يتطابق مع حقيقة الواقع، فالانتخابات البرلمانية 2025 ليست مجرد استحقاق تشريعي، بل هي اختبار وجودي لشرعية نظام سياسي يقف على مفترق طرق تاريخي، وفي هذه اللحظة بالذات، حيث تتداخل الفلسفة مع الواقعية السياسية، يصبح السؤال الجوهري: هل يمكن بناء شرعية حقيقية على أسس هشة من الإقصاء والتهميش وضعف الوعي؟
إن المشهد ينطوي على مفارقة فلسفية عميقة؛ فبينما تعلن الدولة عن التزامها بالمسار الديمقراطي، تمارس أبسط أشكال الإقصاء للمعارضة الحقيقية، وبينما تتغنى بالتمثيل الشعبي، تختزل العملية السياسية في قائمة وحيدة تسير في سباق من دون منافس، وهذه الازدواجية تذكرنا بمقولات الفيلسوفة حنة أرندت حول "اختلاق الواقع" و"تفكيك الحقيقة"، فالشرعية التي تُبنى على الإقصاء الممنهج للمعارضين، وتُحمى بقوانين تخنق الحريات، وتُعرض عبر إعلام يصور الواقع بصورة مشوهة - هي شرعية هشة، تشبه القصور التي تُبنى على الرمال، إنها قد تصمد لوقت، لكنها لا محالة ستتهاوى عند أول اختبار حقيقي.
والأخطر من أزمة الإقصاء هو أزمة الوعي المصاحبة لها، حيث يتحول المواطن من شريك في صنع القرار إلى متفرج على مسرحية سياسية، تذوب فيها الحقيقة تحت وطأة الخطاب الرسمي والإعلام الموجه، وفي هذا المشهد، يصبح السؤال الأعمق: كيف يمكن الحديث عن شرعية نظام يفتقر إلى الرضا الشعبي الحقيقي، ويعتمد على العزوف الانتخابي كمؤشر على "القبول" لا على الرفض؟ إن الإجابة على هذا السؤال ستحدد ليس فقط مصير البرلمان القادم، بل مستقبل مصر ككل في العقود القادمة.
الإصلاح كضرورة وجودية
تنبني الفلسفة السياسية في جوهرها على مفهوم "العقد الاجتماعي" الذي صاغه فلاسفة التنوير، حيث تستمد الأنظمة السياسية شرعيتها الأساسية من خلال الرضا الشعبي والإرادة الحرة للمحكومين، وليس من خلال القوة أو الإكراه، وهذا المبدأ يشكل حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي، حيث تكون السلطة تفويضاً من الشعب، وليست حقاً إلهياً أو وراثياً، بينما في الواقع المصري الراهن، تتعرض هذه الفلسفة لاختبار قاسٍ، فالمؤشرات الواضحة، وعلى رأسها العزوف الانتخابي الذي لم تتجاوز نسبته 17.1٪ في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، لا تعكس مجرد عدم اكتراث سياسي، بل تشير إلى أزمة شرعية عميقة الجذور، هذه النسبة المتدنية ليست رقمًا إحصائياً عابراً، بل هي صرخة مدوية تعبر عن قطيعة بين المواطن والنظام السياسي بأكمله.
والنتيجة الحتمية لهذه الأزمة هي تحول النظام السياسي إلى كيان هش، يشبه البناء الشامخ ظاهرياً، لكنه قائم على أساس من الرمال المتحركة، قد يصمد هذا البناء لفترة تحت ظروف الاستقرار النسبي، لكنه ينهار حتماً عند أول اختبار حقيقي، سواء كان أزمة اقتصادية طاحنة، أو ضغوطاً سياسية مفاجئة، أو احتقاناً اجتماعياً متصاعداً، وهنا تكمن المفارقة التاريخية: فالنظام الذي يفقد شرعيته الشعبية يتحول من كيان يستمد قوته من إرادة مواطنيه، إلى هيكل فارغ يعتمد على القمع والترهيب، مما يجعله عرضة للانهيار في لحظة المواجهة الحقيقية مع التحديات المصيرية.
كما تُصرّ السلطة المصرية على تقديم نفسها في صورة الحارسة الأمينة للاستقرار والضامنة للأمن، مستخدمةً خطاباً يضع الاستقرار في قمة الأولويات، حتى لو كان الثمن تقييد الحريات الأساسية، ولكن الحكمة الفلسفية والسياسية عبر العصور تُعلِّمنا أن هذه المعادلة تحتاج إلى إعادة نظر جذرية، فالاستقرار الحقيقي - بحسب الفكر السياسي المستنير - لا يُبنى على أنقاض الحريات، ولا يتحقق من خلال قمع الحقوق الأساسية، بل إن الفلسفة السياسية الحديثة تؤكد أن التوازن الدقيق بين متطلبات الأمن وضرورات الحرية هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار حقيقي ومستدام، فالمجتمع الذي تُختزل فيه الحرية مقابل الأمن يشبه المريض الذي يُعالج بمسكنات قوية تزيل الأعراض الظاهرة لكنها تفاقم المرض الخفي.
وفي هذا السياق، يقدم المفكر الإسلامي البوسني علي عزت بيجوفيتش رؤية عميقة حين يؤكد أن "الحرية سابقة على كل شيء، وهي أساس الأخلاق والشرط اللازم للإيمان والإنسانية"، فهي ليست مجرد حق يمكن التضحية به، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه كل القيم الأخرى، بل ويذهب بيجوفيتش إلى أبعد من ذلك في تحليله الأخلاقي للأنظمة السياسية، فيرى أن "الدكتاتورية غير حميدة الأخلاق، حتى عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر! والديمقراطية حميدة حتى عندما تسمح بالحرام!" مؤكداً على أسبقية الحرية حتى لو كانت تحمل بعض المخاطر، ورغم أن هذه الرؤية تحمل تحليلاً ثورياً يتحدى المنطق السطحي، إلا أنها تقدم تفسيرها في ذاتها، فالأخلاق في النظام الديكتاتوري تظل فاسدة حتى عندما يقوم بمنع الأفعال المنكرة، لأن غياب الإرادة الحرة والاختيار يجعل الامتثال مجرد قشرة خارجية فارغة من المضمون الأخلاقي الحقيقي، بينما تظل الديمقراطية أخلاقية في جوهرها حتى عندما تسمح ببعض الممارسات غير المرغوب فيها، لأنها تحترم حرية الإنسان وقدرته على الاختيار، وهي القيمة الأخلاقية العليا.
وهكذا، يؤكد بيجوفيتش على أسبقية الحرية وقيمتها المطلقة، حتى لو كانت تحمل في طياتها بعض المخاطر واحتمالات الخطأ، فالمجتمع الحر الذي يخطئ ويتعلم من أخطائه، خير من مجتمع مستقر لكنه مقيد ومُحْجر عليه، لا يملك حتى حرية الاختيار بين الصواب والخطأ.
تشريح الأزمة الهيكلية
تشكل القوانين الثلاثة - قانون التظاهر، قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجمعيات الأهلية - معاً نموذجاً متكاملاً لفلسفة القمع القانوني الممنهج، حيث تتحول التشريعات من أداة لتنظيم الحياة العامة والحفاظ على الحقوق، إلى سلاح فتاك في يد النظام لسحق الحريات الأساسية وإسكات الأصوات المعارضة، وهذه الثلاثية التشريعية لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتداخل نصوصها وتتكامل آلياتها لتشكل ما يمكن تسميته بدقة "الديكتاتورية القانونية" أو "الاستبداد التشريعي"، وفي هذا النموذج المقلوب، يتحول القانون من ضمانة للحريات ودرعاً واقياً للحقوق، إلى غطاء قانوني متقن لشرعنة الممارسات الاستبدادية.
فالقانون الذي يفترض به تنظيم الحق في التظاهر يتحول إلى أداة لمنعه، وتشريع مكافحة الإرهاب يتحول إلى سيف مسلط على رقاب المعارضين السلميين، وقانون تنظيم العمل الأهلي يتحول إلى أداة لخنق منظمات المجتمع المدني وتحويلها إلى أدوات تابعة للسلطة، فهذه الآلية التشريعية الممنهجة تخلق نظاماً قانونياً مزدوج الوجه: ظاهره يحاكي دولة القانون ويتماشى مع الشكليات الديمقراطية، وباطنه يكرس الاستبداد ويشرعن القمع تحت غطاء من النصوص القانونية التي تبدو محايدة، لكن تطبيقاتها تكون انتقائية وقمعية.
وبهذا تتحول الدولة من حارسة للحقوق إلى خصم للمواطنين، ومن ضامنة للحريات إلى سجان لها، كل ذلك تحت ستار من الشرعية القانونية الزائفة التي تجعل من النظام القمعي يبدو وكأنه يسير ضمن الأطر القانونية، بينما هو في الواقع يشوه جوهر القانون ويحرفه عن مساره الحقيقي. كما يشهد المشهد البرلماني المصري تحولاً خطيراً، يجسده الانزياح من مفهوم التمثيل الشعبي الحقيقي إلى صيغة "نادي لأثرياء السياسة" المنغمسين في مصالحهم الشخصية، حيث تتحول المقاعد النيابية من منصة لخدمة الصالح العام إلى سلعة في سوق المزايدات المالية، وهذه الظاهرة ليست وليدة الصدفة، بل تؤكد نظريات فلسفية قديمة تجد مصداقيتها في الواقع المعاصر، فقد حذر الفيلسوف اليوناني أفلاطون في جمهوريته من المسار الحتمي لتحول نظم الحكم، إلى أوليجاركية (الأقلية الثرية)، معتبراً أن هذا التحول يحدث عندما تتحول الثروة من مجرد وسيلة للعيش إلى معيار أساسي للوصول إلى السلطة وممارسة النفوذ، ورأى أن الدولة تبدأ بالانهيار عندما تصبح القدرة المالية هي الممر الإجباري للوصول إلى المراكز السياسية، ودوائر الحكم.
وفي الواقع المصري، لم يعد البرلمان مجساً لقياس نبض الشعب وهمومه، بل تحول إلى ساحة لتصفية حسابات الأعمال وتنفيذ صفقات المصالح، فظاهرة "التجارة بالنيابة" لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت واقعاً ملموساً تتجلى في سيطرة رجال الأعمال على المقاعد البرلمانية، وتحول العمل التشريعي من عملية سياسية تخدم المصلحة العامة إلى أداة لتعزيز المصالح الاقتصادية الضيقة، وهذا التحول الأوليجاركي لا يقتصر على مجرد هيمنة الأثرياء على المقاعد النيابية، بل يمتد إلى تحويل العملية التشريعية برمتها إلى آلية لتحصين مصالح النخبة المالية وتكريس هيمنتها، فأصبحت القوانين تُصاغ لا لخدمة العدالة الاجتماعية، بل لضمان استمرارية سيطرة تحالفات المصالح التجارية على مقدرات البلاد.
بهذا يكمل النظام الدورة المفرغة؛ من ديمقراطية شكلية تفتقر إلى التمثيل الحقيقي، إلى أوليجاركية مقنعة تتحكم بمفاصل الدولة تحت غطاء من الشرعية الانتخابية الزائفة، مما يؤكد أن الحكم عندما يفقد قيمته الجوهرية يتحول إلى أسوأ أشكال الحكم - حكم الأقلية الثرية على حساب مصالح الأغلبية.
سيناريوهات المستقبل وتحولات الشرعية
في ظل استمرار النهج السياسي الحالي دون إصلاحات جوهرية، تشير التحليلات الاستشرافية إلى تطور عدد من الظواهر السلبية التي ستشكل في مجملها منحى تدهورياً خطيراً، يمكن إيجازه في المحاور التالية:
أولاً: التآكل المتصاعد للشرعية الشعبية؛ فمن المتوقع أن يشهد الواقع السياسي المصري استمراراً في تآكل الشرعية الشعبية للنظام، حيث ستتسع الفجوة بين الدولة والمجتمع، مع تنامي مشاعر السخط والاغتراب السياسي بين فئات متعددة من الشعب، لاسيما مع استمرار سياسات الإقصاء وتهميش الرأي المخالف.
ثانياً: تفاقم الاحتقان السياسي وتصاعد وتيرته؛ حيث سيسفر استمرار النهج الحالي عن ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاحتقان السياسي، ويتحول السخط الشعبي من حالة سلبية من العزوف والانسحاب إلى أشكال أكثر حدة من التعبير عن الرفض، مع تزايد احتمالية تحول أجزاء من المعارضة من العمل السلمي إلى أساليب أكثر تشدداً.
ثالثاً: تدهور الصورة الدولية لمصر ومكانتها الإقليمية؛ فستواجه مصر تراجعاً متزايداً في صورتها الدولية، حيث ستتعمق الفجوة بين الخطاب الرسمي الموجه للخارج والممارسات الفعلية على الأرض، مما سينعكس سلباً على موقفها في المحافل الدولية ويقلل من قدرتها على لعب دور إقليمي فاعل، كما سيعرضها لمزيد من الضغوط الدولية في ملفات حقوق الإنسان والحريات.
رابعاً: تفاقم الأزمات الاقتصادية وهشاشة النظام الاقتصادي؛ لأن غياب الرقابة البرلمانية الفعالة واستمرار هيمنة النخب الاقتصادية على القرار التشريعي، سيؤدي حتماً إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية، حيث سيتم إقرار سياسات اقتصادية تخدم مصالح فئات ضيقة على حساب الصالح العام، مع استشراء الفساد وتراجع الشفافية، مما سيؤدي إلى تعميق الأزمات المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وهذا السيناريو لا يمثل مجرد توقع أكاديمي، بل هو نتيجة حتمية لاستمرار نفس السياسات والأدوات التي أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار الحقيقي والتنمية المستدامة. بينما يقوم سيناريو الإصلاح التدريجي على إعادة هيكلة جذرية للنظام السياسي من خلال ركائز أساسية تشكل في مجملها نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، نحو عقد اجتماعي جديد، وذلك عبر المحاور التالية:
أولاً: إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، ويمثل هذا المحور حجر الزاوية في عملية الإصلاح الشامل، من خلال الانتقال من نموذج العلاقة الرأسية القائمة على التبعية، إلى نموذج تشاركي يقوم على مفهوم المواطنة الكاملة والحقوق المتساوية، وذلك عبر إعادة تعريف أسس الشرعية السياسية لتصبح قائمة على الرضا الشعبي الحقيقي والمشاركة الفاعلة، وليس على الإكراه أو القمع أو التلاعب بالإرادة الشعبية.
ثانياً: تحويل البرلمان من أداة تصديق إلى سلطة رقابية فاعلة، ويتطلب الإصلاح تحولاً جوهرياً في دور المجلس النيابي، من كونه مجرد "ختم مطاطي" يكرس قرارات السلطة التنفيذية، إلى مؤسسة تشريعية ورقابية حقيقية تمارس دورها الدستوري كاملاً، وذلك من خلال تمكينه من مساءلة الحكومة، ومراقبة أدائها، وإقرار التشريعات التي تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية، وتتوافق مع المصالح العليا للوطن.
ثالثاً: بناء شرعية جديدة قائمة على المشاركة والتمثيل الحقيقي، ويسعى سيناريو الإصلاح إلى تأسيس شرعية سياسية جديدة، لا تقوم على القوة أو الترهيب، بل على المشاركة الشعبية الواسعة والتمثيل الحقيقي لكافة التيارات والفئات المجتمعية، وذلك عبر ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وشموليتها، وتمثيلها للإرادة الشعبية الحقيقية، مما يمنح النظام السياسي شرعية مستمدة من رضا المحكومين وقناعتهم، وليس من خوفهم أو اضطرارهم.
وهذه الركائز الثلاث تشكل في مجموعها نظاماً متكاملاً للإصلاح، يؤدي إلى انتقال تدريجي وسلمي من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي التعددي، الذي يحترم حقوق الإنسان، ويضمن الحريات الأساسية، ويؤسس لشرعية سياسية حقيقية مستدامة.
التوصيات - من التنظير إلى التطبيق
يُعد الإصلاح الدستوري هو المدخل الأساسي والأكثر جذرية لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود، حيث يشكل الدستور الإطار الناظم للحياة السياسية والضامن للحقوق والحريات، ويتطلب ذلك إعادة نظر شاملة في البنية الدستورية الحالية من خلال المحاور التالية:
أولاً: مراجعة شاملة للمواد الدستورية التي تتيح الالتفاف على المبادئ الديمقراطية، وتمثل هذه المراجعة الخطوة الأولى نحو بناء نظام ديمقراطي حقيقي، من خلال تعديل النصوص الدستورية التي تتيح للسلطة التنفيذية التوسع على حساب السلطات الأخرى، أو تلك التي تمنح صلاحيات مطلقة دون ضوابط رقابية كافية، كما يجب إلغاء المواد التي تسمح بتعليق الحقوق والحريات تحت مبررات فضفاضة، واستبدالها بنصوص واضحة تحدد ضوابط محددة ودقيقة لأي قيود قد تُفرض على هذه الحقوق.
ثانياً: ضمان استقلالية القضاء الانتخابي وتحييده عن التأثيرات السياسية، حيث يتطلب الإصلاح الدستوري تأكيد استقلالية الجهات المشرفة على الانتخابات، وضمان حياديتها التامة، ومنحها الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها دون عوائق، وذلك من خلال النص الدستوري على إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لأعلى معايير الشفافية والمحاسبة، مع ضمان تمثيل مختلف التيارات السياسية في تشكيلاتها.
ثالثاً: إقرار مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات وتوازنها، فيجب أن ينص الدستور بشكل واضح وصريح على مبدأ الفصل بين السلطات ليس كمجرد نص شكلي، بل كحقيقة عملية تترجم في توزيع الصلاحيات وتوازنها، وذلك من خلال منح السلطة التشريعية صلاحيات رقابية حقيقية على السلطة التنفيذية، وتمكين القضاء من ممارسة دوره المستقل في الرقابة على دستورية القوانين، مع وضع آليات فعالة لتحقيق التوازن بين السلطات ومنع هيمنة أي منها على الأخرى.
هذه الإصلاحات الدستورية ليست مجرد تغييرات شكلية، بل تمثل إعادة تأسيس لعقد اجتماعي جديد يقوم على احترام إرادة الشعب وضمان الحقوق والحريات، وتأسيس دولة القانون والمؤسسات التي تحقق العدالة والمساواة وتصون كرامة المواطن.
كما تُعد ظاهرة تسييس المال واستغلاله في الحياة السياسية من أخطر التحديات التي تهدد جوهر العملية الديمقراطية، حيث تتحول المنافسة الانتخابية من سباق أفكار وابتكارات وبرامج إلى منافسة مالية طاحنة، وتتطلب المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة إجراءات حاسمة تشمل:
أولاً: تأسيس سقف واقعي واضح للإنفاق الانتخابي ومراقبة صارمة للتطبيق، للإنفاق على الحملات الانتخابية، مع وضع آليات رقابية صارمة لمراقبة الالتزام به، بما يشمل إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة التمويل الانتخابي، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، وإلزام المرشحين بتقديم كشوفات مالية مفصلة ومستندة بتدقيقها من جهات مستقلة.
ثانياً: إقرار مبدأ الشفافية المطلقة في تمويل الحملات الانتخابية، ويتطلب ذلك إلزام جميع المرشحين بالإفصاح الكامل عن مصادر تمويل حملاتهم، ونشر البيانات المالية بشكل دوري ومنتظم، مع توفير آلية للجمهور للوصول إلى هذه المعلومات بسهولة وشفافية، كما يجب منع التبرعات المجهولة والمشبوهة، وتحديد سقف للتبرعات الفردية والشركات لضمان عدم تحول العملية الانتخابية إلى استثمار تجاري.
ثالثاً: مكافحة "تجارة النيابة" وتحويل المقاعد البرلمانية إلى سلع، فيجب مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال إصدار تشريعات صارمة تجرم تحويل المقاعد النيابية إلى سلع قابلة للشراء والبيع، وتضع معايير واضحة للكفاءة والنزاهة للترشح، مع إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد الانتخابي تكون مختصة بمتابعة ومحاسبة من يستغلون ثرواتهم لشراء النفوذ السياسي.
وهذه الإجراءات المتكاملة تشكل ضرورة حتمية لاستعادة الثقة في العملية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع تحول البرلمان إلى سوق للمزايدات المالية، والحفاظ على الدور الحقيقي للمؤسسة التشريعية كمرآة حقيقية لإرادة الشعب وليس كمنصة لمصالح الأثرياء.
تداعيات الاستمرار في عدم الإصلاح
التداعيات السياسية: تشير التحليلات الاستشرافية إلى أن استمرار النهج السياسي الحالي دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة تهدد الاستقرار الوطني على المدى المتوسط والبعيد، وذلك من خلال المحاور التالية:
أولاً: استمرار وتعمق أزمة الشرعية السياسية الهيكلية، حيث سيؤدي استمرار النظام في الاعتماد على آليات الإقصاء والتهميش إلى تفاقم أزمة الشرعية السياسية، حيث سيتحول العجز الشرعي من ظاهرة مؤقتة إلى حالة هيكلية مزمنة، وهذا الوضع سينعكس سلباً على قدرة النظام في قيادة الدولة ومؤسساتها، وسيفقده المقبولية المحلية والدولية، مما يجعله نظاماً يعتمد على القوة في البقاء بدلاً من الشرعية في الحكم.
ثانياً: تفاقم الاحتقان السياسي وتصاعد وتيرة التوترات، فمن المتوقع أن يشهد المشهد السياسي تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الاحتقان السياسي، حيث ستتحول السلبية واللامبالاة السائدتين إلى غضب شعبي متصاعد، مع تزايد حدة الخطاب السياسي وتصلب المواقف بين النظام ومعارضيه، وهذا الاحتقان سينعكس على شكل احتجاجات متفرقة ومظاهر متعددة للرفض، مما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي.
ثالثاً: تحول الخطاب المعارض من السياسي إلى الراديكالي، حيث سيؤدي إغلاق قنوات المشاركة السياسية السلمية إلى تحول تدريجي في خطاب المعارضة من المطالبة بالإصلاح إلى الدعوة للتغيير الجذري، حيث ستفقد المعارضة السياسية التقليدية مكانتها لصالح التيارات الراديكالية، التي تتبنى خطاباً أكثر تشدداً وأقل استعداداً للتفاوض، وهذا التحول سيعمق الاستقطاب المجتمعي ويفتح الباب أمام تصاعد العنف السياسي.
وهذه التداعيات المتسلسلة تشكل خطراً وجودياً على الاستقرار الوطني، حيث تخلق حلقة مفرغة من انعدام الشرعية يؤدي إلى احتقان سياسي، ينتج عنه تصاعد في الخطاب الراديكالي، مما يقود إلى مزيد من التضييق ويفاقم بدوره أزمة الشرعية.
التداعيات الاقتصادية: سيكون للاستمرار في النهج السياسي الحالي تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة، تهدد بانهيار المنظومة الاقتصادية من خلال ثلاث آليات رئيسية:
أولاً: استمرار هيمنة تحالفات المصالح الضيقة على مقدرات الاقتصاد الوطني، حيث سيؤدي استمرار الوضع الراهن إلى ترسيخ سيطرة شبكات المصالح الضيقة على مفاصل الاقتصاد، وتتحول السياسات الاقتصادية من أدوات لتحقيق التنمية الشاملة إلى آلات لتعظيم ثروات النخبة الحاكمة وتحالفاتها، وهذا الأمر سينتج عنه تشويه هيكلي لأسواق البلاد، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى غنيمة تتصارع عليها مجموعات المصالح، على حساب العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ثانياً: تفاقم ظاهرة الفساد المؤسسي واستشرائه في ظل غياب الرقابة البرلمانية، حيث يؤدي استمرار تهميش الدور الرقابي للبرلمان إلى تفشي ظاهرة الفساد بمستويات غير مسبوقة، ويتحول الفساد من ممارسات فردية إلى نظام مؤسسي متكامل، فغياب المحاسبة والشفافية سيفتح الباب أمام إهدار المال العام، والتراخيص غير المشروعة، والعقود الوهمية، مما يستنزف موارد الدولة ويحرم المجتمع من عوائد التنمية الحقيقية.
ثالثاً: تدهور مناخ الاستثمار نتيجة عدم الاستقرار السياسي المزمن، فسيدفع عدم الاستقرار السياسي والاحتقان المجتمعي إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، حيث تتحول مصر من سوق واعد إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال، هذا التراجع سيؤدي إلى هروب الأموال المستثمرة، وتجميد المشروعات، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وبطء وتيرة النمو الاقتصادي، مما يفاقم مشاكل البطالة والفقر ويوسع رقعة الحرمان الاجتماعي.
وهذه التداعيات المتشابكة تخلق حلقة مفرغة من التدهور الاقتصادي، حيث يغذي الفساد سوء توزيع الثروة، مما يزيد الاحتقان السياسي، الذي بدوره يضعف البيئة الاستثمارية، لينعكس سلباً مرة أخرى على النمو الاقتصادي ويفاقم الأزمات الاجتماعية.
التداعيات الاجتماعية: سيؤدي استمرار الأزمة السياسية دون حلول جذرية إلى تداعيات اجتماعية عميقة تهدد البنية المجتمعية من خلال ثلاث ظواهر خطيرة:
أولاً: اتساع الفجوة الهيكلية بين الدولة والمجتمع وتحولها إلى قطيعة مؤسسية، ستعمق الشرخ بين مؤسسات الدولة والمواطنين، حيث تتحول العلاقة من توتر مؤقت إلى قطيعة هيكلية دائمة، وهذا الانفصام سيظهر في تراجع مستوى الثقة في كل المؤسسات الرسمية، وتصاعد خطاب الرفض والعداء للدولة كمؤسسة، وتحول العلاقة من تعاقد اجتماعي إلى صراع وجودي، مما يقوض أسس العيش المشترك ويُضعف الولاء الوطني.
ثانياً: ترسيخ ثقافة اللامبالاة السياسية كسلوك مجتمعي مزمن، حيث يؤدي إخفاق المحاولات المتكررة للإصلاح إلى تحول اللامبالاة السياسية من موقف مؤقت إلى سمة دائمة في الشخصية المصرية، وهذا التحول سينتج عنه مجتمع منقسم إلى فئتين: أقلية محتجة تعبر عن غضبها بطرق غير تقليدية أو غير مشروعة، وأغلبية صامتة تختار الانسحاب الكامل من الحياة العامة، مما يفقد المجتمع حيويته وقدرته على المشاركة في صنع مستقبله.
ثالثاً: استمرار نزيف الكفاءات وهجرة العقول كنتاج طبيعي لغياب الأمل في التغيير، فتتحول هجرة الكفاءات من ظاهرة مؤقتة إلى نزيف دائم للموارد البشرية، حيث يختار الشباب الطموح والمتخصصون المتميزون الهجرة كحل وحيد لتحقيق طموحاتهم، وهذا النزيف لن يقتصر على الخسارة الكمية في رأس المال البشري، بل سيشمل خسارة نوعية للطاقات الإبداعية والقدرات القيادية التي تشكل عماد أي تنمية حقيقية، مما يحكم على المجتمع بالجمود والتخلف على المدى الطويل.
وهذه التداعيات تشكل معاً حلقة مفرغة من التدهور الاجتماعي، حيث يغذي انعدام الثقة اللامبالاة، وتقود اللامبالاة إلى هجرة الكفاءات، مما يفقد المجتمع قدرته على الضغط من أجل التغيير، فيدخل في دوامة من التدهور يصعب الخروج منها.
النداء الأخير قبل الغروب: نحو فلسفة إصلاحية مصرية
تبقى الحقيقة الفلسفية التي لا مفر من مواجهتها هي أنه يستحيل بناء نظام سياسي مستقر ودائم على أسس هشة من الإقصاء الممنهج والتهميش المتعمد، فالتجارب التاريخية عبر العصور تثبت أن الاستقرار القائم على القمع يشبه بناء القصور فوق براكين، قد يبدو راسخاً للحظة، لكنه محكوم عليه بالزوال عند أول اختبار حقيقي، والإصلاح في هذا السياق لم يعد خياراً يمكن تأجيله، أو ترفاً فكرياً يمكن الاستغناء عنه، بل تحول إلى ضرورة وجودية تمثل شرطاً أساسياً لاستمرارية الدولة المصرية ذاتها.
إن الخيار الذي تواجهه النخبة الحاكمة في مصر يحمل في طياته مصيراً وجودياً: إما الشروع الفوري في عملية إصلاح حقيقية وشاملة تعيد بناء الشرعية السياسية على أسس سليمة من المشاركة والتمثيل الحقيقي، أو المخاطرة بانهيار كامل للشرعية يصاحبه تداعيات لا يمكن تصورها على كل المستويات، وهذا الخيار يشبه مفترق الطرق التاريخي الذي لا يسمح بالتردد أو المناورة.
وفي هذه اللحظة المصيرية، تظل كلمات الزعيم الوطني الخالد سعد باشا زغلول تتردد كنداء خالد عبر الزمن: "الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة"، إنها ليست مجرد شعارات تاريخية، بل تمثل فلسفة حكم متكاملة تضع الحقوق والحريات في المقام الأول، وتؤكد أن الحكومة مجرد أداة في خدمة الأمة، وليس العكس.
حان الوقت لكي تعود مصر إلى هذا المنطق الأصيل، فتختار طريق الإصلاح الجذري والشامل قبل أن يمضي القطار، وقبل أن يجف حبر الفرصة الأخيرة، فالوقت ليس في صالح الترقيع، والشعب المصري لم يعد يقبل بأنصاف الحلول أو الوعود الجوفاء، فالمستقبل ينتظر من يمتلك الشجاعة لاختيار طريق الإصلاح قبل فوات الأوان.
هذا التحليل يمثل رؤية فلسفية تحليلية تستند إلى معطيات الواقع المصري وتطورات المشهد السياسي، ويسعى لتقديم إضافة نوعية للنقاش الدائر حول مستقبل الإصلاح السياسي في مصر...
-----------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش
الجزء الأول من المقال
البرلمان المصري بين ختم الإذعان ومفتاح التغيير