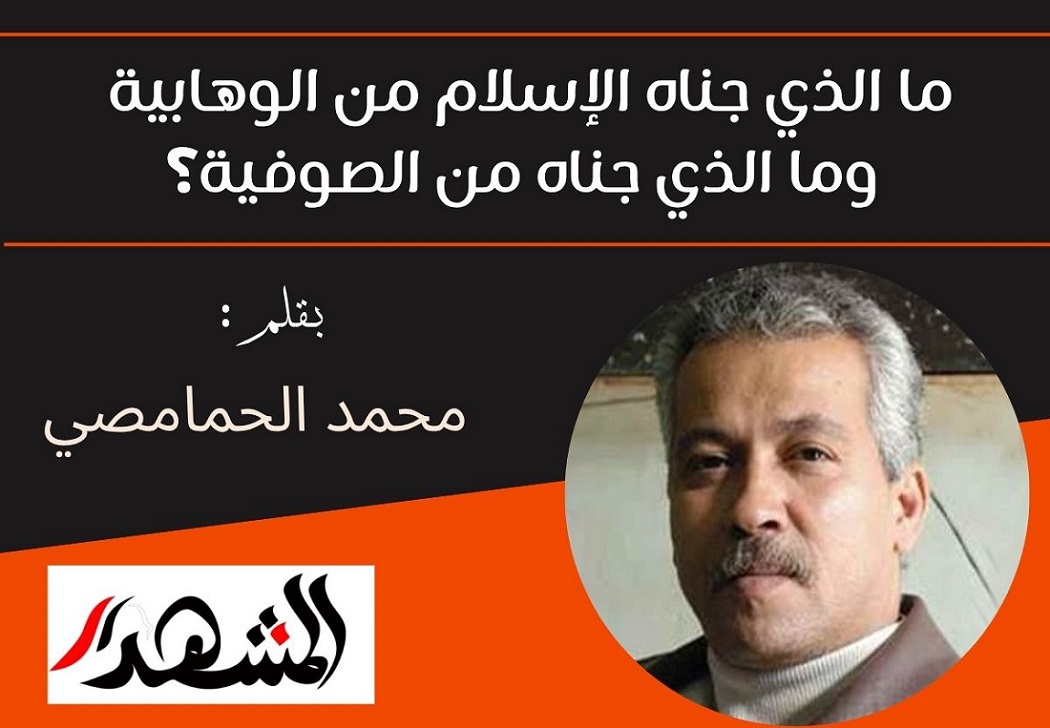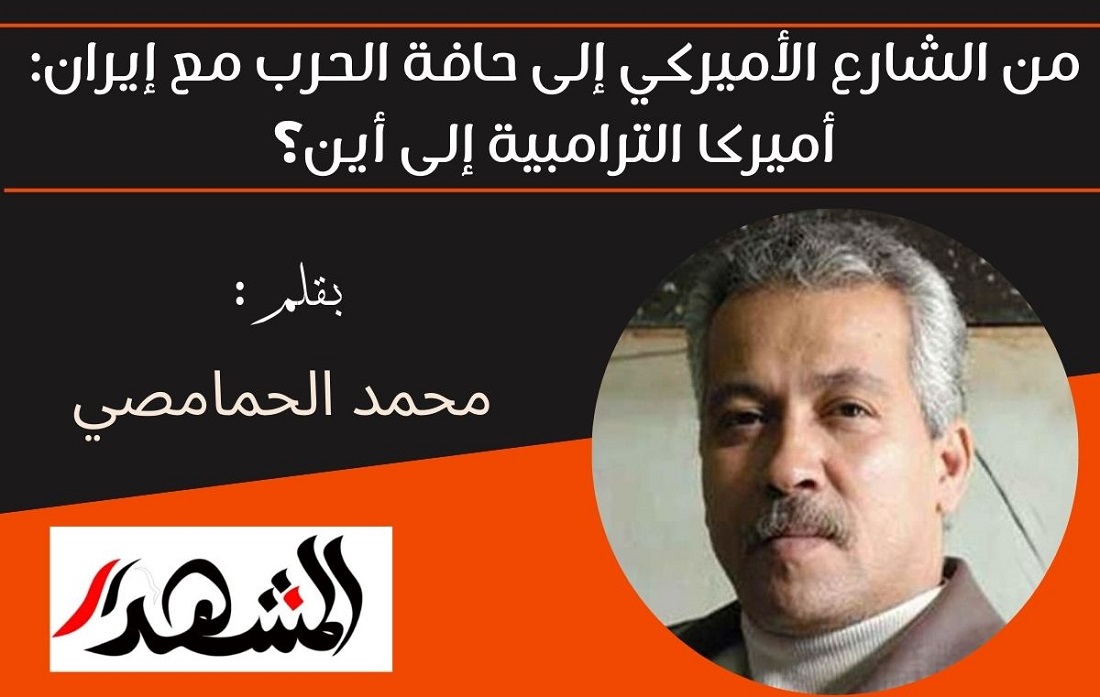منذ نشأة الدعوة الوهابية في القرن الثامن عشر على يد محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، والإسلام يعيش أحد أخطر مراحل تحوّله في نظر العالم الخارجي والداخلي معًا. تلك الحركة التي رفعت شعار “تجديد الدين وتنقيته من البدع”، انتهت إلى تشويه صورته وإفقاد جوهره الإنساني والروحي، فيما كانت الصوفية ـ في المقابل ـ تبني عبر قرون طويلة نموذجًا حضاريًّا وروحيًّا جماليًّا قدّم الإسلام للعالم في ثوب التسامح، والإبداع، والمحبّة، والصفاء.
تستند الوهابية في أساسها إلى فكر ابن تيمية الذي أعيد إحياؤه بصورة متشددة ومنغلقة. فمحمد بن عبد الوهاب في كتابه “التوحيد الذي هو حق الله على العبيد” جعل كل ممارسة دينية غير منصوص عليها حرفيًا بدعة تفضي إلى الكفر، بما في ذلك التوسل بالأولياء أو الاحتفال بالمولد النبوي أو زيارة القبور. وهو ما مهّد لولادة فكر إقصائي ينفي الآخر المسلم قبل غيره.
حين تحالفت الوهابية مع القوة السياسية الصاعدة ـ الدولة السعودية الأولى ـ عام 1744، تحولت الدعوة إلى مشروع سياسي توسعي، اعتمد على السيف والتكفير معًا. تشير المصادر التاريخية، مثل "تاريخ نجد" لعثمان بن بشر، إلى أن الوهابيين اعتبروا أنفسهم “الفرقة الناجية”، وأنّ كل من خالفهم في العقيدة أو الطقوس "كافر حلال الدم والمال". فدمرت مدن ومقابر ومساجد في الحجاز والعراق وسوريا بدعوى "هدم الشرك"، وكان أبرزها هدم قبور البقيع سنة 1806.
ومع القرن العشرين، لم تبقَ الوهابية حركة محلية، بل تحولت مع الثروة النفطية إلى أيديولوجيا عابرة للحدود. فقد موّلت المؤسسات السعودية، منذ السبعينيات، آلاف المدارس الدينية والجمعيات التي نشرت فكرها في آسيا وإفريقيا وأوروبا. ومع أن هذا بدا ظاهريًا دعوة للتوحيد، إلا أن مضمونها الحقيقي كان تكريسًا لفكر يختزل الدين في طقوس جامدة وفتاوى تحريضية.
وقد رصد المفكر الفرنسي أوليفييه روا في كتابه "الإسلام والعولمة" أن الوهابية ساهمت في إنتاج جيل من المتطرفين المعزولين عن الثقافة والإنسانية، وأنها شكلت الأرضية الفكرية التي غذّت حركات مثل "القاعدة" و"داعش" و"هيئة تحرير الشام" و"جبهة النصرة" وغيرها. كما أكدت الباحثة البريطانية كارين أرمسترونغ في كتابها "الإسلام في مرآة الغرب" أن الخطاب الوهابي "ألغى البعد الروحي والأخلاقي في الإسلام لصالح رؤية عقابية متسلطة جعلت الدين يبدو أمام العالم كمنظومة عنف لا كرسالة رحمة".
الوهابية إذن لم تُجدّد الدين، بل جفّفته. حولته من تجربة إيمانية حية إلى جهاز رقابي يطارد النوايا ويكفّر المخالف. شوّهت صورة الإسلام في الإعلام والوعي الغربي، ودفعت البشرية إلى الربط بين "الإسلام" و"الإرهاب" في القرن الحادي والعشرين. ولم تقدّم فكرًا إبداعيًا أو فلسفة أخلاقية أو منجزًا ثقافيًا واحدًا يمكن أن ينهض بروح الإنسان، بل أنجبت خطاب الكراهية والقتل والفتاوى العبثية.
على النقيض من ذلك، قدّمت الصوفية منذ القرن الثالث الهجري الإسلام في أجمل وجوهه: دينًا للحب والمعرفة، لا للتكفير والوعيد. لم تكن الصوفية بدعة كما رآها الوهابيون، بل كانت استجابة روحية عميقة للبحث عن الله في الإنسان، وللسعي إلى تزكية النفس وتحريرها من الأهواء.
كتب الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه أن "طريقنا هذا مبنيّ على الكتاب والسنة"، وقال الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه "اعمل بالشريعة ورافق الحقيقة". أي أن التصوف لم يكن خروجا عن الإسلام بل تعميقًا لمعناه.
بفضل الصوفية، انتشر الإسلام في شرق آسيا وإفريقيا دون سيف ولا حرب. فزوايا الصوفية في الهند، وإندونيسيا، والمغرب، وبلاد السودان، كانت مدارس للتربية والتسامح. ويكفي أن نذكر أن شخصيات عظيمة مثل جلال الدين الرومي، محيي الدين بن عربي،الحلاج، رابعة العدوية، النفري، وعبد السلام بن مشيش وأبو الحسن الشاذلي، وابن عطاء الله السكندري وعبد الحليم محمود وعبد الغني النابلسي وغيرهم، الذي شكّلوا مدرسة روحية ألهمت كبار مفكري الغرب مثل غوته، وإمرسون، ونيتشه، وهنري كوربان.
فبينما أنبتت الوهابية جماعات القتل والدمار، أنبتت الصوفية أدبًا، وشعرًا، وفلسفةً، وموسيقى، وفنًّا، جعلت الإسلام مرادفًا للسلام والجمال. وفي حين أغلقت الوهابية باب الاجتهاد، فتحت الصوفية باب التأمل والتجربة الشخصية، فأطلقت العنان للعقل والقلب كي يفهما الدين في ضوء الرحمة الإلهية.
وقد كتب المستشرق الألماني أنماريوس شميل في كتابه "الأبعاد الصوفية في الإسلام" أن التصوف "هو الذي أنقذ الإسلام من أن يتحول إلى منظومة فقهية جامدة، وهو الذي حمل جوهر الروح الإسلامية إلى آفاق الإنسانية العالمية".
وحتى داخل العالم الإسلامي، كانت الصوفية عامل توازن واستقرار. فطرقها وزواياها احتضنت الفقراء والمهمشين، وربطت الدين بالحياة اليومية وبالفن، لا بالعقاب. فالأذكار والإنشاد والاحتفال بالمناسبات الدينية تحولت إلى ممارسات جماعية تبني الروح الجماعية وتُعلي من قيم المحبة والتآخي.
الحصيلة التجربتين: ما الذي جناه الإسلام إذن؟.. من الوهابية، ورث انقسامًا وتكفيرًا وتشويهًا في الوعي العالمي، وأجيالًا من المتطرفين الذين لا يرون في الدين إلا العداء والدم. ومن الصوفية، ورث ثقافة التسامح، والروحانية، والفن، والحكمة، وجعل الإسلام دينًا قادرًا على الحوار مع العالم، لا الصدام معه.
لقد أنتجت الوهابية ثقافة "التحريم" فيما أنتجت الصوفية ثقافة "الإلهام". الوهابية فصلت الله عن الإنسان، والصوفية جعلت الله حاضرًا في كل ذرة من الوجود. الأولى جعلت الإسلام يخاف من الجمال، والثانية جعلت الجمال طريقًا إلى الله.
وحين ننظر إلى الأثر الحضاري، نجد أن الوهابية لم تقدّم عالِمًا واحدًا في الفلسفة أو الآداب أو الفنون، بينما تركت الصوفية إرثًا أدبيًا وفنيًا هائلًا، من المثنوي إلى الفتوحات المكية إلى ديوان الحلاج، وصولًا إلى الفكر الأخلاقي والعرفاني الذي أعاد تشكيل الوعي الإنساني في الشرق والغرب.
الخلاصة أن الإسلام لا يُقاس بمن يرفع شعاره، بل بما يقدّمه للعالم من قيم ومعانٍ. والوهابية، مهما ادّعت نصرة التوحيد، شوّهت الإسلام، وأنبتت التطرف والعنف، وقضت على روحه الإنسانية. أما الصوفية، فقد نقّت الإسلام من الشكليات، وجعلته دينًا عالميًا يتكلم لغة القلب والعقل، وترك سادتها وأولياؤها تراثًا خالدًا من المحبة والمعرفة ألهم المفكرين والفنانين في الشرق والغرب. وهكذا، إذا كانت الوهابية قد زرعت في العالم خوفًا من الإسلام، فإن الصوفية زرعت فيه حبًّا له.
-----------------------------
بقلم: محمد الحمامصي