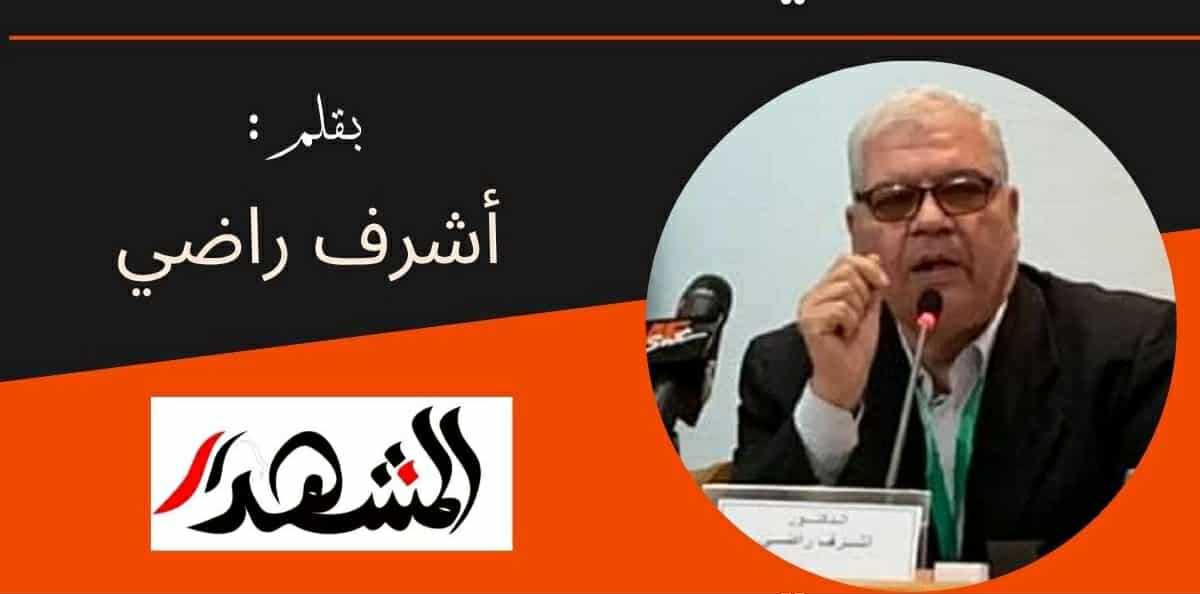لا يكتفي خصوم الرئيس الراحل أنور السادات بتحويل ذكرى يوم نصر أكتوبر إلى يوم ذكرى اغتياله وهو يحتفل بذكرى النصر، لكنهم مصرون، على ما يبدو، على أن تصبح هذه الذكرى في كل عام، مناسبة للطعن في الرجل وتشريح سياساته، بل أمعن عبود الزمر، أحد المتهمين في حادث المنصة، وأبرز خصوم السادات في الانتقام من الرجل بعد مرور أكثر من 30 عاما على رحيله، بأن استغل وجود حلفائه في السلطة لإخراج سيارة الرئاسة المكشوفة التي كان يستقلها الرئيس السادات من المخازن ليستقلها لحظة دخوله ساحة استعراض الاحتفال بذكرى أكتوبر في عام 2012، في خطوة استفزت مشاعر كثير من المصريين وكانت من النقاط التي سجلوها ضد الجماعة التي كانت تحكم مصر آنئذٍ. لم يكتف خصوم الجيوش العربية التي حاربت في أكتوبر 1973 بالانتقام من الأشخاص، بل امتد إلى الجيوش، التي اعتبروها مانعًا يحول دون تمكينهم من السلطة، إلى حد إلغاء الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، مثلما فعلت حكومة أحمد الشرع في سوريا. غير أن العداء للسادات لا يقتصر على جماعات الإسلام السياسي التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، بل يمتد إلى أطياف كثيرة من التيارات القومية والناصرية واليسارية، وبعض المحسوبين على أحزاب تدعي الليبرالية، وهذه مسألة تسترعي الانتباه وتستدعي التأمل والتفكير في محاولة للتفسير.
لم أكن أخطط لكتابة هذا المقال مكتفيًا بما أكتبه إنصافًا للرجل، سواء في قرار الحرب في عام 1973 واستراتيجيته في إدارتها، وفي سعيه لتحقيق الهدف النهائي للحرب بكل الوسائل الممكنة، وهو تحرير كامل التراب الوطني المصري وإخراج قوات الاحتلال من سيناء، وفي الحالتين فعل ذلك استنادًا إلى قراءة دقيقة للمشهد الدولي والإقليمي وتقدير القدرات المتاحة لمصر أو التي تستطيع تدبيرها، لكن دفعني لكتابة هذا المقال ما كتبه الصديق العزيز عمرو عبد الرحمن على حسابه على الفيسبوك يوم (9 أكتوبر)، والذي أشار إلى أن "من الواجب تسجيل الامتعاض والانزعاج من استخدام" مناسبة الاحتفال بذكرى أكتوبر "لتطويب السادات والانتصار لرؤيته التالية عن السلام والتطبيع مع إسرائيل". ورأيت في تعليق الصديق العزيز وهو باحث مرموق في العلوم السياسية، تحميل السادات ومبادرته لاستعادة الأراضي المصرية كامل المسؤولية، على نحو قد يصل إلى حد اتهام الرجل بالتآمر والخيانة، وقال بالحرف إن السادات يتحمل مسؤولية "كاملة وحصرية" عن تمكين إسرائيل من استعادة إسرائيل زمام المبادرة على الجبهة المصرية وتحقيق اختراق عسكري في الثغرة، بسبب قرارين أخدهما بالمخالفة لرأي كل القادة العسكريين الميدانيين في الجيش المصري، وأحالنا لتدعيم وجهة نظره إلى عدد من المذكرات، من بينها مذكرات حاييم هرتزوج، والد رئيس إسرائيل الحالي ومذكرات عدد من القادة العسكريين بخلاف مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي. وقلت رأيي في اعتماد المذكرات كمصدر وحيد لتوثيق الحرب في مقالي بعنوان "التجديد الواجب لذكرى حرب أكتوبر"، المنشور على موقع جريدة المشهد يوم 7 أكتوبر.
القراران اللذان أشار إليهما يحتملان تفسيرات وتقييمات أخرى، وأدعو إلى ترتيب ندوة يشارك فيها خبراء عسكريون ومحللون استراتيجيون وباحثون ممن أجروا دراسات عن حرب أكتوبر في محاولة جادة للتقييم والوقوف على حقيقة ما جرى، غير أن مثل هذا النقاش ليس بديلًا عن الدعوة التي وجهتها في مقالي السابق، لكنها ضرورية إلى أن تحين لحظة كتابة سردية عن الحرب تحظى بأكبر قدر من التوافق عليها لتكون مكونًا أساسيًا من مكونات بناء الذاكرة الوطنية المعاصرة. وأشير هنا إلى أن العسكريين المصريين على اختلافاتهم وتوجهاتهم يتحدثون كثيرًا عن روح أكتوبر، التي يرى كثير منهم أنها غائبة الآن، وكيف يمكن أن تكون هذه الروح التي تستلهم الدروس الأساسية لحرب أكتوبر أن تكون نقطة انطلاق لعبور مصر إلى المستقبل، أما أن يُترك تقييم حدث على هذا القدر من الأهمية والخطورة ليدلي فيه المختصون وغير المختصين بآراء تعكس توجهات وتحيزات سياسية مع السادات وسياساته، فهذا أمر بالغ الخطورة على سلامة الحس الوطني العام، ولن يخرجنا من دائرة "التخوين"، التي يعلن جميع الفرقاء نبذه ورفضه، سوى الاحتكام إلى الدراسات الرصينة وغير المدفوعة بتحيزات ومواقف مسبقة للوقوف على الحقيقة استناداً إلى معلومات وحقائق والاحتكام إلى منطق التحليل والبحث العلمي، بديلًا عن ذلك النوع من الخطاب الذي يهمين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من منصات إعلامية، والذي لا يفيد سواء فيما يخص بناء الذاكرة الوطنية المشتركة، أو في بناء التوافق العام حول التوجهات الأساسية للدولة المصرية واختياراتها الوطنية، وإنهاء ذلك الخلط بين الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية والتضامن الواجب مع الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وهي حالة تؤدي إلى التجرؤ على مصر وقيادتها.
الحرب والسلام وتغيير الوضع الراهن
إن الكتابات عن الثغرة وحصار الجيش الثالث في السويس كثيرة، منها مثلاً كتاب السيد محمد حافظ إسماعيل "أمن مصر القومي"، الذي شغل منصب مستشار الرئيس السادات لشؤون الأمن القومي، والذي كلف بتولي قناة الاتصال السرية التي تم فتحها مع الولايات المتحدة، كجزء من استراتيجية الخداع المصرية قبل الحرب. إن كثيرًا من التعليقات التي تقال عن حرب أكتوبر لا تعكس أي مستوى من الدراية أو الخبرة سواء في مجال العسكرية أو الاستراتيجية، أو حتى العلاقات الدولية، وتعتمد فقط على ما قاله السيد محمد حسنين هيكل تعليقًا على الوثائق التي نشرها بين دفتي كتابه عن أكتوبر الذي حمل عنوان "أكتوبر ٧٣ .. السلاح والسياسة"، والتي يمكن قراءتها من أكثر من زاوية وتوظيفها لأكثر من غرض من أغراض البحث والدراسة. وقد اعتمدت على الوثائق المنشورة في هذا الكتاب في دراسة منشورة في مجلة "السياسة الدولية" الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، والتي عرضت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ملخصًا لها ضمن ملخصات الأبحاث التي تضيف إلى البحث العلمي في موضوعات شتى. إن الفرضية الأساسية التي تقوم عليها معارضة التيارات غير الإسلامية للسادات تتأثر بشدة بموقفهم من إسرائيل وطريقة التعامل معها، ومن المهم هنا، طرح بعض السيناريوهات التي قد تترتب على موقفهم هذا، لو ان الرئيس السادات لم يقم بمبادرة في نوفمبر عام 1977، والتي أطلقت ما يعرف بعملية السلام وهي العملية التي انخرطت فيها أطراف عربية أخرى غير مصر.
إذا كان الهدف الذي يتطلع إليه الجميع هو تغيير الوضع بالنسبة للقضية الفلسطينية وتعديل ميزان القوة المختل بشدة لصالح إسرائيل، في الوقت الراهن على الأقل ولأسباب لا نختلف عليها، ألا يجد بناء التفكير في الوسائل المختلفة التي تقربنا من تحقيق هذه الهدف، خصوصًا الوسائل المتاحة لدينا والتي يمكن الاعتماد عليها. لقد طرحت سؤالًا في ندوة نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في مطلع الأسبوع الحالي بمناسبة ذكرى أكتوبر، للتفكير فيه استند إلى مقارنة عقدتها في مقالات سابقة بين ما حققه النهج التفاوضي وما حققه نهج الكفاح المسلح، وهو سؤال يثير امتعاض واستياء كثير من مناهضي التطبيع، رغم أن السؤال لا علاقة له بمسألة التطبيع. والتمييز بين السعي للسلام والتطبيع واضح في أذهان كثير من القوى المنتمية إلى "معسكر السلام" الذي تراجع بشدة في إسرائيل منذ اغتيال إسحق رابين، رئيس الوزراء على يد متطرف يهودي، في 4 نوفمبر عام 1995، بل نجد جماعات مثل "بتسيلم" و"جوش شالوم" و"حركة السلام الآن"، منخرطة بقوة في أنشطة داعمة لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية والأسواق الخارجية، وتزود المؤسسات الحريصة على عدم انتهاك القانون الدولي بمعلومات عن هذه المنتجات لإدراجها على قوائم المقاطعة التجارية.
لا يُمكن فهم مثل هذه الفروق لمن يصر على تبني تصورات عامة لا تركز في التفاصيل ويرفض انتهاج أي وسيلة لتغيير الوضع القائم سوى الكفاح المسلح والمقاومة المسلحة، الذين يكثر تواجدهم في المعسكر الكاره للسادات، الذين يكيلون له من الاتهامات التي تصنف ضمن السب والقذف لرجل رحل عن عالمنا أكثر مما تنتقد سياساته وتقيمها، والحقيقة أن هذا الموقف يتجاوز الخصومة السياسية والشخصية، ويبنون موقفهم من المذكرات على أساس مدى الاقتراب أو الابتعاد عن رؤية السادات على النحو الذي أوضحته في تقديمي لمقالي على حسابي على الفيسبوك تعليقا عن ندوة اللواء حمدي بخيت. وللإنصاف نشير إلى أن الدكتور عمرو عبد الرحمن كان منصفا في تقييمه النهائي للسادات حين حسب له "جرأته في اتخاذ قرار الحرب ... بالرغم من الخلل الفادح في موازين القوى"، وتصديه بحزم للرؤى الانهزامية ولروح الاستسلام، التي وجدت حتى في قيادة القوات المسلحة والتي تبناها عدد من القادة العسكريين، لكنه سرعان ما تراجع عن هذا بطرح أمور تستدعي ما يتجاوز الدراسة والتقييم إلى إجراء تحقيق مستقل لكي ينال كل مسؤول ما يستحق من إشادة أو إدانة، فالمسألة مسألة تلميع لقائد أو زعيم أو الحط من شأنه، بالفعل المسألة مسألة الإنجاز الذي حققه المصريون جميعا في أكتوبر، وهل أهدر هذا الإنجاز أم لم يهدر لكننا لم نفعل ما يجب علينا لوضعه في سياقه الذي يستحق في تاريخ مصر، وإنما في استحضار دروسه واستلهامها في اللحظة الراهنة، وأيضا إجراء تقييم شامل للخطوات التي اتبعها الرئيس السادات والقيادة السياسية والعسكرية لاحقًا، سواء في اتفاقيتي فض الاشتباك الأول والثاني، أو في زيارة القدس وما ترتب عليها من نتائج، وتقييم مسؤوليتها عن التطورات اللاحقة التي تغفل وقائع مهمة في تاريخ المنطقة، ومن بينها ثم الحرب الأهلية في لبنان (1974 -1990)، وضرب المفاعل النووي العراقي في 17 يونيو عام 1981، وهو الهجوم الذي يُلام فيه الرئيس السادات، دون أن يسأل أحد عن رد فعل العراق الذي كان يخوض حربًا مع إيران، بررها الطرفان بالسعي لتحرير القدس، ثم الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982، وما أعقبه من خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت وإبعادها إلى تونس، التي انتقل إليها مقر جامعة الدول العربية بسبب المقاطعة العربية لمصر التي استمرت حتى نهاية الثمانينات، والانتفاضة الفلسطينية أواخر عام 1987، ثم الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام 1990، وما ترتب عليه من انقسام في العالم العربي، وكان نقطة تحول في العلاقات الخليجية الفلسطينية وكان لها تأثيرات بعيدة المدى على القضية الفلسطينية. لقد مرت عقود على زيارة القدس التي كان تقدير السادات أنها ضرورية لتحقيق الهدف الرئيسي من الحرب، وهو طرد قوات الاحتلال من الأراضي المصرية وتحرير مرتفعات الجولان السورية التي لا تزال محتلة، ولم تتمكن سوريا إلى الآن من تحريرها بالحرب أو بالمفاوضات.
لنفترض مثلًا، أن الرئيس السادات لم يبادر بخطوة زيارة القدس، وعادت مصر إلى حالة اللاسلم واللاحرب، التي سادت على الجبهة المصرية بعد قبول "مبادرة روجرز" في عام 1970 ووقف حرب الاستنزاف التي استمرت ثلاث سنوات، كيف كان الوضع في سيناء التي استرجعتها مصر بشروط فرضتها معاهدة السلام. هناك عسكريون مصريون مشهود لهم بالاستقلالية ويعارضون السادات في كثير من قراراته يقولون إنه حتى بالرغم من القيود التي تفرضها اتفاقية السلام، فإن التواجد العسكري المصري في سيناء يفوق بفارق كبير تواجد القوات قبل حرب 1967، وإذا أخذنا في الاعتبار التطورات اللاحقة بسبب الحرب على الإرهاب والتي ما كان يمكن أن تحدث لولا استقرار معاهدة السلام، فإن وضع القوات المسلحة المصرية في سيناء أفضل بمراحل ويمثل قوة ردع حقيقية في وجه أي مغامرة أو تهور من الجانب الآخر. ونتساءل بشكل واضح، هل الوضع الآن على الجبهة السورية أفضل من الوضع على الجبهة المصرية؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب قدرًا كبيرًا من الصراحة مع الذات والشجاعة.
إننا في حاجة إلى إعادة تفكير تزيل ذلك التعارض المصطنع بين المقاومة بأشكالها المختلفة، بما في ذلك المقاومة المسلحة للسياسات التوسعية والعدوانية لإسرائيل وبين التفاوض السياسي والعمل الدبلوماسي لتحقيق الغاية ذاتها، إعادة تفكير تنقلنا من منطق المقاطعة إلى منطق المواجهة الشاملة ووضع حدود للسياسة الإسرائيلية وتفكيك التحالف الدولي الداعم لإسرائيل، ويتطلب هذا إعادة تقييم واجبة لإدارة السادات للصراع مع إسرائيل وتقييم حدود مسؤولية التحرك من أجل الدفاع عن مصالح مصر الوطنية عن التدهور اللاحق في ميزان القوة الإسرائيلي-العربي، وعلاقة هذا التدهور بالانقسام الذي أحدثه الغزو العراق للكويت في النظام الإقليمي العربي، وبمجمل التحولات التي حدثت في بنية هذا النظام بعد حرب 1973. علينا التفكير في كل هذه التطورات بدلًا من إلقاء المسؤولية كلها على مصر واختياراتها. ولنفترض مسارًا آخر للأحداث يتصور حدوث ما أقدمت عليه دول عربية في السنوات القليلة الماضية من إبرام اتفاقيات مع إسرائيل، حين سبقت مصر الدول العربية على هذا الطريق أو لو كان الفلسطينيون ضغطوا من اجل المشاركة في عملية السلام في ذلك الوقت، كيف كان يمكن أن يكون الحال؟ حتى بعد بدء مؤتمر مدريد في عام 1991، لم تتبنى الوفود العربية المشاركة موقفًا موحدًا، حتى فيما يخص المسار المتعدد الأطراف؟، الأمر الذي منح لإسرائيل هوامش كبيرة للمناورة والتلاعب على تباين أولويات المشاركين العرب، بما يؤكد أن التضامن الذي أظهره العالم العربي في حرب أكتوبر كان قصير الأجل وغير قابل للتكرار.
وبدلًا من أن تكون حرب غزة مناسبة لإجراء مثل هذا المراجعة، وإخراج القضية الفلسطينية من تعقيدات وتشابكات السياسات الوطنية العربية، أبرزت هذه الحرب التناقضات والانقسامات وبات الموقف من المقاومة الفلسطينية مرهونا بالموقف من تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينظر لحماس على أنها جزء منها، كذلك أضعف تورط حزب الله في الحرب الأهلية السورية لدعم نظام الرئيس بشار الأسد موقفه كفصيل من فصائل المقاومة للسياسات الإسرائيلية. ربما كانت محاولة البعض الربط بين حرب أكتوبر عام 1973 وهجوم السابع من أكتوبر 2023، محاولة لإقامة هذا الجسر بين الحدثين اللذين سعيا لتغيير المعادلة وتعديل ميزان القوة المختل، لكن هذه الحرب عمقت الانقسام بين أنصار النهجين. إقامة حوار حول حرب أكتوبر واستراتيجية مصر في هذه الحرب وما بعده، وتحديد ما إذا كان الرئيس السادات أقدم على هذا الخطوات منفردًا دون أي دعم من أي قوى داخل مصر، أم أنه حظي بدعم قوى اجتماعية داخل مصر. وهل ما تحقق لمصر بسبب هذه السياسيات أفضل، وما الذي كان يمكن أن تجنيه مصر والقضية الفلسطينية إذا اختارت مصر نهجًا آخر غير نهج المفاوضات؟ والسؤال الأهم هل كان أمام مصر اختيارات أخرى وفضلت نهج المفاوضات عليها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: أشرف راضي