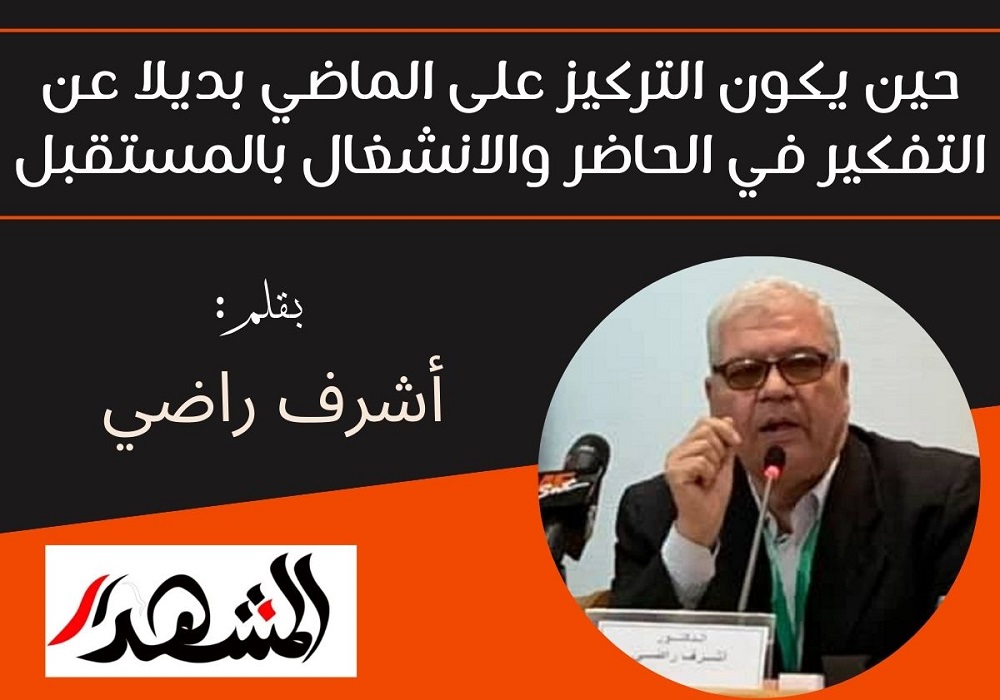لا أميل، عادة، للانخراط في السجالات التي تشتعل من حين لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بسبب انتقاد موجه لسياسات أو مواقف زعيم راحل. فالخلافات في مثل هذه السجالات تستند إلى انقسامات أيديولوجية بالأساس، ولا يكون لها تأثير، في الغالب، على السياسات الراهنة أو الخطط المستقبلية. وأشعر بانزعاج أكبر ممن يكرسون مجهودهم وطاقتهم لمهاجمة من يجرؤ على انتقاد زعيم يخلدونه أو سياسات ينحازون لها، لأن في ذلك الموقف مؤشر سلبي على مدى استعدادنا لتقبل التفكير النقدي، وعدم إدراك لأهمية الدور الذي يلعبه مثل هذا النوع من التفكير في تقدم المجتمعات، الأمر الذي يتجلى في دفع البعض بسرد الإيجابيات التي حققها الزعيم، رداُ على السلبيات التي يركز عليها المنتقدون.
قد ينزلق البعض في ردودهم إلى حد معايرة من يمارس حقه في النقد بأنه لولا سياسات الزعيم الذي ينتقده ما كان وصل إلى ما وصل إليه من مكانة وحيثية، وهو الأمر الذي حدث مع عمرو موسى وزير الخارجية والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عندما انتقد استبداد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وهو الانتقاد الذي أشعل وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية بسجالات حول عبد الناصر وسياساته، على نحو نشعر معه وكأن الاستبداد، الذي يُعد سمة أساسية للنظام السياسي المصري منذ عام 1952، كان حكراً على الحقبة الناصرية وحدها، أو كأن الإيجابيات التي حققتها السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية في مرحلته، مبرر يسوغ له الاستبداد.
حول الإيجابيات والسلبيات
أتذكر أنني تقدمت في أوائل الثمانينات ببحث لمسابقة نظمتها جامعة الزقازيق حول "سلبيات وإيجابيات الثورة العرابية". وفاز البحث بالمركز الأول، رغم أنني انتقدت في مقدمته الحكم على حدث كبير، مثل الثورة العرابية، من منظور الإيجابيات والسلبيات، وهو ما ألفناه في مقررات التاريخ التي ندرسها في مراحل التعليم المختلفة. لقد مارست في هذا البحث نقداً مزدوجًا للطريقة التي ندرس بها التاريخ وكذلك للعنوان الرئيسي للمسابقة. وأظن أن البحث فاز نظراً للالتزام بقواعد البحث العلمي واستناده إلى قائمة كبيرة نسبيًا من المصادر والمراجع وبسبب منهجيته، وهي أمور تدربت عليها جيدا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حين كنت طالبًا فيها في ذلك الوقت، وشفع هذا الالتزام لي بالخروج على المنهجية التي اختارتها اللجنة التي نظمت المسابقة وأشرفت عليها، وهم كوكبة من أساتذة التاريخ في جامعة الزقازيق.
أسرد هذه الواقعة، هنا، لتأكيد أن المنهج المتبع لدينا في تقييم أي حقبة تاريخية من منظور الإيجابيات والسلبيات، وهو المنهج الذي ميز معظم المداخلات في هذا السجال، هو منهج قاصر ولا يسهم في تقدم المعرفة والبحث، ولا يحقق الغرض الرئيسي المرجو من دراسة التاريخ، خصوصًا فيما يتعلق بمعرفة الحاضر واستشراف المستقبل. فما يعيشه وطننا اليوم لا ينفصل، بأي حال، عن السياسات التي اتبعت في فترات سابقة، سواء في المرحلة الناصرية أو ما قبلها أو ما بعدها. وسمح لي المنهج الذي طبقته في دراستي للثورة العرابية، أن أسلط الضوء على موقف النخبة المصرية في الفترة اللاحقة على هذه الثورة التي انتهت أحداثها بعد هزيمة الجيش المصري بقيادة عرابي أمام القوات البريطانية وهو ما أدى إلى احتلال مصر عسكريًا في عام 1882. ولم يكن انتقاد النخبة المصرية لعرابي و"هوجته"، وتحميله مسؤولية التصعيد الذي أدى إلى الاحتلال. إلا أن النخبة لم تقف عند هذا الحد وإنما سعت إلى استكشاف طرق ووسائل أخرى لمواصلة الكفاح الوطني لتحرير مصر من الاحتلال وتخليصها من استبداد القصر، وهو السعي الذي توج بثورة 1919، التي رفعت شعار "الدستور والاستقلال".
غير أن السجال الراهن حول عبد الناصر ومسؤوليته عما آلت إليه أوضاعنا، أو الرغبة في استدعائه، أو على الأقل استدعاء تجربته لمواجهة الأوضاع الراهنة على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي والدولي، لم يخل من بعض الاجتهادات المهمة التي طرحت تساؤلات تنشغل بالحاضر والمستقبل، مثل السؤال الذي طرحه الصديق العزيز عبد العظيم حماد حول كيفية تجاوز الدولة الناصرية. وأظن أنه سؤال في غاية الأهمية ويستحق منا التفكير والبحث عن إجابات. وسوف اجتهد في إجابته في مقال آخر.
مما يلفت النظر في هذا السجال الرغبة في استدعاء ناصر وتجربته للحظة الراهنة، رغم أن التجربة شهدت سلسلة من النكسات والأحداث التي أفضت، أيضًا، إلى هزيمة مصر في حرب عام 1967، واحتلال القوات الإسرائيلية لسيناء، ولم يستدع الرئيس الراحل أنور السادات وسياساته التي واصلت الجهود والاستعداد لحرب تحرير سيناء في عام 1973، ولا مبادرته التي استكملت، بوسائل سياسية، ما لم نستطع تحقيقه بالوسائل العسكرية، في حدود القدرات وميزان القوة الشامل. وهو سؤال اجتهد الزميل معوض جودة للإجابة عليه في مقاله المنشور من خلال موقع "المشهد"، أمس الثلاثاء. لقد طرح المقال قضية أخرى مهمة لا تقتصر على عقد مقارنة بين عبد الناصر والسادات، والتي تعكس أيضًا انقساماً حادًا فيما يخص الصراع مع إسرائيل وكيفية مواجهتها عسكريا وسياساتها. وهي قضية كتبت فيها كثيرًا، لكن من منظور مختلف، ينبه إلى ضرورة الفصل بين تشخيصنا للصراع وطبيعته ومساراته، وبين إدارة هذا الصراع والتكيف مع تحولاته. وهذا الانقسام يؤسس أيضاً على مواقف أيديولوجية في المقام الأول.
إن الدفع بالإيجابيات والتركيز على الإنجازات لموازنة السلبيات، ليس فقط منهجا قاصرا لتقييم مرحلة تاريخية، وإنما أبضًا منهج معيب ويعبر عن خلل أكبر في طريقتنا في التفكير في الشأن السياسي والشأن العام. فإلى جانب المسألة الخاصة بالتفكير النقدي الذي يفرض علينا التفكير في أسباب الفشل وفي العيوب والسلبيات بقصد التنبيه لها والتعامل معها، على الأقل لترسيخ الإيجابيات وتعزيزها، فإن الطريقة التي يجري من خلالها تناول مسألة الإيجابيات أو الإنجازات تعطي انطباعًا بأن هذه الإيجابيات والإنجازات، بغض النظر عن تقييمها الدقيق، ليست واجبًا والتزامًا على الحاكم، وإنما هي منحة منه وتفضل على هذا الشعب البائس الذي لا يجد من يحنو عليه. وتعكس هذه الطريقة خللًا أعمق في رؤيتنا وتقييمنا للعقد الاجتماعي الذي يفترض أنه الأساس لأي نظام سياسي مستقر وفعَّال.
قد يكون الحديث عن هذه النقطة مقدمة للإجابة على سؤال كيف نتجاوز الدولة الناصرية؟ وهو سؤال وثيق بالحاضر وبالمستقبل، والأهم أن فيه إشارة واضحة لطبيعة العقد الاجتماعي الذي يحكمنا منذ الخمسينات، والذي تناولته العديد من الأدبيات عن التاريخ السياسي لمصر.
عقد اجتماعي أم عقد إذعان
بغض النظر عن الموقف من عبد الناصر أو السادات وسياستهما، علينا أن نفكر تفكيرًا حرًا ونقديًا في طبيعة العقد الاجتماعي الذي تستند إليه العلاقة بين الدولة والمجتمع وبين السلطة والمحكومين، وهذه الطريقة تعكس بدرجة ما الأزمة الدستورية الممتدة في مصر منذ دستور 1923، الذي وضع قبل أكثر من مئة عام كمنجز من منجزات ثورتنا الوطنية الديمقراطية في عام 1919. وأطرح على القارئ سؤالًا للتفكير فيه بتروٍ، قبل القفز لتقديم إجابة عليه، ما هو العقد الاجتماعي الذي نستند إليه وما هي طبيعته؟ لقد تعرض دستور 1923، المستوحى من الدستور البلجيكي، للانقلاب عليه مرتين: الأولى في عام 1930، حين وضع رئيس الوزراء إسماعيل صدقي دستورا يناقض الفكرة الأساسية في دستور 1923، وهي تقييد صلاحيات السلطة ممثلة في القصر، لصالح فكرة السيادة الشعبية التي يجسدها البرلمان المنتخب والحكومة التي يشكلها الحزب الحاصل على أغلبية الأصوات. والمرة الأخرى بعد حركة الضباط الجيش في عام 1952، وإلغاء دستور 1923 وتأميم الحياة السياسية من خلال حل الأحزاب السياسية وظل الوضع في مصر يدار من خلال دساتير موقتة حتى عام 1971.
ويشير الانقلابان في عام 1930، وفي عام 1952، إلى إصرار السلطة على توسيع صلاحياتها من خلال السيطرة على السلطة التنفيذية وتركيزها في يد الحاكم، وتهميش السلطة التشريعية والبرلمان، والمناورة مع السلطة القضائية لتطويعها بما يخدم السلطة التنفيذية. ولم يغير دستور 1971، بتعديلاته المختلفة التي كان آخرها في مارس 2011، ولا الدساتير اللاحقة من هذا الترتيب للعلاقة بين الحاكم والمحكومين، وما ترتب عليها فيما يخص طبيعة العقد الاجتماعي، الذي يعد إلى حد كبير عقد إذعان تمتلك فيه السلطة تقرير التزاماتها وواجباتها وتغيير هذه الالتزامات والواجبات من طرف واحد ودون تقديم تنازلات كبيرة فيما يخص الضمانات المنصوص في الدستور بخصوص حقوق المواطنين، التي يجري تقويضها عبر سلسلة من التشريعات والإجراءات المقيدة للحريات. وكان لهذا الوضع تأثيرات خطيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على النحو الذي تكشفه تغير السياسات الاقتصادية من نظام التخطيط المركزي والاقتصاد الموجه بقرار من السلطة دون تشاور، ثم التعامل مع تبعات هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية عبر سلسلة من التشريعات والسياسات والبرامج التي تقدم جزئية للمشكلات التي تستفحل وتتفاقم نتيجة لهذه التشريعات إلى أن نصبح أمام وضع معقد يصعب التعامل معه، وهو ما يكشفه القانون الجديد الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والذي سار خطوة أبعد نتيجة لكثير من العوامل والاعتبارات الاقتصادية والسياسية والذي من المتوقع، حسبما تشير التقديرات، أن تكون له تداعيات اجتماعية خطيرة، تتطلب جهودا جبارة، لا أظن أن الحكومة في مقدورها التعامل معها دون إشراك للمجتمع وإجراء حقيقي ومنظم.
هناك فرصة لا تزال قائمة لوضع الأسس لمثل هذا الحوار المنظم والمشاركة المجتمعية الواسعة للتعامل مع الآثار المحتملة لهذا القانون من خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، على الرغم من عيوب قانون الانتخابات. من المأمول ألا تنضم هذه الفرصة إلى القائمة الطويلة من الفرص التي ضاعت على مصر في سبيل تطوير نظامها السياسي، على نحو يرسخ حقوق المواطنين ويوسع هامش الحريات بما يضمن تمثيلا سياسيا واجتماعيا يخفف من وطأة التغييرات الجذرية التي تحدثها السياسات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية والتي تتعامل مع مشكلات متراكمة ومعقدة ومتشابكة. إن من شأن هذه المشاركة أن تتعامل مع كثير من العيوب وأوجه القصور في المعالجات الراهنة والتي تعكس الغياب التام للاهتمام بالتطورات المستقبلية المحتملة والتي ترصدها الكثير من الدراسات الدولية والوطنية والتي يرتبط بعضها بتغيرات مناخية تقع خارج السيطرة. وهذا الغياب للاهتمام بالمستقبل ملمح آخر للبعد المتعلق بالإذعان في العقد الاجتماعي القائم.
قد يكون التفكير في تعديل العقد الاجتماعي مقدمة للتفكير في كيفية تجاوز الدولة الناصرية التي لا تزال تحتفظ بكثير من ركائزها ومقوماتها الأساسية فيما يتعلق بأسلوب الحكم والعلاقة بالمواطنين رغم تغير توجهات السلطة وانحيازها الاجتماعي، الذي تعبر عنه السياسات الاجتماعية والاقتصادية وأولوياتها، التي تظهرها بنود الموازنة العامة التي لا تفي بالحدود الدنيا للإنفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية المقررة بموجب دستور عام 2014، ناهيك عن الاتفاق على الثقافة، أو وضع سياسات وبرامج اجتماعية لمحاربة الفقر وما يرتبط به من جرائم قائمة وأخرى مستحدثة ووافدة.
فهل تجرى الانتخابات بما يسمح بمجلس تشريعي حقيقي يدفع إلى تشريعات تعكس أولويات منحازة للغالبية الساحقة من المواطنين وتراعي مصالحهم وتسعى للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتمهد للبدء في صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على التوافق على الأولويات ويوازن بين حقوق المواطنين وصلاحيات السلطة؟ أليس هذا السؤال أولى بالانشغال والإجابة عليه من تكرار نوبات السجال حول زعماء رحلوا بسياساتهم التي تجاوزتها التطورات والأحداث، وهل يمكن استعادة أي دور لمصر على الساحتين الإقليمية والدولية دون أن تقدم المثال والقدوة للتفكير في المستقبل وتحدياته؟
---------------------------
بقلم: أشرف راضي