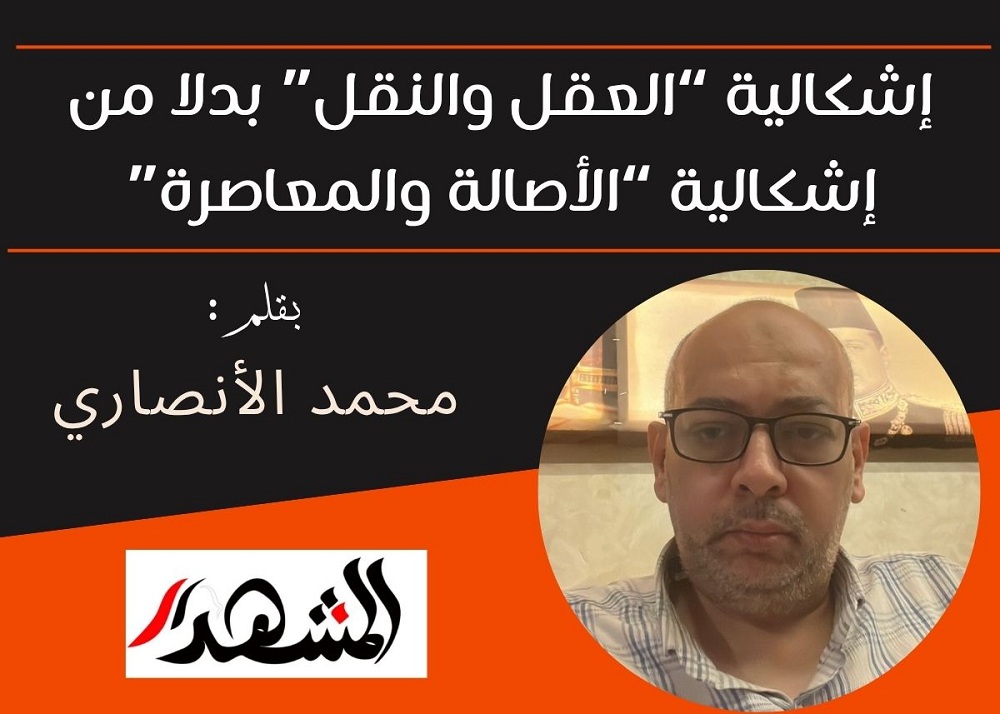سنظل أسرى لمقولاتنا السائدة ما لم نراجعها ونعيد تعريفها، أو نشطبها تمامًا ونستبدلها. هذا المقال يمثل استجابة لأفكار الدكتور مصطفى النشار، وهو واحد من أهم الرموز الفلسفية المصرية المعاصرة، ورئيس الجمعية الفلسفية المصرية. رصد الدكتور مصطفى في واحد من أهم كتبه بعنوان: "الفكر العربي الحديث بين الأوهام الأربعة ورؤى التجديد والنهوض" أربعة مقولات، تمثل في رأيه أوهامًا تعيق التفكير في النهضة والتجديد على أسس قويمة. الأوهام/ المقولات الأربعة هي: وهم تفوق الحضارة الغربية، ووهم التنمية والتقدم على الطريقة الغربية، ووهم الديمقراطية كنظام سياسي أمثل، ووهم الأصالة والمعاصرة.
غني عن الذكر أن كل مقولة من هذه المقولات تحتاج إلى مقالات، وربما دراسات للاشتباك معها، سواء اتفقت مع الدكتور مصطفى أو لم تتفق. ما يهمني هنا هو المقولة الرابعة المتعلقة بـ "وهم الاصالة والمعاصرة". وهذا موضوع يشغلني منذ زمان، إذ أرى هذه المقولة بمثابة تحصيل حاصل، لا تضيف ولا تحذف شيئًا. فنحن مشدودون لماضينا بكل حمولاته التراثية، شئنا أم أبينا، و في نفس الوقت نعيش تفاصيل الحداثة فكرًا وعملًا، شئنا أم أبينا. وفي ضوء ذلك الاستنتاج، أرى أن مقولة "العقل والنقل" أجدر بالاشتباك معها ومحاولة استنطاقها، لإيجاد حلول ناجعة لإشكالية النهضة التي تؤرقنا منذ ما ينيف على قرنين من الزمان.
إشكالية الأصالة والمعاصرة عند مصطفى النشار
يرى الدكتور النشار أنه آن الأوان لاستحداث أورجانون "آلة فكرية" جديد لتجاوز ثنائية الأصالة والمعاصرة، الناتجة عما أسماه "التمترس التاريخي" حول ثلاثة مواقف: موقف العودة للتراث، وموقف اعتناق الحداثة الكلي، والموقف التوفيقي (التلفيقي). ويؤكد أن وضع الإشكالية في قالب ثنائية "الأصالة والمعاصرة" تحصيل حاصل، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من ترسيخ الطابع التلفيقي. لكن مع كامل احترامي وتقديري للدكتور مصطفى، فإنه لم يطرح بديلًا حقيقيًّا يحل محل تلك الثنائية المفخخة.
شبهة ”احتكار النص" وشبهة "فرض المرجعية"
أنا أطرح ثنائية بديلة في هذا المقال، وهي ثنائية "العقل والنقل". لكن يحوط طرح هذه الثنائية مخاوف أساسية، قد تثار من جانب تيار متواجد لا يستهان به في جسم الأمة، وهو التيار الرافض للمرجعية الدينية. أهم المخاوف تتمثل في شبهتين: احتكار النص، وفرض المرجعية. وقبل أن أقدم مبررات ثلاثة للأخذ بإشكالية "العقل والنقل" يجب أن أسعى لتفكيك هاتين الشبهتين. فيما يتعلق باحتكار تفسير النص أو امتلاك المعنى الديني، فإن المخاوف المتعلقة بهذه النقطة هي مخاوف حقيقية، تستند إلى تراث تاريخي طويل من احتكار للعلوم الشرعية من قبل المؤسسة الدينية الإسلامية. ولكي لا يأخذنا التاريخ بعيدًا في بحور لجج، دعونا نبدأ من حدثين مفصليين في تاريخ المسلمين: الدعوة الوهابية في نجد، وانفصال التعليم الحديث عن الأزهر في ظل مشروع محمد علي التحديثي.
***
رسخت الدعوة الوهابية في حلف غير مقدس مع أمراء آل سعود، مبدأ تخلي الحاكم عن دوره الديني، الذي ظل يمارسه بشكل أو بآخر منذ صدر الإسلام. وأصبح التأويل الشرعي حكرًا على العلماء من أسرة آل الشيخ (أسرة محمد بن عبد الوهاب 1703-1792). والغريب أن موقف الوهابية هذا، التي تدعي الإيغال في شرعية التوجه الديني، هو موقف علماني بعمق، إذ يُرجع النص بتأويلاته إلى المؤسسة الدينية، بينما ينفرد الحاكم بالسياسة الدنيوية. من السخرية أن محمد بن عبد الوهاب الذي يتباهى بمرجعيته لابن تيمية صاحب "السياسة الشرعية في إصلاح أحوال الراعي والرعية" يتنكر على مستوى الممارسة لمجمل الرؤية الشرعية للرجل الذي يتخذه مرجعًا.
التطور التاريخي الثاني الذي رسخ مفهوم احتكار النص، جاء في طيات العلاقة بين الأزهر والوالي محمد علي في مصر، في النصف الأول من القرن التاسع عشر. كانت قضية فصل التعليم الحديث عن التعليم الديني في صلب أولويات الحاكم المصري. وفي الواقع، فإن حراس الأزهر من الغالبية غير المتنورة (الاستثناءات معدودة) قد رحبت بهذا الأمر؛ لما يعطيها من الامتيازات المصاحبة لاحتكار المعنى الديني من شرف، ووجاهة، ومال.
فرض المرجعية قضية لا تقل أهمية عن احتكار النص، ولكن يمكن النظر إليها من وجوه أخرى، ستتضح أكثر في سياق ما تبقى من المقال. ولكن لنتساءل سويًّا: منذ متى أحجم الرافض للمرجعية الإسلامية - مع كامل الإقرار بحقه في ذلك الرفض - عن استخدام النص الديني قرآنًا وسنة وفقهًا، في الوصول إلى قناعات مؤيدة لموقفه، متى ما كان ذلك مواتيًا؟ فلماذا يصبح الاستشهاد بالنص فرضًا للمرجعية فقط، في حالة أن يكون الاستنتاج غير موافق للقناعات؟ في الواقع، تنطلق رؤيتي من أن النص لدى غير المؤمن به أو بمرجعيته، يحمل قيمة فكرية ومعرفية بمعزل عن مصدره الإلهي.
ديمقراطية المعنى الديني
قبل احتكار المؤسسة الدينية لكل ما يتعلق بالعلوم الشرعية، وعلى رأسها إشكالية العقل والنقل، وهي صيرورة تمت على مدى زمني واسع، كان مفهوم الاجتهاد والتفكير الفردي في الأمور الدينية وعلاقتها بالواقع، أكثر شيوعًا وترسيخًا عبر العشرات من الآيات والأحاديث. وهنا تكتسب قضية العقل والنقل بعدًا ديمقراطيًّا واسعًا. لا يمكن أن ينادي عاقل بالانتهاء من المؤسسة الدينية تمامًا، ولكن شيوع ثقافة العقل والنقل سيساهم في حصول أمرين لازمين، في إطار نهضتنا الفكرية: نزع القداسة غير المبررة عن المؤسسة الدينية، بوصفها مؤسسة استشارية فقط، وإلغاء الاحتكار المطلق لتأويل النص الديني من جانب العلماء. وهذا غير ممكن في ظل سيادة إشكالية الأصالة والمعاصرة التي تحصر جوانب القضية في ثلاثة بدائل: إما القداسة المطلقة للمؤسسة الدينية، أو الرفض المطلق للنص، أو التلفيق المخزي. إني لا أطرح هنا أقل من أن تصبح إشكالية العقل والنقل هي إشكالية الجماهير، بدلًا من إشكالية الأصالة والمعاصرة، والتي هي بالأساس إشكالية نخبة.
لا يمكن القضاء على سلطة النص
منذ نزول الوحي وحتى قيام الساعة، لن يتمكن أي تيار أو حركة مهما كانت جارفة، ومهما ساندتها قوى خارجية، من القضاء على سلطة النص في قلوب وعقول ونفوس السواد الأعظم من المسلمين. لذلك قلت ما معناه أن النص مقدس لدى المؤمن، ويحمل حمولة معرفية ما لدى غير المؤمن. فلا مناص من التعامل معه من خلال إشكالية العقل والنقل. وبينما لا يمكن القضاء على سلطة النص، يمكن جعل إدراكه إدراكًا أكثر عقلانية. وذلك هو المبرر الثاني لتبني إشكالية العقل والنقل بديلًا عن إشكالية الأصالة والمعاصرة.
تجاوز إشكالية التفضيل
وأعني بإشكالية التفضيل مبدأ تفضيل العقل على النقل، أو تفضيل النقل على العقل، الذي ظهر منذ نشأة المعتزلة ثم الأشاعرة. يجب تجاوز هذه الإشكالية التي تشطر العقل النهضوي انشطارًا عنيفًا مؤلمًا. لكل قضية صغرت أو كبرت بعدان: نصي، وعقلي. فلا أدري حقيقة كيف ومتى نشأ هذ الانفصال التعسفي تحت مسمى النصوص "قطعية الدلالة". فحتى أكثر النصوص قطعية قابل للاشتباك المعرفي العقلي، مثلما فعل سيدنا عمر بن الخطاب مع حد السرقة، وسهم المؤلفة قلوبهم مثلًا. يجب أن نتجاوز التفضيل، فالعقل والنقل متضافران إلى يوم الدين، وقد اتفق على ذلك مؤلفان متنافران مشربًا، مثل ابن رشد وابن تيمية من بعده. وجاء دورنا نحن المعاصرين للإدلاء بدلونا في مشوار النهضة الممتد.
--------------------------------
بقلم: محمد الأنصاري