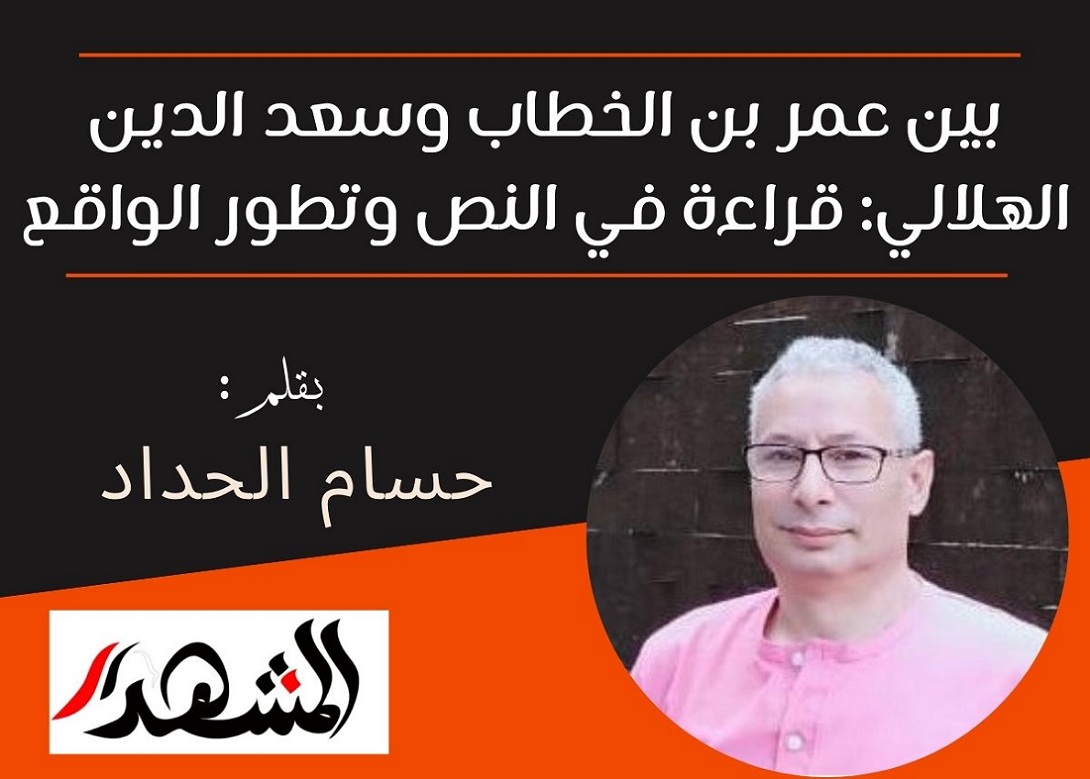في قلب الشريعة الإسلامية تقف النصوص القرآنية كمرجعية ثابتة، لا لبس فيها من حيث المصدر، ولكن عندما ننتقل إلى تطبيق هذه النصوص، نجد أمامنا تاريخًا طويلًا من التأويل والتفسير والاجتهاد. لقد أدرك فقهاء الإسلام الأوائل، وعلى رأسهم الصحابة، أن النصوص قد تكون ثابتة، ولكن الواقع متغير، والفقه هو جسر العبور بين النص والواقع. وفي هذا الإطار، يُمكن النظر إلى موقفين مهمين يبرزان مرونة الفقه الإسلامي: موقف الخليفة عمر بن الخطاب من آية "المؤلفة قلوبهم"، وموقف الدكتور سعد الدين الهلالي من مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
عمر بن الخطاب وآية "المؤلفة قلوبهم"
في سياق بناء الدولة الإسلامية وتثبيت أركان الدعوة، جاءت آية {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60]، لتحدد بوضوح مصارف الزكاة الثمانية، ومن بينها فئة "المؤلفة قلوبهم". وقد كانت هذه الفئة تشمل أولئك الذين إما دخلوا الإسلام حديثًا، أو كانت قلوبهم مائلة إليه، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي يرسّخ إيمانهم ويُحسن صورتهم عن الدين الجديد. في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يُعطى بعض وجهاء العرب من الزكاة ضمن هذا الباب، بهدف تعزيز الولاء، وتحييد الخصوم، وكسب الحلفاء.
لكن مع استقرار الدولة الإسلامية واتساع رقعتها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، أعاد النظر في هذا المصرف تحديدًا. فرأى عمر أن الإسلام لم يعد في حاجة إلى استرضاء أحد أو شراء ولائه بالمال، بعد أن قويت شوكة المسلمين، وتوسعت رقعة الإسلام جغرافيًا وعسكريًا واقتصاديًا. ومن هنا، قرر إيقاف صرف الزكاة لـ"المؤلفة قلوبهم"، معتبرًا أن هذا الباب كان مؤقتًا، يخدم ظرفًا تاريخيًا معينًا، وقد انتهت الحاجة إليه في ظل دولة قوية ومتماسكة.
لم يمر هذا القرار دون نقاش داخل صفوف الصحابة. فقد عبّر بعضهم، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس، عن اختلافه مع موقف عمر، معتبرًا أن الحكم الشرعي الوارد في القرآن لا ينبغي تعطيله، حتى لو تبدلت الظروف. كان النقاش في جوهره يدور حول مدى ارتباط النص القرآني بالسياق، وهل يجوز لولي الأمر أن يجمّد تطبيق نص من القرآن إذا رأى تغيّر مقتضى تطبيقه. لكن اللافت أن هذا الخلاف لم يصل حد الاتهام في العقيدة أو التشكيك في عدالة عمر، بل بقي في حدود الاجتهاد المشروع والاختلاف المقبول.
في النهاية، كان لقرار عمر دلالات أعمق تتجاوز حدود الواقعة نفسها؛ فقد كشف عن طبيعة فقهية مرنة تُراعي تغيّر الأحوال والمصالح العامة، وتعطي لولي الأمر صلاحية الاجتهاد في تنفيذ النصوص على ضوء معطيات الواقع. وهذا القرار لم يُفهم حينها بوصفه نسخًا للآية أو خروجًا على النص، بل كنوع من التعطيل الإجرائي المؤقت المبني على فقه المقاصد وتقديم مصلحة الجماعة. بهذا الموقف، أسّس عمر بن الخطاب نموذجًا عمليًا لفهم النص في ضوء الواقع، لا بمعزل عنه.
الدكتور سعد الدين الهلالي والمساواة في الميراث
في الأيام الأخيرة، أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا داخل الأوساط الدينية والاجتماعية في العالم العربي، بسبب آرائه الجريئة في قضايا الشريعة، وعلى رأسها مسألة الميراث. فقد دعا الهلالي إلى إعادة النظر في بعض أحكام التوريث، خصوصًا ما يتعلق بتفاوت أنصبة الذكور والإناث، حيث يرث الذكر مثل حظ الأنثيين في أغلب الحالات، معتبرًا أن هذا التفاوت كان مرتبطًا بسياق تاريخي واجتماعي معيّن، لم يعد قائمًا اليوم.
يرى الهلالي أن المرأة في العصر الحديث خرجت من دائرة التبعية الاقتصادية إلى ميادين العمل والتعليم والمشاركة المجتمعية الكاملة، وأصبحت في كثير من الحالات شريكًا أساسيًا، بل ومعيلًا رئيسيًا في الأسرة. وبالتالي، فإن التعامل مع المرأة بمنطق الاستضعاف والاحتياج المالي لم يعد منطقيًا في ظل هذا التحول العميق في أدوارها داخل المجتمع. من هنا، يدعو إلى إعادة قراءة النصوص المنظمة للميراث، ليس بهدف إنكارها، بل لفهم مقاصدها في سياقها الزمني وتفعيلها في ضوء الواقع المعاصر.
الهلالي لا يعتبر طرحه خروجًا عن الدين أو عدوانًا على النص القرآني، بل يرى فيه اجتهادًا مشروعًا يستند إلى قاعدة معتبرة في الفقه الإسلامي: "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان". ويؤكد أن آيات الميراث، مثل غيرها من التشريعات، جاءت لتحقيق العدل والرحمة والمصلحة، لا لفرض قوالب جامدة لا تصلح لكل زمان. ومن ثم فإن الاجتهاد في ضوء المتغيرات ليس تعديًا على النص، بل محاولة لتوصيله إلى الناس بما يحقق روحه ومقاصده في بيئة مغايرة.
مع ذلك، قوبلت آراء الهلالي بانتقادات شديدة من جانب المؤسسات الدينية التقليدية وعدد من العلماء، الذين اعتبروا أن أحكام المواريث منصوص عليها بوضوح في القرآن الكريم، ولا مجال للاجتهاد فيها. لكن الجدل الذي أثاره الهلالي أعاد فتح باب النقاش حول علاقة الشريعة بالواقع، وحدود الاجتهاد، ومدى إمكانية تطوير الفهم الديني بما يتلاءم مع متغيرات العصر. وبهذا الطرح، قدّم الهلالي نموذجًا لإسلام فقهي معاصر يحاول أن يوازن بين النص والثابت من جهة، ومتطلبات الواقع المتغير من جهة أخرى.
موقف المؤسسة الدينية من تصريحات الهلالي
قوبلت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث برفض قاطع من قِبل المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي شدد على أن أحكام المواريث في الإسلام قطعية الثبوت والدلالة، مما يعني أنها واردة بنصوص قرآنية صريحة لا تقبل الاجتهاد أو التأويل. وقد عبّر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن هذا الموقف بوضوح، مؤكدًا أن الدعوة إلى مساواة الرجل والمرأة في الميراث تتعارض مع صريح القرآن الكريم، ولا تستند إلى منهج علمي معتبر في الفقه أو أصول الشريعة.
وفسّر الأزهر تفاوت أنصبة الميراث من منطلق التكامل لا التمييز، موضحًا أن الرجل في الشريعة مُلزم بالنفقة على أسرته، زوجته وأولاده ووالديه، بينما المرأة، حتى لو كانت غنية، غير مطالبة شرعًا بالإنفاق على أحد، ولا تُلزم شرعًا بإعالة الأسرة. ومن هذا المنطلق، فإن ما قد يبدو "عدم مساواة" في الأرقام هو في الحقيقة عدالة وظيفية تراعي الأدوار الاجتماعية والمالية المفروضة على كل من الجنسين. وبالتالي، فإن محاولة فرض مساواة رقمية دون النظر إلى هذه الأعباء يُعد إخلالًا بعدالة الشريعة.
عدد من العلماء التابعين للمؤسسة الدينية، من بينهم أعضاء في هيئة كبار العلماء، أعربوا عن قلقهم من مثل هذه الطروحات، معتبرين أن الاقتراب من الأحكام القطعية يفتح الباب لفوضى فقهية، يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المرجعية الدينية. وحذّروا من أن التوسع في تفسير النصوص القطعية وفق الأهواء أو المتغيرات الاجتماعية، دون ضوابط أصولية دقيقة، قد يمهّد الطريق لإلغاء العديد من الأحكام الشرعية الأخرى بحجج مشابهة، مما يُضعف من صلابة المرجعية الفقهية الإسلامية.
ورغم أن الأزهر لم يهاجم الهلالي بالاسم في معظم تصريحاته، إلا أن رسائل الرفض كانت واضحة في سياقها وتوقيتها، حيث صدرت بيانات وتصريحات فورية بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل. ويعكس هذا الموقف تمسّك المؤسسة الدينية بدورها التقليدي في حماية النصوص القطعية ومنع تجاوزها، مؤكدة أن أي تطوير أو اجتهاد لا بد أن يبقى ضمن الثوابت الشرعية التي لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف، حتى لو تغيّر الواقع أو تطورت الأدوار الاجتماعية.
المقارنة بين موقف عمر والهلالي
رغم الفارق الزمني الكبير بين موقف عمر بن الخطاب في صدر الإسلام، وموقف الدكتور سعد الدين الهلالي في العصر الحديث، فإن كليهما ينطلق من رغبة في ملاءمة الأحكام الشرعية للواقع المتغيّر. عمر أوقف سهم "المؤلفة قلوبهم" من الزكاة لأن مبرراته في سياق الدعوة الأولى للإسلام قد انتفت، بينما الهلالي يدعو إلى إعادة النظر في أنصبة الميراث، لأن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة قد تغيّر جذريًا. في الحالتين، لم يكن الدافع مجرد رأي شخصي، بل اجتهادًا مرتبطًا برؤية مقاصدية للشرع تهدف إلى تحقيق المصلحة.
في كلا الموقفين، هناك قراءة فقهية تفاعلية تُراعي تغير الأحوال والظروف. عمر رأى أن تأليف القلوب بالمال لم يعد ضروريًا بعدما اشتد عود الدولة الإسلامية، فأسقط هذا السهم اجتهادًا. والهلالي يرى أن المرأة التي أصبحت شريكة في الإعالة والتعليم والعمل، لم تعد تستدعي تخصيصًا ماليًا أقل من الرجل. هذه القراءة المقاصدية في كلا الحالتين تعكس فهمًا لاكتفاء الأحكام بالنصوص فقط، بل باشتراط تفعيلها في بيئة اجتماعية تؤدي نفس الغرض الذي جاءت الأحكام من أجله.
كما أن كليهما يُعبّر عن مرونة كامنة في الفقه الإسلامي، تسمح بإعادة النظر في التطبيق بحسب تغير الواقع، دون أن يعني ذلك مساسًا بالنص القرآني ذاته. عمر لم يُنكر وجود سهم "المؤلفة قلوبهم" في الآية، لكنه رأى أن شرط تطبيقه – وهو الحاجة لتأليف القلوب – لم يعد قائمًا، والهلالي لا ينكر نصوص الميراث، لكنه يدعو إلى اجتهاد تأويلي يعيد فهمها في ضوء التطورات المعاصرة. هذه النقطة المشتركة تسلط الضوء على الفقه بوصفه نشاطًا بشريًا يتعامل مع النص من خلال الواقع.
وأخيرًا، يُظهر موقف كل من عمر والهلالي أن الاجتهاد ليس طعنًا في النص، بل تجديدٌ في تنزيله على الواقع. اجتهاد عمر قُبل من أغلب الصحابة لأنه صدر من رجل عُرف بفقهه وبعد نظره، أما الهلالي، فرغم الهجوم عليه، فإنه يتموضع ضمن تيار يعتقد أن الجمود على تفسيرات قديمة دون اعتبار لتغير الزمان والمكان يعيق وصول الشريعة إلى مقاصدها. في الحالتين، فإن الاجتهاد كان محاولة لإبقاء الشريعة حيّة في الناس، لا معطّلة بفعل تغيّر الزمان.
دلالات الموقفين وأهمية فهم النص
يعكس موقف كل من عمر بن الخطاب والدكتور سعد الدين الهلالي قضية محورية في الفقه الإسلامي، وهي التفاعل الديناميكي بين النص القرآني الثابت والواقع المتغير. فالنصوص، بوصفها وحيًا، محفوظة لا يطالها التبديل أو التحريف، لكنها – في الوقت ذاته – تستدعي عقلًا بشريًا قادرًا على فهمها وتفعيلها في سياقات تاريخية واجتماعية متجددة. وهذا الفهم لا يكون جامدًا، بل مفتوحًا على الاجتهاد الذي يستقرئ المقاصد ويتلمس المصلحة العامة.
من خلال قراره بإيقاف سهم "المؤلفة قلوبهم"، يُقدّم عمر بن الخطاب نموذجًا عمليًا لفهم الاجتهاد: لم يُلغ النص أو يشكك في مصداقيته، لكنه نظر إلى الحكمة منه وظرفه التطبيقي، فوجد أن العلة التي أُعطي من أجلها هذا السهم لم تعد قائمة. ومن هنا، أعاد توجيه النص إلى ما يخدم المصلحة الراهنة للأمة، مع المحافظة على قدسيته. بهذا المعنى، يُصبح الاجتهاد أداة لخدمة النص، لا للتحرر منه.
أما الهلالي، فهو يُحيي سؤالًا فقهيًا جادًا حول أدوات الفهم المعاصرة للنصوص المرتبطة بالواقع الاجتماعي، خصوصًا تلك التي تشكّل مساحات تماس حساسة بين التشريع وحياة الناس اليومية، مثل الميراث. وهو بذلك يدعو إلى أن نتحلى بالشجاعة الفقهية التي امتلكها عمر، ولكن ضمن ضوابط مؤسسية تضمن ألا يتحول الاجتهاد إلى فوضى تأويلية. الهلالي لا يتحدى النص، بل يتحدى الجمود في آلية التعامل معه.
كل هذا يقود إلى سؤال حيوي: هل نمتلك اليوم القدرة المؤسسية والعلمية على التمييز بين "الثابت" و"المتغير" في الشريعة؟ إن فتح هذا الباب يتطلب إعادة تفعيل أدوات الاجتهاد، وتطوير المؤسسات الدينية والفكرية التي تتولاه، بحيث تجمع بين أمانة النص وفهم الواقع. وإذا لم نجب عن هذا السؤال بجدية، فإن الفقه سيبقى رهين فتاوى الماضي، بعيدًا عن هموم الحاضر، وغير قادر على مواكبة تحولات العصر.
------------------------------
بقلم: حسام الحداد