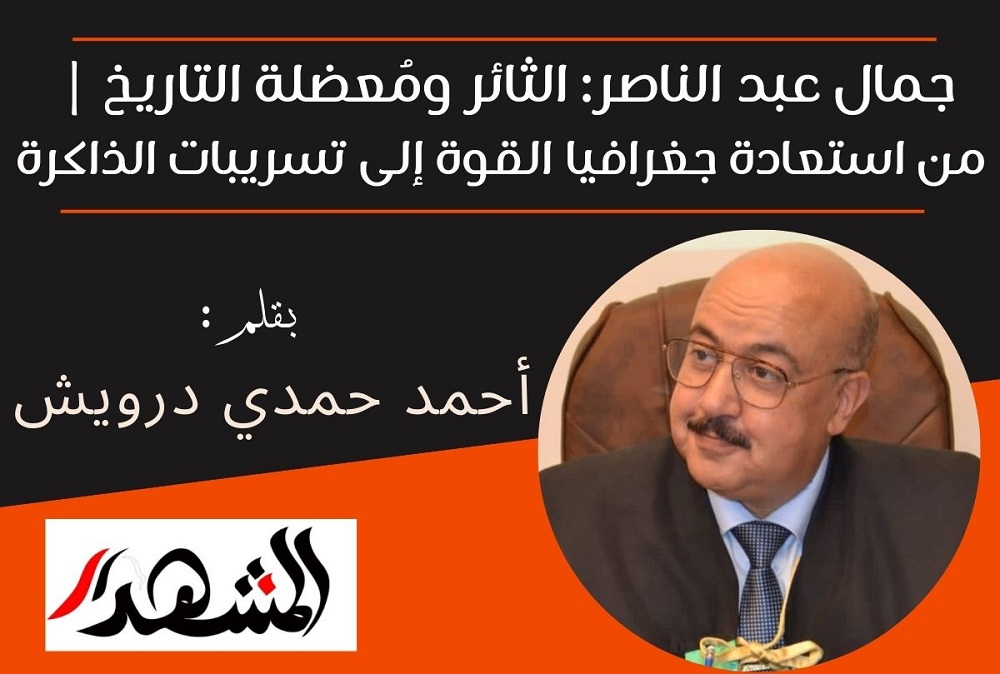جمال عبد الناصر (1918–1970)، ليس مجرد زعيم سياسي، بل ظاهرة تاريخية حوَّلت مسار مصر والمنطقة العربية وأفريقيا، وقاد ثورة 23 يوليو1952، التي أنهت الحكم الملكي، والإرث الاستعماري الذي دام 2309 سنوات (نعم 2309 سنوات من الاحتلال تبادلت خلالها أمم مختلفة الإرث المصري فيما بينها وتركت أثراً عميقًا مازلنا نعاني منه)، كما أسس ناصر لعهد جديد قائم على العدالة الاجتماعية والقومية العربية ومقاومة الاستعمار ورغم الانتقادات التي تُوجَّه لسياساته ولا ننكر أن بعضها إيجابي، إلا أنه يظل رمزاً للكرامة الوطنية ومشروعاً تحررياً استثنائياً، تُحلِّله الدراسات الأكاديمية كحالة فريدة في بناء الدولة الحديثة خارج الإطار الغربي.
ومؤخرًا تم تسريب مكالمةٌ هاتفيةٌ مفترضةٌ بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين معمر القذافي، تُظهر الزعيمَ الثوري، ناصر، في لحظةِ مراجعةٍ صادمة لمواقفه التحررية، فهل تعكس هذه التسريبات تحولًا استراتيجيًّا في سياساته تحت وطأة الإرهاق العسكري وانكسارات النكسة، والضغوط السوفيتية، أم أنها محاولةٌ مُفتعلةٌ لتفكيك أسطورته؟ فتحليل التسريب يفتح أبوابًا شائكة؛ فبينما يُلمّح المحتوى إلى واقعيةٍ جديدةٍ تبررها تحديات 1970، إلا أن توقيت النشر اليوم – مع تصاعد حرب غزة – يطرح أسئلةً عن أهداف خفية، هل يُعادُ توظيف تاريخ ناصر لتبرير سياساتٍ راهنةٍ تُهادن الاحتلال؟ أم أن الصراع داخل عائلته وأرشيفه هو ما أخرج هذه الوثيقة إلى النور؟
وبين "الخيانة" و"المراجعة"، يبقى السؤال الأكبر؛ مَن يملك حقّ تفسير الماضي، وكيف يُحوَّلُ التاريخ إلى سلاحٍ في معارك الحاضر؟ وهذه الورقة تُحاول تفكيك الخيط الرفيع بين الواقع والأجندة.
الفصل الأول،
بناء الإنسان المصري: الثورة الاجتماعية والاقتصادية
لم يكن جمال عبد الناصر مجرد قائد يطمح إلى تغيير نظام الحكم، بل كان مُهندسًا لثورةٍ إنسانية تمسّكت بفكرة واحدة؛ أن التحرر السياسي لا يكتمل إلا بتحرير الإنسان من قيود الجهل والفقر والتهميش، فبعد قرون من النظام الإقطاعي الذي حوّل الفلاح إلى عبدٍ للأرض، والمرأة إلى كائنٍ هامشي، والطبقات الفقيرة إلى وقودٍ للامتيازات، جاءت ثورة يوليو 1952 لتهزّ هذه البُنى من جذورها.هنا لا نتحدث عن سياساتٍ جافة، بل عن ثورة في مفهوم المواطنة. فكيف حوّل ناصر الأراضي من سجونٍ للعبودية إلى مصدرٍ للكرامة؟ وكيف استبدل ثقافة "الاستعانة بالأجنبي" بإرادة التصنيع المحلي؟ ولماذا اعتبر أن تعليم الفتاة الريفية وتطعيم طفل الصعيد هما أقوى أسلحة الوطن؟
من قوانين الإصلاح الزراعي بتحديد الملكية الزراعية، وتوزيعها على الفلاحين، الأمر الذي قلَّص الفوارق الطبقية، التي قلبت موازين القوى في الريف، وبفضلها انتشر التعليم وتحسنت الصحة العامة بين ابناء الريف المصري، فانخفض معدل وفيات الأطفال بنسبة 30%، فضلا عن الالتزام بمجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية، فارتفعت أعداد الطلاب بجميع المراحل التعليمية من (840,000) طالب عام 1952 إلى (550,000) طالب عام 1970، إضافة إلى صروح الصناعة لاسيما الثقيلة التي حوَّلت العمال إلى شركاء في التنمية، وحققت اكتفاءً ذاتيًا فريدًا في التاريخ الحديث مدعومًا ببنك التنمية الصناعية، وقد ساهمت تلك الصروح الصناعية في تحقيق أعظم نصر على أكبر تحدي استراتيجي في تاريخ مصر المعاصر خلال حرب الاستنزاف، وصولًا إلى السد العالي الذي حمى مصر من الفيضانات ووسّع الرقعة الزراعية، فلم يُروِ الأرض فحسب، بل أرواحًا عطشى للأمل… هنا تُكتشف أولى لبنات "الجمهورية الجديدة"، التي أرادها ناصر وطنًا لا يُقسَّم أبناءه إلى سادة وعبيد، بل إلى أيدي تبني وعقول تُبدع. وهكذا، وبين مصانع حلوان وصفارات مدارس القرى، ووجوه نساءٍ لم تته في زخم تلك الحقبة، فدخلن البرلمان لأول مرة، ومنحن حق التصويت والمشاركة السياسية، واندفعن لأول مرة في التاريخ الحديث إلى المنافسات السياسية والمناصب العليا، فنحن هنا نقرأ قصة مشروعٍ لم يكتفِ برفع العلم فوق القصور، بل رفع كرامة الإنسان فوق كل الاعتبارات.
الفصل الثاني،
القومية العربية ومحاربة الاستعمار
إذا كان بناء الإنسان المصري هو قلب المشروع الناصري، فإن انطلاقته نحو العروبة والعالم كانت روحه التي لا تُقهَر، فلم يكتفِ عبد الناصر بتحرير مصر من الاستعمار، بل رأى في كلِّ شبرٍ عربي أرضاً يجب تحريرها، وفي كلّ ثورةٍ أفريقية صوتاً يُكمِّل صرخته، وكانت رؤيته كالإعصار: تبدأ من وادي النيل، لكنها لا تعرف حدوداً إلا حيث ينتهي الظلم. هذا ليس مجرد سردٍ لتحالفاتٍ سياسية أو معارك دبلوماسية، بل هو قصة حلمٍ كاد يُغيِّر وجه المنطقة، فكيف حوّل ناصر قناة السويس من شريان استعماري إلى رمزٍ للكبرياء الوطني وصرخة ضد الهيمنة الغربية، محققاً انتصاراً سياسياً رغم العدوان الثلاثي؟ ولماذا آمن بأن دماء الجزائريين الثائِرين هي جزء من دماء المصريين؟ وكيف استطاع، بصوته الجهوري عبر "صوت العرب"، أن يُحوِّل فلسطين من قضيةٍ مُهمَّشة إلى جمرةٍ تتقد في ضمير كل عربي؟
فمن وحدة مصر وسوريا التي أزهرت كأول تجربةٍ عربية معاصرة للوحدة، إلى مؤتمر باندونج حيث جسَّد تحالف "الجنوب العالمي" ضد استغلال الشمال، وصولاً إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كإعلانٍ بأن الحق لا يُورث ولا يُساوم عليه… هنا نقرأ كيف حوَّل ناصر السياسة الخارجية من لعبة مصالح إلى رسالة وجود. إنه زمن المُستحيل الذي تحوَّل إلى واقع، ففتحت مصر أبوابها لكل ثائرٍ عربي وأفريقي، ورفضت أن تكون حارساً للحدود، فاختارت أن تكون جسراً للتحرير والتحرر، وكانت أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز التي تدعو إلى سياسة خارجية مستقلة عن المعسكرين الشرقي والغربي، وسعت جاهدة إلى تحقيق وحدة عربية، وحتى حين تعثرت خطواتها، ظلَّت فكرتها كالنار تحت الرماد، تنتظر من يُعيد إشعالها.
الفصل الثالث،
أفريقيا في قلب الاستراتيجية الناصرية
لم يكن جمال عبد الناصر قائدًا مصريًّا أو عربيًّا فحسب، بل كان ابنًا للقارة السمراء التي رأى في نضالاتها امتدادًا طبيعيًّا لمعركة مصر ضد الاستعمار، فإذا كانت العروبة دمه، فإن أفريقيا كانت نبضه الذي ينبض بوتيرة واحدة: وتيرة التحرر، فمن أعماق القاهرة حيث تُنسج السياسات، امتدت يده لتلامس أدغال الكونغو وسهول كينيا، مؤمنًا أن تحرير مصر لن يكتمل إلا بتحرير كل شبرٍ يُكبل بالسلاسل. هذا الفصل من حياة مصر يروي قصة إخاءٍ ثوري تجاوز الجغرافيا، فكيف حوَّل ناصر الأزهر من جامعٍ إلى جسرٍ ثقافي يربط بين الإسلام الأفريقي والعربي؟ ولماذا أرسل مدرسين مصريين إلى مالي وتشاد قبل أن تُبنى فيها المدارس؟ وكيف استطاع، بمجرد استضافة مؤتمرٍ في القاهرة، أن يُعيد تعريف التضامن الدولي بعيدًا عن وصاية القوى العظمى. من تدريب "الماو ماو" الكينية على فنونالمقاومة، إلى دعم باتريس لومومبا الذي دفع حياته ثمنًا لحرية بلاده، وصولًا إلى خطاباتٍ نارية في قمم الوحدة الأفريقية تُذكِّر الزعماء بأن "الاستعمار الجديد يرتدي عباءة الاقتصاد"… "الاستعمار الجديد يرتدي عباءة الاقتصاد"... (نكررها مرارًا وتكرارًا) هنا نكتشف أن ناصر لم ينظر إلى أفريقيا كخريطةٍ سياسية، بل كجسدٍ واحد تُؤلمه جراحٌ مشتركة.
لقد كانت مصر تحت قيادته القاهرة الأفريقية بامتياز: عاصمةً للثوار، ومركزًا لإشعاع فكريٍّ جمع بين الأصالة الدينية والحداثة التنموية، حتى في لحظات ضعف النظام الدولي، ظلَّ صوت ناصر يتردد في أرجاء القارة: "ليست الحرية ملكًا لشعبٍ دون آخر، بل هي النهر الذي يروي كل الأوطان العطشى"..
الفصل الرابع،
السياسات العالمية.. إرث لا يُنسى
إذا كانت الفصول السابقة تُجسِّد مشروع ناصر المحلي والعربي والأفريقي، فإن هذا الفصل ينتقل بك إلى رحابة العالم، حيث حوَّل الزعيم المصري سياساتِه إلى مِطرقةٍ تُحطم قيود التبعية، وإبرةٍ تخيط ثوبًا جديدًا للجنوب العالمي، فلم يكن ناصر رجلًا يُقلِّد النماذج الجاهزة، بل كان مهندسًا لاشتراكيةٍ عربية، تخلط تراب الأصالة بأسمنت الحداثة، تجسدت في الجمع بين التخطيط المركزي والقطاع العام، مستلهماً تجارب مثل الصين 'ماو'، ولكن بخصوصية عربية، جعلت من الاقتصاد سلاحًا للاستقلال بدلًا أن يكون أداةً للاستعمار.
فهنا حيث يُمسك ناصر بخيوط اللعبة الدولية بيدٍ من حديد، ونسمع صدى رفضه لشروط صندوق النقد الدولي كصرخةٍ مدوية: "لا مساومة على سيادة القرار".. فكيف استطاع أن يُحوِّل القروض السوفييتية إلى مصانعَ تلد الحديد وتُنعش الأمل؟ ولماذا آمن بأن "الاتحاد الاشتراكي" ليس حزبًا سياسيًّا فحسب، بل ورشةً لصنع المواطن المنتج، ومن تأسيس نموذجٍ اقتصاديٍ يرفض التصنيفات الجاهزة – لا شرقي ولا غربي – إلى تحويل مصر من حقول قطنٍ إلى مداخنَ صناعية، ومواجهة الديون بخطى واثقة.. وهنا تُكتشف مقولة ناصر الخالدة: "الاقتصادُ هو حرب التحرير الحقيقية".
إنه فصلُ المُغامرة المدروسة، حيث تُلامسُ أحلامُ العالم الثالث أرضَ الواقع، فحين رفض ناصر أن يكون تابعًا، لم يدفع مصر نحو العزلة، بل صنع لها مكانًا تحت شمس السياسة الدولية، مكانًا لا يُقاس بالذهب، بل بالكرامة.
الفصل الخامس،
نكسة 1967.. المؤامرة أم الإخفاق؟
في خريفِ المشروع الناصري، حيثُ كانت أحلامُ التحرر تُثمرُ وحدةً عربيةً وصناعاتٍ واعدة، هبَّت عاصفةٌ قلبت كلَّ الموازين، فلم تكن حربُ 1967 مجرد هزيمة عسكرية، بل زلزالٌ سياسيٌ هزَّ أركانَ "الجمهورية الجديدة"، ووضعَ ناصرَ أمامَ مرآةِ التاريخ: هل كانت النكسةُ مؤامرةً دوليةً لاغتيال المشروع التحرري، أم ثمنًا لثغراتٍ في البناء الداخلي؟ هذا الفصلُ ليس محاكمةً لشخص، بل غوصٌ في أعماقِ لحظةٍ حاسمةٍ كشفتْ هشاشةَ الأحلام الكبرى أمامَ واقعِ الجيوبوليتيك، فكيف سقطَت صواريخُ التفوق الإسرائيلي كالمطر الناري على جيشٍ كان يعدّ العدةَ لمعركةٍ أخرى؟ ولماذا خرجَ المصريون بالملايين – رغم الهزيمة – رافضين الهزيمة، رافضين التنحي، يصرخون: "هنحارب"؟ومن غرفِ العمليات المُظلمة التي فشلتْ في قراءةِ تحركات العدو، إلى شوارعِ القاهرة التي حوّلت استقالةَ الزعيم إلى انتصارٍ شعبيٍ لإرادة البقاء… هنا تُفتحُ الجراحُ وتُطرحُ الأسئلةُ المُؤلمة، هل خانَ الحلفاءُ العربُ مصرَ؟ أم أن خطابَ "القيادة العربية" أخفى ضعفًا استراتيجيًّا؟
وبين رواية المؤامرة التي تحمّلُ الخارجَ كلَّ المسؤولية، ورواية الإخفاق التي تبحثُ عن الأخطاءِ الداخلية، يقفُ هذا الفصلُ على حافةِ الهاوية، لكنه لا يكتفي بالسقوط، بل يلتقطُ لحظةَ الارتداد الأخير: عودةُ ناصر بقوةِ المظاهراتِ التي أرادتْ أن تقولَ للعالم: "الهزيمةُ قد تُسقطُ أرضًا، لكنها لا تُسقطُ إرادةَ شعبٍ اختارَ كرامتَه سلاحًا". إنه فصلُ الواقعِ المرير الذي يُعيدُ تشكيلَ الأسطورة، فكما قال ناصر نفسه: "إن الهزيمةَ قد تُعلِّمُ أكثرَ من النصر"، وكأنه كان يرى في دماءِ يونيو بذورَ صحوةٍ قادمة. فمن سياق الحرب ونتائجها؛ تُعزى الهزيمة لعوامل متعددة؛ تفوق عسكري إسرائيلي، دعم غربي لإسرائيل، أخطاء استخباراتية مصرية، تقدير خاطئ للموقف، وأخيرًا هشاشة التحالفات العربية، إلا ان المظاهرات الشعبية العارمة الصارخة بالأمل رفضت تنحي ناصر وأعادته بشرعية شعبية جارفة.
الفصل السادس،
مكالمة ناصر والقذافي (أغسطس 1970): السياق والدوافع
قبل شهرٍ واحد من رحيل جمال عبد الناصر (سبتمبر 1970)، كانت المنطقة تعيش ذروة توترات "حرب الاستنزاف" مع إسرائيل، وضغوطًا اقتصاديةً وعسكريةً هائلة على مصر. في هذه الأجواء، يُفترض أن المكالمة المُسربة تعكس مرحلةَ مراجعةٍ استراتيجية من ناصر، ربما تحت وطأة:
1. الإرهاق العسكري: خسائر متتالية في الأرواح والمعدات بعد عامين من الحرب.
2. الضغوط السوفيتية: موسكو تُلحّ على تسويةٍ سياسيةٍ لوقف نزيف الدعم لمصر.
3. القلق من تدخلات إقليمية: تصاعد التوتر مع ليبيا بقيادة القذافي، الذي كان يُنظر إليه كشريكٍ غير مستقر.
مضمون المكالمة؛ بين "الواقعية" و"الأسطورة"
حسب التسريب، يبدو ناصر – المُلهِم الثوري – منكسرًا، يُجادل بضرورة "إعادة حساب المواقف" تجاه القضية الفلسطينية، معتبرًا أن التضحيات المصرية في الصراع قد تجاوزت حدود المصلحة الوطنية، وهذا الطرح، إذا صحّ، لا يعني تنكرًا لمبادئه، بل قد يكون تعبيرًا عن:
- رهانٍ على الدبلوماسية: استعدادٌ لمساراتٍ سريةٍ مع القوى الدولية، كتلك التي قادت لاحقًا إلى اتفاقية كامب ديفيد (1978).
- إدراكٍ لاختلال موازين القوة: الهزيمة العسكرية في 1967 جعلت استمرار المواجهة المباشرة مستحيلًا دون إعادة بناء الجيش خاصة حائط الصواريخ.
- قلقٌ من التورط الليبي: حديثه مع القذافي ربما يحمل تحذيرًا من مغبة الاندفاع العسكري غير المحسوب.
وبمحاولة البحث حول دوافع التسريب الآن – تفكيك الأسطورة لصالح الأجندة الحالية – فتحليل الاستاذ أشرف راضي خلال تعليقه على مقال (تسجيلات ناصر "تنكأ جراح القومية العربية"... لكن لماذا الآن؟) المنشور بجريدة النهار العربي بتاريخ 29 إبريل 2025، يشير إلى أن التسريب – خاصةً إذا صدر من عائلة ناصر – قد يُستخدم لتبرير سياساتٍ مصريةٍ راهنة، مثل:
1. تطبيع العلاقة مع إسرائيل: تقديم ناصر "الواقعي" كنموذجٍ يشرعن التعايش مع الاحتلال تحت ذريعة "المصلحة الوطنية".
2. تقويض السردية الثورية: تفريغ القضية الفلسطينية من بُعدها العروبي، وتحويلها إلى مجرد "أزمة حدودية".
3. ضرب شرعية المقاومة الفلسطينية: إذا كان ناصر نفسه يُفاوض سرًّا، فلماذا تُدان حماس أو غيرها اليوم؟
ويربط بين نشر التسريب وبين التصعيد الحالي في غزة، بتوقيت مريب حيث الانقسام العربي، وحيث تواجه مصر ضغوطًا دوليةً لعزل المقاومة، وقد يكون الهدف:
- تشتيت الرأي العام: تحويل النقاش من جرائم الحرب الإسرائيلية إلى "فضائح تاريخية".
- إضعاف الجبهة الداخلية المصرية: تشكيك الشباب في ثوابت كانت مُقدسة، مثل أولوية فلسطين.
- تلميع صورة النظام المصري: عبر تصوير موقفه الحالي كامتدادٍ لواقعية ناصر، لا كخيانةٍ للقضية.
الفصل السابع،
أبرز الانتقادات لسياسات ناصر
1. الاستبداد السياسي تحت شعار "الشرعية الثورية"
- ألغى التعددية الحزبية وحوّل النظام إلى حكم الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي) وقمع المعارضين بذرائع مثل "حماية الثورة".
- حوّل المؤسسات إلى أدوات لتعزيز سلطته الشخصية، كتحويل البرلمان إلى مجلس مُصفّق (موافقون).
2. فشل النموذج الاقتصادي المركزي
- أدت سياسات التأميم والتخطيط المركزي إلى بيروقراطية معطلة، وانهيار الإنتاجية في القطاع العام.
- اعتماد الاقتصاد على القروض الخارجية (خاصة السوفيتية) زاد الدين العام دون ضمانات استدامة.
3.عسكرة الدولة وتضخم الدور الأمني
- سيطرت المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد والسياسة، مما أضعف الكفاءة المدنية.
- حوَّل المخابرات العامة إلى دولة داخل الدولة، لترسيخ النظام عبر الخوف.
4. إخفاق المشروع القومي العربي
- فشل الوحدة مع سوريا (الجمهورية العربية المتحدة) كشف تناقضات بين الخطاب العاطفي والواقع السياسي.
- دعمه لحركات التحرر بالسلاح دون استراتيجية واضحة أوجد فوضى إقليمية (مثل أزمة اليمن).
5. إدارة الصراع مع إسرائيل بتهور
- تجاهل تحذيرات استخباراتية قبل نكسة 1967، ووضع الجيش في موقف غير متكافئ.
- ربط القضية الفلسطينية بالصراع العسكري المباشر، دون تطوير أدوات دبلوماسية بديلة.
6. تهميش التنمية الريفية الحقيقية
- رغم الإصلاح الزراعي، ظلّت الفجوة بين الريف والحضر كبيرة، مع تركيز الاستثمارات في المدن الكبرى.
- غياب سياسات بيئية أدى لاستنزاف الموارد (مثل آثار السد العالي على التربة).
الخاتمة،
عبد الناصر في ذاكرة التاريخ
رغم مرور نصف قرن على رحيله، لا يزال ناصر حاضراً في الخطاب السياسي العربي والأفريقي، كمشروعٌ تحرري فكري واجتماعي مستمر، فقد وضع قواعد الدولة القوية المستقلة، ودعم عدالة التوزيع، وجمع بين العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، وسعى لتوحيد الأمة العربية والإفريقية سياسياً وثقافياً، وإن اختلفت التقييمات حول بعض ممارساته وأساليبه، فإن إنجازاته في التأميم والإصلاح الزراعي والسد العالي، وانتصاراته الرمزية في مواجهة الإمبريالية، جعلته رمزاً لا يُمحى في الذاكرة الجماعية، ومُلْهمَ أجيالٍ من قادة العالم الثالث حتى اليوم، وإن إنجازاته في التعليم والصناعة، ومواقفه المناهضة للاستعمار، تؤكد أنه لم يكن مجرد زعيم لمرحلة، بل مهندساً لوعي جمعي جديد، والنقد العلمي لناصر لم يقلّل من شأنه، بل يُظهر إشكاليات أي مشروع تحرري يواجه تناقضات؛ الثورة أم الاستقرار؟ الشعبوية أم الديمقراطية؟ التحرير أم التنمية؟ وكما قال المفكر ياسين الحافظ: "ناصر صنع أمّةً تبحث عن هويتها، لكنه لم يترك لها أدوات الحفاظ عليها"، وكما قال الكاتب محمد حسنين هيكل: "ناصر جعل المصريين يعتقدون أنهم قادرون على تغيير مصيرهم"، وهذه أعظم هزيمة للمستعمر...
وفيما يخص المكالمة المسربة، فالتاريخ سلاحٌ ذو حدين، ويمكن أن نفترض صحة التسريب، لأن تفسيره يجب أن يراعي تعقيدات لحظة 1970، لا أن يُختزل إلى "خيانة"، فناصر – كأي زعيم – واجه معضلاتٍ بين المبدأ والواقع، لكن اختيار توقيت الكشف عنه بعد نصف قرن يُثير شكوكًا حول نوايا من يدفع به اليوم، فهل الهدف هو فهم التاريخ أم توظيفه لتمرير استسلام الحاضر؟
والسؤال الأكبر: لماذا تُعادُ كتابةُ تاريخ ناصرالآن، في وقتٍ تُحاصرُ فيه غزة، وتتراجعُ مكانةُ القضية الفلسطينية؟ والجواب قد يكمن في مقولة ناصر نفسه: "إذا أردتَ قتل المستقبل، ابدأ بتحريف الماضي".
----------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش